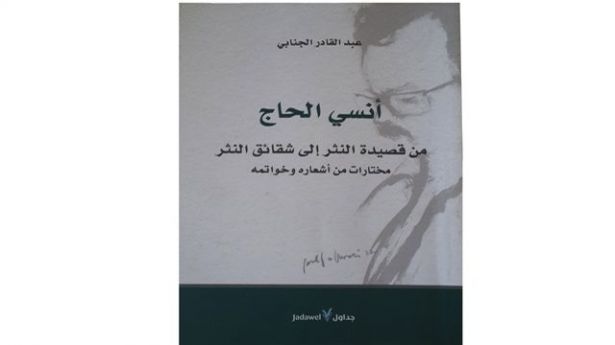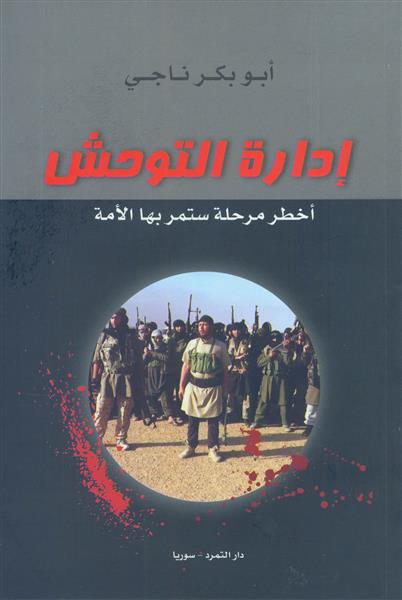سورية: آليات الاستبداد وعوامل تفككه

سليمان تقي الدين
في هذه المراجعة أربعة كتب عن سورية لاكاديميين من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية صدرت مترجمة عن دار رياض الريّس للكتب والنشر. ومع ان الكتب صادرة كلها منذ عقد من الزمن اقلا، الا انها تقدم خلفية مفيدة لفهم آليات تشغيل النظام السوري.
ليزا وادين: مراوغات السيطرة
تتناول وادين مسألة «شرعية النظام» في سورية رغم تحفظها على نظرية الشرعية، لتجد أن النظام امتلك شعبية وأشرك جمهوره في الموافقة على القرارات السياسية الخارجية المتعلقة بمناهضة ضغوط أميركا وإسرائيل. وتتساءل وادين عن استخدام ريموند هينبوش مفهوم النظام البونابرتي بالنسبة لنظام البعث استنادا الى تحليل ماركس عن «نظام سلطوي يعقب الثورة ويكون فوق الطبقات ويشرف على تشكيل الدولة الجديدة والانتقال من النظام الاقطاعي إلى نظام حداثي معقد». لكنها لا تجد في هذا النوع من التأويل أو التفسير السوسيولوجي غايتها. فهي ترى «أن ظاهرة تقديس الأسد هي استراتيجية للسيطرة قائمة على المطاوعة بدلا من الشرعية». ينتج النظام «المطاوعة» (فرض الطاعة) من خلال المشاركة الاجبارية في اشكال الامتثال الزائفة الجلية، سواء لأولئك الذين يخترعون هذه المظاهر أو أولئك الذين يستهلكونها. وتعمل ظاهرة تقديس الرئيس حافظ الأسد كأداة ضبط تفرز سياسة الخداع العام التي يتصرف المواطنون خلالها كما لو أنهم يحترمون قائدهم.
صحيح أن الايديولوجيا البعثية المستخدمة في مشروع قداسة السلطة والرئيس هي بيئة تعبوية تحريضية، لكنها «محفورة في الممارسة السياسية» (التوسير، هول) ولينين أيضا هو القائل ــ بعد ماركس ــ أنه تصبح للأفكار قوة مادية حين تسيطر على أذهان الجماهير. تترافق شخصنة السلطة مع انتاج «نخبة» هي التي تشكل عصب المشروع. فالانضباط والعقاب (فوكو) هما آليات تكنولوجية تستخدمهما السلطة في تأكيد حضورها الطاغي، عبر الاستعراضات العامة والدائمة.و ليس العقاب كما في حال السجناء السياسيين إلاّ وسيلة من بين عدة وسائل، بل أن العقاب لا يعود ضروريا حين تصبح القداسة حصارا شاملا للمجتمع ينفي الخصوم ويزيلهم عند الضرورة.
تذكر وادين فكرة مهمة عن ان السياسة ليست فقط الصراع على السلطة المادية، بل هي أيضا منافسة حول العالم الرمزي وحول إدارة المعاني والاستحواذ عليها.
ربما كانت هذه الفكرة مفتاحية لفهم صراعات الجماعات (الطوائف، الاثنيات، القبائل، العوائل، الأحزاب) حين تقوم بتأويل التاريخ مثلا أو بمصادرة الثقافة العامة أو الإرث الثقافي لوضعه في خدمة طرف من الأطراف. هكذا يتحول كل إنجاز تاريخي إلى رصيد في خدمة هذا الطرف دون سواه ويتم الاستيلاء على مسميات ومعاني الأشياء عبر التماشي والصور واللافتات وأسماء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
في أساس السيطرة هناك دائما نقطة انطلاق يتكثّف حولها المعنى الاخلاقي. ترى وادين أن الرئيس حافظ الأسد قد أصبح في هذا المجال «منقذ لبنان» منذ تدخله العسكري والسياسي فيه عام ١٩٧٦. يتخذ الحدث طابعا أسطوريا في المشروع العام الذي سوف يمتد في ما بعد إلى مقولة استقرار سورية وتنميتها وتحديثها والدفاع عن القضية القومية وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية.
لكن السلطة الشخصية لا تدور في فراغ بل تجري بين متنافسين ينجذبون نحو الشخص الذي يلعب دور الحَكَم. فتحيط القيادة الشخصية نفسها بمتزلِّفين متنافسين لكي تحكم سيطرتها على الجهاز الحاكم. أما الصورة التي يُقدَّم بها الرئيس فهي صورة الأب الوطني. وقد بدأت صيغة الأبوة للشهداء والمواطنين وعناصر الجيش مع حرب تشرين ١٩٧٣. وتقدم وادين نماذج حيّة من إفادات المواطنين عن حلول الأب الأعلى (الرئيس) محل الأب الطبيعي في مسار حلول القداسة محل الوظائف الاجتماعية والإنسانية الأخرى. هناك طبعا سياسة اخضاع الخصوم والتي يتم من خلالها إجبار المساجين على توقيع تعهدات بعدم القيام بأي نشاط مناهض للسلطة، وبإقرارهم بشرعيتها ومحاسنها وباعلان الولاء لها. ولكن في سياسة الاخضاع المنظم هذه يتولى المواطنون أنفسهم اخضاع بعضهم بعضا بالخوف من السلطة العليا حتى لو كانوا لا يصدقون هذه الطاعة، أو بالأحرى لا يقتنعون بها. إنها «جمهورية الخوف» كما في كتاب المنفي العراقي كنعان مكية عن نظام صدام حسين. يقابل سياسات الضبط هذه سياسة «تنفيس» أو تسريب للغضب وللكبت. تشرح وادين بالنماذج كيف يستخدم التلفزيون والسينما والأعمال النقدية السياسية «كصمام أمان». وتضرب على ذلك الأمثلة من مسرحيات («غوار الطوشي» لدريد لحام ومحمد الماغوط) أو من خلال الكاريكاتور (علي فرزات) او بعض الأفلام والنكات، كل هذه التقنيات تسمح بهوامش للاحتفاظ بالمشهد الإجمالي الذي هو رسوخ وثبات السلطة الغامضة.
كارستين ويلاند: الإصلاح بدلا من السلاح
يبدأ ويلاند نصه من لحظة انتقال السلطة بعد وفاة الأسد الأب إلى الأسد الإبن عندما مارس وزير الدفاع مصطفى طلاس كل الضغوط والتهديدات على نائب الرئيس عبد الحليم خدام لتوقيع المستندات المؤدية لتولي الرئيس بشار السلطة. كانت تلك أولى إشارات صراع النفوذ بين الأسد وخدام. عدل الدستور وتولى الرئيس بشار السلطة لكن فراغا كبيرا وقع حاول ملأه الابن ببطء شديد.
يرى ويلاند أن المرحلة الأولى قد اتسمت بضعف شخصية الرئيس ووصمته بأنه غير واقعي ويرى الأمور بصورة وردية. فيما يرى آخرون أن عهد الأسد الابن كان بداية تحول كبير لأن ديناميات النظام قامت على وجود مركز سلطة واضح. في السابق كان الحكم بيد شخص، أما الآن فثمة كثيرون يحكمون. وكان الناس يغمزون في المقاهي من «ان السلطة اليوم في أيادي الأشباح». ويبدو أنه في عام ٢٠٠٤ تخلص الرئيس من مجموعة النافذين حوله (رئيس الأركان حكمت الشهابي و٤٥٠ ضابطا تم استبدالهم) فوطد موقعه في النظام. وفي مؤتمر الحزب عام ٢٠٠٥ خاب أمل الذين توقعوا قرارات إصلاحية ولاسيما إنهاء حالة الطوارئ وإقامة التعددية السياسية وإلغاء احتكار البعث للسلطة وإصلاح القضاء وفتح أبواب الحرية. كذلك حصل تغيير داخل الحلقة الضيقة للنظام فأبعد عبد الحليم خدام لمصلحة فاروق الشرع، وأمسك أحد المتشددين الايديولوجيين (محمد سعيد بخيتان) مركزا أمنيا أساسيا وبقي في قيادة الحزب القطرية.
يرى ويلاند ان جزءا من شرعية النظام يقوم على الخوف والتخويف من الأسلمة تعقب ثورة عنيفة من المحتمل أن يمولها المتشددون السعوديون بدولارات النفط. ويشكل هذا الخوف ورقة رابحة بأيدي العلويين الحاكمين ومؤيديهم العلمانيين. ويلحظ ويلاند وجود ميليشيات تلعب دورا مهما في الاعتداء على المعارضين بوحشية وهي مكونة من فروع العائلات المحيطة بأقطاب السلطة القلقة على خسارة النظام. منذ العام ٢٠٠٠ كان خطاب الرئيس محبطا حين قال بضرورة وجود اتصال بين البرنامج السياسي والبنية الاجتماعية معتبرا أن سورية لا تستطيع أن تسلك طريق الديمقراطية الغربية. وقد حاول النظام أن يحذو حذو الصين في اعتماد نظام من التحرر الاقتصادي دون ان يرافقه الإصلاح السياسي. وفي ذلك العام ٢٠٠٠ ذاته، نشطت المعارضة في المجتمع المدني عبر بيان الـ ٩٩ الذي طرح برنامجا متكاملا للإصلاح. لكن النظام مارس سياسة القمع على هؤلاء المعارضين وأصدر قانون الإعلام للعام ٢٠٠١ الذي كان بمثابة خطوة هائلة إلى الوراء. كذلك جرى ابعاد عدد من الوزراء ذوي الاتجاه الاصلاحي. وفي عام ٢٠٠٤ انفجرت أعمال عصيان في أوساط الشعب الكردي وهدد النظام كل حركة سياسية تنشأ خارج إطار الجبهة الوطنية بالقمع. فرضت المسألة الكردية نفسها كتحدٍ جدي. حاول النظام على الطريقة العراقية أن يحدث تغييرا ديموغرافيا بين العرب والاكراد في المنطقة الشمالية مواصلا السياسة المعتمدة منذ العام ١٩٦٢ بعدم احصاء أكثر من تسعين ألف كردي في تعداد السكان. هكذا يوجد حتى الآن عشرات الآلاف من الاكراد المحرومين من الجنسية السورية.
أما القنبلة الاقتصادية الموقوتة فتتجلى في شراء النظام لشرائح من رجال الأعمال والطبقة الوسطى بديلا من الإصلاح؛ والاستثمار في السياسة الخارجية بدلا من الاستثمار في التنمية الاقتصادية. تذهب العقود الهامة الى كبرى العائلات الموالية وإلى أعضاء عشيرة الرئيس (الهاتف النقال، وكالات السيارات، الخ.) والمحسوبية مستشرية في امبراطورية ابن خال الرئيس، رامي مخلوف. إلى ذلك يحتشد ثلاثماية ألف شاب سنويا في سوق العمل بينما لا يوفر النظام في القطاع العام أكثر من عشرين ألف فرصة عمل سنويا. ويقال أن ١١ إلى ٣٠ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، يسكن معظمهم في الأرياف وعلى الحدود التركية ــ العراقية.
تزايدت عزلة سورية الاقتصادية والسياسية فراحت تبحث عن شركاء لتحالفات مستقبلية على أسس براغماتية عوضا عن الايديولوجيا، وافتتحت عملية التقارب مع تركيا في هذا الاتجاه. واستمرت سياسة النظام في ممارسة التضييق على الحريات. وصرح معارض سوري عام ٢٠٠٥ بأن المعتقلين السياسيين قد بلغ عددهم ألفا وخمسماية معتقل و ٧٥٠٠ من الجماعات الإسلامية.
ولقد عارضت الجماعات الإسلامية الرئيس حافظ الأسد منذ إقرار دستور ١٩٧٣ حين فرضت عليه ذكر الشريعة كمصدر من مصادر التشريع. وقد واجه النظام احتجاجات الإسلاميين في ١٩٧٦ وفي ١٩٨٢ (حماه) لكن ظاهرة انتشار الحركة الإسلامية ظهر بوضوح في ٢٠٠٥. في المقابل، ظهرت العلمانية في سورية مع ارتفاع مد القومية العربية، لكن المجتمع ظل ينظر اليها على أنها من بدع ثقافة غربية غير الملائمة لمسار المجتمع العربي. غير أن الأنظمة القومية استخدمت العلمانية أداة للنخب ذات التعليم العالي لشرعنة حكمها ولم تلتزم بها كركائز فكرية وسياسية كما هي حال العلمانية الغربية. والعلمانية البعثية انبثقت عن ثقافة التسامح في المجتمع العربي وقبول المكونات التعددية الدينية دون أن يطاول ذلك التعددية السياسية.
وعندما تولى الرئيس حافظ الأسد السلطة رئيسا عام ١٩٧١ جاء في ركابه الكثير من العلويين من الأرياف لتقوية مواقعهم في السلطة وحاول أن يعطي بعدا علمانيا أكبر في الدستور لأن ذلك يخدم في استجلاب دعم وولاء الأقليات الأخرى. وهو الأمر الذي كان يثير حفيظة الإسلاميين بشدة. وقد لجأ هؤلاء إلى استخدام تحريض طائفي لا ديني بوجه النظام. فالإسلاميون لا يجادلون في الثقافة الدينية بل يستخدمون سياسة براغماتية معادية لاحتلال ضباط وموظفين علويين موقع العمود الفقري للنظام. وقد مارسوا سياسة الاغتيال ضد تلك الكوادر العلوية. ويفرد المؤلف حيزا كبيرا للبحث في ايديولوجيا النظام. ينطلق من ان النظام السوري يضع صورة الأسد في قلب خريطة العالم العربي ناسبا اليه الدور المركزي القيادي لتوحيد الأمة في الوقت الذي استحال فيه حتى انجاز تعاون بين حزبي البعث الحاكمين في العراق وسورية. ويستشهد ويلاند بمقولة بينيدكت اندرسون القائلة بأن الأمم «مجتمعات متخيلّة» رغم القوة المؤثرة للوهم الذي يصبح حقيقة على المستوى الاجتماعي ويؤدي الى نتائج سياسية. فالعروبة التي حملها البعث، وكانت مستمدة من ثقافة غربية رحبة، تحولت في المواجهة مع الغرب الفرنسي والانكليزي الى ثقافة معادية وقطعت اتصالها العضوي بهاتين الثقافتين.
والحال انه مع وصول البعث إلى السلطة تحولت العروبة الى نزعة للادلجة على نطاق واسع وإلى مجرد إيديولوجيا تبريرية وذخيرة من العبارات الدعائية. وقد شكل احتلال العراق نهاية لهذه العروبة عندما سقط البعث ولجأت الدول العربية الى تحالفات تجاوزت الاطار العربي (سورية وإيران). ليس هذا وحسب بل إن السياسة السورية عانت من تناقضات متزايدة حتى أن حزب البعث تحول إلى جماعة تعاونية تضم كل الاتجاهات بما في ذلك الإخوان المسلمون. ولم تعد الإيديولوجية مهمة فيه.
يقدّم النظام السوري الخوف من الإسلاميين عذرا لتأخير انفتاح البلاد، علما انه كان من الممكن لحركة ربيع دمشق ٢٠٠٠ ــ ٢٠٠١ ان تشكل مدخلا لتعاون النظام مع العلمانيين إلاّ أنه أضاعها. فقامت المعارضة عام ٢٠٠٥ بخطوة في اتجاه توحيد خطواتها من خلال «إعلان دمشق» (١٦ تشرين الأول ٢٠٠٥) وقد شاركت في اجتماع لندن كل جماعات المعارضة من حركات المجتمع المدني والنشطاء الأكراد والمسلمين المعتدلين والإخوان المسلمين. دعا «إعلان دمشق» إلى «عقد اجتماعي جديد» ودستور ديمقراطي واعتبار المواطنة أساس الحقوق والإقرار بالتعددية والتداول السلمي للسلطة وحكم القانون والمساواة بين المواطنين دون تمييز. وتميزت مرحلة ما بعد ٢٠٠٥ بالتعاون بين العلمانيين والليبراليين والعروبيين والاخوان المسلمين الذين غيروا من اسلوبهم وخطابهم وأعلنوا التزامهم الديمقراطية والدولة المدنية حسبما أعلن زعيمهم علي صدر الدين البيانوني من لندن. غير أن هذا لا يعني غياب الحركة السلفية وتصريحاتها المفعمة بالكراهية، ما يجعل عدد من المثقفين في المعارضة السورية حذرين جدا من حكم الإسلاميين. ويعتقد بعض المثقفين أن الفرصة متاحة أكثر للإسلاميين مقارنة بسائر المعارضين لقدرتهم على استخدام المؤسسات الدينية ولا سيما الجوامع، وتقديمهم الخدمات لجمهورهم.
من جهة ثانية فإن النظام السوري قد اغتنم كل فرصة متاحة خلال السنوات الثلاثين الماضية لخلق حالة ضبابية من الدعاية المعادية لإسرائيل. وهكذا بالموازاة مع المتطرفين في إسرائيل، عزز النظام الجو لخلق عقبات كبيرة أمام السلام بين شعوب المنطقة. ويرى ويلاند أن النظام السوري لديه ملف لدى الوكالات العالمية لمكافحة الإرهاب وهو يدعم جماعات إسلامية تمارس العنف مع انه لا يتفق معها ايديولوجيا (كحماس). كما شاركت سورية بتزويد المقاومة العراقية بالسلاح. وقدرت بعض المعلومات عدد المتسللين من سورية إلى العراق بنحو من ١٥ ألفا. كذلك تدعم دمشق «حزب الله», الشوكة في خاصرة إسرائيل بذريعة احتلال الجولان. ويدين الرئيس الأسد للشيعة بفتوى الإمام موسى الصدر الذي أكد إسلامية الطائفة العلوية عكس فقهاء من السنّة الذين يعدوهم مهرطقين. وتتعامل سورية بوجهين مع أميركا، فهي أحنت رأسها لاحتلال العراق ومن جهة ثانية دعمت الحركات المقاومة ضد الاحتلال. وهي من جهة اخرى، عقدت مفاوضات مع إسرائيل وأبدت استعدادها للحل الذي رفضته القيادة الإسرائيلية. لكن أميركا ظلت إلى عام ٢٠٠٥ تنظر إلى دور سورية في لبنان كدور إيجابي في هذه الدولة الهشة مخافة اتساع دائرة الإرهاب. وحين قررت أميركا إخراج سورية من لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري واتهام دمشق بالضلوع فيه، خرج من النظام أركان أقوياء، منهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، حكمت الشهابي ورجل الأمن الذي سيطر على لبنان لفترة طويلة، اللواء غازي كنعان.
وحين بدأت المعارضة تنشط في دمشق تلقت سورية إشارات أميركية متناقضة. شكا المعارضون السوريون من دعم واشنطن لتيارات إسلامية على حساب العلمانيين. وما يقلق السوريين هو شكل التغيير الحتمي من داخل أو من خارج. ويخلص ويلاند أن لدى بشار الأسد الفرصة للقيام بحركة إصلاحية من فوق تدعمها الأقليات والعلمانيون المتوجسون من الحركة الإسلامية. أما الثورة العنيفة فلن تكون في مصلحة التيار المدني ولا في مصلحة الغرب. ولكن استنتاج ويلاند تطور بعد ٢٠٠٦ فإذا به يعلن أن نظام بشار يمر بمرحلة انكماش وان المشهد أصبح أكثر كآبة بعد تواتر عمليات القمع السياسي.
رايموند هينبوش: صراع الريف مع المدينة
يتابع رايموند هينبوش فكرة أن التغيير السياسي كان موعودا تحت حكم الرئيس بشار الأسد. ولكنه يستدرك سلفا بالقول أن مشروع بشار هو «عصرنة الاستبدادية» أي تحسين عمل النظام وتوليد تنمية اقتصادية لضمان قاعدة النظام على أن يترافق ذلك مع تحسين الإدارة والمحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد. لكن بشار خيّب آمال أولئك الذين انتظروا منه دمقرطة الحياة السورية وأنه في مؤتمر الحزب عام ٢٠٠٥ اقفل النقاش الاقتصادي على نظرية «اقتصاد السوق الاجتماعي» ما يؤكد المسار بالتحول الى اقتصاد السوق.
يعتقد هينبوش أن الشعبوية السورية التي اتصف بها حزب البعث هي نوع من الفاشية التي استرضت الطبقة الوسطى وجمعت من حولها في السياق السوري الأقليات الطائفية. إذ لا تقوم سلطة النظام السوري على الإكراه وحده بل على توسيع القاعدة الشعبية من خلال التنظيم الشعبي الذي هو حزب البعث. ولا يمكن فصل سيطرة الفاشية في الشرق الأوسط عن سياق الحروب الوطنية والنزاعات الدولية على المنطقة. هذا النموذج الذي يزعم أنه يشق طريقا ثالثا بين الاشتراكية والرأسمالية قام فعلا ببناء رأسمالية دولة للانتقال من الاقطاعية ولكن مع توسيع دور الدولة الريعية على حساب التطور الرأسمالي الانتاجي.
لم تكن السياسات التي اتبعها الضباط الذين لعبوا الدور الأكبر في المتغيرات سياسات طائفية ولكنها وجدت موضوعيا في الفئات الريفية الفقيرة والمهمشة، وبصورة خاصة في الأقليات، مادتها الاجتماعية الأساسية التي أعطت حزب البعث تلك الشعبية. ويصف هينبوش جزءا مهما من تاريخ سورية السياسي على انه صراع بين القوى الريفية والقوى المدينية بثقلها البرجوازي وعائلاتها الثرية.
لكن الأسد الأب الذي ضيّق حلقة القوى المشاركة له قد استخدم النخبة العائلية والطائفية وبعض شرائح التكنوقراط والنخب المدنية لإدماجها في السلطة، وألحق بهؤلاء جزءا من حماية ورعاية مصالح البرجوازية المدينية.
وفي اتجاه إقامة السلطة المركزية الاستبدادية اعتمد الرئيس الأسد على الضباط العلويين في المراكز الأمنية الحساسة لكي يؤمن لنفسه نخبة موثوقة حتى ضد خصومه من الشركاء في الأقليات الذين ساهموا في وصوله إلى السلطة. لكنه اعتمد بعض الوجوه المدنية الحزبية السنية لشبك علاقات أوثق مع البرجوازية السنية في المدن.
ويرى المؤلف أن الاستياء من الهيمنة العلوية يظل المصدر الأساسي لعدم شرعية النظام باعتبار أن هذه الجماعات تحظى بامتيازات واضحة وتتصرف على نحو يظهرها فوق القانون. وفي عهد الأسد الاب شاركت المؤسسة الحزبية في صنع القرار على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والخدماتي والإداري لكنها لم تكن الطرف المقرر في السياستين الأمنية والخارجية. وقد ساهم الحزب في مد خطوط التواصل مع القاعدة الشعبية وفي تجنيد النخبة السياسية الجديدة التي كانت في معظمها تكوّن بيروقراطية الدولة. ويعتقد (هينبوش) ان الأسد استثمر نفوذه على قاعدتي الدولة الريعية (القطاع العام والمساعدات العربية) والاشتغال على الهوية السياسية العروبية، القومية العلمانية التي توفر المساواة بين المجموعات المذهبية.
أنشأ النظام طبقة جديدة من خلال هيمنة الدولة على الاقتصاد. وشكلت النخب العسكرية والمدنية النواة الأساسية لهذه الطبقة. لكن استراتيجية هذا النظام التي أدت الى تعميق جذور الطبقة الجديدة أخذت تتآكل مع تعاظم النظام التسلطي والتحيز الريفي والطائفي للسلطة والفساد والفوارق الاجتماعية، ما قوى اتجاه الإسلام السياسي كاديولوجية بديلة تطعن بشرعية البعث. وقد سيطرت النزاعات البعثية ــ الإسلامية خلال السبعينات والثمانينات الى أن استخدم النظام التحولات الإقليمية في صالحه وخاصة مع اتفاقية كامب ديفيد ووجه ضربة مدمرة لقوى المعارضة الإسلامية كانت ذورتها في حماه (١٩٨٢).
ويصف هينبوش السياسة السورية من الستينات حتى التسعينات التي استثمرت على الهوية العروبية الوحدوية وعلى قضية فلسطين ليصل إلى أن السوريين قد بدأوا يركزون على هويتهم السورية ويعقدون تحالفات تضمن أمن النظام في الصراع الإقليمي من خلال علاقتهم بإيران ولو أدى ذلك إلى خروجهم عن استراتيجية التضامن العربي. ويعتقد هينبوش أن الأسد ركز على توازن القوة مع إسرائيل واستخدم لذلك استراتيجية سورية الكبرى، ضد إسرائيل الكبرى ما مكنه من إعادة بناء قوة سورية واستقرارها. وفي هذا السياق استثمر الأسد تدخله في لبنان منذ العام ١٩٧٦ ولاحقا دعمه للمقاومة الاسلامية فيه. وفي خلاصة رأي هينبوش أن سورية استطاعت أن تحافظ على موقعها في ظل الحرب الباردة والتوازنات الدولية لكنها اليوم لا تستطيع أن تحافظ على الموقع نفسه بعد أن فقدت جزءا مهما من شرعيتها العربية وعليها أن تواجه لحظة التكيّف مع العولمة اقتصاديا وسياسيا.
ستيفن هايدمان: الدولة ضد المجتمع
يتميّز ستيفان هايدمان عن معظم الباحثين في سورية المعاصرة في اطروحته القائلة ان الاستمرارية السياسية للنظام السوري لا تتأتى من مرونة النظام وقدرته على التكيّف بقدر ما هي ناجمة عن عوامل أخرى، وبصورة رئيسية الإكراه. فالنظام لا يعدو كونه أداة لفرض السلطة وضمان تدفق موارد الدولة إلى تحالف اقصادي ــ طائفي معين وبالدرجة الأولى حلقته الاضيق التي هي الحلقة العلوية. ذلك ان هايدمان يؤكد أن الطائفية والقمع ليستا العنصرين الأساسيين، بل هو يبحث ما وراء هذه السيطرة في الاقتصاد السياسي.
ان قيام الدولة بالسيطرة على الاقتصاد وتوسيع مؤسساتها أديا إلى إدماج الرأسمالية فيها. وفي تلخيص كثيف لحجم التغيرات التي أحدثها البعث (١٩٦٣ ــ ١٩٧٠) يقول إنها أحدثت تحولا ثوريا في الدولة والمجتمع والاقتصاد، إذ استكملت قيادة البعث تهميش طبقة الاقطاع وقضت على النفوذ السياسي للرأسماليين وأسست قطاعا عاما يسيطر على ثلاثة أرباع الاقتصاد الوطني. وعززت النموذج القمعي النقابوي للتعبئة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي وأرست نظاما تسلطيا شعبويا في الهيكليات والمؤسسات البيروقراطية للدولة معيدة تكوين الدولة على أنها «القوة الكلية الوجود في التنمية».
ويعتبر صعود الأسد الى السلطة مرحلة قمع للرؤيات المتناحرة حول طبيعة الدولة السورية التي ظهرت منذ الاستقلال. فقد أعاد البعثيون هيكلة وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع عبر توسيع حجم الدولة وتعميق تدخلها في الاقتصاد والمجتمع من خلال التأميم، بناء جهاز مؤسساتي ضخم لإدارة القطاع العام، السيطرة على تداول رأس المال والسلع، وتحديد الملكيات الزراعية وترسيخ الممارسة الراديكالية الشعبوية. وقد واجهت الدولة الحركة الاعتراضية البرجوازية ثم الحركة الإسلاموية وألحقت التنظيمات النقابية العمالية والفلاحية والشبابية والمهنية بسيطرتها. وقد ارتكزت نظرية الأسد على أن غياب الرساميل الأجنبية والانغلاق الاقتصادي يوفران افضل السبل للتنمية. ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، بدأت هذه السياسات تتعرض لضغوط تدفع نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وليس فقط الليبرالية الانتقائية.
لكن هذا الكتاب الذي يتناول تاريخ سورية الحديث إلى عام ٢٠٠٠ قّدم مؤلفه الطبعة العربية بالتأكيد على أن بشار الأسد استفاد من عملية بناء المؤسسات وتوسيع الدولة التي قام بها والده. ولقد استفادت سورية مما عرف بالاستقرار الذي وفره النظام منذ العام ١٩٧٠ بوصفه قطيعة مع اضطراب السياسة السورية والانقلابات والنزاعات السابقة. لكن الرئيس بشار يواجه اليوم مضاعفات وتداعيات تطور النظام الاقتصادي الاجتماعي وبروز معارضة التيارات الإسلامية وضغوط البرجوازية السورية من أجل توسيع الخيار الليبرالي وادماج الاقتصاد السوري بالسوق العالمي. أما محاولات الرئيس السوري «لتحديث التسلطية» فلا تأخذ مداها في ظل سياسات قمع النشطاء الديمقراطيين منذ بداية ٢٠٠٦. وخلاصة المؤلف ان محاولة النظام التكيّف الجديدة للتغلب على عزلته المتزايدة تبدو قاصرة عن تجديد شرعيته بل هي غير مجدية نظرا لأداء الرئيس بشار الأسد الهزيل على هذا الصعيد.
خلاصة
تكاد هذه الكتب تكون أطروحة واحدة عن سورية في ظل حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد وتقديس السلطة وأدوات ووسائل هذا التقديس والاستبداد اللاغي للديمقراطية، والمتربع فوق مجتمع تلفحه رياح الإسلاموية وتنكشف علمانيته عن شكل من أشكال الحكم الطائفي. يستعصي النظام الذي قام في سورية على فكرة الإصلاح من فوق التي جاءت مع تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة، ليكون الإصلاح الموعود مزيدا من انغلاق السلطة على نفسها على دائرة ضيقة من النخبة الحاكمة وليكون الانفتاح الاقتصادي ولبَرْلة الاقتصاد مقدمة لتداعيات اجتماعية سلبية. أما كتاب التسلطية الأشمل في معالجته لتاريخ تطور حكم البعث فهو أكثر تحليلا لمكونات المجتمع السوري الاجتماعية ولتناقضات هذا المجتمع وحبسه في نظام سياسي يستعيد شكلا من أشكال الشعبوية ذات ركيزة أساسية هي الضبط الأمني الذي من خلاله تعيد السلطة ترتيب المجتمع وتشكيله.