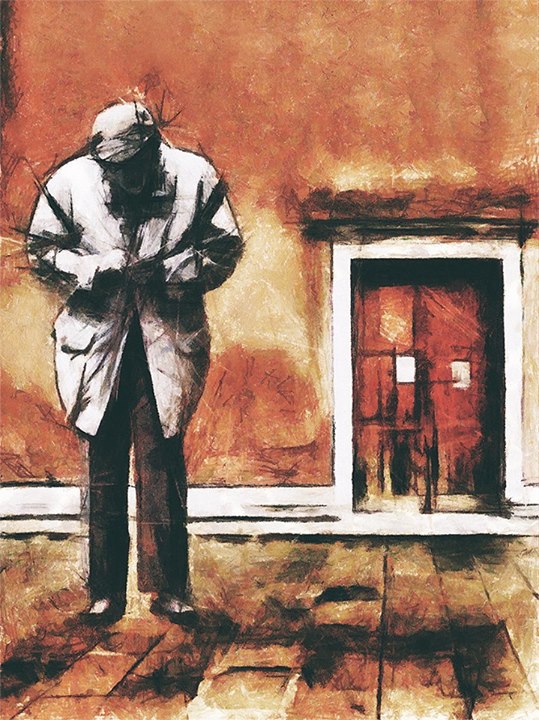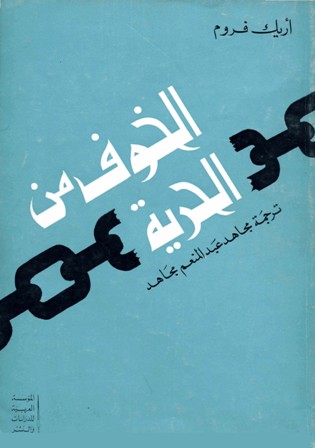طفولة سوريا الغد
رامي الأمين
الطفل الصغير يقف على مسرح أُعدّ خصيصا للمناسبة. يلبس نظارات شمسية، وثياباً عسكرية مرقطة، ويحمل رشًاشاً بلاستيكياً، ويعلن انضمامه إلى “الجيش السوري الحر”. لوهلة يبدو المشهد عادياً، لا يعدو كونه مزحة يوتيوبية (نسبة إلى يوتيوب)، أو واحداً من آلاف الأفلام المركّبة التي تبتغي ربح ابتسامات ونسب عالية من المشاهدة. قد تبدو المزحة سمجة للبعض، لكنها تبقى مزحة، فيما لو تأكد لنا أنها كذلك. الأطفال يمكن ان نستخدمهم أحياناً للمزاح، أو للتسلية. هناك برامج لإستعراض مواهب الأطفال بالعشرات. بالغناء والتمثيل والعزف والرسم وسرعة البديهة، وحتى الكوميديا. الأطفال أيضا يُستخدَمون في الإعلانات، وخصوصا للسلع التي تخصهم: الحليب، الحفاضات، الألعاب… مع ذلك يجب ألاّ ننزعج كثيرا، فهذا عالم يمكن أن يستفيد من أي شيء كي يبيع ويشتري. هذا العالم سوق ليس إلا. يجب ألاّ نحزن بسبب تحول الطفولة إلى سلعة، طالما أننا سلع أيضاً، وطالما أن لا شيء ينجو على هذه الأرض من العرض والطلب.
لكن فيديو الطفل الصغير الذي لا يتعدى عمره السنوات الثلاث، والذي يعلن انشقاقه عن جيش النظام السوري وانضمامه إلى “الجيش السوري الحر”، يثير فينا أحد أكثر مشاعرنا اقترانا بالألم. ذلك الشعور بفوات الأوان الذي ليس بعده احتمال لأيّ أمل.
غيمة من اليأس تتلبد فجأةً في الدماغ، الذي يشتغل بحثاً عن مسوّغ لاستخدام الطفولة في حروب الكبار، على ما تقول أغنية لفيروز.
ومع أن كثيرين لا يؤمنون بالغناء سبيلاً إلى الحرية، إلا أنه قد يكون مدخلاً إلى الأمل، الذي لا محيد من سلوك طريقه إلى الحرية. الأمل في حاجة إلى براءة طفل، إلى نظرته العميقة إلى الغد البعيد، الممتد كبحر أزرق مريح للبصر والبصيرة.
عينا الطفل في الفيديو محجوبتان بنظّارتين شمسيتين، لا يمكن رؤية ما وراءهما. لا شك أن وراءهما أملاً يلمع. الطفل المنفرج الأسارير، يلهو ببراءة، بلعبة العسكر، التي لا بد أن معظم أطفالنا يتقنونها منذ نعومة أظفارهم حتى خشونتها، أو حتى تتحول أظفارهم إلى مخالب.
الطفل يلهو مسروراً بلعبته. ضحكته تسيطر على وجهه. ضحكة طفولية لا تتوافق مع هندامه العسكري. صوته، وهو يعلن انشقاقه، ويطالب بقتال النظام السوري وتلقينه درساً، لا يتلاءم البتة مع جدية ما يطرحه، أو ما أراد له مصوّرو الفيلم أن يطرحه.
لا يمكن أن ترى في الطفل إلا طفلاً. لكن لا يمكنك أن ترى مستقبلاً للطفل. لا يمكنك إلا أن تتخيله مقاتلاً، قاتلاً أو مقتولاً.
تزيد فداحة الخسارة عندما تعلم بعد أن تسأل، أن الطفل هو الناجي الوحيد من عائلة ابتلعها وحش النظام. وهو ينشقّ وينضم إلى “الجيش السوري الحر” لينتقم. لا بد أن طفلاً في الثالثة من عمره، لن يقوى على التفكير في الإنتقام. لم يفكر، إن فكّر، إلا في الفقد، في الخسارة التي مني بها، في الألم والأسئلة التي لا اجابات عنها. التهمه وحش الوحدة. سقط في فم الوحدة الواسع، إلى بطن السؤال الأصعب: لماذا؟
لم يجبه أحد عن السؤال. لا أحد يملك اجابة. وحدهم الذين صوّروه على هذه الشاكلة، وجدوا اجابة واحدة: الإنتقام. الإنتقام أو الثأر، هو الجواب الوحيد على مصيبة الطفل الصغير. الثأر الذي سيعيش معه الطفل حتى النهاية. حتى يقتله. المؤسف أن عرض هذا الفيديو على الـ”فايسبوك”، يبرر للطفل والطفولة الخضوع للغة العسكر والإنتقام والعنف. عندما قلت إن في المشهد بعداً بعثياً يحاول النظام أن يكرسه حتى لدى خصومه، قال إن استخدام الطفولة على هذا النحو مبرر في وجه من يرتكب المجازر. ستة وستة مكرر. قاعدة ظننتها لبنانية، فتبدى أنها تنسحب اليوم على سوريا. نيتشه يقول إن من يقارع وحوشاً يجب أن ينتبه ألا يتحوّل وحشاً مثلهم. من ينظر عميقاً في الهاوية، تحدق الهاوية فيه! من يقارع البعث يجب أن يحتاط من احتمال التصرف كبعثي. هذا ما قلته، وتمنيت أن تسقط العقلية البعثية في سوريا مع بشار الأسد.
الطفولة تحضر في صورة أخرى، يحملها مجموعة أطفال، يعلنون “انشقاقنا عن الروضة والإنضمام إلى الجيش السوري الحرّ”. الصورة في تركيبها، تبدو كأنها انشقاق عن البعث، بكل ما يتركه الإنشقاق من رواسب واساليب تصرّف. صورة، لم استطع أن أرى فيها إلا خدمة للبعث، الذي يريد أن يعيث تخريباً في المستقبل قبل الحاضر. هدف البعث أن لا يترك مستقبلاً من بعده. أن يترك سوريا تتناهشها الطائفية والإنتقام والكراهية. البعث ضد الطفولة، لذا يريد أن يورّطها في الصراع من أجل الحرية. أحدهم علّق على الصورة بأنها تبدو كأنها صنيعة ضابط استخبارات. للأسف معه حق.
يمكن الأطفال أن يشاركوا في صناعة المستقبل. بل إن المستقبل الذي يصنع هو لهم في الضرورة. في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين شاهدنا أطفالاً يشاركون في التحركات المطلبية. لكن أطفال الثورات هذه بقوا محافظين على طفولتهم، على شكلهم الطفولي، وبراءتهم غير المتكلّفة. لم يحمّلوا لافتات لا يفقهونها، ولم يحفَّظوا عبارات لا يفهمونها. كانوا يلتقطون النبض من آبائهم وأترابهم والمزاج العام السائد. يهتفون مع الهاتفين: الشعب يريد اسقاط النظام. الطفل يحق له أن يطالب بإسقاط النظام، شرط أن لا يُسقط عنه أحدٌ طفولته، ولا يسرق أحدٌ منه براءته.
تذكرتُ في هذا السياق الصورة المؤلمة التي حفظناها من حرب تموز الهمجية التي شنّها العدو الصهيوني ضد بلادنا. تذكرتُ الأطفال الذين استقدمهم الجيش الإسرائيلي ليوقعوا صواريخ حملتها الطائرات قتلاً مجانياً وهمجياً لأطفالنا. كان ذلك قتلاً ممنهجاً للطفولة لدى الإسرائيليين، ولكل ما يمت إلى البراءة بصلة. من هنا فإن الزجّ بالطفولة في لعبة العسكر، تحطّم اسطورة الربيع، الذي لا يستطيع الطاغية تأخيره حتى لو سحق الأزهار. الأطفال، كما تقول الأسطورة، عندما يموتون، يصيرون ملائكة، أو فراشات، أو أزهاراً. أي ربيعاً.
في سوريا، الرهان هو على بقاء الطفولة الصادقة التي يحاول النظام قتلها بالرصاص والقذائف، على رغم سقوط مئات الأطفال قتلى لم ينجح النظام في محو اللمعة التي تتشح بها عيون أطفال سوريا، تلك اللمعة التي تنير درب المستقبل بوميض الأمل، والتي لا يستطيع أحد اطفاءها. لذا، فإن المعارضة السورية مطالبة بالمحافظة على الطفولة وعدم الزجّ بها في الحسابات السياسية والطائفية والعسكرية الضيقة. الأطفال لا دين لهم ولا جنسية ولا عرق. الأطفال أطفال، في العالم كلّه. قاتِلُهم واحد في كل العالم، وإنْ بمسميات مختلفة.
النهار