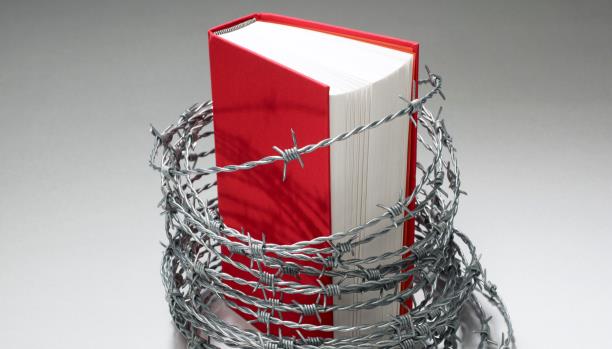عندما وقعتُ وانكسرت يدي/ نجاة عبد الصمد

في كلية الطب، يبدأ درس تشريح اليد بفكرة: كي تختبر وظيفة اليدين في حياة الإنسان؛ جرِّب أن تحبس يدك اليمنى أو اليسرى، لا فرق، في جيب جاكيتك لساعة نشاط واحدة، ثم حاوِل البدء بأي عمل. قد تمضي دقيقةٌ أو اثنتان قبل أن تكتشف أنك لن تستغني عن إحداهما لإنجاز أبسط الأشياء. هذا من غير أن تكون اليد مريضةً أو مصابة أو مكسورة العظم، ومؤلمةً كما لا يطيق جسدٌ ولا عقل.
كان أن وقعتُ على أرض بيتي. كم طال الوقت قبل أن أصحو من سقطتي؟ لا أدري. الكهرباء مقطوعة والدنيا عتم، أحاول رفع رأسي لأعي أين أنا، كتفي اليمنى رخوة وساخنة. أحضّها لترفعني عن الأرض؛ تحرن هذي اليمين التي كانت كل العمر طائعة. ربما شُلّت؛ أقول لنفسي. ربما لن أستطيع الجراحة أو الكتابة أو حتى غسل وجهي إلى أمدٍ لا أعرف كم سيطول. لا ألم بعد، فقط نذير عجز.
انتفضت يدي اليسرى كفدائية تستبسل لتحمي أختها المنكوبة. انسلّت وعبرت من تحت جذعي لتلاقيها وتحضنها بكلّ الحنان الممكن. نسيت اليسرى كل مهارات عمرها باستثناء حمل أختها ورفض إفلاتها. صار تحالف الأختين غير مشروط حين بدأ الألم. أوه. أي ألم كان ذاك. لا ألم الضرس ولا ألم نوبة الكلى ولا ألم المخاض. صعقات كهرباء تفتق حنجرتي وتبعث منها صرخات وأصواتاً ربما تعود إلى ذلك الإنسان البدائي حين كان لا يزال وحشاً، زعيقاً أشبه باستغاثة حيوان خرافيّ لا اسم ولا شكل له. ألمٌ لا يقابَل إلا باستسلام خالص، ألمٌ مجنونٌ استحضر أمامي عذابات المعتقلين في السجون.
حين استطعتُ الجلوس، ووجد ظهري له متّكأً على الحائط، راحت أفكاري إلى حيث لم يسعها الوقت يوماً أن تذهب. وقوعٌ كهذا يشبه الوقوع في العشق؛ يعقبه صحوٌ وتذكار. العاشق يتذكّر، والمريض يتذكّر. أواجه نفسي بسؤال ما أخفّه وما أثقله: يا بنت، يا أنا؛ كم مضى عليك من السنوات في دوامة العمل؟! هل كان يجب أن تقعي مشلولة اليمين لتحتسبي أن ثلاثة وعشرين عاماً وشهرين وبضعة أيام قد مضت وأنت تشتغلين بلا يوم عطلة أو عيد؟! جرّبي الآن أن تذوقي طعم الحياة بعيداً من ضغط العيادة أو مشاوير الليل إلى المشافي.
رسمتْ صورةُ الأشعة كسراً متفتّتاً في أعلى العضد، وانقلاع العضلة المستندة إليه وتمزّقها. في اليوم التالي ارتسمت تحت جلد يدي ألوانٌ مفزعة: أخضر من لون الحشيش إلى ظلال العفن القاتم، قرميدي كآثام الخريف على أوراق الشجر، بنفسجيّ غامق كالأسى، أسود كالليل. كل ألوان الوحشة ارتسمت على اليد التي انتفخت بكسرها وآلامها ونزفها لتغدو بضعفَي حجمها الطبيعيّ. انضمّتْ إليها بعد يومين آلام رضوض متفرقة كانت صمتت من قبل خجلاً من أوجاع يدي. مساحات زرقاء وخضراء وسوداء على رجلي ومرفقي الأيسر، الركبة اليمنى مكشوطة الجلد. ظفر إبهام القدم اليسرى مقلوعٌ من سريره. هل سيشفى هذا كلّه؟!
التفّ الرباط حول يدي إلى كتفي وعنقي، والضمادات حول الجروح الباقية، وبكمشة من المسكّنات هجعتُ قليلاً. بقي أن أستوعب أنّ سقطةً غافلة قد تحيل إنساناً فاعلاً إلى كيان معاق يعوزه من يرعاه.
هل كان عليّ أن أستسلم؟! لن يعدم ذو عقل ولسان وسيلةً للخروج من أي محنة. عليَّ أن أبدأ حياة موازية طالما الطبيعية متعذّرة.
بيدي اليسرى، وبخطّ تلميذ في الصف الأول ابتدائي، كتبتُ نقلاً عن النت قائمة بأسماء الأغذية المرممة للكسور. أين يوجد الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم والفوسفور وفيتامينD ،K. فعدا الحليب والبيض تبين أن هناك عشرات الأطعمة البلدية اللذيذة ملأى بهذه المعادن: اللوز، الزبيب، التين المجفف، الفليفلة الخضراء، السبانخ، الخس، البندورة، البازلاء، الذرة، البطاطا والبطاطا الحلوة، الملفوف القنبيط (ما أطيب شوربة اللبن بالقنبيط! هل كان الكسر لازماً لأكتشفها؟!) وأيضاً البقول والحبوب الكاملة. القمح المنبّت، غذاء الحياة. وبالطبع اللحوم، ولأنني لا أحبها استعضتُ عنها بالسردين والتونة.
قسمتُ طعامي خمس وجبات صغيرة ترمّم الكسر وتحمي من زيادة الوزن، وفوق ذلك تحمي من كآبة الجوع وردود الأفعال غير المتوازنة.
خاطبتُ جسدي ككائن مستقل: أيها الطيّب، يمكننا أن نتفاهم. ليس هيّناً ما ينتظركَ، سأطعمكَ وجبات صحية خفيفة وكثيرة كرسائل الغيم إلى البشر، تحييهم وتجعلهم خفافاً كالعصافير. أيها الأليف صدِّقني، ستفهمني وتطيعني. أعرف أنك لا تحبّ الحليب. لا عليك. اللبن جيد وأنتَ تحبّه، وستحبّ السردين هكذا وحده من غير خبز. سنطرد زنخته بالليمون والفلفل. سأطعمكَ براعم القمح كأنك ابن الطبيعة الوحيد والمدلّل. تذكّر أننا لن نستطيع الحركة قريباً، وليس مسموحاً لنا بأن نسمن. سنقاوم. سنحاول وسننجح.
حلّ الخصام مع النوم. أرقٌ ظالمٌ لا يريد المهادنة. أخاف الذهاب إلى السرير الذي تراكمت عليه مخدات البيت، خلف ظهري وعلى جنبيَّ علّها تمنحني وضعية مريحة تستدعي النوم في وضعية الجلوس. أغمض عينيَّ أستمطر النعاس البخيل ليزورني متى شاء. أفتح له بوّابات الدعاء وأنتظر. أفرح به إن لبّاني، أعانقه وأغيب في مدن النوم القلق. تصبح ساعة متواصلة من النوم عيداً أفيق بعده بكامل صحوي وألمي. أتمشى بين الغرف أو على الشرفة. أغبط الأطفال اللاهين على الطريق بألعاب لا تنتهي. أو أنسج حديثاً متخيّلاً بيني وبين عابر نادر، ربما كان في وسط المدينة، ربما يُسمعني خبراً طازجاً عنها. أحمل بيدي الكتاب، أقرأ ولا أركّز تماماً، فأنا مضطرة إلى اختبار سلامة خطواتي خشية عثرة جديدة.
في المقابل كرّتْ سلسلة مهارات مكتسبة ما كنت أحسبها ممكنة، بدأت اليسرى تكتب وتتخفف من ثقل أصابعها حول القلم، وصارت تنقر لوحة مفاتيح الكومبيوتر، وتفتح المرطبان بعد تثبيته بين ركبتيّ مهما كان إغلاقه محكماً، وتثبّت علبة معجون الأسنان بين الإبهام والسبابة بينما أفتح غطاءها بأسناني، أو أثبّت الصحن بين ذقني وعنقي بينما أحمل باليسرى فنجان الزهورات إلى الغرفة لأختصر مشواراً إضافياً بينها وبين المطبخ. وتدرّبت أصابع قدميّ على التقاط المحرمة أو الجوارب عن الأرض ورفعها إلى يدي.
حلّ عيد آخر حين تعلّم زوجي كيف يربط لي شعري. تلبّك كثيراً قبل أن يقول لي: قصّيه. يظنّ هذا الطلب سهلاً على امرأة. تألم قلبي لكنني لم أغضب. الزوج المحبّ يعادل قبيلة أهل، كان يتدرّب كل يوم على تثبيت ملاقط الشعر وإتقان تسريحة ذيل الحصان وتمييز الكريم الليلي من النهاريّ. بحنان كثير كان يعيد ترتيب المخدات ويغطيني ويكمكرني حتى أذني كي لا يجمدني برد الليل. تحمّل عناء الجلي لأيام ثلاثة قبل أن يحتج بل يستنكر: لن أحتمل أكثر، لنأتِ بمَن يساعدنا في أعمال البيت. انتظرتُ حتى الصباح لأجيبه: لكنني طوال هذي السنين أجلي وأمسح وأكنس إضافة إلى مهنتنا العسيرة، هل كنتَ تسمعني أشكو؟!
ربما يتشابه المصابون في ملامح أحزانهم على اختلاف عمقها، ويختلفون حول ما يقلق أحدهم أكثر من سواه. ما أخافني هو الفراغ الذي صرت فيه. قلت لنفسي لن تقفر الحياة ما دام فيها كتبٌ وأهلٌ وأصدقاء. هؤلاء حضروا سنداً آمناً. منهم من صار أيقونةً سريّة شفيعةً سرتْ بي إلى خدود الغيم.
على غير انتظار، تنفتح نافذة عريضة إلى داخلكِ، إلى جوهر روحكِ. ترقبينها بصفاء وحياد رقيق. إنه السلام المشتهى. لم أسأل ربي: يا ربي لماذا أصبتني؟ أو يا ربي لماذا أنا دون سواي. أوصتني أمي بألا أنسى أن كل بلاء يدرأ ما هو أعظم منه، وبأنّ فيه حكمةً لا بد سأفهمها يوماً ما.
لن أقول أنها حقبةٌ سعيدة، لكنها لم تكن بالغة السوء، فيها تدلّلت كما لم أتدلل في حياتي يوماً بتفهّم زوجي لكل ما انكسر في حياتنا معاً. تدلّلتُ بالكسل والأصدقاء والهدايا والطبخات اللذيدة من أهلي وأحبّتي يأتونني بها والبخارُ ينبعث منها رسول حبّ وتعاضد. أمضيتُ وقتاً رائعاً أمسح فيه أوراق زرّيعة البيت وأفتح قصاصات أوراقي القديمة، وأفكّر في أشياء شخصية عالقة لم يتح لي التفكير فيها وسط وطأة الهمّ العام. وأسمع الموسيقى. تهمس الموسيقى: شكرا للنكبات.
في المحن يسندكِ غرباء لم يكونوا في دائرة انتباهكِ. لا بأس أن تعترفي كم كنتِ عاقة وكم كانوا أوفياء صامتين، ويجافيكِ أصدقاء كانت لك فيهم آمال كبيرة. تتلبّكين بين ألمكِ لخسارتهم وفرحكِ بكل يد جديدة تنسل منكِ هَمّاً وترسم نقشاً حانياً على أديم روحكِ. البطانية التي بعثت بها أختي كانت بدفء أخت ووهج مدفأة بينما أختي نفسها في منطقة سكنها المحاصرة لم تستطع أن تزورني. تولّت ابنة أختي الأخرى تشذيب حاجبيّ وتزيين أظفاري وتمسيد فروة رأسي باحتفالية، بلمسات ولا أرقّ منها. هي المراهقة المبتدئة التي تركض بخطىً فائرة إلى هودج النساء، وتتدرّب بي على فنون زيناتهنّ.
أخيراً، بعد ستة أسابيع، نزعتُ هذا الرباط عن يدي، شكرته سنداً وأماناً، ثم اعتذرتُ منه قبل أن أرميه بعيداً عن مدى يدي: سامحني! لم أعد أطيقك، فأنا معافاة. معافاة.
ربما كان زوجي على حقّ، فقد قصصتُ شعري في آخر المطاف. صارت خصلاته الضعيفة تعلق بين أسنان المشط وتهوي منها على الأرض كبب سوداء مفزعة. إنما صار يمكن يدي اليمنى أن ترتفع لتلمس وجهي بألفة كأنها لم تُهجّر قسراً عنه منذ أسابيع ستة. أسير الآن لكن بضعف. أتحرك ببطء. أعيد التدرب على الحياة. أستطيع احتمال ألم العلاج الفيزيائي وإعادة تأهيل يدي التي ستعود إلى الحياة كوليد طريّ الزغب لا بدّ سيشتد عوده يوماً، كما بلدي، سوريا الوحيدة، الفريدة التي ستقوم يوماً من انكسارها الفادح.
كتب لي صديقي طلال يداويني من منفاه: أرجوكِ اكتبي عن اليد المكسورة، عن أيادينا المكسورة، عن تفاصيل عيشنا في عزلتنا الحاضرة. وها أنا بعد بدء العافية أكتب لأخبر كل ذي ألم أنه ليس وحيداً في هذا العالم. أكتب بعد إبرامي اتفاقاً مع طبيبي الرائع أن أعمل معه – لا كطبيبة، بل كمريضة سابقة – لتشكيل فريق دعم نفسي يؤازر مرضى الحوادث أو السقطات التي لن تنتهي طالما الحياة مستمرة.
سوريا
النهار