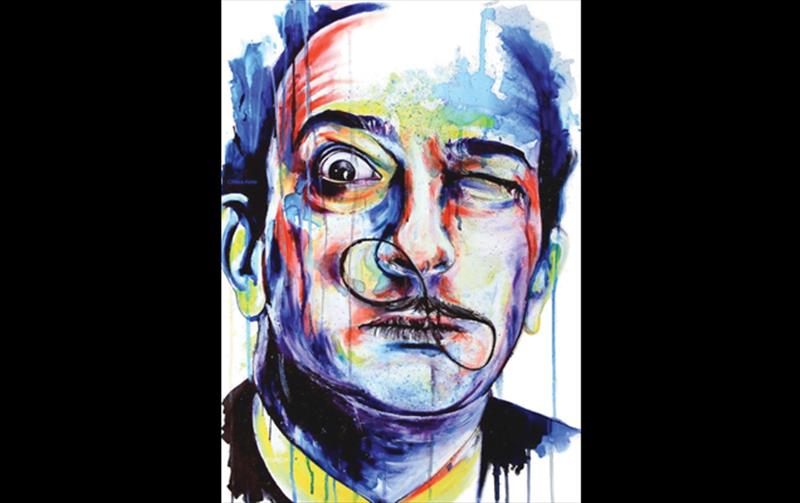عن «السلطة» والوهابية والنساء في السعودية/ محمد تركي الربيعو

■ تعد دراسة الأنثروبولوجية السعودية ثريا التركي «النساء في المملكة العربية السعودية: الأيديولوجيا والسلوك بين النخبة» التي نشرت عام 1986 في جامعة كولومبيا، من أولى الدراسات التي سعت إلى تقديم قراءة ميدانية لواقع النساء السعوديات في فترة الثمانينيات. وعلى الرغم من أن الكتابات حول المملكة العربية السعودية لم تكن حديثة في تلك الفترة، مع ذلك فإن معظم هذه الدراسات غالباً ما ركزت على تاريخ المملكة والسياسة والأسلمة والنفط، في حين بقيت المعرفة بتاريخ النساء في المملكة تعاني من فراغ كبير، في ظل صعوبة وصول الباحثين الغربيين ممن درسوا المملكة إلى فضاءات النساء من أجل أغراض البحث. ولذلك جاءت محاولات التركي في البداية لتعبر عن انعطافة جديدة في حقل الدراسات حول النسوية السعودية. وقد بينت التركي في دراستها السابقة، وتحديداً من خلال دراستها لعيّنة من أسر الطبقة الوسطى في مدينة جدة، أن المرأة السعودية بسبب تعليمها والطبقة التي تنتمي إليها أخذت تعمل على تغيير مكانتها مستفيدة من سياسات الدولة الحديثة في التطوير ورغبة بعض الرجال المنفتحين في تحسين أوضاع الأسرة وتحديثها، وعادت التركي لاحقاً برفقة دونالد كول في كتابهما «مدينة الواحة العربية: تحولات عنيزة» (ترجمة جلال أمين بعنوان «عنيزة: التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية») إلى دراسة التحولات التي شهدتها حياة النساء في السعودية عبر حيوات بائعات سعوديات في سوق عنيزة (مسقط رأس التركي) يعملن في بيع التوابل والطعام المجفف.
وقد شكّلت دراسات التركي السابقة، نقطة الانطلاق لعدد من الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجية حول سياسات الجندر في البلاد، كما في دراسات الليبية صديقة عريبي والسعودية منى يماني، ويمكن أن نشير في هذا السياق أيضاً إلى الدراسة الرائدة للأنثروبولوجية الفرنسية أميلي لورنار «النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعودية»، التي تعد من أهم المحاولات على مستوى البحث الأثنوغرافي، مقارنة بجهود عدد من الباحثات الأنثروبولوجيات السعوديات اللواتي لم يعد يتاح لهن، بسبب بعض المواقف السياسية، فرصة الدخول إلى البلاد لإجراء مقابلات وجولات ميدانية أوسع كما في حالة الأنثروبولوجيتان مضاوي الرشيد ومي يماني مثلاً.
وقد حاولت لورنار من خلال إجرائها لعدد كبير من المقابلات الميدانية في مدينة الرياض، وعبر إقامتها وترددها إلى البلاد لما يقارب الخمس سنوات، أن تكشف عن دور السلطة التي تعمل «على ترتيب الأشياء بأسلوب مرهف وغير مرئي»، كما يرى فوكو؛ ولذلك وبدلاً من تأكيدها على السردية التي تعيد مسألة الفصل المجالي بين الرجال والنساء في مدينة الرياض، على أنه تقاليد قبلية، أو أنه يعبر عن ثقافة وهابية حاولت أن تفرض رؤيتها على «مجتمع ما قبل الغزو النجدي» كما لمحت إلى ذلك الأنثروبولوجية السعودية مي يماني في كتابها «الهوية الحجازية»، بدت لورنار أكثر تركيزاً على دراسة السياسات العامة التي وضعتها الدولة السعودية في الستينيات، التي بدت بمثابة العامل غير المرئي أو الحيادي لدى جل الباحثين، مع أنها قد تكون العامل الرئيسي الذي أفرز فضاءات عامة مخصصة للرجال وممنوعة عن النساء. ذلك أن إعادة بناء المدينة ـ وفقاً للباحثة- على نمط المدن الأمريكية، حيث الشوارع الرئيسية المشكلة للأحياء السكنية طويلة وتتلاقى باتجاه تقاطعات الطرق الرئيسية، وتعميم نمط الفيلات بين الناس الميسورين بجدران مرتفعة، قد اختلف مع مخطط المدينة العتيقة الذي كان يتميز بأزقته القصيرة وقرب المنازل من بعضها، مما كان يسمح بتجول النساء على أقدامهن بين المنازل، ولكون المدن الجديدة باتت ممتدة جدا ًوتحتاج للسيارات فإن الزيارات العائلية لم تعد تقع فجأة، بل بدأت تقل تدريجياً، وهذا يعني أن التطبيق الصارم للفصل الجنسي أخذ يصدر في الوقت نفسه عن ترتيبات الدولة.
ولعل هذه النتيجة التي توصلت إليها لورنار حول عدم كفاية سرديات الإسلام الوهابي أو القبيلة لتفسير إقصاء النساء عن المجال العام السعودي، هي ما تشكّل الفكرة الأساسية لكتاب الأنثروبولوجية مضاوي الرشيد «الدولة الأكثر ذكورية: الجندر والسياسة والدين في المملكة العربية السعودية»، الذي تُرجم للعربية عن دار الجمل بعنوان «الدولة الأكثر ذكورية: المرأة بين السياسة والدين في السعودية».
إذ ترى الرشيد (الأنثروبولوجية السعودية وصاحبة عدد من الكتب حول السعودية، لعل أهمها أطروحتها للدكتوراه حول «السياسات في واحة عربية: إمارة آل الرشيد» التي أشرف على إعدادها يومها عالم الاجتماع الفرنسي ارنست غلنر) أن الوهابية لا تستطيع لوحدها تفسير سبب تأخير تحرر النساء في المملكة العربية السعودية، بقدر ما أن تهميشها يعود لسياسات اجتماعية وثقافية وحتى دينية وُضعت من قبل الحكام في السعودية. هذا الأمر لا يعني ـ وفقاً للرشيد- تبرئة للسياسات الدينية الوهابية، أو القول إن هذه التيارات بريئة على مستوى تشكيل مخيال ديني متشدد حول دور النساء، بل ما تهدف الرشيد لقوله هنا، أن هذه الأيديولوجيا الدينية لم تكن لتؤثر بهذا الشكل لولا وجود سلطة قوة قهرية (سلطة)، وفق تعبير ماكس فيبر، داعمة لهذه الرؤية في سياق التأسيس للأمة السعودية المتخيلة الجديدة. ولتوضيح هذه الفكرة، تقترح علينا الرشيد اعتماد فكرة «القومية الوهابية الدينية» بوصفها شكلاً من أشكال التمثيل الجماعي المسيّس، وكمشروع لتطوير المجتمع وإعادته إلى الإسلام الحقيقي. كانت النساء في هذا المشروع ركيزة أساسية من البدايات الأولى، وعلامة واضحة، وأداة في هذا المشروع. وقد تطلعت القومية الدينية لخلق «نساء صالحات» يحدد مصيرهن تصميم الله لهذا العالم.
هنا نجد ـ وفقاً للرشيد- أن القومية الدينية لا تختلف كثيراً عن القومية العلمانية في دول ما بعد الاستعمار، وذلك حيال سياساتها تجاه دور النساء. فقد بين بارثا تشاترجي في كتابه المهم حول تجربة الهند «الدولة القومية والعالم الاستعماري»، كيف أن القومية الهندية جمعت بتناقض صارخ بين جانب حداثوي غربي وحنين تقليدي جمعي للأصالة ولاستمرار التقاليد الهندية الكلاسيكية. كما تخيلت النخب الهندية أن أمتهم قادرة على تحقيق هذه المهمة الصعبة، ولذلك سعوا لجعلها حقيقة واقعة عبر النظر للمرأة باعتبارها منبعاً للروحانية، والحياة الأسرية والأصالة.
الأمر ذاته، جرى مع النساء السعوديات عندما نظر إليهن من قبل القومية الدينية كأيقونات تدل على أصالة الأمة وامتثالها لشريعة الله. وحتى عندما بدأت الدولة تعليم البنات، تعهدت بأن المقصود من هذا ليس تغيير وضعهن، بل لتأكيد تدجينهن تحت إشراف علماء الدين. ولذا تم إدخال الفتيات في تعليم أيديولوجي مُتحكم به من قبل منظّري الدين، ليصبحن أمهات صالحات يساهمن في إنتاج الأمة الورعة والمطيعة والمتجانسة. في كلا الحالتين، حُوِّل النساء إلى رموز، يمثلن أي شي إلا أنفسهن.
هنا نصل إلى استنتاج مفاده، أن سياسات القومية الدينية التي تقوم بها الدولة، وليس الوهابية هي التي رسمت وخططت لدور النساء السعوديات، وبالتالي فإن إهمال بعض الفتاوى والآراء المعنية (مثل تجاوز فتاوى تحريم قيادة النساء للسيارة) أو الترويج لفتاوى أخرى يعود ـ وفقاً للرشيد- لأسباب سياسية بحتة.
ففي ستينيات القرن الماضي مثلاً تدخّلت الدولة لإدخال تعليم الفتيات، وسط مقاومة من علماء الدين، من أجل تعزيز نفسها كوكيل التحديث في المجتمع السعودي. لكن هذه السياسات أخذت تتراجع في الثمانينيات عندما عملت الدولة جنباً إلى جنب مع العلماء لفرض المزيد من القيود على النساء بهدف تطبيق أسلمة متزايدة لتعزيز مكانتها الدينية، خاصة بعد الثورة الإسلامية في إيران (1979) وحدث احتلال الحرم المكّي مع جهمان العتيبي في العام نفسه. لاحقاً، وفي أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وجدنا أن الدولة بدت مستعدة لعكس عقود من القيود، والترويج لنفسها كبطل لتحرير النساء، لكن ضمن الحدود ووفقاً لثوابت الشريعة آنفة الذكر. وهذا ما نشهده كذلك اليوم عبر بحث الدولة عن حلفاء محليين وشرعية دولية لتغدو حسب تعبير الرشيد «دولة نسوية» في مواجهة طابعها التاريخي باعتبارها الدولة الأكثر ذكورية. هنا، وضمن هذه السياسات الجديدة، لا يتم إلقاء اللوم على السلطة السعودية، بل تُحمَّل المؤسسة الوهابية كل الذنب، في المقابل تتم الإشادة من قبل نخب نسوية وليبرالية بالقيادة السعودية كقوة تقدمية تقضي بشكل تدريجي على عقبات الإصلاح الثقافي والديني، لكنه إصلاح لا يتم وفقاً لهذه النخب إلا من خلال استخدام الدولة للعنف تجاه المؤسسة الدينية، كما يشير إلى ذلك المثقف الليبرالي السعودي تركي الحمد، الذي نشر قبل أيام قليلة تغريدةً على صفحة التويتر مفادها «في عام 1929، واجه الملك عبدالعزيز الإخوان بمعركة السبلة عندما أصبحوا خطراً على الدولة بأيديولوجيتهم المتطرفة. اليوم يبدو أننا بصدد سبلة جديدة»، وهي مفارقة تعني تبرئة ساحة السلطة مما جرى، بدون أي محاولة نقدية أو إشارة تذكر لدور سياسات الدولة الجنسانية في تهميش النساء السعوديات لعدة عقود.
٭ كاتب سوري
القدس العربي