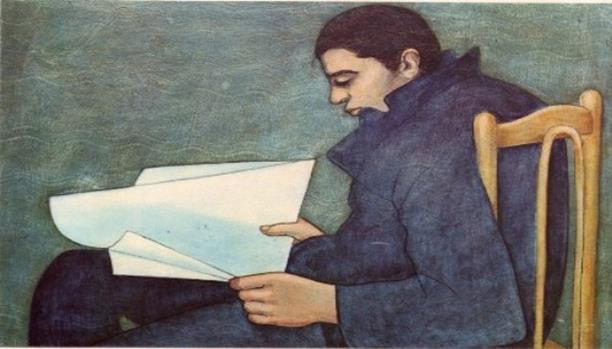فصول من المسيرة الناقصة للسويدي توماس سترانسترومر (نوبل): الذكريات ترصدني
ترجمة: بول شاوول
“الذكريات ترصدني” مشروع سيرة ذاتية بقلم الشاعر السويدي توماس سترانسترومر لم يكتمل، بسبب الظروف الصحية التي عاناها الكاتب، فاقتصرت على مرحلة الطفولة والصبا والشباب يقول سترانسترومر “حياتي” عندما أفكر في هذه الكلمات أرى أمامي شعاع ضوء. وفي النظر إليه عن كثب، ألاحظ أن لهذا الضوء شكل نيزك وهذا يمتلك رأساً وذيلاً. طرفه الأكثر ضوءاً، أي رأسه، هو الطفولة وسنوات التكون. أحاول ان أتذكر، أحاول أن أمضي الى هناك. لكن الكاتب يتوقف هنا لأنه “من الصعب الانتقال الى هذه المنطقة الكثيفة! وهذا يبدو محفوفاً بالخطر، ويعطيني انطباعاً بالاقتراب من الموت”، ويتوقف الشاعر السويدي في رأس الشعاع الطفولة والصبا… متهيباً إدراك تلك الأزمنة التي تطل على الهاوية… الهاوية السحيقة: الموت.
اخترنا من الكتاب ثلاثة فصول.
[ الحرب
كان ذك في ربيع 1940. كنت صبياً نحيلاً في التاسعة غالباً ما ينحني على خريطة العمليات العسكرية المنشورة في الجريدة، حيث كان تقدم القوات الألمانية المدرعة مشاراً إليها بأسهم سوداء. هذه الأسهم كانت تخترق فرنسا، وهي تعيش حياة طفيلية في أجسامنا، نحن أعداء هتلر. ذلك لأني كنت أعتبر نفسي من بينهم. لم أنخرط اطلاقاً بمثل هذا الشغف السياسي.
يمكن أن يبدو الكلام تافهاً على التزام في سن التاسعة، لكن الأمر لم يكن يتعلق بالسياسة تحديداً. كنت أهتم فقط بمتابعة الأزمة. لم يكن عندي أدنى فكرة عن المسائل الاجتماعية، والطبقات الاجتماعية، والنقابات، والحياة الاقتصادية، وعن توزيع الموارد، والاشتراكية مقابل الراسمالية.. الخ..
كان يسمى “شيوعياً، الشخص الذي ينتمي الى معسكر روسيا. واليميني كان بعض شرائح هذا الحزب، يؤيد ألمانيا. ما فهمته آنئذ عن “اليمين”، أن من ينتخبهم هم من الاغنياء. لكن ماذا تعني كلمة “غني”؛ كنّا ندعى أحياناً للعشاء من قبل عائلة تحسب أنها غنية. كانت تعيش في ابلفيكن ورب البيت كان تاجراً بالجملة، بيت كبير خاص، خدم بلباس الأبيض والأسود. دونت أن الولد الذي يجايلني يملك شاحنة كبيرة بدواسات سيارة إطفاء يحسد عليها. ولكن كيف السبيل الى توفير مثلها. في لحظة، تملّكني شعور بأن هذه العائلة تنتمي الى طبقة اجتماعية أخرى، الى تلك التي تستطيع توفير الامكانات لتقديم سيارات بدواسات من الحجم غير الاعتيادي. لكن بقي ذلك ذكرى معزولة، ذات أهمية نسبية.
ذكرى أخرى من تلك الحقبة: بمناسبة زيارة الى أحد زملاء الصف، دهشت بمعرفة انه لم يكن في الشقة مرحاض، ولكن بيت الخلاء في الباحة، كما كان عندنا في الريف. فالتبول يتم في حجرة عتيقة، تفرغها أم صديقي في طنجرة. كان ذلك بالنسبة إلي تفصيلاً بارزاً. ما عدا ذلك، لم أكن أفكر في حال أن هذه العائلة محرومة من كل شيء. ولم تبدُ قبلاً “إيليك” ذات أهمية خاصة. كنت مجرداً من هذه الملكة التي يتمتع بها كثيرون منذ صغرهم، وهي القدرة ومن الهولة الأولى، على هذا الحكم على الانتماء الاجتماعي لبعضهم، والمستوى الاقتصادي لجوارهم. كثير من الأطفال قادر على ذلك، ليس أنا.
غريزتي السياسية ركزت على النازية والحرب دون سواهما. كنت أفكر إما نحن مؤيدون للنازية أو ضدها. ولم أتوصل الى فهم الفتور العمومي في السويد، الانتظار والانتهازية من قبل مواطني، فسرتهما بأنهما دعم ضمني للحلفاء، أو شكل مخفي من النازية. وعندما كنت أتأكد من أن شخصاً أحبه يؤيد الألمان أحسست بضغط هائل على الصدر. كل شيء يتحول عدماً، يزول كل ما هو مشترك بيننا.
كنت أنتظر من الأقرباء تضامناً مطلقاً في هذا الميدان. ذات مساء كنا عند العم الوف والعمة أغدا، سمعت بعد الأخبار عمي، الصامت عادة، يقول: “والانكليز أجروا انسحاباً متوجاً بالنجاح” قالها بطريقة مشفقة لكن لحظت أن هناك أيضاً نبرة ساخرة في هذا التعليق (كانت السخرية عادة بالنسبة إليه نوعاً ما غريبة)، وأحسست أيضاً بضغط على صدري، فالنظر الى وقائع حرب الحلفاء يجب ألا تكون موضع أخذ ورد. نظرت نظرة مقطبة الى مصباح السقف. كان له شكل الخوذ الانكليزية ذاته: شكل صحن الشوربا.
غالباً ما كنا نتعشى يوم الأحد عند عمي الآخر وزوجته، اللذين يسكنان في انسلكيد، وتحولا الى عائلة تبنّي لوالدتي منذ طلاقها. كان الطقس يتطلب أن نفتح الراديو، لسماع النشرة السويدية لـBBC.
لن أنسى إطلاقاً جينيريك البرنامج. نسمع أولاً دقة لندن، ثم النغمة التي كانت تستخدم كإشارة والتي نتأكد منها أنها Trumpet voluntary، لبورسيل (على أنها كانت في الحقيقة تدبيراً مُفخماً لجيرميا كلارك.
كان صوت المذيع الهادئ يكلمني، بنبرة خفيفة، عن عالم أبطال عاديين يستمرون بهدوء في اخلاء مواقعهم، تحت وابل من القذائف.
عندما كنّا في قطار الضاحية الى “انسكيد” أردت دائماً أن تفتح أمي التي تكره لفت الانتباه، الجريدة الدعائية “أخبار انكلترا”، لتكشف هكذا، ومن دون أي كلمة، في أي ضفة نحن؟ كانت تقريباً تفعل كل شيء من أجلي، حتى هذا. لم ألتقِ أبي إلا نادراً أثناء سنوات الحرب. لكن ذات يوم، جاء من دون إنذار واصطحب أمي الى حفل نظّمه أصدقاء صحافيون. كانت كؤوس على الطاولات، وشوشات وضحك، وكثير من دخان السجائر. قمت بجولة حول الاجتماع لأسلم وأجيب عن الأسئلة التي تطرح عليّ. ساد المكان جو من التسامح ومن الفرح، حيث كان في إمكاننا قول كل ما نشاء. انتحيت جانباً واستعرضت رفوف مكتبة هذا البيت المجهول.
وقعت على كتاب صدر حديثاً “شهيد بولونيا”. عمل وثائقي. اقتعدت الأرض وقرأت الصفحتين الأولى والأخيرة، في الوقت الذي لم يتوقفوا عن الوشوشة فوق رأسي. هذا الكتاب الرهيب الذي لم أعثر عليه إطلاقا ًبعد ذلك حرّك كل ما كان يثير مخاوفي أو أملي. كان النازيون لا يقلون لا إنسانية عما تخيّلت وأسوأ كذلك.
وهذا يعني أنني كنت دائماً على حق!. كل شيء كان موجوداً في هذا الكتاب. وكل شيء معززاً بالأدلة. انتظروا! وسترون يوماً ما، يوماً ما سنرى الحقيقة في وجوهكم، أنتم الذين يشككون”. لن تخسروا شيئاً في انتظاركم! وبهذه الطريقة تمت الأمور.
[ ذكريات
“حياتي”، عندما أفكر في هذه الكلمات، أرى، أمامي شعاعاً من ضوء. وإذا حدقت فيه عن قرب، ألاحظ أن لهذا الضوء شكل الشهاب، وانه يتمتع برأس وبذنب. طرفه الأكثر إشعاعاً، أي في الراس، هو الطفولة وأيام التكوين. النواة، يعني قسمه الأكثر تركيزاً، يوائم الطفولة، حيث تتحدر الخصائص الأكثر انطباعاً في الشخصية. أحاول التذكر، أحاول الوصول الى هناك. لكن من الصعب التنقل في هذه المنطقة الكثيفة: وحتى هذا يبدو مخيفاً ويعطيني انطباعاً بالاقتراب من المدن. أبعد، في الخلف، يذوب الشهاب في جزئه الأطول.
ينتشر، من دون الكف عن التوسع، أنا اليوم بعيد جداً عن ذنب الشهاب: أكتب هذه السطور وأنا في الستين.
تجاربي الأولى، في معظمها، صعبة المنال بالنسبة إلينا. الوقائع، ذكريات الذكريات، إعادة البناء تتأسس على اختيار مشاعر تلتهب فجأة. ذكراي الأقدم تتصل بشعور، بشعور بالفخر.
كنت قد بلغت تماماً الثالثة وقيل لي أنه حدث بالغ الأهمية، لأنني الآن صبي كبير. نمت في غرفة واسعة مضيئة، وفجأة، أزلق على الأرض، واعياً تماماً انني في طريقي إلى أن أصبح راشداً. عندي دمية أعطيتها أجمل اسم: كارين سبينا. لا أعاملها معاملة الأم لابنها… وإنما كصديقة أو عزيزتي الصغيرة، كنا نقطن في أحياء ستوكهولم الجنوبية، شارع 33 بليكينجيغتان.
جدي، كارل هلمر ويستربرغ، ولد في 1860. كان طياراً ساحلياً وصديقي الأعز، يكبرني بـ71 عاماً. شيء غريب، كان فارق السن ذاته بينه وبين جده، المولود عام 1789: عام سقوط الباستيل، تمرد انجالا، العام الذي ألف موزارت مقطوعته “كنتيت” ودوكلارينيت. خطوتان الى الوراء بالطول ذاته، خطوتان كبيرتان إلا إذا لم تكن أكبر من ذلك. وتلامس التاريخ.
كان جدي يعبر بلغة سويدية من القرن التاسع عشر. معظم التراكيب التي يستخدمها تبدو اليوم عتيقة جداً، لكن، من فمه، وبالنسبة إلي، تبدو طبيعية، كان جدي ذا قامة قصيرة، بشاربين أبيضين وبأنف غليظ، ومقوس نوع ما” كما ومثلما كان يقول “كأنف تركي”. لم يكن مجرد من المزاجية ويمكن أن تتملكه نوبة غضب. لكن نوبات غضبه لم تكن تؤخذ على محمل الجد ممّن حوله، وتعبر حالاً. كان جدي مجرداً تماماً من العدوانية. كان، في الواقع قابلاً بسرعة كبرى لعقد اتفاق بحيث يمكن أن يظهر بمظهر الضعيف. وكان يصر أيضاً على أن يبقى على علاقة جيدة بالغائبين، هؤلاء الذين كانوا عرضة للنميمة في سياق حديث بلا أي أهمية.
لكن يا أبي عليك أن تعترف بأن فلاناً نصاب!.
آه، عجيب، لست على علم بشيء عن ذلك بعد الطلاق انتقلنا أنا وأمي الى مبنى سكنه. شرائح شكلية من الطبقة الوسطى ويقع في 57 فولكيننماتان خليط من الأنواع. يعيش في أمكنة ضيقة. الذكريات التي أحفظها من ذلك المنزل تمر وكأنها تقريباً كفيلم من الثلاثينات أو الأربعينات، حيث كل مجموعة من الأشخاص تجد مكانها. كانت هناك زوجة الناطور المسلية وهو رجل صامت ومتماسك أعجبت به كل الاعجاب، لأنه تسمم بآلة الغاز، ما يعني أنه كان على مقربة مباشرة من الآلات الخطرة.
نادراً، رؤية أشخاص غرباء في المبنى. مع هذا يتوصل بعض السكارى أحياناً الى الوصول الى قفص المصعد: مرة أو مرتين أسبوعياً.
يطرق المتسولون بابنا، يتمتمون في الدرج، تحضر أمي لهم الحلوى وتقدم منها شرائح الخبز بدلاً من المال.
كنا نسكن في الطابق الخامس. يعني عالياً، أربعة أبواب هناك، خارج العلية.. على احدها، كتب أحدهم “أورك مصور فوتوغرافي صحفي”. بطريقة ما يمكن أن نتخيل أن وجود مصور فوتوغرافي صحفي جاراً لنا أمر ظريف.
جارنا الأقرب، الذي نسمعه عبر الجدار، عازب بسن ناضجة وبشرة صفراوية يمارس مهنته في المنزل في نوع من وكالة سمسرة.. وكان أثناء مكالماته التلفونية يطلق قهقهات ضوضائية.. ضجة أخرى تتكرر باستمرار صادرة عن سدادات بورسلين تقفز. فزجاجات الجعة الشقراء “بيلسين” لم يكن لها عندها كبسولات. هذه الضجة الدينوزياكية، هذه النغمات المرنانة وجلبة الزجاجات التي تفتح لم يبدُ لي أن لها علاقة بهذا الرجل الطيب ذي الشحوب الجثثي. الذي ألتقيه أحياناً في المصعد. ومع السنوات يصبح الدمث مرتاباً وضحكاته متباعدة.
ذات يوم وقعت حادثة عنيفة عندنا. كنت لا أزال صغيراً. رمت امرأة أحد الجيران خارج البيت. كان ثملاً في نوبة من الغضب، وتخفيت في الشقة. حاول خلع الباب وهو يهمدر متوعداً. ما أتذكر، أنه كان يكتب هذه الجملة الغريبة: “لا أبالي، في أن أذهب الى كانغشولمن!؟ “فماذا هو كانغشولمن؟” سألت أمي.
شرحت لي أن مفوضية الشرطة المركزية كانت في جزيرة كانغشولمن. الحي، في نظري، اكتسب فجأة شيئاً حزيناً، وأحزن كذلك من اللحظة التي ذهبت فيها الى مستشفى سانت ايريك” ورأيت معوّقي الحرب الآتين من فنلندا يعالجون فيه أثناء شتاء 1939 1940.
كانت أمي تذهب الى العمل باكراً صباحاً. لم تستقل الأوتوبيس، على امتداد حياتها في مرحلتها الراشدة، كانت تروح وتجيء بين أحياء سودر وأوسترمالم تعمل في مدرسة “هيدينغ اليونورا”، الابتدائية وتتولى كل سنة تدريس الصفين التاسع والعاشر. كانت مدرّسة متفانية وقريبة من تلامذتها. وكان من الصعب الاعتقاد بأنها قد تتقاعد. لكن لم تكن الحال كذلك: فقد شعرت بالارتياح. وما دام العمل متوفراً لوالدتي، فعندنا خادمة منزل، أو “مدبرة تقوم بكل شيء”، كما كان يقال آنئذ، وإن، كان من الأرجح القول انها خادمة الطفل. كانت تنام في غرفة صغيرة تؤدي الى المطبخ ولم تكن من ضمن غرفتنا والمطبخ وهي التسمية الرسمية للشقة التي نقطنها.
عندما كنت في الخامسة أو السادسة كان اسم الخادمة أنا ليزا وآتية من “اسلوف”. كنت أراها جد جذابة بشعرها المضيء والأجعد، وأنفها، الخانس ونبرتها المتلجلجة العذبة. كانت كائناً رائعاً وما زلت أحس حتى اليوم بشيء خاص عندما أمرّ بمحطة القطار في اسلوف. لكن لم أنزل إطلاقاً إلى هذا المكان السحري.
بين مواهبها المتعددة، كانت أنا ليزا تجيد الرسم. متخصصة بشخصيات والت ديزني. في هذه المرحلة، نهاية الثلاثينات، لم أكن أتوقف عن الرسم. كان جدي يجلب لي لفافات طويلة بيضاء، من النوع ذاته الذي يستخدم في محل الحلويات، وكنت أغطي هذه الورقة بالحكايات المصورة. تعلمت الكتابة في الخامسة، لكن لم يتم ذلك بشكل سريع. فمخيلتي كانت تتوق الى وسائل تعبير أسرع. الى ذلك. لم أكن أتمتع بالصبر لأرسم بشكل صحيح. وسّعت نوعاً من الستينوغرافيا الشخصيات، تخترق أجسامها حركات عنيفة وتشترك في حلقات درامية خطرة، لكن من دون أي تفصيل. كانت رسوماً من الشرائط المصورة التي كنت أتصفحها وحدي.
ذات يوم، منتصف الثلاثينات، اختفيت في قلب ستوكهولم، ذهبنا أنا وأمي لحضور أمسية موسيقية لعمّي. في غمرة الزحمة، ولدى الخروج من “دار الكونسير”، أفلتت يدي من يد أمي التي كنت أمسك بها، فجرفتني الموجة البشرية، وبما أنني كنت صغيراً لم تتوصل أمي إلى العثور عليّ. هبط الليل على هوتورجيت، الشارع الواقع قرب المبنى. تملكّني الخوف. ثمة أناس حولي، لكن مشغولون باهتماماتهم. لم يكن هناك ما أستطيع التعلق به. كانت في الواقع تجربتي الأولى في الموت.
بعد لحظات من الذعر، بدأت أفكر. لا بد أن يكون هناك احتمال وجود سبيل، وأكثر، للعودة الى المنزل. جئنا بالأتوبيس. جثوت عندها على المقعد، كما أفعل دائماً، ونظرت من النافذة. لم يكن عليّ إلا أن أخذ الطريق ذاته بالاتجاه المعكوس، من محطة أتوبيس الى أخرى. ذهبت في الوجهة الصحيحة. لم أعد أتذكر إلا جزءاً من هذا المسار الطويل. أن أصل الى جسر الشمال وأرى هناك الماء. في هذا المكان كان السير مزدحماً ولم أكن أجرؤ على عبور الشارع”.
توجهت الى رجل كان قربي وقلت له “هناك سيارات كثيرة هنا”. أخذني بيدي وأوصلني الى الجهة الأخرى، بعدها تركني وحدي. أجهل تماماً لماذا يفكر هذا المجهول وكل الراشدين الآخرين أن عبور طفل ستوكهولم وحده ليلاً أمر طبيعي. لكن هكذا كانت الحال. ما تبقى من مساري عبر “المدينة القديمة” وهي سودر من خلال سلوسن. لا بد كان معقداً ربما كنت أحمل في داخلي هذه البوصلة السرية التي تمتلكها الكلاب والطيور المهاجرة حيثما تترك تعثر دائماً على الطريق التي توصلها الى صاحبها. لم أعد أتذكر شيئاً من الجزء الأخير لنزهتي سوى أمر واحد: بأن ثقتي تكبر باستمرار، وإنني كنت في حالة من النشوة المطلقة عندما وصلت الى البيت. استقبلني جدي… أمي كانت منهارة تتابع مجرى البحث في مفوضية الشرطة. أعصاب جدي لم تهن، عرف كيف يستقبلني بشكل طبيعي. كان طبعاً سعيداً، لكن من دون تهويل: كان كل شيء إذاً بسيطاً ومطمئناً.
[ تعزيم
قلق رهيب انتابني في شتاء الخامسة عشرة من عمري. كان بروجكتور يحاصرني في دائرة هي أقرب الى القمة منها الى الضوء. يحبسني كل بعد ظهر، عندما يفرّ النهار، فلا يزول خوفي إلا في اللحظة التي ينبثق فيها الفجر. كنت أنام قليلاً جداً، جالساً في سريري، وكتاب ضخم مفتوح أمامي: في تلك المرحلة، “قرأت عدة كتب ضخمة، لكن لا أستطيع التأكيد. إنني قرأتها، لأنني لم أحتفظ بأي أثر. كانت هذه الكتب ذريعة لإبقاء اللمبة مضاءة.
كل شيء بدأ نهاية الخريف. في أحد المساءات التي ذهبت فيها الى السينما لأشاهد فيها “السم” (فيلم أميركي لبيلي وايلدر، 1949)، الذي يروي قصة مدمن كحول انتهى به الأمر الى الوقوع في الهذيان مشهد صادم قد يكون بدا لي اليوم عبثياً. لكن في تلك المرحلة… “عندما نمت ذات مرة أو على وشك أن أنام رأيت الفيلم يدور أمامي كما يحدث غالباً بعد حفلة سينما.
فجأة، بدا الرعب يجمّد مناخ الغرفة. شيء ما انتابني، ومن دون صراخ راح جسمي يرتجف، خصوصاً الساقين.
تحولت دمية آلية تقفز وتتحرك في كل اتجاه، كأنما فاقد الرشد. كانت هذه التشجنات كلها خارج إرادتي. لم أمرّ بمثل هذه التجربة من قبل. صرخت مستنجداً فدخلت امي الغرفة. زال التشنج شيئاً فشيئاً، ولم يتكرر. لكن الخوف ازداد وصار يلازمني، من الغروب حتى انبلاج النهار. ما أحسست في تلك الليالي جعلني أفكر بالرعب الذي عرف فرتيز لانغ كيف يوجه في بعض مشاهد من فيلم “وجبة الدكتور مابوز لا سيما الأول، في مشهد المطبعة، حيث هناك شخص مختبئ في الزاوية، بينما تدور الآلات وكل شيء يهتز حولها. “لقد تمثلت نفسي في ذلك. مع هذا، كانت لياليّ أقل ضجيجاً”.
كان المرض أكبر مدى يمكن للوجود أن يدركه. لم يعد العالم سوى مستشفى واسع. أمامي، دائماً، رجال بأجسام مبتورة وبنفوس مجروحة. تحاول اللمبة المضاءة إبعاد هذه الوجوه المرعبة، لكن يأخذني النعاس أحياناً، تطبق جفوني، وفجأة تعود وجوه الرعب لتلتصق بوجهي.
لم تكن هناك أي ضجة، لكن أصوات تشتغل بلا انقطاع في الصمت.. الأوراق الملصقة على الجدران تكشر فجأة. وأحياناً، تكسر جدران يجعلني أنتفض.
ما يحدث ذلك؟ ومن يحدثه أنا؟ كنت أسمع تكسر هذه الجدران لأن أفكاري المرَضية تدفعني الى سماع ذلك! وهنا الأسوأ… أتراني جُننت؟ أم على حافة الجنون؟
كنت أخاف أن يختل عقلي، مع هذا لم أكن تحديداً مهدداً بالمرض: ليس مرض الوسواس. كلا هذا الرعب اثاره بلا شك فيلم “سلطة العذاب المطلقة للمرضى”. في مثل هذه الأفلام حيث نشاهد شفة عادية جداً يتغير شكلها ما إن ترتفع موسيقى موجهة لترعب المشاهد، العالم الخارجي يبدو لي كذلك لأن فيلم “سلطة العذاب المطلقة للمرضى” كانت شاملة. قبل سنوات أردت أن أكون باحثاً. وها اني أدخل في بلاد مجهولة لم أرد اطلاقاً أن أمضي اليها. اكتشفت قوة شريرة. أو الأحرى، ان هذه القوة الشريرة هي التي اكتشفتني.
مؤخراً، وقعت بين يدي مقالة تتناول هؤلاء المراهقين الذين فقدوا كل فرح بالحياة، لأنهم مهووسون بفكرة أن السيدا تسود العالم. لا بد وانهم يفهمونني.
وفي نهاية هذاالخريف، وقد زالت هذه الأزمة كانت أمي شاهدة على تشنجاتي الليلية، لكنني أردت أن أبعدها عن كل ذلك، فيجدر بأقاربي أن يبقوا خارج ما يحدث لي: كانت أرهب من أن أتكلم عنها. كنت محاطاً بالأشباح. وصرت أنا بالذات شبحاً يتردد الى المدرسة كل صباح ويحضر الصفوف من دون أن يعترف اطلاقاً بسره. فالمدرسة كانت مكاناً للراحة، حيث يبدو القلق غائباً. كانت حياتي الخاصة مسكونة. كل شيء يبدو مقلوباً.
كنت أرتاب، في تلك المرحلة من كل أشكال الدين ولا أتلو أبداً الصلوات. وإذا كانت الأزمة قد حلت بعد ذلك بسنوات، لرأيت فيها تجلياً أو شيئاً كان من شأنه أن يفتح عيني، بطريقة اللقاءات الأربعة التي حققها سيدهارتا (مع عجوز، مريض، جثة وراهب متسول). لكنت أحسست أكثر. بالتعاطف وأقل بالخوف من هؤلاء المرضى المشوهين الذي يبرزون في العتمة: لكن في لحظات القلق هذه، لم أكن أمتلك أي تفسير على مستوى ديني يمكن اللجوء اليه. لا صلوات، ولكن محاولات من التعزيم الموسيقي. لأنه عندها تحديداً بدأت جدياً بضرب ملامس البيانو. ورحت أكبر. في بداية الفصل الأول كنت أصغر الطلاب وأكبرهم في نهاية الربيع. كأنما الخوف الذي أعيشه كان التراب الذي يوفر للنبتة بأن تنمو. أوشك الشتاء على نهايته، والأيام تطول، وهنا بالذات حدثت المعجزة: انسحبت العتمة من وجودي. وتمّ ذلك تدريجاً وتطلب مني وقتاً لأعي ذلك. ففي مساء ربيعي أحسست أن الخوف بات هامشياً. في رفقة بعض الرفاق، كنت “أتفلسف” (مدخّناً سيجاراً) و في لحظة عودتي الى المنزل في هذا الليل الربيعي المنقشع، فهمت، انني لم أعد على موعد مع الرعب في البيت.
مع هذا، فهو شيء عشته جيداً. لكنه انتهى. كنت أرى فيه آنئذ الجحيم، لكنه لم يكن سوى المطهر.
المستقبل