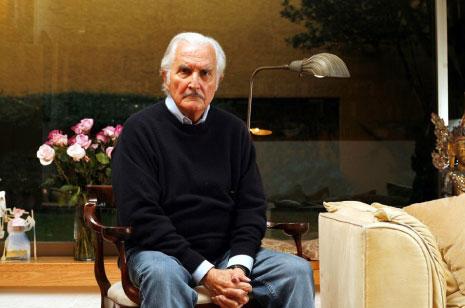قصائد هَيْرفيلْد التلّ” لسعدي يوسف لحظاتٌ عابرة
تبديد الخفوت السري للشعر في النثر اليومي
محمد أبي سمرا
في مجموعته الشعرية الأخيرة، “قصائد هَيْرفيلْد التلّ” (دار الجمل)، يقترب سعدي يوسف من كتابة لحظات يومية عابرة، اعتماداً على حساسية شعرية مكنونة تنهل من اليومي وتصدر عنه مستغرقة في نثريتها السريعة التي تستنزفها المداومة على الكتابة بوصفها حرفة أسلوبية.
يسجل الشاعر العراقي سعدي يوسف نثر حياته اليومية شعراً أقرب إلى نثر الحياة اليومية في تيهه متشظياً بين لندن وباريس وطنجة وبروكسيل وامستردام، غير عابئ باقترابه من الثمانين من العمر، الا في واحدة من أخريات قصائده في الكتاب: “إن لي يا زهرة…/ تسعاً وسبعين؛/ ماذا تريدين مني؟/ وماذا أريد؟/ تقولين: عمّان بيتكَ./ عمان بيتي،/ وهاأنذا، أسكن القفر… أسكن لندن/ حيث الضواري أحنُّ من الناس”.
التيه العراقي
منذ ما بعد المحطة الأولى من تيهه شيوعياً عراقياً في بيروت، بين أواسط سبعينات القرن العشرين وصيف 1982، أخذ شعر سعدي يوسف يميل في الكثير من قصائده إلى أن يكون شعر تيهٍ وتشرّد ثوري، مداره ومداده لحظات آنية عابرة. في قطار “أيروستار” المتجه من باريس إلى لندن في 4 نيسان 2011، كتب في مستهل مجموعته: “غادرت باريس صبحا…/ كان منعقَدٌ من السحاب شفيف./ كان في شفتيَّ برْدٌ،/ وبُقْيا نبيذ الليل (…) باريس التي شرعت تنأى/ أراقبها من نافذات قطار”. في مطلع 2013 كتب قصيدته “موعد؟” التي يقول فيها ان لندن قفر، وضواريها أحنّ من ناسها، بعد تذييله الكثير من قصائد المجموعة بتواريخ كتابتها في لندن التي يسجل لحظاتٍ من حياته فيها، فيلتقي نساءً كثيرات في غرف وأوقات كثيرة عابرة، من دون ان يلمح ويرينا أيّاً من الضواري، سوى بعضٍ من الكلاب “الداجنة” في البيوت أو الغرف التي دخل إليها.
في بعض القصائد اللندنية الأخرى يتردد اسم العراق، بعد استعادته، في بداية المجموعة، ذكرى من فُتُوَّته في دمشق العام 1957: “حفرنا بأظافرنا السود، خنادق حول دمشق…/ بساتين الغوطة كانت بكثافة أدغال الأمازون، ومن أعلى جبل الشيخ يسيل الماءُ زلالاً بين أصابع مفعمة بتراب الأرض./ شربنا عرقاً، رُبعَ البطحة/ ثم نعمنا بشطيرة خبزٍ عربي، رُبعَ الليرة…/ في الـ57/ أحببنا/ وكتبنا في ضوء الشمع قصائدنا الأولى./ كان زماناً ذهباً”. أما اسم العراق، فشأن ذكرى دمشق، يحضر أيقونة حنين طالع من حلم يقظة سعيد في لحظات التشرّد والتيه المديد غرباً. واذا كان الحنين الجارف والجريح إلى العراق، ورفعه ايقونة فردوسية للخلاص من التيه والتشرد في المنافي، يحضران حضوراً واسعاً وقوياً في الكثير من الشعر العراقي، فإن هذا الحضور في شعر سعدي يوسف يختلف عنه في شعر بدر شاكر السياب، رائد الشعر العراقي الحديث. فكلمة العراق وحدها، من دون صفة ولا إضافة في أشعار السياب، تنطوي على شحنات راعفة من الشجن والأسى واللوعة، كما في “غريب على الخليج”: “صوت تفجّر في قرارة نفسي الثكلى: عراق (…) الريح تصرخ بي: عراق، الموج يعول بي: عراق، عراق”، الذي ضاعفت قوة القهر والسجون والرعب والتعذيب والقتل فيه، من قوة حضوره في اشعار العراقيين المقتلعين والتائهين في المنافي. لكن ليس من شعر لصيق بالعراق، وطالع من الروح العراقية والطبيعة العراقية، أكثر من شعر السياب الذي يكاد ان يكون جدارية ملحمية للعراق ومآسيه: “كل عام – حين يعشب الثرى – نجوع/ ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوع”. و”أكاد اسمع النخيل يشرب الماء/ وأسمع القرى تئن، والمهاجرين/ يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع/ عواصف الخليج، والرعود، منشدين: مطر… مطر… مطر/ وفي العراق جوع/ وينثر الغلالَ فيه موسمُ الحصاد/ لتشبع الغربان والجراد/ وتطحن الشوّان والحجر/ رحىً تدور في الحقول… حولها بشر”، (من “أنشودة المطر”).
اللوثة الغامضة
مقارنة مع شعر السياب، تبدو أشعار سعدي يوسف، “السيّابية” الروح والخارجة عليها والمبتعدة منها والمنقطعة عنها في وقت واحد، تفاصيل آنية عابرة من الجدارية السيّابية الكبرى. فهي أقرب الى يوميات يجري تدوين لحظات منها، اعتماداً على حساسية شعرية مكنونة تنهل من اليومي العابر وتصدر عنه، مستغرقة في نثريتها السريعة التي تستنزفها المداومة على الكتابة، بعد تحوّلها حرفة أو مهنة أسلوبية متناسلة، غابت عنها المفاجأة والجدة والابتكار والرؤية التأملية للوجود والعالم. كأن ذلك الخفوت السري الأليف الذي تميزت به قصائد سعدي يوسف، فقد بطأه وتلاشى، ليكتب الشاعر نثر حياته اليومية المتسارعة في لحظات معدودات، ويتفرَّغ لما يعتبره سلوكاً شعرياً، وموقفاً شعرياً من العالم والوجود. فسعدي يوسف يعتبر الشعر مذهباً سلوكياً أكثر منه عملا كتابياً. في هذه الحال يبدو الشعر أقرب الى لوثة غامضة لا يحتاج المصاب بها الى شيء آخر سواها لتصير كلماته شعراً خالصاً، مصدره التدلّه بالذات الشاعرة التي يمتلكها قبل مباشرته الكتابة التي تترجم أصداء سلوكه الشعري ومذهبه الشعري في حياته اليومية: “أنا أبحثُ عن بيت/ منذ سنين وأنا أبحث عن بيت/ كم بلدان طوّفت بها وأنا ابحث عن بيت! كم قاراتٍ! كم أثواب نساء…/ كم ساحات للقتل!/ كم كتب…/ كم مدن!/ وأخيراً: أنا في طنجة أبحث عن بيت (…) لكنني سأعود (كما كنت) بلا بيت/ اللابيتُ هو البيتُ… إذاً!”.
تنضيد الكلمات
على هذا المنوال يكتب سعدي يوسف قصائد مجموعته الأخيرة، جاعلا من الخفوت السري القديم في قصائده مشجباً علنياً واضحاً يعلّق عليه الكلمات، متخلياً عن كل إيقاع داخلي وخارجي للكتابة التي تسلس له القياد بقليل من الجهد والأناة. كأن الكلمات ملقاة على الطريق، ولا تحتاج الى شيء آخر سوى تنضيدها لتصير شعراً: “اليوم/ كادت غيمة بيضاء تدخل غرفتي/ (أعني اوتيل/ ريتز) كادت، في الحقيقة، تدخل غرفتي،/ حتى لقد فتحتُ نافذتي لتدخل: أقبلي يا غيمتي البيضاء…/ أنتِ أتيتِ عبر مضيق سبتة/ من شمال العالم: الفقراء ينتظرون ماء منكِ/ ينتظرون أن تغدو الحقول، بلحظة، خضراء”. وكما في قصيدة البحث عن بيت، يبدو التكرار اللفظي عماد الشعر والكلمات. ويكفي أن يكون الختام على شاكلة “اللابيت هو البيت”، أو على شاكلة أن “الفقراء” و”الحقول ينتظرون” المطر من غيمة، لتكتمل شعرية التكرار اللفظي للكلمات. والحق أن قصائد المجموعة في معظمها مكتوبة وفق هذا المذهب الذي يفترض ان الكلمات تصير شعراً، لأن كاتبها شاعر مكرّس ومطعون بالشعر طعنة وجودية نجلاء منذ عقود، ويتدفق منه الشعر تدفق الماء من الينبوع. وإلا ما الذي يجعل هذا الكلام شعراً: “كان احتلال بلدي وشيكاً./ لكنك ملاك الحرية. تضامنتِ معي، يا أدريان ريتش، بينما أبناءُ بلدي هنا، في لندن، وهناك في الأرض الأخرى، كانوا مولعين بشتمي لأني ضد احتلال بلدي من جانب الإدارة الأميركية.(…) ماذا أقول؟/ القهوة التي شربناها كانت مرّة. القهوة، قهوتنا، نحن المارقين، ستظل مرّة./ (…) أنا الآن في المنفى. أتعرفين يا أدريان ريتش أن لي في المنفى قرابة أربعين عاماً؟”.
هذا الإصرار على البراءة المعذَّبة، على استجداء التعاطف مع منفيّ تائه، مع نبيّ شقيّ بنبوّته، ويضفي على نفسه دور الضحية المنبوذ من أبناء بلده، لأنه وقف ضد احتلال بلده، كيف يمكن صاحبه أن يدرج كلامه هذا في خانة الشعر، من دون شعوره بأنه شاعر مطوّب يستطيع أن يحوّل أي كلام شفوي شعراً خالصاً؟!
الإسلام
في لندن في 4 حزيران 2012، كتب سعدي يوسف: “ما ظللتُ لأجله، أبداً، أغامرُ/ هو أول الأسماء/ آخرها/ وأعظمها، وما يصلُ الحمادة بالسماء: هو العراق الأول العربي”. الشاعر الشيوعي المنفيّ كنبيّ يشقى بنبوّته، كتب أيضاً: “كان الاسلام، الحائط/ آخر ما تلتاذُ به/ حين تضيق بنا/ الدنيا/ ويحاصرنا الأعداء/ الإسلام هو/ الجذعُ، المدرّعُ/ الخيمة حي يطيحُ الأعداء البيت/ الاسلام هو/ المنبتُ والنبت وآياتُ حفاة وشراة/ الإسلامُ عليّ/ عُمَر/ الخنساء/ وطارق بن زياد/ الإسلام هو المرأة في السوق (…) هو/ الحلم بآخرة بيضاء/ وأسراب حمام”. لا يدري القارئ لماذا لم يرد في هذه السلسلة كل من أسامة بن لادن وأيمن الظواهي وأبو مصعب الزرقاوي وأبو حفص المصري؟!
النهار