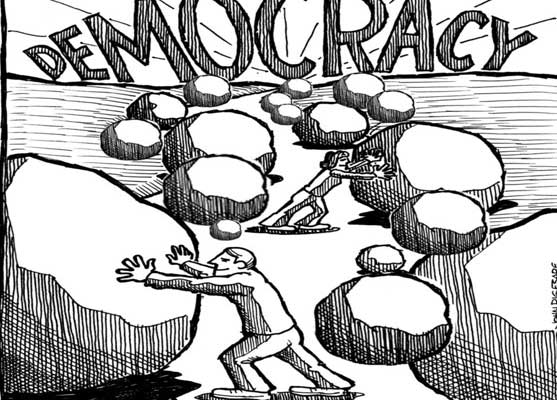قضية فلسطين بين مرقص والحافظ والعظم/ ماجد كيالي

لم تناقش قضية فلسطين، وقضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بعمق ومسؤولية وجدية كما تمت مناقشتها من قبل ثلاثة مثقفين سوريين، هم الياس مرقص، وياسين الحافظ، وصادق جلال العظم. فهؤلاء بالذات تميّزوا عن غيرهم بنظرتهم النقدية للتجربة الوطنية الفلسطينية، في مرحلة صعودها، أي في المرحلة التي انجرف فيها معظم المثقفين العرب، ومعظم التيارات السياسية العربية، نحو محاباة هذه التجربة، والتمجيد بالعمل الفدائي، والكفاح المسلح، وحرب التحرير الشعبية. وقد تميّزوا، أيضًا، بوضع قضية فلسطين والصراع مع إسرائيل على رأس جدول أعمالهم. وفضلًا عن هذا وذاك، فقد فكّر ثلاثتهم بقضية فلسطين وقيام إسرائيل ربطًا بواقع التأخّر العربي، وفوات البُنى السياسية والاجتماعية العربية، واعتبروا أن مواجهة إسرائيل لا تقتصر على الجيوش أو على العمل المسلح فقط.
الحديث هنا يدور، وبشكل محدّد، عن الياس مرقص، لا سيما في كتابيه “عفوية النظرية في العمل الفدائي” (“دار الحقيقة”، 1970)، و”المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن” (“دار الحقيقة”، 1971)، وعن ياسين الحافظ في كتابيه “اللاعقلانية في السياسة” (“دار الطليعة”، 1975) و”الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة” (“دار الطليعة”، 1978)، وعن صادق جلال العظم في كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة” (“دار الطليعة”، 1968).
ولا تستهدف هذه المقالة الاسترجاعية عرض هذه الكتب، بقدر ما تتوخّى التذكير بالأفكار الأساسية التي قدمها هؤلاء المفكرون، وتأكيد أهميتها الراهنة، والتعبير عن العرفان لمرقص والحافظ والعظم الذين أتوا بأفكار جريئة، بل ومبكّرة، في نقدهم الواقع السائد، بالقياس لغيرهم، بخاصة أنهم وقتها تحدوا التيار السائد بين المثقفين، سواء الذين حابوا الأنظمة أو الذين ركبوا موجة الثورات أو التيارات “الثورية” اليسارية والقومية وضمنها حركات المقاومة المسلحة.
طبعا لا بد لنا في مطالعة الأفكار المذكورة من أن نأخذ في اعتبارنا مستوى التطور الذي وصل إليه الفكر السياسي العربي، وضمنه الفكر السياسي في سورية، في ذلك الوقت، أي في الستينيات والسبعينيات أولًا. وثانيًا، ملاحظة حداثة التفكير السياسي في بلداننا، الذي اعتمد أساسًا، على الخطابات العاطفية والشعاراتية والأيديولوجية، فغلبت عليه لغة المطلقات والبديهيات والحتميات والرغبات. وثالثًا، حداثة التجربة السياسية والحزبية في المجتمعات العربية، حيثما وجدت، إذ حرّمت النظم العربية السائدة المشاركة السياسية، أو حدّت كثيرًا من الحريات السياسية، على تفاوتٍ بين بلد وآخر.
لعل ذلك كله يوضّح الأهمية التي يستحوذ عليها الفكر النقدي، الذي بادر إلى إطلاقه المذكورون (مرقص والحافظ والعظم)، في حقل التفكير السياسي العربي، في تلك الحقبة، حيث كانوا أهم أعمدته عن جدارة، إذ ساهموا بنشاط ودأب كبيرين في كسر اليقينيات والبديهيات والحتميات السائدة وتفكيكها، وإن بحدود معينة، ومن هنا تتأتى أهميتهم التاريخية والثقافية.
مرقص: إبعاد الأوهام
كان الياس مرقص أكثر الثلاثة نقدًا للشعارات المتعلقة بالصراع ضد إسرائيل، وللمفاهيم التي رأى أنها مضطربة، وقاصرة، حول الحرب الفدائية، أو الكفاح المسلح، أو حرب التحرير الشعبية، إذ بيّن أن كل واحد من هذه المفاهيم له دلالاته المختلفة عن الأخرى، وله متطلباته، وأن العمل الفلسطيني المسلح لا يشتغل وفق استراتيجية معيّنة، وأنه يفتقد للواقعية والعقلانية. ففي كتابه “عفوية النظرية في العمل الفدائي”، يقول مرقص: “في المفهوم: “الثورة الفلسطينية”. في الواقع: لا نشاهد “الثورة” الفلسطينية، بل نشاهد عملا فدائيًا محددًا محدودًا، ينطلق من الأغوار من الأردن ـ الضفة الشرقية، من سورية، من لبنان، من مصر، إلى داخل فلسطين… على الصعيد العسكري، أكبر قصور، أكبر خطأ وذنب تقع مسؤوليته على قادة العمل الفدائيين أنهم لم يصنعوا لا نظرية عسكرية لعملهم ولا مبادئ لهذه النظرية… حدودها؟ إمكانياتها؟ موقعها، مكانها… إن حرب الأنصار الفدائية الفلسطينية تنتظر نظريتها السياسية ـ العسكرية”.
ويؤكد مرقص أن “بداية كل نظرية، وشرطها الأول، وما قبل الأول، إبعاد الأوهام… والمثل، طرد الأشباح، الحركة الفدائية ستعمل وتنمو وتعيش حتى النصر، حتى التحرير، بدون هذا الشطح. تحرير فلسطين، أكبر بكثير من العمل الفدائي… إن “حرب الأنصار” الفدائية الفلسطينية تنتظر نظريتها العسكرية، السياسية ـ العسكرية، التي ليست مجموعة من آراء غيفارا وجياب ولينين وماو تسي تونغ، ولا مجموعة صورهم، ولا عددًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولا اجتماعات ما بين هذه وتلك”.
وعنده فإن الاتصال “بين العمل الفدائي وحرب التحرير الشعبية… ليس إلا اتصالا وهميًا” (213ـ 217). وفي كتابه: “المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن”، تحدث مرقص عن تغير موقف المقاومة، فبرأيه: “نمت المقاومة الفلسطينية بعد عدوان حزيران (يونيو) 1967، وخلال عام 1968 (معركة الكرامة)، وبعد مدة من الزمن أخذت في الانحسار. ففي عام 1970 خاضت معاركها الكبرى خارج فلسطين، في عمان وإربد والسلط، إلخ. وكانت هذه المعارك أكبر مئة مرة من معاركها في نابلس والخليل وغزة وحيفا ويافا”… وإنه “بدلًا من أن تكون لدينا نظرية واستراتيجية وتكتيك، وبدلًا من أن يكون لدينا تصور عن الواقع والمستقبل والاحتمالات والسبل والمراحل والهجوم والدفاع والسياسة والحرب يكون لدينا شعارات” (ص 15ـ 21). وعنده فإن “المقاومة الفلسطينية قد تتصور أن الجوهر هو في ذاتها: ثورة فلسطينية، كفاح مسلح، حرب تحرير شعبية. ولكن بين هذا التصور وبين الواقع مسافة كبيرة، هي الواقع، والدول (العربية والعالمية) والشعوب، والجيوش والأحزاب والطبقات والبترول… في الواقع الجوهر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ليس أيديولوجيتها (ليس ما تعتقده) بل ولا كفاحها المسلح الحقيقي ضد الصهيونية، الجوهر بالنسبة لها هو علاقاتها مع الدول والأنظمة العربية، في الصراع التاريخي بين الصهيونية والأمة العربية” (ص 96)، ويذهب مرقص في نقده إلى حد اعتبار أن “ما توفر من سلاح ومال للمقاومة الفلسطينية ولأية منظمة من منظماتها كثير وأكثر من كثير. لا أعتقد أن ماو تسي تونغ… نال ربع هذا السلاح والمال، ولا هوشي منه… إن الأيديولوجيا المقاومة قد منحت براءة ذمة وجواز مرور لجمعية المنتفعين بالقضية الفلسطينية. تلك هي وظيفتها الموضوعية المشهودة في العيان” (ص 102).
هكذا انتقد مرقص تحويل المقاومة إلى أيديولوجيا، وهي المرض أو الكارثة، التي ما زلنا نعاني منها، مع انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية وتحولها إلى سلطة، ومع تكشف حزب الله عن حزب لا وطني، أي ديني، وطائفي ـ مذهبي، وكذراع إقليمية لإيران وكمشارك في قتل السوريين دفاعا عن نظام الأسد الاستبدادي، وهي ذات الأعراض التي أصابت الظاهرة المسلحة في الثورة السورية، علما أن “داعش” وجبهة النصرة خارج هذه الحسابات، لمعاداتهما الثورة السورية، وأجنداتهما المختلفة والخارجية.
الحافظ: اللاعقلانية في السياسة
وكان ياسين الحافظ، رفيق مرقص، اشتغل على الخط ذاته، في نقده “اللاعقلانية في السياسة”، باعتبارها من أهم أسباب تخلف السياسة العربية، ومن أهم الأسباب التي تكمن في إخفاقاتها، طوال العقود الماضية. يقول في كتابه “التجربة التاريخية الفيتنامية”: “في الصراع العربي ـ الإسرائيلي كثير من الأوهام ينبغي أن تبدّد، وتبديد هذه الأوهام، هو الشرط الذي لا بد منه لقلب التفوق الإسرائيلي. إن التطور الفكري للشعوب يتلخص في انتقالها الطويل البطيء المتلاحق من الأسطورة والأيديولوجيا إلى الحقيقة الواقعية… ينبغي أن نخرج رؤوسنا من الواقع لا أن نخرج الواقع من رؤوسنا، وهذه هي نقطة البداية في مواجهة عقلانية، وبالتالي ناجعة للتحدي الإسرائيلي. يقينًا إن الأيديولوجيا ترزقنا بأمل ما يشدّ عزائمنا، غير أن الأمل الواهم لا يصنع تقدمًا ولا ينتزع تحررًا… آن لنا أن نجعل آمالنا مرتكزة على صخرة الواقع الصلبة لا الأوهام والأيديولوجيا… لأن آمالنا لم تكن ترتكز على أرض الواقع تكسرت رؤوسنا وما تزال على صخور هذا الواقع” (ص 26).
شدد الحافظ إجمالًا على نقد اللاعقلانية، ففي كتابه “الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة”، تحدث عن تعويض “المعتقد الإيماني الديني بمعتقد إيماني آخر، ربما زمني أو ثوري أو تقدمي أو اشتراكي أو قومي أو شيوعي .. لأن العالم الأيديولوجي أو الثقافي للناس، لم يبن بأحجار عقلانية وواقعية، لذا فإن ذبول معتقد إيماني ديني في عقل من العقول، لا يتبعه بالضرورة انبثاق توجهات عقلانية” (ص 17). ويلفت النظر هنا استخدامه تعبيرات “المعتقد الإيماني الديني” في وصفه المعتقدات الأيديولوجية الأخرى، وهذا في محله، وما زلنا نعاني من تبعات ذلك حتى اليوم، ولا سيما المجادلات والاختلافات حول الثورات العربية. إذ تبين أن الأيدولوجيات والأفكار الكبرى (القومية والشيوعية والعلمانية والليبرالية) باتت عند كثيرين، ولا سيما عند الأحزاب التقليدية، بمنزلة عمارات نظرية مغلقة ومطلقة ونهائية، لذا باتت عصيّة على التطور، وعلى التوطّن في البيئات العربية، ما جعل أصحابها “طوائف” أخرى، مثل الطوائف الدينية، أي أنها تحولت إلى طابع هوياتي.
بناء على ذلك، فقد دأب الكاتب على الدعوة إلى تأسيس رؤية واقعية لطبيعة المشروع الصهيوني وسبل مواجهته، وذلك برفضه إلقاء تبعات هزائمنا على الخارج، والأهم هو رفضه لعقلية المؤامرة، أو تفسير ما يحصل معنا بها، باعتبار ذلك مجرد محاولة للتغطية على العجز والتهرب من مواجهة الواقع، المتمثل بالتأخّر، وضمنه تأخر بنى المجتمع العربي، بتساؤلاته: “لماذا هذا التساقط السهل أمام الاستعمار، لو لم تكن بنى المجتمع العربي متآكلة ومفوّتة، وبالتالي، قابلة للاستعمار؟!”. ويتابع: “الخارجي ليس شيطان العرب إلا بقدر ما يسمح له بذلك تآكل وفوات الداخلي: الفوات العربي هو ذلك الشيطان… عندما نقرّ، وهذه حقيقة، أن الخارجي يفعل بقدر فوات وتآكل الداخلي، لا نعود بحاجة للصراخ على الطالع والنازل على الخارجي. بل سيكون تثوير وتحديث الداخلي وإقامة بنى جديدة، وبالنتيجة تعديل نسب القوى، وسيلة الفعل بالخارجي” (ص 213).
ومثلما لم ينظر الحافظ إلى قضية فلسطين بوصفها مجرّد قضية أرض محتلة، أو قضية شعب معين، وإنما باعتبارها قضية قومية وعربية، فهو لم ينظر إليها، أيضًا، بوصفها معركة عسكرية، أو مجرد تحدّ عسكري، وإنما نظر إليها من منظور أعمق وأشمل، وأكثر تعقيدًا، باعتباره قيام إسرائيل تحديًا للعالم العربي، من مختلف الجوانب. وتبعًا لذلك، فإن العمل من أجل تحرير فلسطين، ومواجهة إسرائيل، جزء من المعركة ضد التأخّر، ومن أجل تحقيق الوحدة، والنهوض، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي.
ورغم مساندته لصعود الكفاح الفلسطيني، إلا أنه انشغل أكثر بنقد الشعارات السائدة، وترشيد منطلقاتها، وتصويب أحوالها، إذ منذ البداية أخذ الحافظ على الحركة الوطنية الفلسطينية، “أولا، كونها حركة شبه تقليدوية. وثانيًا، كونها حركة إقليموية (يقصد وطنية أو قطرية)”.. وبرأيه فهذا “جعلها عاجزة من جهة عن القبض على وعي مطابق”، وهذا يفسّر، بحسب رأيه، أنها “لم تعجز فحسب عن إطلاق حرب تحرير شعبية حتى في الأرض الفلسطينية المعمورة عربيًا (الضفة والقطاع).. بل أيضًا عجزت عن تطوير المقاومة الشعبية إلى حد مناسب فيها.. وبالتالي لم تحرر أية رقعة فلسطينية بالصراع المسلح” (ص 126 ـ 127)، وهو ما كانت نتيجته الطبيعية التخلي عن برنامج التحرير لصالح التسوية.
أما عن حرب التحرير الشعبية، فإن هذا الأمر يحتاج عنده إلى شروط عديدة، مماثلة للشروط التي تمثلتها التجربة الفيتنامية، ويكمن أهمها في إطلاق الكفاح المسلح في ظل وجود “قيادة طليعية مرتبطة بالشعب تملك وعيًا كونيًا وتاريخيا.. تخوضه أمة موحدة تحت قيادة هذا الحزب (الطليعة) .. جيش شعبي قهر التقنية الحديثة بالإرادة البشرية كما امتلك ناصية هذه التقنية.. انبثاق سلطة تنتمي إلى الشعب انتماء أصيلًا حقيقيًا” (ص 245).
ويتابع الحافظ على الخط نفسه، مبيّنًا الصعوبات والتعقيدات التي تحد من إمكانيات تطور العمل الفدائي في ظل الأنظمة العربية السائدة، التي ستشتغل على احتواء الحركة الوطنية الفلسطينية أو توظيفها في خدمة سياساتها: “من أخطر وأكبر الثغرات التي تلغم “الاستراتيجيات” الرائجة لتحرير فلسطين هي الزعم بأن من الممكن أن تقوم حرب فدائية تتنامى إلى حرب تحرير بمعزل عن الظروف السياسية السائدة في البلدان العربية المحيطة بإسرائيل… إن الدول العربية بتكوينها الطبقي والسياسي الراهن لا يمكنها… أن تترك العمل الفدائي بعيدًا عن نفوذها أو رقابتها… فإما أن تخاف الدول العربية المعنية مضاعفاته، بسبب ردود الفعل الإسرائيلية والإمبريالية، أو تخاف من إفلات الزمام من يدها، فتعمل عندئذ على قمعه وتصفيته. وهنا يقع العمل الفدائي بين نارين من الأمام ومن الخلف: نار إسرائيل ونار الحكومات المعنية. والاحتمال الثاني الذي يترصد العمل الفدائي هو أن تتولى الدول العربية احتواءه ليكون طوع بنانها… إن أفق الحركة الفدائية الراهنة يقف عند الحدود التي تقررها أنظمة الحكم العربية.. ستضع الحركة الفدائية في طريق مسدود” (ص 251 ـ 252). حقًا، فهذه العبارات تبدو بالقياس إلى توقيت طرحها بمثابة نبوءة.
العظم: قصور الرؤية العربية
إلى جانب مرقص والحافظ، يأتي صادق جلال العظم، في كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، وهو الذي عمل مباشرة في مركز الأبحاث الفلسطيني في لبنان، مطلع السبعينيات، أي أنه احتك مباشرة بالفصائل الفلسطينية. ففي هذا الكتاب الذي جاء لمناقشة ردود الفعل على الهزيمة المفاجئة التي ألحقتها إسرائيل، الدولة الصغيرة، بالعالم العربي، لا سيما بأهم نظامين قوميين فيه آنذاك (مصر وسورية)، خرج العظم عن المألوف، أو عن أنماط التفكير السائدة عند معظم التيارات السياسية العربية، لا سيما اليسارية والقومية، في إحالته هزيمة حزيران (1967) إلى العامل الداخلي، وليس إلى العامل الخارجي، أي إلى التأخّر السياسي والاجتماعي والثقافي والعلمي، مثل مرقص والحافظ. وهو في ذلك ساجل مختلف الأطروحات التي حاولت التخفيف من أثر تلك الهزيمة بالادعاء أنها مجرد “نكسة”، بل إنه سخر من هذا التعبير، الذي يغطّي على نكبة أخرى، وعلى هزيمة عقليات ونمط من سياسات وأنظمة تتحكم بالبلدان العربية.
أيضًا، التقط الكاتب التناقض الفج الكامن في الرؤية العربية السائدة، وقتها، لدى الأنظمة والأحزاب والمثقفين، لإسرائيل، الذي يتضمّن التبرير والمواربة والتهرّب من المسؤولية، الكامن إما في الاستخفاف بإسرائيل أو المبالغة بقدراتها. يقول العظم: “من الأخطاء المريعة التي وقع فيها العرب بالنسبة لقضيتهم الأولى الاستخفاف الشديد بقوة العدو. أما الخطأ المريع الثاني… فهو تضخيم قوتها ونفوذها إلى حد صبغها بقدرات أسطورية فائقة، تجعلها سيدة النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي ومجرى التاريخ مرة واحدة. وبطبيعة الحال إن تضخيم قوة العدو وسطوته ونفوذه على هذا النحو الخيالي هو أسلوب من أساليب تبرير فشلنا، وإسقاط مسؤولية الهزيمة على أسباب خارجة عن نطاق إرادتنا” (ص 69).
وبين هذا وذاك جادل الكاتب في النظرة التي تستخف بإسرائيل باعتبارها مجرد دولة صغيرة، وقليلة السكان، في مقابل كثرة عربية تمتد على مساحات واسعة وتمتلك إمكانيات كبيرة، مقللا من أهمية هذا المعيار الكمي الجامد، إذ الكثرة يمكن أن تصبح عبئًا أو قيدًا، مدللا على ذلك بقدرة اليابان على هزيمة روسيا، في مطلع القرن العشرين. يقول العظم: “أكبر مثل على الطاقات العربية البشرية المهدورة هدرًا تامًا، هو نصف الشعب العربي… وأعني بذلك المرأة العربية. عندما ننظر إلى الموضوع من هذه الناحية نرى أن الشعب العربي لا يتكون من مئة مليون نسمة، كما قالت لنا الإذاعات، بل من خمسين مليونا فقط. ولا شك أن المرأة العربية تشكل اليوم في مجتمعنا أضخم مستودع للطاقات الإنسانية الكامنة غير المستخدمة وغير الممسوسة بعد” (ص 94).
هذا يفيد بأن كتاب “النقد الذاتي” ساجل قصور الرؤية العربية في المجالات: السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي جعل انتصار إسرائيل، وهزيمة الأنظمة العربية، بمثابة تحصيل حاصل، بحسب رأيه. كما ساجل بشدة المفاهيم التي سادت في تلك الفترة والمتعلقة بحرب التحرير الشعبية، بيد أن هذا النقد لم يصل إلى نهايته، أو أنه انطلق من التسليم بصحتها، في ظروف وتصورات معينة، (ص67 و82)، وهذا ما يمكن أن يؤخذ عليه، إلى حد ما، ولا سيما أنه في تلك الفترة بالذات كان ظهر، من جيله، من ينتقد هذه المفاهيم من أساسها، وأقصد هنا أن الياس مرقص وياسين الحافظ، اللذين كانا أكثر قطعا، أو أكثر جذرية منه في نقد هذا الشكل والقطع معه.
*****
ما ينبغي التذكير به في الختام، أيضًا، أن مرقص والحافظ والعظم ووجهوا بالإنكار، والهرطقة، ليس من السلطات العربية فقط، التي استشعرت أثرهم على زعزعة مكانتها وادعاءاتها، وإنما حتى من الأحزاب السياسية العربية، وضمنها أحزاب اليسار العقيمة، التي اشتغلت على محاربتهم وإقصائهم، لأنهم باعتقادها يسممون “أفكار” منتسبيها ويزعزعون منظوماتها النظرية الجامدة.
ضفة ثالثة