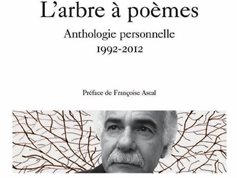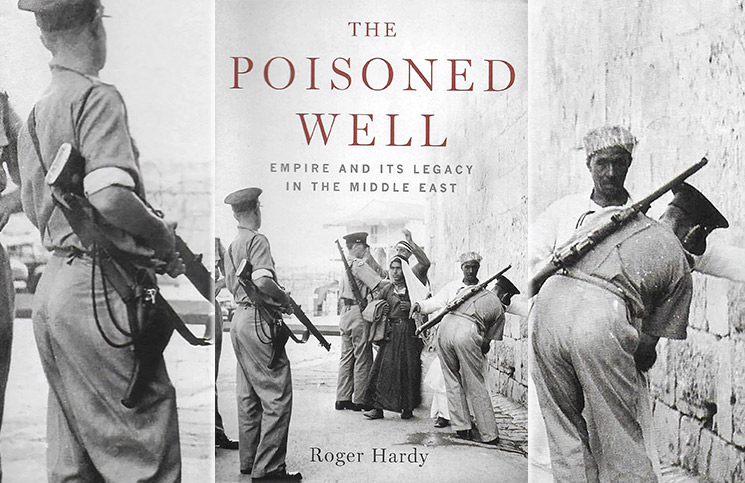كتاب سلامة كيلة عن «مصائر الشمولية»

الجزء الأول
سوريا في صيرورة الثورة
كتاب مهم، تحليلي، دقيق، عميق صدر لسلامة كيلة بعنوان «مصائر الشمولية، سوريا في صيرورة الثورة» (عن رياض الريس للكتب والنشر، بيروت).
يتناول الكتاب التحولات التي عصفت بسوريا على مستويات عدة، الأول هو مستوى تكوين السلطة ومآلها بعد موت حافظ الأسد، وفيه تفسير لماذا تحققت هذه السيطرة وبالشكل الاستبدادي الشمولي الذي عشنا؟ المستوى الثاني يتعلق بالأزمة التي تبحث عن هذا التكوين، والصراع الذي قادته نخب المعارضة من أجل التغيير. والمستوى الثالث يتعلق بالسياسة الاقتصادية التي حكمت العقد الأخير، واعتمدت على تدمير القطاع العام ونهبه، وتعميم الخصخصة، وبالتالي انتصار اللبرلة، وآثار ذلك على الاقتصاد والمجتمع. أما المستوى الرابع فيتعلق بتقويم سياسات المعارضة عموماً، والتي كانت تبلورت عام 2005 في إعلان دمشق والأوهام التي تحكمها، وتعلق بعضها بالدور الخارجي.
انحكم الوضع السوري منذ تسعينات القرن العشرين لمتغيّر عالمي، تمثّل في انهيار المنظومة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة، وبالتالي تحوّل الولايات المتحدة إلى «القطب الأوحد» وميلها للتفرّد في تقرير مصير العالم مستندة إلى تفوّقها العسكري المطلق. بعد أن كان قد انبنى الوضع منذ الخمسينات على أساس التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية، أو بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في إطار ما أُسمي بالحرب الباردة، التي سمحت بنشوء ميزان قوى عالمي ساعد البلدان المتخلّفة على أن تستقل وأن تطمح بتحقيق أهداف كانت السيطرة الإمبريالية تمنعها بالقوة في الغالب، من هذه الأهداف: التطور الاقتصادي وبناء الصناعة، الطموح لتحقيق التوحيد القومي، تطوير القدرات العسكرية، واستقلالية دور الدول في العلاقات الدولية.
بمعنى أن هذه البلدان تمتّعت بحرية المناورة إلى أبعد مدى، كما على التناقضات. وهذا ما سمح بتحقيق تطوّر معيّن، حيث جرى تدمير البنى الاقتصادية الاجتماعية القديمة (الإقطاعية)، وبُدء ببناء الصناعة وتطوير الاقتصاد. لكن طبيعة الفئات التي حكمت، أسست لنشوء سلطة استبدادية عِبْرها كان يتم تحقيق مصالح تلك الفئات، من خلال نهب الرأسمال المتراكم في يد الدولة، والذي نتج من التأميم والمصادرات، وبالتالي توظيفها في «البناء» الذي بات مشوّهاً نتيجة ذلك. ولكن كانت الحركة السياسية بمجملها تتدمّر، ونشأت أجيال لم تولِ اهتماماً للشأن العام، وبالتالي لم تدخل ميدان النشاط السياسي.
هذا الوضع فرض إعادة البحث من جديد عن أفق للتغيير، حيث تتفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة الوضع المعيشي الصعب الذي باتت تعيشه الطبقات الشعبية، بعد التسارع الذي حكم عملية الخصخصة وتعميم الاقتصاد «الحر»، لكن المهيمن عليه من قبل الرأسمالية الجديدة (مع حصة للرأسمالية القديمة). وتقف استبدادية السلطة في وجه كل محاولات تفعيل الحراك المجتمعي، وهي تدافع عن هذه الرأسمالية التي لها طابع مافيوي واضح، وتسعى إلى التشبيك مع الرأسمال الإمبريالي من أجل تحقيق مصالحها. على الرغم من «التناقض» الذي يحكم علاقتها مع ذلك الرأسمال، خصوصاً مع الإمبريالية الأميركية. والذي يبدو كـ»تناقض» شكلي لأن الخلاف فيه هو حول شكل السلطة أكثر منه خلاف حول سياسات وأهداف.
وبالتالي فإذا كانت التناقضات الطبقية تتصاعد نتيجة الوضع الاقتصادي، فإنها تتصاعد في إطار وضع عالمي مقلق، وأخطار تعصف في كل المنطقة، انطلاقاً من الميل الإمبريالي الأميركي، والأوروبي إلى الهيمنة وفرض تغييرات عميقة في الجغرافيا السياسية لها. لهذا تعيش سوريا وضعاً مربكاً، ومنذراً بتغيرات عميقة نتيجة تراكب أخطار متعددة، في وضع تبدو فيه قوى التغيير هامشية ومشتتة، وبعضها يتشابك مع الضغوط الإمبريالية.
[ حدود التغيير
وإمكانات مختلف القوى
[ أ إذا بدأنا بعزل الوضع العالمي والدور الأميركي في الضغط والتغيير، يمكن أن نطرح السؤال: هل هناك إمكانية لتحقيق التغيير من الداخل؟ أي بقوى داخلية؟ سواء هدف التغيير إلى تغيير السلطة أو تغيير آلياتها فحسب؟
من الضروري هنا أن نلمس ميزان القوى الداخلي، وطبيعة التوازن بين السلطة كقوى حاكمة والحركة السياسية المعارضة. ولكن من الضروري أن نلمس كذلك حدود الحراك الاجتماعي؛ لأن أي تغيير، أو أي ضغط، لن يكون ممكناً من دون قوى اجتماعية. فقد استندت السلطة في فِعْلها التدميري إلى الحركة السياسية (سواء بدمجها بالسلطة عبر الجبهة، أو بوضعها في السجون وشلّ حركتها المجتمعية)، إلى التكوين الطبقي الذي أسهمت في تشكيله، من خلال الإصلاح الزراعي الذي وسّع من الفئات الوسطى في الريف (صغار ملاّك الأرض)، وأيضاً ربط مصلحة الفلاّحين بالدولة عبر الدور التسويقي الذي أدته، وكذلك دورها في توفير المواد الضرورية للزراعة (البذور والأسمدة واللقاحات والمبيدات). كما من خلال التأميم والتوسّع في التصنيع، الأمر الذي سمح بإيجاد فرص عمل لجيش العمل الاحتياطي الذي تحرّر من الريف بعد قانون الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع. ولقد كانت الدولة المجال الأكبر للتوظيف، في الجيش والأمن والإدارات، ما وسّع كذلك من قاعدة الفئات الوسطى المدينية. وفي إطار كل ذلك حققت الدولة العديد من المطالب العمالية، فأقرت تحديد ساعات العمل بثماني ساعات، وحقّقت الضمان الاجتماعي والصحي، وحق العمل ذاته. إضافة إلى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار عبر ضبط الأسعار والتحكم بالجارتين الخارجية والداخلية، وفي الوقت نفسه الذي انفرض فيه المجاني الذي لامس أحلام فئات واسعة خصوصاً في الريف الذي كان يشكّل الكتلة الأساسية من السكان، والكتلة الأساسية التي كانت تعاني أقسى أشكال الاضطهاد الإقطاعي.
وبالتالي تشكّل تكوين طبقي تغلب عليه سيطرة الفئات الوسطى الريفية والمدينية، وتحقق فيه وضع أفضل للطبقات الفقيرة (العمال والفلاّحون الفقراء). وأصبحت الدولة تستحوذ على كتلة أساسية من قوة العمل، سواء كان عملها في الإدارات أو في المشاريع المملوكة للدولة، أو لها مصلحة في العلاقة مع الدولة (خصوصاً هنا الفلاحون، وحتى فئة التجار والصناعيين). هذا الوضع كان يقود حُكماً إلى حالة من «الاستقرار الطبقي»، ودعم اجتماعي من كل هذه الفئات للسلطة. وبالتالي توفير املقدرة للسيطرة على اتحادات العمال والفلاّحين والطلبة خصوصاً، قبل السيطرة العنيفة على باقي الاتحادات المهنية، التي مثّلت الفئات الوسطى المدينية المطالبة بالديموقراطية خلال أزمة سنوات 1979-1980.
هذه الملاحظة الأخيرة يمكن أن تلقي الضوء على مشكلة سوريا نهاية سبعينات القرن الماضي، حيث نشأت المعارضة من طرفين: الأول: هو الفئات الوسطى المدينية التي بدأت تحلم بتحقيق الديموقراطية. ولقد سار في هذا المسار أحزاب متعددة هي التي شكّلت «التجمّع الوطني الديموقراطي»، لكنها شملت فئات مهنية عملت في اتحادات المهندسين والمحامين والأطباء بدرجة أقل. والثاني: جماعة الإخوان المسلمين التي عبّرت عن فئات وسطى مدينية كان التطوّر الاقتصادي يهمّشها، وأقصد بالأساس الحرفيين وصغار التجّار، أو البنية التجارية الحرفية التقليدية التي كانت تشكّل عماد المدن. ولقد جمعت بعض الفئات الريفية في مناطق كانت لا زالت مغرقة في التخلّف (حوران وريف حلب خصوصاً). وبين هذا وذاك كان صراع البعث العراقي ضد السلطة من موقع الحلم بالوصول إليها من دون أن يكون له أي برنامج مختلف، أو رابطة العمل الشيوعي (ثم حزب العمل الشيوعي) التي انطلقت من أن الرأسمالية استنفدت ضرورتها، فاعتقدت بأن الواقع يفرض الانتقال إلى الاشتراكية، وإن من أجل تحقيق «البرنامج الانتقالي» أولاً، وبالتالي تضادّت مع الحركة الأصولية ولم تقبل برنامج «التغيير الوطني الديموقراطي» الذي طرحه التجمّع.
وفي ما عدا تلك الفئات الوسطى التقليدية والمهنية، كان التكوين الاجتماعي خارج الصراع القائم، حيث كان إما داعماً للسلطة نتيجة مكاسبه، أو محايداً نتيجة وضعه المستقر. حتى أن قطاعات أساسية من البورجوازية التقليدية كانت متحالفة مع السلطة، وكيّفت مصالحها معها عبْر تحالف «موضوعي»، على الرغم من «تدخّلات القوة» التي قامت بها فئات من السلطة لـ»الشراكة» الاقتصادية مع هذه الفئات، والتي بدت كـ»خوّة».
لكن البورجوازية في المقابل استفادت من نهب الدولة بطرق شتى (المشاركة في مشاريع عبر القطاع المشترك، والتهريب والتسويق للدولة).
وبالتالي كان الصراع (خارج صراع الإخوان المسلمين) يتّخذ شكلاً «سياسياً» فحسب، من دون قاعدة اجتماعية، وفي إطار مطالب ديموقراطية عامة كانت تعبّر عن ميول فئات وسطى مدينية (على الرغم من وجود بعض المطالب الأخرى المحدودة)، في مواجهة سلطة امتلكت قوة هائلة نتيجة استنادها إلى قاعدة اجتماعية واسعة. الأمر الذي مكّنها من بناء أجهزة أمنية قوية على الرغم من ضعف فاعليتها، ومستفيدة من الإطار الطائفي في ذلك لضمان الولاء المطلق، ما أسس لنشوء سلطة مستبدّة فائقة القوة ومتمكنة. وبالتالي كانت قادرة على فرض هيمنتها على النقابات والاتحادات والمنظمات التي أنشأت معظمها، وكذلك على المدارس والجامعات، وفي الغالب على المؤسسات الدينية والنوادي الرياضية والمنتديات، أي على كل أركان المجتمع المدني وعلى معظم أركان الحياة الاقتصادية والتعليم، وعلى الجيش بكل تأكيد، وكذلك على الحياة السياسية بالطبع، خصوصاً بعد دمج أحزاب لها تاريخ مثل الحزب الشيوعي السوري في الجبهة الوطنية التقدمية التي كانت الغطاء السياسي لممارسات السلطة، وفي الوقت نفسه «الدليل» على تعدديتها! لتبدو السلطة وكأنها تبتلع المجتمع، حيث السياسة المحكومة من قِبَل الأجهزة الأمنية تهيمن على الاقتصاد والتكوين الاجتماعي وعلى «الحياة العادية»، أي على تفاصيل حياة المواطنين «من المهد إلى اللحد»، وهو الأمر الذي أسس لنشوء السلطة الشمولية.
وكان هذا الوضع يفرض تهميش الحركة السياسية: الملتحقة بالسلطة، والتي أصبحت آلياتها متوافقة مع آليات السلطة، ومحددة بها، وبالتالي لم تكن قادرة على الخروج عنها. والمعارضة التي تعرّضت لضربات أمنية قوية، دمّرت قواها، وحوّلتها إلى هوامش، حيث عانت من كون معظم كادرها قد دخل السجون، ومنْ بقي عاش متخفياً وفي وضع صعب. لكن الأهم هنا أن ذاك التكوين الاجتماعي الذي وُجد (والذي كان يعبّر عن مرحلة انتقال من نمط قديم/ إقطاعي جرى تدميره، إلى آخر جديد كان يتشكّل من دون أن يعني ذلك أنه سينتصر) أسس لنشوء أجيال لم تدخل المجال السياسي، وظلّت بعيدة عن التفكير والعمل السياسيين، على الرغم من تفتّحها على آفاق من الوعي كبيرة نتيجة التطور العام العالمي وتقنيات التواصل والتطور المعرفي(بعكس الواقع الريفي السابق الذي جعل المعارف محدودة وإمكانات التواصل شبه معدومة، مع استمرار الثقافة التقليدية، وهو ما حكم الحركة السياسية السابقة). الأمر الذي فرض إحداث قطيعة بين الحركة السياسية بمختلف أطيافها (في ما عدا حزب السلطة الذي استقطب كل من يسعى إلى امتياز مادي أو معنوي، على الرغم من أن هؤلاء ظلّوا من دون معرفة سياسية)، وبين المجتمع الذي كان يتشكّل من أبناء هؤلاء الذين حصلوا على الأرض، أو الذين أصبحوا عمالاً أو موظفين، في دولة باتت هي رب العمل الكبير. وإذا كان قد تهمّش وضع الريف السياسي، وكذلك وضع العمال السياسي نتيجة هيمنة السلطة، وبات هؤلاء «يعيشون الحياة» فحسب، وما دام كل ذلك قد أوجد استقراراً اجتماعياً، فإن «أبناءهم» الذين أصبحوا طلاباً باتوا غير معنيين بالنشاط السياسي، خصوصاً وأن قوة السلطة القمعية أشارت إلى الخطر الذي يلاحق كل من يمارس هذا النشاط، إضافة إلى أن «مصالحهم المباشرة» لم تعد تؤسس الدافع للانخراط في العمل السياسي.
وهذا الأمر كان يهمش الحركة السياسية من جهة، لكنه كان يحولها الى حركة هرمة من جهة أخرى. لأنها لم تعد ترفد بناشطين جدد، ما قلص من مقدرتها وفاعليتها وامتدادها. وحيث بات متشرنقة في وعيها «القديم» من دون رفد جديد، وبالتالي من دون المقدرة على رؤية المتحولات. مع ملاحظة أن وعيها وتصوراتها كانت اشكالية، وهذا ما يحتاج الى بحث جاد، لكنه كان ينعكس على مقدرتها على وعي التحولات التي جرت منذ الوحدة المصرية ـ السورية سنة 1958، وخصوصاً منذ انقلاب آذار/مارس سنة 1963. وبالتالي تقديرها للدور الذي يمكن ان تؤديه في الوضع الجديد. وكان ذلك سبباً في أزمتها وتهميشها، حيث ان معظم المهام التي نادت بها لم تخرج عما تحقق، وبعضها كان طموحه اقل ما تحقق، مثل الحزب الشيوعي مثلاً.
ولا شك في ان السلطة تسير نحو الضعف والهزال منذ بدء الأزمة الاقتصادية سنوات 1985 ـ 1986، نتيجة تناقض المساعدات القادمة من الدول النفطية، ووضوح ارتباك البناء الاقتصادي الذي تحقق خلال عقدين، ومن ثم تصاعد النهب الذي بات قانوناً عاماً، وفرض نشوء تمايز طبقي واضح خلال العقود الاربعة السابقة، حيث قلة باتت تمتلك مليارات الدولارات هي تلك التي تبوأت مناصب كبيرة في الدولة، وأكثرية مفقرة. والى تأزم وضع «القطاع العام» وإفلاس شركات عديدة كانت تمول من ميزانية الدولة، الأمر الذي أوقعها في وضع حرج. وبالتالي تشكل «طبقة» تميل الى التخلص من دور الدولة الاقتصادي، والى احتكار السوق لمصلحتها المباشرة، وهو ما فتح الافق لحراك اجتماعي بدأ في بعض الاضرابات العمالية، وبعض التحركات الاحتجاجية. وكذلك فان الوضع الراهن يتسم بوجود ازمة اقتصادية طاولت الدولة نتيجة تراكم النهب وسوء التخطيط الاقتصادي وقلة كفاءة المدراء والمسؤولين، تنذر بانهيار اقتصادي، في الوقت الذي تتزايد فيه امكانية تصاعد الحراك الاجتماعي. وفي وضع عالمي ينذر بالخطر على السلطة التي باتت محاصرة ومهددة، وبالأساس على الوطن كله.
بمعنى ان الاستقرار الذي افادت منه السلطة طيلة عقود بات في مهب الريح، وان قوتها باتت تتآكل بعد ان انفضت قاعدتها الاجتماعية عنها، وباتت تشكل خطراً نتيجة ازمتها التي يمكن ان تدفعها الى «التمرد» والعصيان.
لكن على الرغم من ذلك، لا زالت الحركة السياسية تعيش وضع العقدين الأولين من سلطة البعث، وتعتقد ان قوة السلطة لا زالت كما كانت، وان الوضع الشعبي لا زال كما هو، او انها لم تفكر في النظر الى واقع الطبقات الشعبية، وكذلك لم تلمس تآكل السلطة وانحدار قوتها. وإذا كان قد اصبح بمقدورها الجهر بآرائها، فهي لا زالت تعتقد بأن هذه السلطة مؤبدة. ونتيجة الوضع الذي حاولت توصيفه للتو، حيث هيمنت السلطة على المجتمع (بالتالي بدا ان ليس هناك مجتمع اصلا)، وحيث بدت السلطة هي الجبروت، فقد تمركز الخطاب المعارض حول الديموقراطية التي بدت انها المطلب الوحيد، وتغلب الميل لمطالبة السلطة لتغيير ذاتها، أو الحلم بدور «خارجي» لتغييرها. ولقد باتت تشكل المعارضة من نخبة من السياسيين القدامى في الغالب، ومن مثقفين، منغلقة ومعزولة عن الواقع الاجتماعي، وبعيدة عن الحراك الاجتماعي الذي بدأ يتشكل. ولا شك في ان التوترات الاجتماعية وحالات الافقار التي باتت تطاول قطاعاً واسعاً من الطبقات الوسطى والدنيا، اصبحت تشكل الاساس لميل تديني لدى قطاعات اجتماعية، باتت تشكل بيئة لحركات اصولية، مثل الاخوان المسلمين و«القاعدة» (او التيار الوهابي عموما الذي يبدو انه هو الذي يقاوم اميركا)، وبالتالي اصبحت قاعدة اساسية لإمكانية تحول هذه الجماعات الى قوة فعلية. لكن لا زال قمع السلطة وامساكها الوضع الداخلي يمنع تلك الجماعات من الوجود القوي. على الرغم من ان اي تحول في السلطة باتجاه «انفراج ديموقراطي»، أو نهاية السلطة، سوف يجعلها قوة فاعلة، بعكس كل الأحزاب الأخرى التي ستبقى تمثل النخبة السياسية الثقافية. وهذا لا يعني «تخويف» من طرح مسألة التغيير، بل يعني رؤية الوقائع كمقدمة للوصول الى استنتاجات ضرورية لفعل اليسار الماركسي. وبالتالي يجب ان نلحظ بأن تقوقع النخبة ضمن خطاب «موحد» من دون تمايزات واختلافات هي في صميم الواقع، ويركز على المستوى السياسي فحسب، لن يسهم في أن تتقاطع مع الوضع الاجتماعي المتأزم والذي يطرح اسئلة أخرى ويطمح الى مطالب تتعلق بعيشه قبل ان تطال الديموقراطية. وميزة الأصولية، والتي تجعل منها قوة قادرة على التغلغل في النسيج الاجتماعي، هي في عنصرين، الأول، الدين الذي يشكل جسراً ما وان كان غير كاف، حيث يمكن ان يعبر كذلك عن توترات اجتماعية محدودة، والثاني، الصراع العالمي للاسلام الجهادي ضد «الغرب»، وبالتالي تقاطعه مع الميل الشعبي الرافض للسيطرة الاميركية الصهيونية. وسنلمس بأن الموقف من التوترات الاجتماعية غائب لدى النخبة المعارضة، كما ان الموقف من الحرب الامبريالية الاميركية ملتبس لدى قطاع منها، وهو غائب في فعلها السياسي كذلك.
وإذا كانت الأزمة الاجتماعية قد بدأت عبر التفارق بين الأجور والأسعار، كما عبر نسبة الفقر التي بلغت وفق احصاءات رسمية ما يقارب ثلث السكان (5،3 مليون شخص)، هم الذين يعيشون تحت خط الفقر (الذي يساوي دولاراً واحداً في اليوم)، على الرغم من ان نسبة الفقر أعلى من ذلك اذا علمنا ان متوسط دخل الفرد لا يزيد على مئة دولار، بينما تشير دراسات رسمية أجريت قبل أربع سنوات الى ان متوسط الدخل الضروري للعيش يجب ان يقارب الـ 400 دولار (18 الف ليرة سوريا)، وهو مبلغ يساوي اضعاف متوسط الأجور الحالي. وهذا ما يدفع الى الحراك الاجتماعي. وبالتالي فاذا كانت الأزمة الاجتماعية قد بدأت، فان الوضع «الموروث» يشير الى بطء الفاعلية الاجتماعية نتيجة «الخوف» الذي رافق المرحلة السابقة، على الرغم من ان بعض الاحتجاجات قد بدأت، وان التململ قد اصبح بادياً للعيان. وبالتالي فان انفجار الوضع ليس قريباً، او ليس الآن، على الرغم من انه بات يرفد السياسة بفاعلين جدد ليس من مؤشر الى قدرة الأحزاب القائمة على استقطابهم.
وعلى الرغم من ان قوة السلطة قد تراجعت، وباتت «مفككة» وهشة ومأزومة، نتيجة الوضع الاقتصادي الداخلي وخطر تفجير ازمات متعددة، وحدوث اضطرابات اجتماعية، كما نتيجة الوضع الدولي الضاغط، فان ميزان القوى الداخلي لا زال يميل لمصلحتها، حيث ـ وكما اشرنا ـ ان القوى المعارضة منحصرة في نخبة سياسية ثقافية «هرمة»، وهذا الانعزال هو الذي جعلها تضخم من الحاجة الى الديموقراطية كما نوهنا قبل قليل، لأنها تعتقد بأن الانفراج الديموقراطي هو الذي سوف يسهل لها التفاعل مع المجتمع، ويفتح لها افق التحول الى قوة سياسية فاعلة. بينما تكمن المشكلة في مسائل ابعد من الاستبداد الذي يفرض المطالبة بالديموقراطية، على الرغم من أهمية ذلك، تتعلق بوعيها وبنيتها وأهدافها، وخصوصاً تحويل «الحلقة المركزية» التي هي الديموقراطية، الى حلقة وحيدة، حيث يجري «اللعب» في فضائها من دون لمس أسس الاستبداد وبالتالي مشكلات الطبقات الشعبية الناتجة من النهب الذي كان الاستبداد غطاؤه السميك. لهذا يجري تضخيم المطلب الديموقراطي واعتبار انه هو «الحل السحري» لكل المشكلات، على الرغم من ان الديموقراطية هي ـ في الوضعية التي نناقشها ـ آليات سلطة تنظم الصراع بين قوى اجتماعية سياسية، وتحدد كيفية استلام السلطة وتنظيم الحكم. بمعنى ان رؤية الأحزاب للعمل السياسي، النابعة من وعي «بسيط»، هي التي تشكل مبدأ تقوقعها، وهذا ما لن تحله الديموقراطية.
[ ب ـ لا شك في ان انهيار المنظومة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة. قد وضعتا السلطة السورية في مأزق، حيث انتهت الظروف التي كانت تسمح بالمناورة، وبالتالي تحدد الخيار في الخضوع للقطب الأوحد أو مقاومته، ولأن خيارات السلطة انبنت على التوازن الدولي، فقد باتت تميل الى التكيف منذ الاشتراك في الحرب الاميركية الأولى على العراق سنة 1990 ـ 1991، على الرغم من ان السياسة الاميركية ظلت تضعها في موقع ملتبس.
لكن المتحول العالمي كان عنصراً واحداً، حيث يمكن ان نلمس المتحول الداخلي. فقد قادت التجربة ذاتها الى مشكلات حقيقية، والى وضع غير مستقر، أو يميل الى التأزم. وبات الوضع هشاً وقابلاً للحراك.
فإذا كانت الاجراءات التي قامت بها السلطة في المرحلة الأولى قد أوجدت قاعدة اجتماعية عريضة تستند اليها، بفعل قانوني، الاصلاح الزراعي والتأميم، وكل الاجراءات التي تتعلق بحق العمل والضمان الاجتماعي ومجانية التعليم. وحيث بدا انها تحقق تطوراً في المجتمع. فقد بدأت الأمور تتوضح بعدئذ حيث سنلمس ثلاثة مسائل أساسية حكمت صيرورتها: (1) فقد تبلورت كسلطة فردية دكتاتورية تعتمد على حكم الأجهزة الامنية، وتأسست في شكل شمولي هيمن على كل مفاصل المجتمع، من الادارات البيروقراطية واحتياجات المواطن العادية الى النقابات والاتحادات، الى الحياة العادية للمواطنين (الولادة والزواج والوفاة والحصول على الهوية والمشروع التجاري…)، بحيث تغلغلت في مسام المجتمع واصبحت حاضرة في كل مكان. وإذا كانت قد سمحت بكل نشاط شخصي، بما في ذلك السرقة والرشوة، فقد حرمت النشاط السياسي حتى على القوى التي شكلت «الجبهة الوطنية التقدمية». وبهذا فقد كانت تتعامل بعنف مع كل المعارضين، وتنهي المجال السياسي بشكل تام، في الوقت الذي كانت تلغي دورها كدولة لها مهمات تتعلق بخدمة المواطن وتسهيل نشاطه العادي وتطبيق القانون.
ومن هنا نبع الميل للتأكيد على الحريات الاساسية، وحق النشاط السياسي والديموقراطية، حيث ان نمط السلطة هذا كان تدخليا في المستوى السياسي والاداري الى ابعد مدى، الأمر الذي قاد الى توجيه ضربات عنيفة الى احزاب المعارضة انهت بعضها، وهمشت الآخر، كما قاد الى حصر نشاط احزاب الجبهة في اطارات محدودة اضعفتها الى حد كبير. بحيث باتت الحركة السياسية تشكل هامشاً في الصورة العامة.
[ (2) واذا كانت قد تحسنت اوضاع فئات اجتماعية واسعة في المرحلة الأولى، حيث حصلت على ارض او على عمل وعلى حقوق، وبالتالي احست بتحسن كبير في وضعها، تحسن يوازي النقلة، فان السنوات الماضية اعادت فرز الوضع الاجتماعي بحيث لم يعد تطور الأجور يوازي تصاعد اسعار السلع والاحتياجات الاساسية للحياة، لان توزيع الثروة اصبح محتلاً لمصلحة فئة محدودة عملت على نهب موارد الدولة، وكانت تستفيد من المشاريع التي تمتلكها الدولة لتحقيق مصالحها الخاصة عبر طرق مختلفة كانت تودي بالمشاريع ذاتها وتنعكس خسارة على الدولة وبالتالي على المجتمع، وهو الأمر الذي يؤسس الآن للحديث عن تراكم ديون تلك الشركات، وعن ضرورة خصخصتها لأنها اصبحت عبئاً على الدولة من دون الاشارة الى السبب الجوهري في ذلك، الا وهو النهب، ومن دون التأكيد على ان هناك خياراً آخر غير الخصخصة يمكن ان يتبع ويجب ان يتبع. وبالتالي فقد كان نشاط الدولة الاقتصادي، الذي افاد قطاعات واسعة من مختلف الطبقات، مجالاً لنهب هذه الفئة للتراكم الرأسمالي الذي من المفترض انه ملك للمجتمع، وتحويله الى ثروة خاصة وضعت غالبا في البنوك الأجنبية، الأمر الذي دمر صيرورة التطور ذاتها وأوصلها الى مأزق حتمي.
ولقد اصبح واضحا ان فئة قليلة باتت تمتلك ثروة هائلة، بينما افقرت قطاعات شعبية كبيرة، وتضعضع وضع الفئات الوسطى، ما بدأ يشكل قطيعة بين هذه القطاعات (التي كانت تشكل قاعدة السلطة) والسلطة ذاتها. وباتت اوضاعها سيئة، وهي في مرحلة يمكن ان يزداد السوء فيها نتيجة ارتفاع الاسعار من دون ارتفاع مواز للأجور، ونتيجة الخصخصة والانفتاح على العولمة والتعميم الفظ لليبرالية الجديدة.
كما سيقود ذلك إلى ازدياد هائل في عدد العاطلين عن العمل، وفي الحاجة إلى التعليم. وسيقود كذلك إلى انهيار الضمان الاجتماعي وتردّي الوضع الصحي. وهذه كلها تفرض طرح مطالب جدية وضرورية، وهي كلها ستكون أساساً لنشوء أزمات اجتماعية حقيقية، خصوصاً بعد تسارع تخلّي الدولة عن دورها عبر خصخصة سريعة، وانفتاح متسارع على «العالم الرأسمالي» كما حدث خلال سنوات 2006، 2007 و2008.
[ (3) والوضع الآن يشير إلى توقف «التنمية»، حيث إن الميل الليبرالي فرض تراجع دور الدولة الاستثماري، من دون أن يكون ممكناً أن يأدى القطاع الخاص الدور الضروري لتشغيل قوة العمل الفائضة، ولتحقيق «التنمية» عبر التوظيف الضروري في القطاعات المنتجة. وسوف يؤدي الاندماج بالعولمة إلى انهيار ما بُنيَ وقطْع الطريق على أي ميل لبناء القوى المنتجة.
وبالتالي فإن القوة التي امتلكتها السلطة خلال مراحلها الأولى آخذة في التآكل، وأصبحت أضعف بعد أن انحسرت قاعدتها الاجتماعية. لكن وضع الحركة السياسية ضعيف، وفاعليتها محدودة، وتميل في الغالب نحو موقف ديموقراطي ليبرالي، وبالتالي تبدو أنها تتكيّف مع الميل «الموضوعي» نحو «انتصار الليبرالية» والتبعية للنمط الرأسمالي(…).
كتاب سلامة كيلة عن «مصائر الشمولية» الجزء الثاني
كيف دمّرت السلطة السورية القطاع العام؟
[ طبيعة التناقضات ووضع القوى
وهذا التحديد للسلطة يعني أننا لا نشير إلى السلطة بالمعنى السياسي فقط، بل نشير إلى الفئات التي نهبتها والتي أفقرت المجتمع ودمّرت «القطاع العام«، والتي بدأت مصالحها تتشابك مع الرأسمال العالمي. لهذا كانت تميل إلى التفاهم مع الدولة الأميركية والتكيّف مع سياساتها، رغم أن قصر النظر السياسي لديها جعلها (أو جعل قطاعات متنفّذة منها) لا تفهم حدود القوّة الأميركية ولا طبيعة سياساتها، وقرارها في ما يتعلّق بالسلطة ذاتها. الأمر الذي دفعها إلى ممارسة تكتيكات خاطئة أسهمت في تورّطها، عبر محاولتها توهّم دور لم يعد ممكناً، ووجود لم يعد متاحاً، واستمرار بات موضع شك.
وكان تناقضها المجتمعي، وليس السياسي الذي تمثّل في استمرار السياسة الأمنية ومنع السياسة في المجتمع فقط، بل تناقضها الطبقي كذلك الذي بات واضحاً عبر تحوّل الفئات الحاكمة إلى «طبقة« بالغة الثراء، نتيجة النهب الذي مورس طيلة العقود الأربعة، قد أوجد «بؤر تفجّر« اجتماعيّ ذات خطورة. بمعنى أن المسألة لم تعد مسألة سلطة تسلّطية فقط ، حيث يمكن تغيير آلياتها باتجاه ديمقراطي، بل غدت مسألة صراع طبقيّ يتخذ أشكالاً طائفية أو قومية أو طبقية صريحة، يمكن أن تتطوّر بتسارع بالتوازي مع خطوات تلك الفئات الحاكمة إلى تسريع النهب، أو التحوّل نحو اقتصاد السوق وإنهاء دور الدولة الرعائي كما حدث في السنة الأخيرة.
هذا الوضع يجعل التناقض بين تلك الفئات والطبقات الشعبية متفاقماً، دون مقدرة على تمويهه أو تحييده. ويجعل تلك الفئات، وبالتالي السلطة، غير قادرة على تخفيضه، لأن ذلك يعني وقف النهب وتوظيف أموال طائلة لتحسين وضع الطبقات الشعبية ذاتها، هي غير موجودة لأنها هُرّبت إلى البنوك الأجنبية، إضافة إلى أن هذه الفئات لم تعد تفكّر أو تمتلك المقدرة على ذلك. وهو الأمر الذي يجعلها لا تميل إلى تقديم تنازلات جدّية داخلية لإعادة ترتيب التناقضات، حيث إن ذلك يفترض تقديم تنازلات جوهرية في المستوى الاقتصادي عبر رفع سريع للأجور بما يحقّق مستوى معيشيّ أفضل، وضبط العلاقات الاقتصادية من أجل التحكّم بالأسعار (وهي تفعل العكس من ذلك)، كما إلى التوظيف الاستثماري بما يسمح بامتصاص البطالة الحالية واستيعاب العمالة الوافدة سنوياً، وبتحريك عجلة التطوّر من جديد. وتنازلات في المستوى السياسي تفرض إنهاء كلّ ما هو استثنائي، وإلغاء الطابع الاستبدادي التدخّلي الشمولي للسلطة، وتحقيق الحرّيات العامة، والاتجاه نحو تأسيس نظام برلماني ينطلق من إلغاء الدستور الحالي وصياغة دستور جديد ديمقراطي ويكرّس العلمانية. وتنازلات أخرى في المستوى الاجتماعي تتعلّق بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي (أي بدور الدولة الرعائي). لكي يؤسّس كلّ ذلك لتحييد التناقض الكامن بين السلطة والطبقات الشعبية، من أجل توافق على مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي. وهذا الوضع هو الذي جعل السلطة تفكّر في التكيّف مع السياسات الأميركية وليس «التنازل« للطبقات الاجتماعية، حيث باتت مصالح المافيات الحاكمة تترابط مع الرأسمال الإمبريالي وليس مع المجتمع.
وإذا كانت الدولة الأميركية تسعى إلى تغيير السلطة، وتهديد البلد في إطار رؤيتها للوضع الجيوسياسي في المنطقة، فإن المقدرة على التفاهم بين السلطة والطبقات الشعبية لا تبدو ممكنة، حيث أن التناقض العميق في المستويين السياسي (الاستبداد) والاقتصادي (الوضع المعيشي)، يفرض تنازلات كبيرة من السلطة وهو ما لا تميل إلى تحقيقه، رغم أن الميل العام لتلك الفئات الحاكمة هو التفاهم مع الولايات المتحدة والتكيّف مع مشروعها، وهو خيارها الوحيد لأن مصالحها باتت تفرض ذلك.
إذاً، سيكون التناقض قائماً في مستوى أوّل بين الطبقات الشعبية والسلطة بصفتها تمثّل فئات مافياوية نهبت «القطاع العام«، وأفقرت تلك الطبقات، وأيضاً بصفتها دكتاتورية انطلاقاً من أن الدكتاتورية هي الغطاء الذي سمح بتحقيق كلّ ذلك النهب، وبالتالي أوجد التمايز الطبقي (التفارق الطبقي). لكن التناقض في مستوى ثانٍ هو بين الطبقات الشعبية والمشروع الإمبريالي الأميركي (أو الإمبريالي بقيادة أميركية)، نتيجة «الطابع العام« للرأسمالية كونها تنهب المجتمعات والطبقات، وتفقر الشعوب وتمنع تطوّرها. وكونها تنزع نحو الحروب البربرية وتميل لاحتلال دول. ونتيجة كونها (بالتالي) تحتلّ العراق وفي ترابط لا ينفصم مع الدولة الصهيونية التي تحتلّ فلسطين، وكذلك مجمل سياساتها العامة تجاه الوطن العربي وكسر طموحه نحو الاستقلال والتحرّر والتوحّد (وهذا هو نتاج الشعور القومي العام لديها، والذي هو نتاج الشعور بأن تطورها مرتبط بذلك). وثالثاً نتيجة استهدافها سوريا وسعيها إلى صياغة النظام السياسي الاقتصادي بما يتوافق مع مشروعها الإمبريالي الصهيوني. ولاشكّ في أن الإحساس بالخطر الأميركي حقيقة واضحة لدى تلك الطبقات.
وفي مستوى ثالث فإن «التناقض« بين الفئات الحاكمة والإمبريالية نتج، في لحظة، عن رؤية كلّ طرف لدوره، وبالتالي لدور الآخر، إقليمياً وعربياً. وعن عدم التطابق بين ميل الرأسمالية الإمبريالية لفرض الليبرالية الجديدة المتوحّشة، وبالتالي إطلاق هيمنتها على البنى الاقتصادية (بما في ذلك تدمير بنى قائمة الصناعة مثلاً وإعادة صياغتها) هذا من جهة، وميل الفئات الحاكمة إلى «الهدوء« في تكييف انفتاحها وخضوعها (الذي أُسمي التباطؤ في الإصلاح) من جهة أخرى. لكن يبدو أن الرؤية الأميركية لوضع السلطة لا يقف عند حدّ تغيير السياسات، الأمر الذي جعل «التفاهم« غير مطروح مع السلطة. لكن في وضع السلطة القائمة، فإن مصالح كتلة الفئات التي أثْرت تميل إلى التكيّف، وبالتالي التخلّي عن كلّ العناصر «المعاندة« (أو المرفوضة)، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الاقتصادي، وهو الأمر الذي يشير إلى هشاشة بنية السلطة وعدم تماسكها أمام الضغوط الأميركية.
وإذا ما نشأ ميل لتخفيض التناقض مع الطبقات الشعبية، إنْ تبلور لدى طرف، فسوف يشقّ الفئات الحاكمة ذاتها، لأن مصالحها لم تعد تتوافق مع ذلك، رغم أنها يمكن أن تميل إلى قبول الشقّ السياسي (وإنْ في صيغة مشوّهة، رغم أنه لازال كاحتمال ضعيف)، لكن يمكن أن يتحقّق ذلك في إطار سعيها للتكيّف مع «الإرادة الأميركية«، في سياق تطبيق «التصوّر الديمقراطي الأميركي« القائم على تأسيس نظام برلمانيّ فيدراليّ طوائفيّ، يُضعف الدولة ويؤسِّس لتفككها، ويؤسِّس سلطة هزيلة ملحقة.
لهذا فإن تحالف الطبقات الشعبية مع الفئات الحاكمة لمواجهة «الخطر الأميركي«، أو حتى التركيز فقط على ذاك الخطر، يبدو صعباً. وفي كلّ الأحوال فإن قدرات وقف التكيّف مع السيطرة الإمبريالية الأميركية (بغضّ النظر عن شكل هذا التكيّف) يبدو صعباً كذلك، لأن السلطة ليست متماسكة وتميل في الغالب إلى
التكيّف. ولهذا فهي لازالت تقمع الحراك السياسي عموماً بما فيه الحراك المناهض للإمبريالية الأميركية، ولازالت تشلّ كلّ إمكانية لتنظيم القوى الهادفة إلى مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي.
في هذا الوضع تنطرح مسألة صياغة التحالفات، والتكتيك الضروري الآن. فالتناقض مع المشروع الإمبريالي الأميركي غير قابلٍ للحلّ إلا عبر الصراع، وبالتالي من المنطقي التفكير الجدّي بالمقاومة، وبرؤية عربية للمقاومة مادام المشروع الإمبريالي يطال كلّ الوطن العربي (إضافة إلى آسيا الوسطى وأيضاً
العالم). وهذه مسألة تعزِّز الإطار القومي الديمقراطي للعمل.
لكن، وأمام هذا التناقض، لا يبدو ممكناً تشكيل تحالف مع السلطة نتيجة ما سبق، لهذا يمكن الانطلاق الآن (وكلمة الآن مهمة هنا) من التالي:
[ أ- التأكيد على مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي، والتأكيد على رفض تدخّله وصيغته لتكوين الدولة والمجتمع في سوريا والوطن العربي (والعالم). وهذا المستوى يتخذ شكلاً دعاوياً تحضيرياً، لأن «التلامس« لم يحصل بعد. وسيصبح ملموساً لحظة التدخّل سواء في شكل عسكريّ أو في شكل إقامة سلطة خاضعة.
[ ب – إن الصراع من أجل انتزاع الديمقراطية وحقوق الطبقات الشعبية يظلّ أساسياً في الممارسة العملية مادامت السلطة مستمرّة، ولهذا يكون الهدف هو تحقيق التغيير الديمقراطي العلماني الذي يحقِّق مطالب الطبقات الشعبية.
[ جـ – لكن وجود الخطر الأميركي يفرض ضمن ما ورد في الفقرة السابقة، التحشيد لمواجهته. والعمل لتفعيل الحراك الاجتماعي هو المدخل لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي العلماني، وتحضير القوى لمواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي.
[ إشكالات رؤية المعارضة
انطلاقاً من ذلك يمكن أن نلمس إشكالين يحكمان المستوى السياسي المعارض، ينتجان عن «عقل أحاديّ« يضع المسائل في إطار مبسّط يقوم على ثنائية السلطة أو أميركا، الاستبداد الداخلي أو الخطر الأميركي. الإشكال الأوّل يتمثّل في الميل لاعتبار «الخطر الأميركي« هو التناقض الرئيسي، وبالتالي السعي لـ«الالتفاف« حول السلطة وتمتين «الوحدة الوطنية« من أجل مواجهة «المخططات الإمبريالية«. وربما كان هذا الميل هو استمرار للمنطق الذي ساد في الحزب الشيوعي السوري، الذي كان يغلّب التناقض الخارجي على التناقضات الداخلية، ويعتبر أن مواجهة الإمبريالية هي التي تحظى بالأولوية بغضّ النظر عن كل
«الملاحظات« على الوضع الداخلي، حتى إذا تناقضت الوقائع مع كلّ التوافقات التي تحدَّدت في «ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية«.
هذا الميل الذي كان في السابق وينشأ الآن، يقوم على تبخيس المشكلات الداخلية التي تكوّنت خلال العقود السابقة، والتمايز الطبقي الذي تبلور خلال ذلك، على عكس الوضع حينما تحقّق التحالف مع السلطة، حيث كان الاختلاف الجوهري يتمثّل في مسألة طبيعة السلطة فقط، لأن السياسات الاقتصادية التي كانت تنفذ آنئذ لم تكن تخدم المعارضة الديمقراطية لأنها كانت توسع من القاعدة الاجتماعية للسلطة كما أوضحنا، وبالتالي كانت تهيئ لتحالف قوى تحت شعار «مواجهة الإمبريالية والصهيونية«. لكن الظرف الراهن يؤشّر إلى تناقض داخليّ عميق لا إمكانية لجسره من أجل تحالف يواجه الخطر الأميركي، خصوصاً أن السلطة مستمرّة في آليات ممارساتها في المستوى السياسي وفي المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ولا يبدو أن مصالح الفئات الحاكمة تسمح بذلك كما أشرنا للتو. الأمر الذي يجعل التحالف التحاقاً بسلطة هشّة، وعلى أبواب تغيير بفعل دوليّ وأميركيّ خصوصاً. في وضع لا تضيف القوى السياسية شيئاً في ميزان القوى بعد أن دُمّرت بفعل القمع المديد، وبفعل التحوّلات المجتمعية المشار إليها سابقاً، كما بفعل مشكلاتها الذاتية. وأيّ فعل يفترض فتح السلطة لحرّية الحراك السياسي الاجتماعي من أجل تهيئة القوى لمواجهة الخطر الأميركي.
كما أن «التحالف« الآن، والسلطة هي التي تمارس القمع والنهب، والخطر الأميركي لازال غير ملموس ولا أمر واقع وغير محدَّد الشكل (أي الاحتلال أو التغيير الداخلي)، يجعله التحاقاً من جديد كما كان سنة 1972 حين تأسست الجبهة الوطنية التقدمية، لكن دون جدوى، ودون قبول عام ليس من الأحزاب فقط بل من الطبقات الشعبية كذلك. لهذا سيبدو أن مواجهة الخطر الأميركي سوف تتحقّق فقط بعد أن يكون قد أصبح أمراً واقعاً، وليس قبل ذلك، حيث أن شروط التحالف القادر على المواجهة الآن ليست قائمة، وهي تتعلّق بتنازلات عميقة تقوم بها السلطة بالتحديد.
وربما نتج هذا الميل عن موقف «غريزيّ« تبلور نتيجة النظر الأحادي الذي تحدَّد في «التناقض الرئيسي« مع الإمبريالية. وهو الخطاب الذي ولّد معكوسة نتيجة هشاشته وتبسيطيته الفظّة، والتي بدت واضحة أمام تطوّرات الوضع الداخلي، وتفاقم الاستبداد والنهب وبالتالي التمايز الطبقي. ولأن المسألة باتت «غريزية« فقد جرى غضّ النظر عن التحوّلات الداخلية (التي كانت تترافق بامتيازات لأحزاب معيّنة). وظلّ الشعار العام هو: مواجهة الإمبريالية.
والآن ماذا يمكن أن يضيف أيّ تحالف بعد أن بدت كلّ القوى هشّة، والوضع الداخلي غير قادر على الفعل؟ يمكن أن يضيف فقط اتخاذ موقف يضعف إمكانات المستقبل عبر وضع تلك القوى الداعية إلى ذلك في موقع الالتباس، وربما الشكّ نتيجة تقاربها من السلطة التي أصبحت تمثل فئة مافياوية. وبالتالي فإذا كانت مواجهة «الخطر الأميركي« ضرورة، لكنها لا تفرض التحالف مع السلطة، بل تفرض التعبئة وتحضير القوى المجتمعية للمواجهة حين تصبح قائمة. ومن أجل ذلك ستبرز أهمية الديمقراطية، لأن السعي لمواجهة ذاك الخطر مترابط مع العمل لتحقيقها، كما أن تحقيقها مترابط مع التحضير لمواجهة ذاك الخطر كما أشرت سابقاً.
في المقابل، ينشأ الإشكال الثاني الذي يتمثّل، على العكس، في «الاتكاء« على «الخارج«، وتصوّر أن إنهاء الاستبداد و«نشر الحرّية« لن يكونا إلا بفعل خارجيّ، أميركيّ تحديداً. ولاشكّ في أن القمع العنيف الذي مارسته السلطة، والسجون، وأيضاً الهيمنة الأمنية على المجتمع، كلّها مسائل أسّست لـ «وعي« يقوم على أن التغيير الداخلي مستحيل، حتى أن شعار «إلى الأبد« إنغرس في وعي كلّ الذين باتوا يراهنون على «الخارج«، ويتوهمون بأنه يحمل «المنّ والسلوى« الديمقراطية. وإذا كانت طبيعة السلطة الاستبدادية الشمولية مؤذية ومدمّرة، لا شكّ في ذلك، إلا أن الوضع يحتاج إلى أبعد من رؤية هذه «النقطة«، سواء فيما يتعلّق بفهم الوضع الداخلي الآن (وليس في العقدين السابع والثامن خصوصاً)، وكذلك في ما يتعلّق بفهم طبيعة «الخطاب الديموقراطي الأميركي«، وبالتالي الأهداف الأميركية المبنية على المصالح وليس على القيم.
لقد أنتج الشعور بـ «العجز« والميل لـ «الرد«، الميل إلى رفض كلّ ما قالت به السلطة (الخطاب الأيديولوجي، حتى بكلماته)، وكلّ ما بنته. وبدت أنها «الشرّ المطلق« الذي ليس من خيار لهزيمته سوى عبر «مخلّص«، وهو ذاك الذي تكون له مخططات لتغيير السلطة ومناصبتها العداء، بغضّ النظر عن كلّ أهدافه أو مصالحه وممارساته. كما قاد رفض الشعارات التي أطلقتها السلطة إلى قبول الشعارات المعاكسة، حيث بدل الاشتراكية (التي كانت توسم بها السلطة ، وحتى لدى الذين لم يقرّوا سابقاً أنها كذلك، باتت لديهم الآن هي كذلك) كانت الليبرالية، وبدل القومية كانت «الدولة الوطنية« و«المتحد الوطني«. وبدل مواجهة الإمبريالية النوم في حضنها …. الخ.
هذا الخطاب ينطلق من الغريزة في وعي الواقع، وبالتالي ينطلق من ردود الفعل، الأمر الذي يحوّلها إلى «عملية انتقام شخصي« أكثر منها عملية صراع سياسيّ، وربما مسألة مصالح كذلك لدى فئات منها تحاول أن تركب التغيير من أجل تحقيق «التحول الطبقي». مما يخفض السياسة إلى مسألة «ذاتية«، و«وعي غريزيّ«. وهو الأمر الذي يقود إلى وعي الدور الأميركي كـ«إله منتقم«، وإلى بوش كـ«مخلّص« يحمل رسالة أخلاقية تتمثّل في «نشر الحرّية والديمقراطية« على دبابة. دون الحاجة إلى النظر إلى ما يجري في العراق، وكيف أن وعود الديمقراطية والحرّية تحوّلت إلى فوضى، و«ديمقراطية طوائف« تقوم على المحاصصة، والليبرالية تحوّلت إلى دمار طال البنى التحتية والصناعة … الخ. إن الغريزة التي ترفض ما هو قائم تقود إلى قبول الآخر دون وعي بماهيته. فالرفض هو الأساس دون الحاجة لتحديد البديل أو التدقيق في المشاريع المطروحة.
وهنا تقود مواجهة خطر الاستبداد إلى أخطار كبيرة كذلك، دون التأسيس لدور ذاتيّ مستقلّ، يعي ما يريد، ويعمل من أجل تحقيقه. إنه ينتظر المخلّص لتحقيق «الحلم« الذي بدا كـ «الحلم الاشتراكي» السابق والمحمول على الدبابة السوفييتية، لكن بشكل معكوس هذه المرّة.
هذان الإشكالان يعبّران عن نزعات من الضروري أن تُكشف وأن تُنقد في سياق السعي لبلورة رؤية جدية. لكن سنلمس أنه في المستوى النظري/ السياسي يمكن أن نلمس إشكالين كذلك، يحتاجان إلى خوض صراع فكريّ معهما، رغم الالتقاء في بعض النقاط، لكنهما يمثّلان اتجاهين لا يسمحان بتحقيق التطوّر، بل يكرّسان التخلّف والتبعية. واحد في المستوى الاقتصادي (التيار الليبرالي) والآخر في المستوى المجتمعي (التيار الأصولي الإسلامي)، وبالتالي فهما يتوافقان في نقاط أساسية. وربما كانا يهيمنان على وعي النخب (في السلطة والمعارضة). ولاشكّ في أن التحوّلات القادمة سوف تجعل منهما تيارين قويين، وينشئ «الصدام« معهما، بسبب النتائج الواقعية لدورهما.
فالليبرالية، التي بدأت تصبح خيار النخبة الحاكمة وخيار قوى أساسية في المعارضة، باتت تشكّل تياراً سوف يطبع المرحلة القادمة، ليس على المستوى الفكري فهو أهزل من أن يقدّم فكراً، بل في المستوى العملي عبر تعميم اقتصاد السوق المنفلت، أي دون حساب للواقع ودون ملاحظة انعكاس تعميمه على الطبقات الاجتماعية، وعل مجمل الاقتصاد الوطني، كما على القرار السياسي ودور سوريا العربي والعالمي. الأمر الذي سوف يقود إلى إعادة ربط سوريا بالنمط الرأسمالي العالمي من موقع التبعية، وبالتالي تدمير كلّ القطاعات الاقتصادية التي تشكّلت خلال العقود الماضية، دون بناء قطاعات منتجة جديدة، وبالتالي تعميم الاقتصاد الطفيلي. وهو الأمر الذي سوف يفرض تعميم البطالة والفقر، وإنهاء عملية التطوّر المتوقّفة منذ زمن.
وإذا كانت الفئات الحاكمة قد مالت إلى الليبرالية بعد أن نهبت وأصبحت ذات مصالح خاصة، فإن أزمة الصراع مع السلطة أنتجت الاتجاه ذاته في الحركة السياسية. فقد فرض «العقل الأحادي« الذي اعتبر أن السلطة هي سلطة اشتراكية، فرض أن تصبح الليبرالية هي البديل الوحيد (البديل المقدّس، فهو نهاية التاريخ). كما أن الانتماء للماركسية (وأساساً للمنظومة الاشتراكية) فرض التحوّل إلى الليبرالية لحظة انهيار تلك المنظومة، حيث بدت الاشتراكية كوهم والليبرالية كواقع راسخ.
ولاشكّ في أن هذا التيار يتقاطع مع الميول التي تراهن على «الخارج«، وربما كانت تلك الميول تعبّر عن الحدّ المتطرّف في التيار الليبرالي، رغم أن هذا التيار يتكيّف في إطار العولمة، ولا يرى إمكانية غير ذلك، دون أن يتوافق بكليته تماماً مع السياسات الإمبريالية الأميركية.
نحن هنا إزاء تيار يسعى لفرض التكيّف مع السيطرة الرأسمالية والاندماج في العولمة، وبالتالي الالتزام بكل السياسات العولمية، خصوصاً تعميم الليبرالية الجديدة وتهزيل دور الدولة، وتمييع مفهوم السيادة الوطنية والاستقلال الوطني. الأمر الذي سوف يفرض تفاقم الأزمات الاجتماعية على ضوء انهيار البنى الاقتصادية القائمة. انهيارها بفعل المنافسة القوية من قِبل الشركات الاحتكارية الإمبريالية التي باتت تفرض شروطها، وتصيغ الظروف التي تخدم احتكارها.
ونحن هنا إزاء صراع على تحديد اختيارات تمسّ عملية التطوّر أو تنفيها، وبالتالي تمسّ كلّية المجتمع. وتتمحور هذه الاختيارات حول دور الدولة الاقتصادي الرعائي بالأساس، أو السعي لفرض حرّية مطلقة للسوق وللنشاط الرأسمالي يؤسِّس لتنافس غير متكافئ مع احتكارات عالمية قادرة على أن تفرض منطقها على شعوب العالم. ونحن هنا ننطلق من الدفاع عن ضرورة التطوّر الذي لن يتحقَّق إلا عبر دور الدولة الاقتصادي (مع كلّ الملاحظات التي يمكن أن تُقال عن دورها الماضي والراهن، والإشكاليات التي أنتجتها، والسعي لتجاوز هذه الإشكاليات)، ودورها الرعائي لمصلحة الطبقات الشعبية. دون أن يعني ذلك رفض كلّ دور للرأسمال الخاص، أو فرض «التخطيط المركزي« كما كان يُطبّق في البلدان الاشتراكية، حيث يجب أن يمارس الرأسمال الخاص نشاطه في إطار آليات سوق تقوم على شكل من أشكال التخطيط (الذي يسمّى التخطيط التأشيري)، الذي هو أمر ضروري من أجل عملية التطوّر، وفي إطار دور حمائيّ تمارسه الدولة لتخفيف انعكاس اللاتكافؤ على الاقتصاد الوطني. ولكي يكون الرأسمال الخاص جزءاً من عملية التطوّر ذاتها بدل أن ينشط في القطاع الهامشي أو الطفيلي، أو في الخدمات والتجارة فحسب (…).
المستقبل