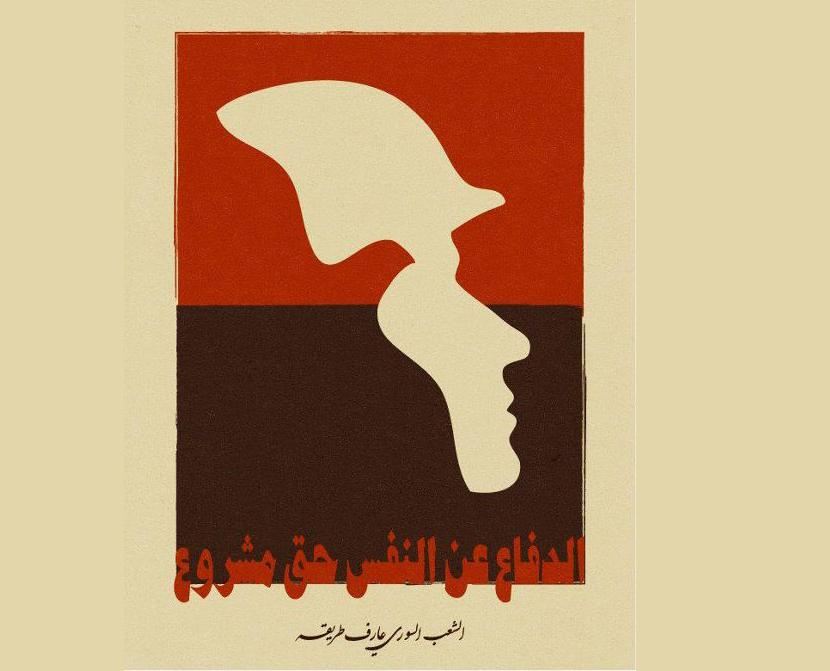“ماذا لو بقي الأسد” مقالات مختارة تناولت الأمر
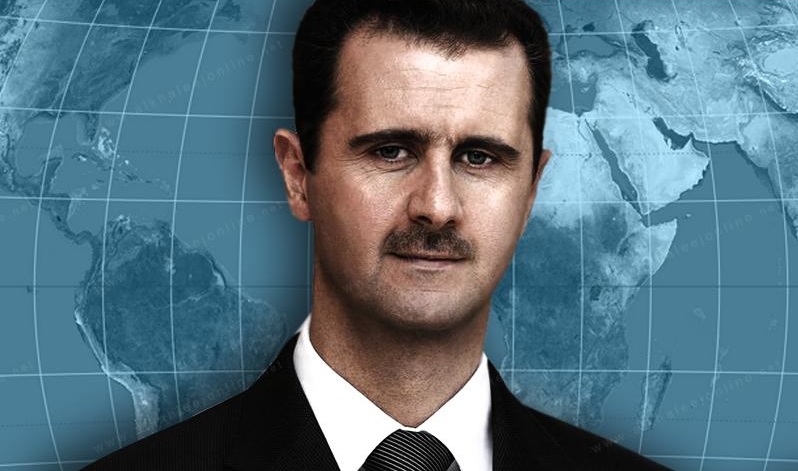
سقط حافظ ولم يسقط بشار/ عمر قدور
في نسبة لا يُستهان بها من قناعات معارضين سوريين ما يزال حافظ الأسد يحكم من قبره، وهي قناعة يُعبّر عنها عند الكثير من المحطات. بل هي قناعة آخرين تُطلّ أحياناً لوصم عموم المعارضة السورية بأنها “تربية” مدرسة الأسد الأب، من دون دراية ووعي منها، ما يجعل تركته موزّعة بين الوريث وخصومه، وهي فكرة مغرية عموماً بقدر ما هي سطحية في الكثير من الأحيان، بما أنها أسهل طريقة لمناقشة أخطاء المعارضة أو الانقضاض عليها فكرياً.
هذه الفكرة، من أي طرف أتت، تستهين بالحدث الأبرز للسوريين متمثّلاً الثورة، سواء عن قصد أو بدون قصد. فالثورة، وفق هذا المعيار، فشلت في إسقاط حكم حافظ عبر وريثه، ووفق منتقديها فشلت في إسقاطه في داخلها أولاً. واليوم، أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الثورة، يمكن الإشارة إلى إخفاقها، مثلما يمكن الاستدلال بأسديين صغار موجودين في صفوفها أو في بعض واجهاتها، مع إغفال واقع انطلاقتها التي استقطبت نسبة ضخمة من السوريين الذين كانوا وبقوا خارج دائرة الأضواء. بالمثل تستهين هذه الفكرة بالأسد الابن “الوريث”، حتى إذا امتلك المؤهلات الكافية للاستهانة به قياساً إلى أبيه أو إلى أي سوري آخر، لتجعل منه مجرد واجهة لقبر أبيه، وهي في ذلك تغفل التطورات التي أدت ببشار ليكون واجهة لقوى خارجية لا لذلك القبر.
في الواقع يسود شعور لدى موالي الأسد بعدم كفاءة بشار وجدارته بوراثة أبيه، تم التعبير عنه في أول الثورة بأن القضاء عليها تأخر لعدم تدخل أخيه ماهر بالعنف المعروف عنه، وبعبارة أنه لا يزال لابساً البيجاما ولم يلبس ثياب الميدان. ويسود الشعور بأن الأب كان قادراً على امتصاص بداية الثورة ضده بطريقة أشدّ وأكثر حنكة، ولن يكون مضطراً على شاكلة الوريث إلى رهن قراره السيادي إلى أية جهة خارجية أو داخلية. أي أن مجمل تلك المقارنات يذهب إلى انقضاء زمن حافظ، وإن عبر تبديد بشار إرثه “الذهبي”، وليس بواسطة سوريين انتفضوا على ذلك الإرث وأعلنوا نهايته.
بخلاف ما سبق، ومن زاوية أخرى، تجوز مقاربة الأمر بأن الثورة أسقطت حافظ الأسد منذ الأشهر الأولى لاندلاعها، فالبنية المخابراتية الصلبة التي رسخها ظهر عجزها التام آنذاك، ولم تفلح أيضاً محاولات استرجاع زمن الأب مع إعادة بعض الشخصيات الأمنية المتقاعدة إلى الخدمة، بخاصة الشخصيات التي يُعتقد أنها نجحت معه في التصدي للتمرد الذي قاده الإخوان قبل ثلاثة عقود من الثورة. المسألة ليست في الإطار الرمزي الذي ينص على أن السوريين كسروا حاجز الخوف، وإنما أيضاً في فشل تلك البنية التي كان يفترض بها صنّاعها القدرة على استباق أي “تمرد”، وتالياً القدرة على تأبيد نفسها. بهذا المعنى نجحت الثورة في إسقاط حافظ الأسد، ولا مبرر للقول بأنه ما يزال يحكم من قبره ومن خلال وريثه، فهو بالأحرى لم يعد يحكم حتى قصره.
إن رمزية بشار لم تعد عملياً منذ خريف 2011 في كونه ابن حافظ الأسد، وإنما في كونه رمزاً لدخول الاحتلال الخارجي مكان الاحتلال الداخلي، ولتحول الأخير إلى مجرد وكيل عند الأول، ويمكن القول بأن من رفض نهايته على أيدي السوريين قد سلّمها فعلياً لأسياده الجدد وفق التوقيت أو الثمن اللذين يرونهما مناسبين. يمكن القول أيضاً بأن نوع المعارضة الذي ينتمي إلى زمن حافظ الأسد قد أصبح حينئذ من الماضي، وأن أقل فجوة زمنية تفصله عن الواقع تتمثّل في ثلاثة عقود من الزمن، هو الزمن الذي أجهز فيها حافظ الأسد على تلك المعارضة مع نهاية السبعينات ومستهل الثمانينات. هذا وحده لا يمنح امتيازاً جيلياً لمعارضين لاحقين أو مستجدين، لكنه يسحب ظله على بعض النقد الموجَّه للمعارضة، وقد يستقيم أكثر بالقول إن مشكلة معارضي زمن الأسد الأب ليست في أنهم تشربوا بشيء من الأسدية، بل هي في أن ذلك الزمن انقضى أصلاً.
من التبسيط الشديد أيضاً النظر إلى ما جرى على أنه انتقال من مقاومة الاحتلال الداخلي “الاستبداد” إلى مقاومة الاحتلال الخارجي، أو الانضواء في منظومة من الصراعات الإقليمية والدولية. الزمن المركّب من تضافر الاحتلالين الداخلي والخارجي هو حتى الآن في طوره الأول، ولا مستقبل لاستمراره على النحو الذي كان مألوفاً من قبل بدعم قوى دولية أنظمة مستبدة في المنطقة، ولا يمكن تصور التدخل الإيراني أو الروسي بمثابة قوة تأديب للسوريين ستغادر حالما تنتهي مهمتها. ولأن نتائج الوضع الحالي قد تتأخر في الظهور فسيكون مستبعداً بروز مقاومة داخلية له سريعاً، وبعيداً عن الصراع الإقليمي أو الدولي.
قد نكون الآن على عتبة المرحلة الثالثة، فإذا كان العام الأول هو عام إسقاط حافظ الأسد، وكانت الأعوام التالية هي زمن وريثه الذي أفلس وإرتهن مع تركته، فما يحدث الآن من ترتيبات ينضوي في إنهاء الحقبة الأسدية كاملة، من دون مكاسب للسوريين ما دام إسقاط بشار قد خرج من أيديهم وصار شأناً خارجياً. هذه النتيجة معطوفة على الطور الثاني أيضاً، ففي الصراع الدولي والإقليمي لم يكن لدى السوريين ما يقدّمونه من امتيازات للخارج بالمقارنة مع ما يقدّمه بشار لحُماته، فضلاً عن الإجحاف الأخلاقي في المقارنة. وإذا كان إسقاط الأب شأناً سورياً فإسقاط الابن لن يكون كذلك، وسيتطلب اشتباكاً مع الخارج على مختلف الأصعدة، الأمر الذي لم تثبت فيه المعارضة حتى الآن مهارة تُذكر. المفارقة أنه إذا كانت كل المؤهلات تصب لصالح الأسد الأب بالمقارنة بينهما فإن المقارنة بين معارضتيهما مقلوبة، إذ أن معارضة الأب لم تكن تتطلب ما هو مطلوب اليوم لإسقاط الابن.
المدن
هل نجح نظام الأسد وحلفاؤه في احتواء الثورة؟/ لؤي صافي
الثورة السورية التي بدأت في منتصف آذار (مارس) 2011 تحولت خلال أشهر قليلة إلى صراع مسلح بين نظام الأسد وقوات «حزب الله» و «الحشد الشعبي» الذي تدعمه طهران من جهة، وقوى إسلامية متطرفة تقاتل تحت راية «القاعدة» وتعمل على ابتلاع القوى الثورية المحلية والمنشقين عن الجيش السوري من جهة أخرى. الثورة التي بدأت ثورة سلمية شعبية ترفع شعارات الحرية والعدالة والكرامة، وتدعو إلى إنهاء احتكار النظام للسلطة، انتهت نتيجة دهاء الطغمة الحاكمة في دمشق إلى صراع طائفي. هل يعني ذلك أننا أمام مشهد جديد يعود فيه النظام إلى سابق عهده، ويتم وأد الثورة وعودة الخضوع لقواعد الحكم السلطاني التي اعتقد السوريون أنهم تجاوزوها عندما أعلنوا قيام الجمهورية السورية عقب الاستقلال من الوصاية الفرنسية؟ هذا السؤال المهم والصعب يدور في رؤوس السوريين في المناطق الخاضعة للنظام والمناطق الخارجة عنه، كما يدور في رؤوس المهجرين السوريين المنتشرين على حدود سورية وعبر القارات الخمس. ولأن السؤال معقد، والمتغيرات التي تحكمه عديدة ومتحولة، فإن محاولة تقديم مشهد واضح لمآلات الصراع ستكون أقرب إلى التنجيم منها إلى التكهن العلمي. وغاية ما نستطيع تحديده عملياً بناء على المعلومات والمعطيات المتوافرة هو رسم الخطوط العريضة لاتجاه الثورة ومآلات الصراع، والتي يمكن اختصارها بالنقاط الست الآتية:
أولا: عودة النظام إلى التحكم بالمجتمع المدني السوري كما فعل قبل الثورة، رغبةٌ إيرانية روسية لا تعضدها الوقائع، نظراً الى التراجع الكبير في قدرات النظام المالية والعسكرية، والتغيرات العميقة التي تركتها الثورة وأساليب القمع الوحشي التي اتبعها النظام والتي ترسخت في وعي جيل كامل من السوريين بلغ رشده خلال سنوات الثورة. الدمار الكبير في البنية التحتية سيحتاج إلى إمكانات غير متوافرة بسبب تراجع الرصيد المالي للدولة، وهجرة الكفاءات العملية خارج البلاد. أضف إلى ذلك أن العبء الاقتصادي الذي تحمله حلفاء النظام لا يسمح لهم بتوفير رأس المال المطلوب لإعادة الإعمار.
ثانيا: سيواجه النظام تحدياً كبيراً في استعادة قدرته على التحكم في مفاصل الدولة عبر أجهزة مركزية، كما فعل خلال نصف القرن الماضي، نظراً للاستنزاف البشري الكبير في حاضنته، وتراجع قدراته المالية والبشرية، وتزايد نفوذ الميليشيات الشيعية والميليشيات التابعة لإيران في جميع المناطق. سيكتشف النظام سريعاً أنه عاجز عن لجم الهيمنة الإيرانية بسبب حاجته إلى دعم إيران الذي سيستمر حتى لحظة سقوطه، نظرا لوصول النفوذ الإيراني إلى داخل الأجهزة الأمنية التابعة له.
ثالثا: الخطة الحالية لإنهاء الصراع في سورية لن تؤدي إلى تجاوز الأسباب التي دفعت السوريين الى الانتفاض والثورة، بل على العكس تسعى إلى تكريس الواقع السيئ الذي ساد خلال حكم حزب البعث، فالنظام الذي تبنى سياسات عنصرية وطائفية وفئوية خلال ولاية حافظ الأسد، أضاف خلال حكم بشار الأسد إلى سجله الماضي مئات الآلاف من ضحايا التعذيب، والاختفاء القسري، والقتل العشوائي للمدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية في أحياء واسعة من المدن والقرى والسورية. تجاوز أسباب الصراع يحتاج إلى الدخول في برنامج محاسبة ومصالحة، وهو أمر يعجز عنه نظام استبدادي مسؤول عن بدء الصراع وتحوله إلى صراع دموي مأسوي.
رابعا: كشفت الثورة السورية مخاطر الاصطفاف خلف حركات التشدد الإسلامي، كما أظهرت عجز الحركات الدينية ذات الرؤية الحصرية عن قيادة المجتمعات المعاصرة، والتشابه الكبير بين الاستبداد العلماني الذي مثله نظام البعث في سورية، والاستبداد الديني الذي تجلى في سلوكيات السلفية الجهادية. التشابه بين سلوكيات الطرفين يؤكد أن المشكلة التي تواجهها المجتمعات العربية ليست مشكلة بنيوية تتعلق بالقوى والأحزاب الحاكمة، بل مشكلة ثقافية تتعلق بالقيم والمواقف التي تقود الإنسان العربي في تحركاته السياسية.
خامسا: أظهرت أحداث الثورة ضرورة بروز كتلة سياسية حرجة، تملك القدرات التنظيمية والقيادة الواعية، لمنع تشرذم المعارضة وتفتتها، كما أظهرت خطل التعويل على الخطاب الداعم لدول تملك مصالح متضاربة للقيام بعملية التغيير. تفكيك المعارضة السورية تم خلال ست سنوات، وبخطوات مضطردة، بدأت بشرذمتها بين معارضة ثورية وسياسية، ثم بين معارضة داخل وخارج، ثم بين معارضة وطنية وأممية.
سادسا: كشفت الثورة في سورية، وفي دول الربيع العربي، التراجع المخيف في قدرات المجتمع العربي الذي عاش تحت ثقل الأنظمة الشمولية المستبدة، وأظهرت تداعيات العيش في مجتمع تحكمه ممارسات القوة والحظوة والمحسوبية، وفي مجتمع لا يدرك أفراده أن كرامتهم وكرامة أبنائهم لا يمكن أن تتحقق في غياب الأخلاق العامة، واحترام القانون العادل، والتضامن في وجه الظلم والفساد.
عودة إلى السؤال الذي انطلقنا منه: هل نجح النظام السوري وحلفاؤه في احتواء الثورة؟
في سياق التطورات على الأرض، وفي ضوء النقاط الست السابقة يمكن القول أن النظام نجح في احتواء الثورة جزئيا، ولكنه عاجز عن السيطرة على البلاد بالطريقة المركزية التي ميزت سورية قبل الثورة. ولأن حلفاء النظام يدركون ضعفه ومكامن القوة الماثلة في المناطق المحررة فهم يسعون اليوم إلى تحويلها من مناطق محررة إلى مناطق هدن. المطلوب تحويل تلك المناطق إلى مساحات لخلق مجال لقيام مجتمع مدني حيوي، ومناطق حكم ذاتي يمكن أن تتحول إلى نموذج بديل من نموذج الدولة المركزية التي تتحكم فيها أسرة الأسد وطغمة فاسدة من أصحاب المال المنتفعين من بقاء النظام. العمل لتحويل الهدن إلى بديل من الحكم المركزي الاستبدادي شيء تجاهلته المعارضة السياسية، المنشغلة بمفاوضات جنيف الفارغة من الفاعلية الدولية، والتي تحولت بالتدريج إلى ثقب أسود تتلاشى داخله جهود المعارضة وتضيع.
المعارضة السياسية التي سبقت قيام الثورة، وتلك التي أفرزتها السنوات الثلاث الماضية، أظهرت عجزها الواضح عن التحول إلى كتلة متماسكة داخلياً، كما عجزت عن توليد قيادة سياسية يلتف حولها الجميع. الشيء الوحيد الذي تستطيع المعارضة الحالية تقديمه هو دعم جهود توحيد مناطق الهدن، وتحويلها إلى مناطق لقيادة المرحلة القادمة سعياً إلى تغيير سياسي حقيقي في سورية يقوم به جيل جديد من الشباب السوري الذي وقف بصلابة في وجه عدوان النظام وإجرامه. المرحلة الأولى من التغيير السياسي بدأت في سورية، ولكن إنجاز التغيير السياسي المطلوب لن يتم من خلال الحراك الشعبي والتضحيات الوطنية وحسب، بل سيحتاج إلى رؤية سياسية واجتماعية جديدة، وإلى نضج فكري ونظرة حضارية مختلفة تماماً عن تلك التي حكمت التحرك الثوري في مراحله الأولى.
* كاتب سوري
الحياة
من القاهرة إلى الأسد/ غازي دحمان
شجعت المتغيرات الحاصلة في سورية نظام مصر على استعجال إعادة العلاقة الدبلوماسية علنا مع نظام الأسد في سورية، ويسعى إلى إخراج العملية بقالب ديمقراطي، عبر الإيحاء بحصولها نتيجة ضغط شعبي، ومطالبة نخب وازنة وشخصيات تمثيلية بإعادة هذه العلاقة. والمفارقة أن هذه الحملة جاءت تحت شعار”من القاهرة هنا دمشق”، فيما يبدو ردَّ جميلٍ لدمشق التي أطلقت إذاعتها في أثناء العدوان الثلاثي على مصر ولحظة توقف إذاعة مصر عن البث شعار “من دمشق هنا القاهرة”.
يطبق نظام السيسي المثل المصري “أكل وبلحقة”، حيث لا يكتفي بارتكاب إثم التقارب مع نظامٍ لم يخف أنه ارتكب ما ارتكب من مجازر بحق السوريين، من أجل تحقيق هندسة اجتماعية عنصرية سماها “التجانس”، بل يسعى نظام السيسي إلى تلميعه وتجميله، فقد تزامنت دعاوى إرجاع العلاقات مع نظام الأسد مع حملة إعلامية منسّقة ومقصودة لحرف الرأي العام المصري، وإعادة تشكيله عبر إعادة صياغة القضية السورية برمتها، بحيث يظهر نظام الأسد ضحية مؤامرة خارجية، وأن القضية في الأصل قضية إرهاب تتعرض له الدولة والجيش السوريان، وأن الأمور وصلت إلى خواتيمها، ويجب مساندة سورية والوقوف معها، وإصلاح الخطأ الذي ارتكبته حكومة الرئيس الرئيس محمد مرسي قطع العلاقات مع نظام الأسد.
لكنّ ثمّة فرقا بين الأحداث يصعب، إن لم يستحيل، تجسيره، ذلك أنه عندما قالت إذاعة دمشق “هنا القاهرة”، كانت دمشق لأهلها وسورية يحكمها أبناؤها، وكانت القاهرة تتعرّض لعدوان واضح عقاباً على سياساتها التحرّرية، سواء لجهة تحرير مواردها وفك ارتباطها بالكمبرادور الخارجي، أو من خلال دعمها حركات التحرّر في محيطها العربي “ثورة الجزائر”.
كان طبيعياً أن تقول دمشق “هنا القاهرة”. في حينها، كانت مصر تقود العمل القومي العربي
“فرق بين أن يكون لمصر دور في مستقبل التطورات السورية وأن تعمل على تأهيل نظام مجرم” وتدافع عن العروبة، وكان رئيسها جمال عبد الناصر يصنع تياراً قومياً في مواجهة تيارات تقول إن مصر فرعونية، وأخرى تنادي يالتوجه متوسطياً، باعتبار أن العلاقات التاريخية مع تركيا واليونان، وحتى إيطاليا وفرنسا، أعمق بكثير وأكثر نفعاً وفائدة من العلاقات مع الدائرة العربية المتخلفة. في المحصلة، كان شعار “هنا القاهرة” ينطوي على فخر كبير لدمشق، واستثمار في رأي عام عربي محتضن مصر وزعامتها.
ثمّة فرق بين أن يكون لمصر دور في مستقبل التطورات السورية وأن تعمل على تأهيل نظام مجرم. أما عن الدور فهو متحصل بشكل أوتوماتيكي لحاجة اللاعبين الكبار في سورية، روسيا وأميركا، إلى دور عربي يظلل نشاطهما، ويشرعنه في عملية تشكيل سورية، وليس هناك أفضل من مصر للعب هذا الدور لأسباب كثيرة، أهمها وزن مصر العربي ومكانتها، وليس لأسباب وظروف آنية، تتعلق بحاكمها الحالي ونخبتها السياسية، وهذا الدور سيكون مطلوبا في بناءٍ عليه، يجب أن تختلف حسابات الدور المصري، وعلى الدبلوماسية المصرية التقاط الفرصة بهدف تعزيز دورها الإقليمي، بما ينعكس على أمنها بشكل فعلي، وليس كما تذهب تقديرات متعجلة من أن دعم الأسد وبقاءه سيعزز من أمن النظام الحاكم في القاهرة، على اعتبار أنه نظام شبيه له يعتمد على العسكر، ويحارب الإسلاميين.
يجب أن تبتعد هذه الحسابات عن العاطفة، وما تنطوي عليه من مكايدات لجماعة الإخوان المسلمين، وأن تركّز على ما هو أبعد من ذلك، فبقاء نظام الأسد يعني استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم بكامله، كما أنه سيعني تعزيزا للوجود الإيراني. ومن يقول غير ذلك يكذب على نفسه، فالأسد أصبح رهينا لإيران، ولا أميركا أو روسيا يعنيهما تفكيك العلاقة بين الأسد وطهران، بقدر ما لهما مصالح معينة، يركزان عليها من دون الاهتمام بأي اعتبارات أخرى.
على مصر أن تدرك أن اللعب في هذا الأمر خطير، فهي ستؤسس لدمار النظام الإقليمي العربي، ليس فقط عبر تدعيم الهيمنة الإيرانية على المشرق العربي، بل أيضاً عبر إعطاء الفرصة لنظام الأسد للعمل على تخريب النظام العربي من الداخل، فهذا النظام فكّك كل علاقاته مع العالم العربي، وما يهمه فقط هو الانتقام من العرب وإذلالهم. ويكفي تحليل الخطابين السياسي والإعلامي لنظام الأسد لاكتشاف حجم الاحتقار الذي يكنه للعرب، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون له.
لا المكايدات ولا اللغة الإنشائية تصلح للتعامل مع قرار خطير بهذا الحجم، في حين أن
“من المعيب اختصار سورية ببشار الأسد، وشطب الشعب السوري من المعادلة” المعطيات هي باتجاه آخر، ولا تجد من يلتقطها للبناء عليها، فلا جيش سورية عربي سوري كما يدعون، بعد أن انشق السنة عنه واستنكف الدروز الخدمة فيه ودفع المسيحيون بدلاً نقدياً عن خدمة أولادهم فيه، وصارت كتائب الزينبيين والفاطميين وأبو العباس وحزب الله تشكل قوات النخبة فيه، ولا سورية (الأسد) دولة مؤسسات حقيقية، تستدعي بالفعل إعادة إنتاجها لإعادة إنتاج المأساة السورية، واستمرار ماكينة القتل والتهميش.
ليس لمصر، أو لأي دولة عربية أخرى، مصالح في سورية، أكثر من المصلحة مع الشعب السوري نفسه المستقر والمتصالح مع دولته. وهذا لن يحصل مع بشار الأسد الذي أخرج ثلاثة أرباع الشعب السوري من وطنيته، ويتوعد في حال استقرار الأمور لصالحه بالانتقام من السوريين فرداً فرداً.
بغض النظر عن اختلافنا مع نظام مصر، ثمة فرصة أمامه للعب دور مؤثر وفاعل في الأزمة السورية، وستكون مكاسبه استراتيجية وبعيدة المدى، وذلك عبر الاصطفاف إلى جانب حقوق الشعب السوري الباقي، وليس نظام الأسد الراحل، ولو بعد سنة أو اثنتين على أبعد تقدير.
إما إذا كانت نخب مصر تعتقد أن عليها ديناً يجب تسديده، فمن المعيب اختصار سورية ببشار الأسد، وشطب الشعب السوري من المعادلة، أما إذا أصررتم فالرجاء أن تغيروا الشعار إلى “من القاهرة إلى بشار الأسد قاتل الشعب السوري”، فالمناورة مكشوفة، ولا داعي لأن تطعمونا جوزا فارغا.
العربي الجديد
قال الأسد: «سورية عبر التاريخ هي هدف»/ لؤي حسين
استشهد الرئيس السوري بشار الأسد، في خطابه الأخير أمام مؤتمر وزارة الخارجية، بمعركة قادش التي حصلت، وفق قوله، عام ١٢٧٤ ق. م، ليبرهن لسامعيه أن «سورية عبر التاريخ هي هدف».
هذا القول هو ذاته الخطاب الاستبدادي الذي فَرض منطقه على مسامعنا بقوة القمع والسلاح منذ منتصف القرن الماضي. فسورية، وفق هذا الخطاب، ليست وطناً للعيش بل قلعة لـ «الصمود والتصدي»، وخندق لـ «الممانعة». فهي ليست موجودة، من قبل التاريخ، من أجل أبنائها، بل من أجل أعدائها: لتكون موضوعاً لاعتداءاتهم الدونكيشوتية، فتتصدى لهم وتمانعهم. فوفق هذا المنطق هي قائمة على رد الفعل من دون أن يتوجب عليها القيام بأي فاعلية.
لكن، للأمانة المعرفية، لا يمكننا نكران أن سورية كانت منذ القِدم هدفاً لكيانات أخرى. لكن هذا ليس لأنها بعثية، أو عربية، أو مسلمة، أو مقاوِمة، أو ممانِعة، بل لكونها بلداً طبيعياً، يتشابه بذلك مع مختلف بلدان العالم «عبر التاريخ». فغالبية البلدان، ما لم تكن جميعها بالمطلق، كانت «عبر التاريخ»، ذاته، «هدفاً» لكيانات أخرى.
لا، ليس ما حصل لسورية ناجماً عن أنها مستهدفة. فالاستهداف قائم دوماً. لكن من أهم مهام الدولة حماية البلد من الاستهداف. والحماية تعني المحافظة على البلاد سليمة معافاة. لكن أن يتشرد أكثر من نصف سكانها، ويُقتل مئات الألوف منهم، وتتهدم نصف بنيتها التحتية، فهذا بكل تأكيد، وبجميع المعايير، وبمحاكمة أصغر العقول، لا تمكن تسميته حماية من الاستهداف، ولا يمكن لواقعة قادش أن تكون دليلاً على أنه نتاج الاستهداف «الغربي». بل هو، ببساطة ومن دون بذل جهد في التمحيص، ناجم عن عدم أهلية السلطات التي من المفترض أن تكون مُؤتَمَنَة على سلامة البلاد بجميع سكانها وممتلكاتها. ولا يعفيها من هذه المسؤولية تذاكيها وتشاطرها باكتشاف أن ما حصل كان نتيجة «مؤامرة» أو «استهداف»، فهذا شأن الصحافة والكتّاب الصحافيين والباحثين والمحللين وليس شأن السلطات، بل إن معرفتها بذلك تضاعف مسؤوليتها لإخفاقها في حماية البلاد.
حماية البلدان ليست أمراً خفيّاً، بل هي جلية لا لَبْس فيها، تظهر للناظر كعين الشمس، لا تحتاج الى تدبيج خطابات ديماغوجية ولا فبركة سرديات بطولية، فالناس تعرف أن البلدان لا تكون إلا ببشرها، وتحصينها يبتدئ من هنا، من الإقرار بأن المبتدأ هو إنسانها وأنه منتهاها. الإقرار بإنسانها على أنه نواتها الجوهر، «وحيد الخلية» المجتمعية الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزيء. إن تعرضت حرياته وحقوقه للانتهاك صَغُرَ فيصغر البلد من صِغَرِه.
لهذا فإن تحصين البلاد يكون بصون حرياتها المطلقة، التي لا يحدها شيء سوى حدود حريات الفرد الآخر، شريك المواطن في الوطن، من دون أدنى اهتمام بدينه أو قوميته أو طائفته أو جنسه أو موقفه السياسي.
حالة البلدان هي انعكاس مُطابقٌ لحالة الفرد فيها وليس العكس بتاتاً. فالفرد هو نواتها المؤسِّسة. إن كان حراً تكون البلاد حرة، وإن كان لا يعلو كرامته سوى سلطة الدستور والقوانين تكون السيادة في البلد للقانون وليس للمخابرات، وحين تكون حقوقه مصانة تكون حقوق بلده ومالها العام وأملاكها مصانة من النهب والفساد. هذا ما يحصّن البلاد وليس الجيش والمخابرات والإعلام الكاذب.
لا يكفي لتحصين البلدان مجرد إقرار إنشائي لمُبتدأيّة الفرد، بل لا بد من وقعنة هذه المكانة بجعلها أسّاً للدولة الحديثة. أي أن تقام الدولة لتكون مجالاً لتجسيد حقوق الفرد وحرياته، وكذلك واجباته. فالفرد الكامل الحقوق والحريات هو غاية الدولة بمفهومها الأحدث، وبالتالي هو هويتها. فالدولة السورية، موضوعنا اليوم، وبعد أن فاتها زمن إقامة «الدولة/ الأمة»، الذي قامت الدول فيه على معنى الأمة، أو على العكس من ذلك، الذي تشكلت فيه الأمة لتكون معنى للدولة، صار من الضروري بناؤها بنسختها الأحدث: الدولة/ المواطن، أو دولة المواطنة. أما التباهي الطاووسي بأنها دولة «الممانعة» أو أي عبارة أخرى من هذا النسق النافل فهو يختص بالدولة/ السلطة التي يقوم عليها الاستبداد والطغيان.
فمواجهة التحديات الخارجية، إن قضت الحاجة، من المهام العَرَضية الطارئة، مهما طالت، وليست من صلب الدولة.
بتكثيف: الفارق بين دولة المواطنة والدولة/ السلطة، أي السلطة الاستبدادية المتمظهرة بمظهر الدولة، هو تحديداً وجود علاقة بنائية بين الفرد والدولة خلال عملية تَحوّل الفرد إلى مواطن في لحظة صيرورة تَشَكّل الدولة، فتكون دولة المواطنة. أما السلطة المتمظهِرة بمظهر الدولة فعلاقتها مع الأفراد تقتصر على تعاملها معهم على أنهم مادة ممارسة سلطتها. فالسلطة الاستبدادية القائمة على الغَلبة تنظر إلى نفسها على أنها دولة سابقة على الفرد، فتضع له ولها معاني إنشائية فارغة، ترغمه بأجهزة قمع تبنيها، فتصبح غاية الفرد خارج ذاته وخارج معنى وجوده. أما الدولة التي تقوم على التعاقد الاجتماعي فهي بذاتها عبارة عن اجتماع الأفراد، وليس مجموعهم.
اجتماع الأفراد، هذا الذي نسميه الدولة، يقضي بانفكاكهم عن روابطهم الدموية السابقة، كالرابطة العشائرية أو القومية أو الدينية أو الطائفية. وما يتبقى، بعد ذلك، للفرد من علاقات مع جماعته السابقة للدولة فلا يُعتَدّ به ضمن فضاءات الدولة ومؤسساتها، بل يندرج ضمن حرياته وحقوقه.
هذا الحديث الآن عن الدولة لا يَرد ضمن باب الترف النظري، كما أنه لا يُستدعى للمناسبة الظرفية. فموضوع بناء الدول ليس عملاً تقوم به المجتمعات في أوقات فراغها، أو في المساء مع كأس الشاي، بل هو «حرفة» نخبها المجتمعية، التي يتوجب عليها القيام به طوال وقت «عملها الرسمي» كنخبة. وعليها مضاعفته خلال الأوقات البنائية، كما هي حال اللحظة السورية الراهنة، حيث يتوجب على كافة المجموعات السياسية، والمدنية أيضاً، موالية كانت أم معارضة أم بَيْن بَيْن، أن تعتمد بناء الدولة معياراً رئيساً لأعمالها. فتأخذ بالأعمال التي ترى أنها ركن من أركان الدولة، وتترك ما عداها.
كذلك، فإن الحديث عن بناء الدولة السورية الآن ليس إزاحة لمسار الصراع إطلاقاً. فموضوع الدولة هو عَيْنُ الصراع. وما التفاصيل التي «صَرَعَنا» بها المتصارعون طيلة الفترة الماضية سوى تفاصيل في سياق شكل الدولة وبنيانها. لهذا فالكلام المباشر في موضوع بناء دولة سورية جديدة هو العتبة الرئيسة في عملية النضال الثوري التحرري. فالثورة التي تنتظرها سورية منذ استقلالها هي تلك التي تبني دولة مواطنيها، لا دولة العرب أو الكرد أو الإسلام أو غير ذلك من التعابير التي يعتمدها الاستبداد دعائم لبنيانه.
ليست لدينا دولة في سورية، لم نعرف الدولة منذ استقلالنا، فكل ما عرفناه هو سلطات، معظمها بشع، تلبس لبوس الدولة، تعتمد أجهزة تسلط تعطيها مسميّات دولاتية لتستخدمها في فرض سيطرتها القهرية على السكان. القول بتاريخية التسلط السوري لا يبرر إطلاقاً الأفعال المخزية التي ارتكبتها السلطة السورية الراهنة، والقول الذي سبقه ليس القصد منه سَوْق المآخذ عليها، إذ إنها أثبتت بجميع الطرق أنها أسوأ السلطات التي حكمت سورية، وأظهرت نفسها بجلاء الصورة أنها مجرد سلطة شارعية لا يمكنها تحقيق ذاتها إلا بانتصار أولاد شارعها على أولاد الشوارع الأخرى.
بناء الدولة هو الميدان الحقيقي للصراع مع النظام، وهو، أيضاً، الميدان الحقيقي للصراع مع قوى التخلف والطغيان الأخرى التي كانت شريكة النظام في الحرب التي دارت بينها وبينه لأكثر من ست سنوات خلت. والآن، وبعد أن حطت هذه الحرب أوزارها وخفتت أصوات مدافعها، في شكل كبير، بات من الممكن استئناف العمل على بناء الدولة المنشودة من دون اعتبارٍ لمقولة إرجاء هذا الاستحقاق إلى اليوم التالي لسقوط النظام، أو لما بعد تنحية بشار الأسد عن السلطة. ذلك لأن العلاقة الصراعية بين النظام الاستبدادي والنظام الدولتي لا تقوم على أن تكون البداية تراجعاً للاستبداد مسافة أو أكثر ليَلي ذلك تقدم للدولة لملء ذاك الشغور، بل تقوم على تقدم مشغول لبنى الدولة يجبر النظام الاستبدادي على التقهقر مسافة على قدر الخطوة الدولتية. فانتظار سقوط النظام هو من مخلّفات التفكير الانقلابي، غير أن بناء الدولة لا يتم بالانقلابات بل عبر آليات بنائية.
تلمّس معرفة كيفية تحقيق ذلك يحتاج لمساهمات عدة. ولكن جميع الكيفيات الممكنة يحتاج، مثل أي عمل آخر، إلى أدوات، وأدوات بناء الدولة هي حصراً التنظيمات المجتمعية، أي التنظيمات السياسية والمدنية التي لا تقوم على نزوع قومي كالعروبة والكردية مثلاً، ولا على روابط دينية أو طائفية كالإسلام أو السنية أو العلوية أو غيرها. كما أنها، وبكل تأكيد، ليست تكتلات مقتصِرة على مواجهة بشار الأسد. فكل هذه الأشكال من التنظيمات داعمة للاستبداد، وعت ذلك أم لم تع، ولا يعوّل عليها في بناء دولة مواطنة تحمي البلاد السورية من أي خراب قادم، وتجعل من سورية وطناً فخراً لجميع السوريين.
* رئيس «تيار بناء الدولة» السوري
الحياة
ماذا لو بقي الأسد؟/ د. رياض نعسان أغا
من المسلمات أن بقاء الأسد يعني استمرار سيطرة إيران على سوريا ولبنان، فضلاً عن سيطرتها على العراق، ويعني انتصار المشروع الفارسي في المنطقة، وقادة إيران يعلنون مشروعهم منذ أن نجحت ثورتهم ووضعوا خطتهم لتصديرها، وهو يعني كذلك بقاء روسيا التي وقعت عقوداً طويلة المدى مع الحكومة السورية وأعلنت أنها باقية. ولعل السوريين يرون في روسيا أهون الضررين رغم أنها هي التي حمت النظام من السقوط كما صرح قادتها. إلا أن الروس سيبحثون عن مصالحهم وحدها في المستقبل، وليست لديهم إيديولوجيا يبشرون بها كما يفعل الإيرانيون الذين يحملون شعارات عقائدية يتوافق السوريون على رفضها بمختلف طوائفهم ومذاهبهم الدينية، وكان إعلانها من الأسباب التي دعت إلى ظهور شعارات دينية مواجهة، اختطفت شعارات الثورة في الحرية والكرامة والديموقراطية واتجهت لمواجهة المشروع الإيراني بخطاب ديني. وقد وقعت في الفخ الذي أراده النظام وخطط له بأن يجعل الثورة ذات صبغة إسلامية، وأن يحشوها بالتطرف والإرهاب فيحول القضية من صراع من أجل الحرية، إلى صراع مع تنظيمات إرهابية، ومع أن العالم كله يعرف حقيقة ما حدث فإنه وقع في ارتباك كبير بين استنكاره للعنف غير المسبوق الذي واجه به النظام شعبه، وبين قلقه من انتصار هذا الشعب، خشية عدم القدرة مستقبلياً على السيطرة عليه.
وعلى رغم أن المجتمع الدولي يقر بأن الأسد مجرم حرب وأنه ارتكب مجازر كبرى ضد الإنسانية، ولدى العديد من دول العالم ملفات قانونية ووثائق خطيرة لإدانته أمام محاكم دولية، ولعل آخرها تقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر أول أمس برقم A/HRC/36/55 والذي أكد على استخدام بشار الأسد لغاز السارين في الهجوم الذي وقع على مدينة خان شيخون بتاريخ 4 نيسان عام 2017، فإن بعض دول العالم بدأت تتراجع باستحياء عن فكرة رحيله مع بدء المرحلة الانتقالية. وقد أقنعها الروس بأن رحيل الأسد المفاجئ سيعني انهيار مؤسسات الدولة وانفراط عقد الجيش كما حدث في العراق، وسيفتح ساحات جديدة للصراع على السلطة كما حدث في ليبيا، وأن الأفضل هو الإبقاء على الأسد وتقليم مخالب النظام، بشكل تدريجي.
ولا أستبعد أن يكون الروس أنفسهم خائفين من ردة فعل الأسد على رغم أنهم أبلغوه أنه لا دور له في مستقبل سوريا كما رشح من معلومات، ولكنهم يخشون إذا ما انقلبوا عليه وطالبوه بالرحيل الفوري أن يفسد عليهم حضورهم في الساحل حيث ثروة الغاز والنفط الكبرى الواعدة. وهم يعلمون أن لدى الأسد ميليشيات قادرة على أن تعكر صفو روسيا بدعم إيراني، ولاسيما أن إيران التي دفعت دماء ومالاً لن تقبل أن تخرج صفر اليدين، وانتهاء حكم الأسد لا يعني خروجها من سوريا فقط، وإنما سيعني خروجها من لبنان ومن العراق أيضاً، وانتهاء تهديدها للمنطقة العربية.
ويبدو أن الروس حائرون، فلا هم قادرون على متابعة مشروعهم مع إيران التي ستبقى شريكاً محاصصاً في كل مقدرات المنطقة، بما سيعني تحالفاً استراتيجياً مديداً بين روسيا وإيران لن يرضى عنه الغرب طويلاً، ولا هم قادرون على التنكر لإيران والقبول باستبعادها وهي تملك قوة عسكرية على أرض سوريا، كما أنها تملك قدرة على نقل الإرهاب إلى روسيا إذا خرجت من حلفها.
وأنا واثق من أن الروس يعرفون أن الأسد لا يملك قدرة على ضمان الاستقرار في سوريا، وأنه من المستحيل أن يقبل السوريون بحكمه لهم ويداه تقطران من دمائهم، والأسد نفسه يعرف استحالة ذلك، ولهذا نجده يخشى عودة المهجرين السوريين ويشيد بما حدث من تجانس اجتماعي بعد رحيل خمسة عشر مليون سوري، وهم في الأكثرية الساحقة من أهل السنة. وقد عبر عن خشيته من عودة المهجرين والنازحين حين شدد على وصفهم في خطابه الأخير بأنهم حثالة، وحين بدأ النظام حملة تهديد لكل من يفكر بالعودة، وقد عبر عن موقفه عضو في القيادة القطرية لحزب «البعث» حين جعل تقبيل البوط العسكري شرطاً لقبول عودة المعارضين المهاجرين، بينما صعد أحد ضباط المخابرات الذي يكتب باسم مستعار وقال: «ستكون أمامهم المشانق»! والطريف قوله: «إن بلداً بلا مشانق جدير بأن يخان»! وهدف هذا التصعيد هو تحذير المهاجرين من خطر التفكير في العودة إلى سوريا، وقد حدث أن تذلل بعض الخارجين كثيراً في استجداء قبول العودة ولكن النظام رفضهم بإهانة معلنة، وأما الذين انضموا إلى اتفاقيات خفض التصعيد فهم يعيشون حالة من التوجس والحذر، وقد ضمنت لهم روسيا وليس النظام بقاءهم في أماكنهم.
والسؤال الأهم: هل تضمن الدول التي تدعو لبقاء الأسد أن تقبل أجهزة الأسد الأمنية بأن تخفض شيئاً من صلاحياتها، أو أن تبدل شيئاً من سلوكها؟ وهل تضمن الدول التي وقفت ضد النظام ألا ينتقم منها بعصاباته الإرهابية كما انتقم من شعبه الذي ثار عليه؟ ويبدو معيباً أن يقول أحد «لا بديل عن الأسد» فهذا يعني «لا بديل عن الديكتاتورية».
الاتحاد
حول أوهام الحل السلمي مع نظام الكيميائي والبراميل/ بكر صدقي
طرح الشاعر السوري منذر مصري، قبل أيام، فكرةً عن مبادرة لحل سياسي مفترض من شأنه أن ينهي المأساة السورية المفتوحة، واستبق ما يمكن أن تتلقاه فكرته من اعتراضات، صاغها بأسلوب يجعلها غير ذات أهمية، بالقياس إلى فكرته.
والحال أن فكرة المبادرة، كما طرحها شاعرنا الجميل، مفعمة بأحلام وردية بقدر امتلائها بالمغالطات. ولو لم يكن منذر مصري هو صاحب الفكرة، لربما كانت غير جديرة بالمناقشة.
ملخص ما طرحه مصري هو أن يتوجه وفد من خمسة عشر شخصاً من «شخصيات وطنية معروفة بينهم معارضون» ينتمون إلى مختلف أطر المعارضة في الخارج والداخل، إلى دمشق، على متن طائرة واحدة تحط في مطار دمشق الدولي، وتضع النظام أمام تحدي التفاوض معهم دون شروط مسبقة، وبلا أي جهات وسيطة، للوصول إلى حل سياسي «سوري ـ سوري» ينقذ البلد من الخراب.
ويقول مصري إن هذه المبادرة ستضع النظام أمام «مسؤوليته الوطنية» التي «لم يبطل يوماً إدعاءها»، وفي مواجهة سياسية مباشرة مع من دأب على إنكار وجودهم.
إلى أي حد يمكن أخذ فكرة مصري عن المبادرة على محمل الجد؟
لندع جانباً كيف يمكن تشكيل وفد من 15 شخصية وطنية «بينهم معارضون سياسيون». أي أن قسماً منهم فقط معارضون سياسيون، علماً بأنهم سيتشكلون، على افتراض مصري، من جميع الأطر المعارضة: الهيئة العليا للمفاوضات، والائتلاف الوطني، ومنصتا موسكو والقاهرة، وهيئة التنسيق، ومعارضات الداخل والخارج، وكل من يقبل بالمبادرة! فإذا تخلينا عن «كل من يقبل» هذه، واقتصرنا على ممثل واحد لكل من الأطر المذكورة، أصبح لدينا 6 أشخاص أو 7 معارضين سياسيين، من أصل 15، في حين أن البقية هم «شخصيات وطنية» لا نعرف ما هو معيار وطنيتها.
يعرف صديقنا الشاعر كيف انتهى ما سمي بـ»مؤتمر الحوار الوطني» الذي عقد برئاسة فاروق الشرع، في يوليو/ تموز 2011، وكيف تعاطى النظام مع المبادرة العربية، ثم مبادرة كوفي أنان الدولية، وبيان جنيف 2012، وهي على التسلسل سورية، ثم عربية، ثم دولية. وكيف اعتقل عبد العزيز الخير من مطار دمشق، وما زال مجهول المصير إلى اليوم، وهو الموصوف بالمعارض الوطني الداخلي. وكل ذلك في فترات كان فيها النظام في أضعف حالاته ميدانياً وسياسياً. فما الذي يمكن توقعه منه وهو يرى نفسه، هذه الأيام، في حالة «انتصار» بفضل حماته الروس والإيرانيين؟ على أي حال لم يترك لنا النظام فرصةً لطرح تكهنات بصدد مسالكه المتوقعة في المرحلة المقبلة. ففي خطابه أمام «مؤتمر وزارة الخارجية» كان رأس النظام واضحاً في رأيه بكل من عارض حكمه. لم ينكر وجودهم، كما يقول المصري، بل اعتبرهم مجرد عملاء وخونة يستحقون العقاب، وقد بلغ بهم «التلوث» مدىً لا يمكن معه إصلاحهم!
فما بال صديقنا الشاعر يريد للنظام أن «يفاوضهم». إن أقصى ما قد يطمح إليه أولئك «المعارضون العملاء» في نظر رأس النظام الكيماوي، هو أن يقبل هذا بإصلاحهم، ولن يقبل لأنهم غير قابلين، في رأيه، للإصلاح. وهنا لا يبقى من حل لمشكلتهم إلا الإبادة.
«المسؤولية الوطنية» أخي منذر؟ في نظر المعارضة لا يملك النظام أياً من تلك المسؤولية، بل هو نظام ارتهن لقوى أجنبية ورهن لها سوريا ومستقبلها بمعاهدات مجحفة (مع روسيا مثلاً) مقابل الإبقاء عليه في السلطة. أما في خطاب النظام، الذي تعكسه تصريحات مسؤوليه ووسائل إعلامه، فالمسؤولية الوطنية تقتضي إبادة المعارضة، مسلحة كانت أم سلمية، إسلامية أو علمانية، مع إبادة «الحواضن الشعبية للإرهاب» التي قدرها رأس النظام، في أحد خطاباته، بالملايين، وصولاً إلى «المجتمع المتجانس»، مجتمع العبيد والروبوتات المبرمجة.
فصديقنا الشاعر يعرف أن اللغة كانت إحدى أوائل شهيدات الصراع في سوريا. يستخدم النظام كلمات كالوطن والشعب والإسلام والمصالحات وغيرها بمعان مختلفة عما ألفه مستخدمو العربية. فمن قال إن المسؤولية الوطنية مفهوم قد يجتمع عليه النظام مع غيره، دع عنك المعارضة، بل مع مطلق غيره؟
واقع الحال هو أن المعارضة انساقت في مسارات تفاوضية عقيمة، في جنيف وآستانة، قدمت فيها تنازلات لا يمكن القبول بها، وتتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة لتقديم المزيد منها. وكل ذلك بلا أي نتيجة حتى على مستوى القضايا الإنسانية كإطلاق سراح مئات آلاف المعتقلين الذين يبادون بصورة منهجية، وتحرق جثثهم في أفران صنعت لهذه الغاية، أو إدخال الغذاء والدواء إلى المناطق المحاصرة تحت شعار «الجوع حتى الركوع» المكتوب على الجدران. بدلاً من ذلك يواصل النظام قصفه لمناطق مكتظة بالمدنيين، على رغم شمولها بالمخطط الروسي المسمى بـ»خفض التصعيد»، وتهجيره للسكان، وغيرها من الأعمال الموصوفة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في حين يفترض أي منطق سليم أن يقوم النظام بتقديم المبادرات والتنازلات، وليس المعارضة، ما دام يدعي تمثيله للدولة، والدولة تعريفاً كيان عمومي فوق التباينات والمصالح والصراعات الجزئية. ويمكن القول، بطريقة معكوسة، إنه ما دام النظام يمتنع عن تقديم مبادرات من أجل الحل، ولا يبدي أي استعداد لتقديم أدنى تنازل من أجل المصلحة العامة، فهو إذن لا يمثل الدولة، بل مجرد طرف في صراع داخلي، يتطلب التفاوض معه طرفاً ثالثاً وسيطاً، وتكون نتائجه انعكاساً لموازين القوى، وليس «المسؤولية الوطنية» أو ما شابه ذلك من كلمات بلا مضمون.
والحال أن النظام يقوم بمبادرات، بعيداً عن الإعلام: فهو يرسل أزلامه إلى إسطنبول وغيرها من منافي السوريين، لإقناع «معارضين» أفراد من ضعاف النفوس بالعودة إلى «حضن الوطن». حتى في هذه «المبادرات» الوسخة يرد النظام على استسلام أولئك الأفراد بالغدر، كحالة بسام الملك الذي أعلن التوبة ونيته بالعودة إلى حضن النظام. لكن هذا الأخير لم يقبل بتوبته، فاضطر للذهاب إلى مصر مع عاره.
ولماذا الإصرار على مطار دمشق الدولي، أخي منذر، في حين تنشط قاعدة حميميم الروسية في مفاوضات جارية على قدم وساق من أجل «حقن الدماء»؟ بينما المطار المذكور عاطل عن العمل منذ سنوات!!
٭ كاتب سوري
القدس العربي
سوريا: «موضوعية» التشفي في الضحية!/ مالك التريكي
كثرت التعليقات السياسية والإعلامية التي تتلذذ بتأنيب بعض الأطراف السورية والعربية التي يبدو أنها لماّ تفهم بعد أن “نظام الأسد قد انتصر” في الحرب الأهلية. تعليقات تتدرع بالواقعية وتتذرع بالموضوعية لتبرير الواقع الهمجي اللاإنساني ولشرعنة القوة باعتبارها هي عين الحق (حسب التعبير الانكليزي الشهير)، بل ولإعلاء القوة فوق الحق. تعليقات محيرة لأن فيها من الالتباس الشديد ما يجعل من الصعب على القارىء أو السامع أن يميز فيها بين ما هو تقرير لواقع وبين ما هو احتفاء بهذا الواقع وانتشاء بذاك “النصر”. تعليقات ربما تطمح أن تكون واقعية أو موضوعية، ولكنها لا تحسن كتمان نزعتها الانتصارية!
صحيح أن المؤرخ الإغريقي ثوسيديدس، الذي مهد لنظرية “حالة الطبيعة” في العلاقات الدولية وكان مدشن المدرسة الواقعية في فهم الحروب والنزاعات، قد قال في سياق روايته لوقائع حرب البيلوبونيز بين أثينا واسبرطة في الثلث الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد: «نعرف وتعرفون، باعتبارنا أناسا عمليين، أن مسألة العدالة لا تثار إلا بين أطراف متكافئين في القوة، وأن الأقوياء يفعلون ما في وسعهم وأن الضعفاء يتكبدون ما لا منجى لهم منه». ولكن ذلك لم يكن انتصارا من ثوسيديدس للأقوياء ولا تشفيا في الضعفاء، مثلما هو حال المعلقين المصفقين لبطولات الأسد في غابة الحرب الأهلية التي أجج أوارها عدم الاكتراث الغربي وكثافة التدخل الإقليمي. بل إن المؤرخ الإغريقي الذي بحث كل الأسباب الممكنة لحرب البيلوبونيز قد تحلى بنزاهة فكرية مدهشة عندما عدّ النزعة الامبريالية التي تمكنت من دولة أثينا هي السبب الأصلي، أو «السبب الأكثر حقيقيّة» حسب تعبيره، لاندلاع النزاع الذي دام حوالي ثلاثة عقود.
أما تعليقات المدرسة الواقعية بشأن سوريا فإنها تمتد على طيف سياسي وإعلامي واسع يبدأ بستيفان دي ميستورا، الذي عرفناه جنتلمان دمثا وبالغ اللطف على المستوى الشخصي، ولا ينتهي بروبرت فيسك الذي حجبت عنه أحداث الثورات الشعبية العربية وما ارتبط بها من حروب أهلية كثيرا من الحقائق فأفقدته ما كان يتميز به طيلة عقود من وضوح الرؤية وصواب الرأي وانحياز للمظلومين. والغريب أن فيسك يعتبر أن انتصار نظام الأسد، بفضل إصرار روسيا على إنقاذ زبونها، هو فضح لمواقف ساسة الدول الغربية من أوباما إلى كامرون وهولاند بلوغا إلى تيريزا ماي، بل وحتى ترامب. وما يوحي به هذا القول هو أن القادة الغربيين قد كانوا جادين فعلا في دعم الثورة السورية وثابتين على المطالبة بوجوب تنحي رأس النظام. ولكن هذا ليس صحيحا. بل إن ما حصل هو العكس، حيث أن الدول الغربية، بقيادة أمريكا، ماطلت وتلكأت وبالغت في التسويف ولم تقدم للمعارضة الديمقراطية دعما يعتدّ به ميدانيا. وتضافر في هذا الموقف الغربي عاملان على الأقل: إحجام أوباما عن إقحام قوات بلاده في أي نزاع، واعتقاد الدوائر الغربية أن النظام منهزم آيل للسقوط لا محالة.
المحاولة الوحيدة لتقديم دعم عسكري عملي للثورة السورية أتت من حكومة كامرون، ولكن مجلس العموم امتنع عن إجازة مشروع قرار التدخل العسكري في سوريا لأن كابوس المشاركة في العدوان على العراق لا يزال يؤرق بريطانيا نخبة وجمهورا. ولهذا فالقول بأن انتصار النظام هو انتصار على السياسة الغربية تجاه سوريا فيه جنوح بعيد عن الصواب. بل على العكس: فقد انتهجت الدول الغربية سياسة اللامبالاة وترك الوضع يتعفن، أي أنه لم يكن لديها سياسة. أما سياسة روسيا فقد تمثلت في العمل الجاد على منع تكرر السيناريو الليبي في سوريا، بزعم أن العواصم الغربية خدعتها بشأن نواياها الحقيقية في ليبيا عام 2011. وبهذا المعنى، فإن نظام الأسد ليس مدينا ببقائه إلا لنظام القذافي..!
أما قمة الاستهتار فإنها تتمثل في أن نظام آل الأسد قد أصبح يستعد الآن للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار (!)، كما كتب الباحث جان بيار فيليو أخيرا. منطق سوريالي أساسه أن النظام لم يكن لديه أي يد في الخراب الذي حاق بسوريا طيلة الأعوام الماضية. خراب قدره البنك الدولي بما لا يقل عن أربعة أمثال الدخل الوطني السوري عام 2010: دمار تام لمؤسسات التعليم والصحة في كل مكان، ودمار كلي أو جزئي لحوالي ربع المساكن في حمص وحوالي ثلث المساكن في حلب، إضافة لوقوع ثلثي الشعب السوري فريسة للفقر المدقق.
٭ كاتب تونسي
القدس العربي
قبول إسرائيل وبقاء الأسد/ ماجد الشيخ
المقاربة الاستشراقية في موسم التسويات السياسية والمراهنات الإقليمية والدولية على بقاء المصالح الخاصة بكل طرف الحاكم الفعلي للتحولات والتطورات القائمة والمحتملة، تبدو المقاربة الراهنة في سورية تتجه لبقاء الأسد «سيدا» ولو من دون «سيادة» للسلطة التي يجري إحلالها محل الدولة، بدعم مزدوج من روسيا وإيران والميليشيات الطائفية المختلفة.
هذا هو «طريق التسوية» السورية الذي خططت له دوائر استراتيجيات النفوذ الذي فازت به روسيا ونجحت في رسم مآلاته النهائية، منذ بدء دخولها على خط الأزمة السورية، بالترافق مع العمل على استعادة النفوذ الروسي في منطقة اعتبرت تقليدياً أبرز «مغانم» هيمنتها منذ أيام الحرب الباردة، وصراعاتها على النفوذ الإقليمي والدولي، وها هي تؤكد في سورية، ما لم تستطع أن تؤكده في الصراع العربي مع إسرائيل، حيث بقيت تمسك بالعصا من الوسط، من دون انحيازها المعلن لدعم الطرف الفلسطيني، ما أبقى التسوية على الجبهة الفلسطينية– الإسرائيلية مجردة من عناصر أي قوة تصطف إلى جانب الحق الفلسطيني، لا عربية ولا إقليمية ولا دولية، الأمر الذي قاد الوضع الفلسطيني إلى مزيد من التفتيت والإضعاف، وبالتالي الإجحاف بحق نفسه وبحق قضايا المفاوضات المتروكة على قارعة تسوية لم تتم ولن تتم في هكذا شروط، عمادها التفكيك والتفتيت، وحتى التشكيك في ما بين أطراف الصف الوطني المختلفة.
في المقابل، يبدو أن المقاربة الكولونيالية، لا تختلف في رؤيتها لمصالحها الاستعمارية إزاء إسرائيل ودورها الوظيفي في هذه المنطقة، بخاصة في ظل وجود إدارة أميركية ترى في وجود إسرائيل «ظلها العالي» الذي لا تقبل بأي تأثيرات تعمل لحجبه من أجندات ووقائع السلوك الاستعماري، وهو يتجه نحو شعبوية عنصرية باتت تؤكد عبر مسلكياتها الفاشية، وكأنها تخوض حربها «الهارمجدونية» وفق خرافات التدين الخلاصي الأكثر اسطورية وكولونيالية في عصرنا الحديث.
في ظل هذه الأجواء واضطرابها السياسي والأمني، واتفاق جميع الأطراف المعنية بأزمات المنطقة، لم تعد دول الغرب في صدد التأكيد على رحيل بشار الأسد عن السلطة، وهي تشهد تحولات في مواقفها الرسمية وخضوعها لمنطق ابتزاز النظم الاستبدادية التي عملت وبإجهاد على تصوير ذاتها وكأنها تواجه الإرهاب إلى جانب القوى التي تحاربه فيما هي من صنائعه، وفي هذا السياق لفتت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها إلى أن الجو السياسي العام السائد في الدول الغربية المعنيّة بالأزمة السورية، يؤشر إلى «التخلي عن موقفها ومطلبها الدائم بتنحي بشار الأسد»، وتحولها إلى موقف «يقبل حتى بترشح الأسد في أي انتخابات رئاسية مستقبلاً». وكما عبر مصدر دبلوماسي غربي، فإن هذه التحولات في الموقف «تعكس رؤية براغماتية واقعية، إذ إن مسألة بقاء الأسد في السلطة، لم تعد مقدمة لأي محادثات».
فهل تعب الغربيون قبل أن يتعب وينهك نظام الأسد، بفعل الدعم الروسي والإيراني؟ ومن يحاسب هذا النظام على جرائمه التي ارتكبت على الأقل منذ عام 2011، أم أن عالم العولمة الراهن والأنظمة الشعبوية العدمية، وهي تقبل «التساهل» مع جرائم الحرب، و «التسامح» مع أنظمة الاستبداد، لم تعد أكثر مسؤولية وجدّة في ما يترتب عليها من مسؤوليات البحث عن العدالة والمساواة، والانتصار لقيم الحقوق الطبيعية والمكتسبة، ومعاقبة إرهاب الاستبداد السياسي الحاكم، إلى جانب تصفية عصابات الارهاب الإجرامية كداعش والنصرة القاعدية وإضرابهما، سواء بسواء؟
وإذا كان هناك من ضرورة لتسوية سياسية، باتت تقتضيها الأزمة السورية، فهذا بالتأكيد ما لا يبرر على الإطلاق، عودة إطلاق يد النظام الأمني، في ظل تغييب السياسة واستبعادها عن كامل أجندات التسوية، وإعادة فرض سلطة نظام، لا تمت بأدنى صلة للدولة ومنطقها، فالهم الروسي للحفاظ على الدولة، لا يبرره ابتلاعها سياسياً وعسكرياً من قبلهم، كما ومن قبل النظام الإيراني وميليشياته، فالسيادة الوطنية لا تقوم على القبول الخارجي من دون القبول الداخلي ودعمه وطنياً، لا طائفياً أو مذهبياً، والاستمرار في لعبة التحولات الديموغرافية وهوياتها القاتلة.
* كاتب فلسطيني
الحياة