مارلين هاكر: أحببتُ رجلاً… أحببتُ امرأةً
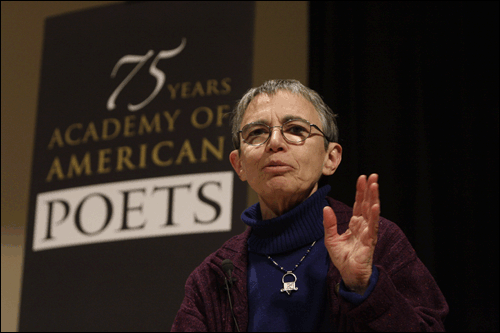
كتابة وترجمة: جولان حاجي
لماذا قُطعت تذكرة الطائرة من عمّان إلى الدار البيضاء عبر الدوحة؟ لم أطرح هذا السؤال على المنظمين في معرض الدار البيضاء للكتاب شتاء 2012. لم أكن أعرف منهم أحداً. أمرضتني الرحلة الطويلة وأمضيتُ الليلة وحدي، محموماً طريح السرير في فندق رياض السلام.
صباح اليوم التالي، بالصفاء الذي يُنعم به على الناقهين أحياناً، صادفتُ مارلين هاكر تعبر البهو الظليل، بخطى خفيفة تصعد درجاً صغيراً، على ظهرها حقيبة خفيفة، مستعدة للذهاب وحدها إلى نزهة على شاطئ الأطلسي. كانت في اليوم السابق قد تسلّمتْ جائزة الأركانة الشعرية. عرّفتها بنفسي، وتذكّرنا صديقنا الشاعر الإنكليزي جيمس بيرن الذي أخبرني عن رغبتها بزيارة دمشق في شتاء 2011. القنصلية السورية في باريس لم تمنحها التأشيرة.
كانت مارلين قد شرعت آنذاك بتعلم اللغة العربية ودراستها، مبتدئة ترجماتِها بقصص زكريا تامر. تنصتُ وتدقّق، متحمّسة في هدوء، متأهبة للكلمات الجديدة المتمنّعة، وتنقل النصوص أحياناً من العربية إلى الفرنسية، ثم تترجم الترجمة إلى الإنكليزية.
كنت أقرأ ديوانها “أسماء”، وعلى صفحة عنوانه إهداء خطّته يدها اليسرى بالعربية، أثناء الوقوف الطويل تحت شمس تموز، منتظراً انفتاح بوابة السفارة الفرنسية في عمّان لتقديم طلب التأشيرة.
حين التقينا تلك السنة، في باريس حيث تقيم منذ سنين، كانت قد انتهت للتو من امتحان اللغة العربية في إينالكو (المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية).
غزيرةٌ ترجمات مارلين هاكر، وأسفارها كثيرة. درست الأدب الفرنسي في جامعة نيويورك، مسقط رأسها حيث ولدت ابنة وحيدة لأبوين مهاجرين يهوديين من الطبقة العاملة كان كلٌّ منهما أول الملتحقين بالجامعة في عائلته. أدارت تحرير مجلة كينيون ريفيو حيث نشرت للعديد من الكتاب الأمريكيين السود، ولم تنقطع عن ترجمة الشعر الفرنسي، كمثل الشعراء الفرانكوفونيين هادي قدور وفينوس خوري غاتا ورشيدة مدني وحبيب تنغور وإيمانويل موزس.
تحبّ مارلين مكتبات باريس، وتحب سماع الشعر يُلقَى أمام الناس. مطلع السبعينيات، عملتْ في مكتبة للكتب القديمة في لندن حيث عاشت أعواماً، وأثناء إقامتها هناك فازت بجائزة الكتاب الوطني الأميركية سنة 1974. أعددنا مختارات من الأدب السوري لمجلة “سِيَكل 21” الفرنسية، ولم أكرر مثل تلك المحاولة في مناسبات أخرى لأنها عادت عليّ بسوء فهمٍ من أصدقاء سوريين كنتُ في غنى عنه. واعدت مارلين في محطة مترو باريسية، ليسهل على كلينا الذهاب معاً إلى لقاء محرري المجلة ذات مساء تساقط فيه ثلج خفيف، مطلع كانون الثاني. كنا ننتظر على رصيفين متقابلين في المحطة نفسها، ولم يرَ أحدنا الآخر. لم تكن مارلين تستخدم هاتفاً نقالاً. تأخر وصولي، لكني استدركتُ ما فاتني، وإن كان اللقاء قد شارف على الانتهاء، وسررت بسماعهم يتحدثون عن شعراء فنلنديين لا أعرف عنهم شيئاً. بعد أن قام المضيفون بتقطيع قالب “حلوى الملوك” وتزيين أطباقنا، ظهرت دمية الملك المتوارية في حصة مارلين، وتوِّجت بتاجٍ من ورق مقصَّب.
تموز الماضي، ترجمتُ قصائدها، المنشورة هنا، حين جمعنا ملتقى نظمته جمعية “تماس” الثقافية، ليترجم عدد من الشعراء بعضهم بعضاً. كنا نلتقي في سخونة القاعات في مبنى ريد هول، في مونبارناس، أو نلوذ بأفياء المقاهي، والمدينة بأكملها مخدّرة بموجة الحر. كتبت مارلين الغزليات الثلاث بعد رحلة إلى تركيا، جمعتنا مع كتاب آخرين في قونية ربيع 2013. أما كتابها “دياسبو/رِنغا” المشترك مع الشاعرة الفلسطينية-الأميركية ديمة الشهابي، فقد بدأتْ بكتابته، على منوال قصائد الرنغا اليابانية، بعد مراسلاتٍ بينهما إثر الحرب الإسرائيلية على غزة 2008- 2009.
شعر مارلين هاكر مسكونٌ بحوار دائم: محاورة الموتى والأحياء، محاورة شعراء وكتاب آخرين من أخماتوفا وجوزف روث إلى كاتب ياسين ومحمود درويش؛ شعرها يدور داخل تاريخ العالم، يحاور الماضي والحاضر، ويتأمل الخسارات والصداقات والمخاوف والرغبات بل حتى شعرها نفسه وقراءاتها، هذا الشعر المتميز بالمراوحة بين جريان الحياة اليوميّة بشوارعها ومقاهيها وناسها ولذّاتها وبين المتسامي والإنساني في أرحب معانيه، حيث يتجاور السياسي والشخصي الحميم في تجلياتهما المختلفة، في تلك المسافة بين العجز والغضب أو بين الحبّ واليأس، تلك المسافة بين مَن يعيش المأساة ومَن يسمعها أو يراها. اللغة حية، وهي -كالناس والبيوت- لا تنجو من الكوارث. لم أقصد بصفة “السياسي” الكلمة التي ترفّع عن استخدامها شعراء كثيرون في مختلف الثقافات، وإنما عذابات العالم وجماله وآلامه التي لا تنتهي، الاستضاءة بجرح الإنسان والاستنارة بالرفض. كتابات مارلين تصبُّ في ذاك النهر الكبير الذي رفده بالأسئلة شعراء مختلفون كلٌّ بطريقته، من أودن ولويس ماكنيس إلى مورييل ريوكايزر وأدريين ريتش، حيث نقع في تلك التجارب الكبرى على ما تتّسع به الحياة، ابتداءً بالحريات الشخصية واحتفائهم بما لا يشبههم وليس انتهاء بمناهضة الحروب التي تستشري والعنصرية وعبادات الموت وكراهية اللاجئين.
تجربة مارلين، بسعة ثقافتها وتعدد مشاربها ومراحلها، انسكبت في أشكال شعرية بالغة التنوع قد لا يستخدمها شعراء كثيرون، من السونيت والبانتُوم إلى الفيوغ والسيستينا والفيلانيل والغزلية. ولعلّ البراعة التي تستخدم بها مارلين هذه الأشكال سهّلت عليها أن تكتب معارضة إنكليزية للزوميات المعري في كتابها الأخير “مرآة الغريبة”. موسيقى الشعر، على صرامتها، تستوعب الراهن المستجدّ، والقصيدة هنا لسان الجسد ووعيه، جسد المرأة-الكاتبة التي تسكن فضاء مدينياً وتتنقل فيه مثلما تتنقل داخل ذاكرتها. كتبت مارلين قصائد إيروتيكية مثليّة في “الحب والموت وتقلبات الفصول”، وروتْ في “أرقام الشتاء” ما عاشته عند إصابتها بسرطان الثدي الذي شُفيت منه. تجوب أصواتُ شعرها المتعددة ممراتٍ تفضي إلى “ساحات وأفنية”، داخل لغاتٍ تنفتح على لغات؛ المترحّلة بين الألسن والأمكنة، كتبت عن الشاعر جيمس رايت في “العودة إلى النهر”: “عرفتَ الكثير عن المطارات والأنهار، /وفتاة رحلتْ في أكتوبر. /الآباء والإخوة والأخوات يموتون بالسرطان. / لكننا لا نزال غريبَين».
■ ■ ■
قصائد مختارة
■ ثلاث غزليات
وراء الباب
(إلى فرخونده وبينا)
قد يُسمَعُ ضحكٌ، موسيقى، أصواتٌ تغنّي أشعاراً وراء الباب.
الفتاةُ الصغيرة تستظهرُ كلَّ كلمةٍ وراء الباب.
نورٌ في بئرِ السلم، يُرى عبر العينِ السحرية:
أذاك زائرٌ تُقْتِ إليه أم خشيتِه وراء الباب؟
الدبلوماسيُّ بولوجهِ مكتبَ القائد
ينسى القبطيَّ، الشيوعيَّ، الكرديَّ وراء الباب.
ساعاتٍ طوالاً في ضوءِ المصباح يتمرّنُ على سلالمِ الموسيقى،
في طباقٍ مع صولفيج عصفورٍ وراء الباب.
المجدُ للقائد، الولاءُ حتى الموت!
لعنةٌ أخرى تُهْمَسُ وراء الباب.
الحبيبةُ الأولى غادرتْ، الثانيةُ تحزمُ حقائبها.
أتلك خطواتُ ثالثتِهنّ القلقةُ وراء الباب؟
النفْسُ مرآةٌ، كامدةُ البريق،
لكن لاحظوا كيف تغيمُ الألوان وراء الباب.
غاسلةُ ثيابِ الثوريّين التي لا اسمَ لها
تتساءلُ: “ماذا يجري لحلمٍ تأجّلَ؟” وراء الباب.
في الريح
(إلى سُميّة)
نُواحُ الناي المنفيِّ معلَّقاً هناك في الريح
يترجِمُ لغةً يمكننا اقتسامُها في الريح.
كلماتُ الشاعر، كساها الخطّاطون ذهباً
ولازوردَ، تنساب لينةً، سُوداً وجُرداً في الريح.
الفقهاءُ والسيّاحُ والحجّاج
يحتشدون قدّام المزار، ثم يخْطُون خارجين ويحدّقون في الريح.
لا فسحةَ وراء الألواحِ الخشبيةِ الفاصلة.
خرجتْ سائرةً إلى الحقل، ركعتْ وقالت صلاتَها في الريح.
وحيدةً، حلّتْ خمارَها تحت شجرةِ ليمون،
انحدرتْ على دربِ الماعز بشعرِها المضفورِ في الريح.
أفهمتِ أنْ سيكون هناك سلامٌ مع العَدْل؟
أيُّ صوتٍ أعْلَمكِ أن التاريخَ مُنصِفٌ في الريح؟
ثعلبٌ حُذِفَ من قصيدةٍ أخرى
ربضَ بالقرب من مدخلِ وَكْرهِ في الريح.
ما كلُّ هذا الهَذرِ الاستشراقيّ؟
معجمٌ واسع يُسْمَعُ بالخطأ، أين؟ في الريح.
تحوكُ الحكواتيّةُ حكايةً أخرى،
ثوباً بوسعِ مسافرٍ ارتداؤهُ في الريح.
امرأة
عبْر النهر، في البستانِ على التلّ، امرأة
قالتْ، حفنةٌ من ترابٍ أحمر أحياناً قد تُشبِعُ امرأة.
ناطقةً تبقى، وإن صمتَتْ؛
تبقى، وإن لا مرئيةً، امرأة.
أحببتُ رجلاً، أحببتُ مدينةً، أحببتُ لغة.
أحببتُ، واستخلِصْ ما شئتَ، امرأة.
ما تكلّمَ أحدٌ ضد قانونٍ يحظرُ الكلام،
ريثما تلميذٌ، ريثما راهبٌ، ريثما امرأة…
مَنْ خطرَ له أنهم قد يتردَّدون في قتلِ طفل؟
مَنْ خطرَ له أنهم قد يتردّدون في قتلِ امرأة؟
ريتّا تتنكّبُ بندقيتَها أمام المرآة.
ثمة أكثرُ من طريقةٍ واحدة ليُثيرَ زيٌّ موحَّدٌ امرأة.
الحكواتيةُ التي تكتبُ الكلماتِ وتشطبُها
بشعرٍ شائب وبلا ثديين لا تزالُ امرأة.
■ ■ ■
■ ثلاث قصائد من كتاب «دياسبو/ رِنغا»
1
الليلُ والخيلُ والبيداءُ تعرفني…
وهذا الشارعُ الضيّقُ
حيث يهمي مطرٌ خفيفٌ قبل الفجر
والطفلةُ في الغرفةِ المجاورة
تسعلُ في نومِها،
النافذةُ في نوفمبر مفتوحةٌ
قليلاً، قلمُ “البِيك”،
والريحُ التي تتسلّلُ
بأصابعَ ملحاحةٍ قارسة.
2
الكلابُ في شارعِ الميناء
تتعاركُ على رأسِ سمكة،
فاكهةٌ تالفة- بمستطاعهِ أن يشمَّ
قشورَ البرتقالِ المتروكة
التي رماها الحرّاسُ إلى الأطفالِ المنفيّين.
كان في السادسة عشرة آنذاك،
مدرِّساً، لا كلباً ولا طفلاً.
تعلّمَ الآخرون القراءةَ
من كتابِ القواعد المبقَّعِ بالشاي
الذي تخطّفه هو أولاً عندما هربوا.
3
“صباح الورد”،
تتمنّى للبقّال.
“صباح النور”، يُجيبها.
نضجتْ أولى حبّاتِ الكرز،
وحبّات الفريز الصغيرة الحلوة.
عادتْ إلى البيت الأسبوعَ الفائت.
بدتِ السماءُ أوسَعَ وأسطعَ
على الرغم مما تفتقده.
ذاك القطُّ السائبُ شقيقٌ،
مطرُ الفجرِ صديقُ طفولة.
■ ■ ■
■ فيوغ على بيتٍ لعمرو بن معد يكرب
ذهبَ الذين أحبُّهم
وبقيتُ مثل السيفِ وحدي.
ذهبوا، أجل، أو يذهبون، في عَزمِهم على
الذهابِ عِنادٌ يُتلِفُ النفس.
أيُّ لحنٍ سيرِنُّ بحضورِه
إذا عزفْتِ على ذاتِ الوترِ القديم – تأمُّلِ النفسِ وحدَه؟
مَن كتبتْ “لن أضيّعكِ مرة أخرى”
انتقلَتْ، ما بعثَتْ رسالةً بعنوانٍ جديد
وفي تلك الذكرى ثمة جبلٌ،
فوقه كان باشقٌ أصهبُ ينقضُّ ويحومُ وحدَه.
مَن أمسكَ سيفاً وقالَ إنه مثلُه،
ما كان في وَحشتهِ إلا سيفاً.
بين الشيخِ والملاكِ الفولاذيّ،
طبيبٌ مُقيمٌ مُتْعبٌ حتى العياء يتدبّرُ جناحَ المرضى وحدَه.
جذرُ الكلمةِ هناك، وأنتِ تتملّين إيقاعَ
الغصونِ وبحوراً لا يسعُكِ إلا تخمينُها.
الترجمةُ عن لغةٍ بطيئةِ البزوغ
أشبهُ بالمحاوَرة، وأنا أقلُّ ضجراً، وحدي.
لكنها نصلٌ ذو حدّين يجعلُ منكِ
سلاحاً ويقلِّبُكِ على مُصابِك.
صامتةً وسط خدَمِها، بلقيسُ عادتْ
أدراجَها إلى مملكتِها وحمدتِ الربَّ وحدها.
وإذا سألَ المُحِبُّ، ماذا تشتهين منّي؟
فدونما سؤالٍ منّي، سيجيبُ “بلى”.
قدحَ النبيذ الذي لم يُقدَّمْ للغريب،
القدحَ الثاني من نبيذِ الليل الذي سكبتُهُ وحدي.
كلمات
العدد ٢٨٧٦ السبت ٣٠ نيسان ٢٠١٦
(ملحق كلمات) العدد ٢٨٧٦ السبت ٣٠ نيسان ٢٠١٦


