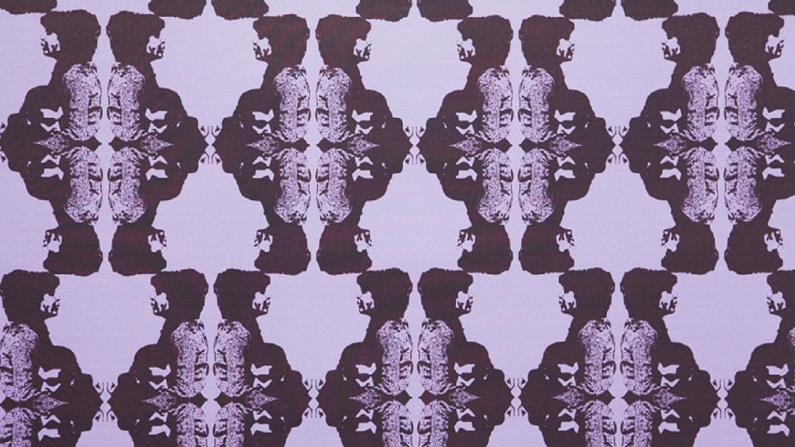محمّدْ الشّرْﯕـي: مقاطع الدّفتر الليلي

رشيد وحتي
إنْ تَوَجَّب، عبر جدليّة مُخَاتِلَةٍ، أنْ يكون في النص — مُخرّب كلّ ذاتٍ — ذات ينبغي الوقوع في حبّها، فإنّها ذاتٌ مبعْثرةٌ، فيما يشْبه قليلاً الرّماد الذي تُذَرّيه الرياح بعد الموت (إزاء موضوعتي حُقِّ الرّماد والمسلّة التّذْكاريّة، باعْتبارهما جسمين قويّين، مغْلقين، مَعْلَمَينِ لِلْقَدَر، يمْكننا وضْع شظايا الذّكْرى، التّآكل الّذي لا يتْرك من الْحياة الْـماضية إلّا بضع ثنياتٍ): لو كنْت كاتباً وميّتاً، كمْ سأحبّ أن تخْتزل حياتي، بعناية كاتب سيرة ودود ومرح، في بضعة أذواقٍ، بضعة نزوعات، لنقل بضع «تفصيلاتٍ سيريّة» biographèmes، سيكون لفرادتها وحركيّتها أن تسافرا خارج كلّ قدرٍ وأنْ تأتيا لتلامسا، على طريقة ذرّات أبيقور، جسداً مسْتقْبليّاً ما، منْذوراً لنفس البعثرة. حياة مثْقوبة، في مجملها، مثلما أدرك بروست كيف يكتب حياته في مؤلّفاته. (رولان بارت: «ساد، فوريي، لويولا»، ضمن الأعمال الكاملة، المجلد 3، منشورات سوي، 1980، ص. 1405، ترجمة: ر.و.)
يعرف محمد الشرﯕـي كيف يلتقط لُهُبَ التفصيلة السيرية حدثاً وشكلاً. هو القادم من تكوين فلسفي رصين، أكاديمياً وقراءاتٍ شخصية؛ صائغ السرد في نثر فني متفرد (انظر مفتتح يَتِيمَتِهِ الروائية في هذا الملف)؛ القادم من مُثَاقَفَةِ الصنعة الترجمية.
المقاطع النثرية، ها هنا، توازي، في كثافتها، جهد الفنان التشكيلي في التركيز على تفصيلة من قماشته دون بقيّتها، وهو ما يكشف عن عمق آخر للكاتب، عن غنى بصري لنصوصه: ذائقته التشكيلية التي تبدو حتى في المادة البصرية التي يختارها لمصاحبة تدويناته شبه اليومية على صفحته الشخصية في الفضاء الأزرق. يصير، هنا، «الشعر رسماً ناطقاً، والرسم شعراً صامتاً» [هوراسيوس].
الحدث، في الغالب الأعمّ من هذه النصوص، حالةُ وَجْدٍ (وفق التعبير الصوفي، وهو أيضاً من بين المرجعيات الكبرى التي يستند إليها الشرﯕـي). أما من ناحية المادة اللغوية التي توسّلها الكاتب، فقد سار فيها على درب الخيار الأصعب ــ مهما ناوشتْه بعض الشعريات العربية ــ من خلال الاستناد إلى معجم رمزيّ مركّز (وهو الخيار نفسه الذي تم لوْم راسين عليه، في المفاضلة بينه وبين كورْنيّ) يشْتغل على معمار الفقرة الفريدة.
أخضعنا ترتيب النصوص لضرورات فنية، بعيداً عن منطق التعاقب الزمني والعمودي. الأواصر بين الْحَيَوَاتِ المتوهجة أفقية.
■ أودية فريد الدين العطار السّبعة
لا ينفكّ كتاب «منطق الطّير» لفريد الدّين العطّار يشع بقوّة روحانية معينة للسالكين دروب البحث عن النّور. هو من الأساسات الارتكازية لعالم الرّوح الشّاسع. وهو، مثل الفتوحات المكّية لمحيي الدين بن عربي، ومثنّوي جلال الدين الرّومي، خارطة طريق كلّ مسافرة ومسافر في اللّيل الكبير. خارطة مجازية تخترق سماءها طيور الزّمن الدّنيوي الباحثة عن السيمرغ، الطائر البهيّ الأسْمى، فتقطع في رحلتها الشاقّة سبعة أودية، كلّ واد منْها بمثابة اختبار لا بدّ من اجتيازه لاستحقاق الوادي الذي يليه. وهذه الأودية العميقة، الزّاخرة بالابتلاء الجسماني والروحاني، هي على التوالي: وادي الطّلب، ووادي العشق، ووادي المعرفة، ووادي الاستغناء، ووادي التوحيد، ووادي الفقر، ووادي الفناء المكتمل بالفناء في المحبوب الإلهي.
■ في ليلتنا العربية الظّلماء يُفْتَقَدُ بدر شاكر السّياب
«… وفي اللّيْلة الظّلماء يفْتقد البدْر» [أبو فراس الحمداني]. وفي هذه اللّيْلة العربيّة الظّلماء، يفْتقد بدر شاكر السيّاب. هو الذي افتقد زمناً فهيماً لنبوغه ورحيماً بهشاشته العضْويّة ملأ بذهب حروفه مناجم الزّمن. كان جسده نحيلاً جدّاً، لكنْ كانت وتبْقى بابل كلّها في نظْرته، والقوّة الخصيبة لما بيْن النّهريْن في روحه. كأنّه انزلق عبر سلالم العصور من أرض سومر العالية، ليقف مشدوهاً ومرتاعاً في عراق كان قد بدأ منذئذ مخاضه التاريخي العسير والوخيم، وفي خليج كان منذوراً للانحدار إلى قيامة مستقبله… بين الكتابة والانخراط السياسي في الحزب الشيوعي وآلام المرض والحاجة، عاش غريباً ثلاث مرّات متزامنة: في جسده وفي العراق وفي الخليج. ولو طال به عمره الأرضيّ، لأدرك أنّ العراق الكونيّ نفسه صار غريباً في عراق الدّمار المجنون، وأنّ خليج الأناشيد والعزّة القديمة وصحارى الشّعراء صار غريباً ومطْموراً ومتنائياً في خليج النّفْط والدّم وممالك الثّراء الوقح والسّيوف المسلولة بجوار ناطحات السّحاب. في شتاء 1964، عاد مسجّى في تابوته — مهده الجديد — لينام أسفل جيكور، قرْية ميلاده الأول، التي يعني اسمها بالفارسيّة: الجدول الأعلى، وقد كانت، تماماً مثْل إيثاكا بالنّسْبة لعوليس، هي موئل رحلته الرّمزية الشاسعة، والقاع الزمني الذي ظلّ يشعّ منه الحلم المكابر لتمّوز، وعشتار، والنّخيل السّماوي، والخصب المقدّس، والروح الثائرة المطاولة لقامات القدر. لكنّه، ككل الشعراء الذين يحمون أساسات العالم ما وراء جدليّة الحياة والموت، لم يأْو إلى قبره المسهّد إلّا لكي يغادره على صهوة حروفه السّحيقة لاستئناف تطوافه اللانهائي في زمن الأرض، مانحاً وهجاً ملْحميّاً غير مسبوق للجغرافيات والرّموز والوقائع التي رفعها إلى مرتبة نشيد أنشاد تحالفت فيه الرّفعة الاحتفاليّة بالانكسار التراجيدي، مغْدقاً فيضه المستهام على نهر بُوَيْب، ووجه غيلان، وشموخ الجزائريّة جميلة بوحيرد، وعرس المطر الكونيّ، وانْبعاث الأزهار والأساطير، وهيْبة المومس العمياء، وزحف مدائن السّندباد المقْفرة، وحالماً، كما رامبو الذي كانت حصّته من العمر معادلة لحصّته، بنهاية الطّغاة على الأرض، وبميلاد الشّعْب منْ جديد، دون أن يدور بخلده، ولا بخلد أمير المركب السّكران قبله، أنّ الأرض والشعب هما اللذان ينتهيان الآن بعدما أفْلح الطّغاة في اختطافهما وارتهانهما، وأنّ الشّعر ازدادت جسامة مهمّته واسْتِعْجَالِيَتها لاسْترداد المجالات والحيوات والذّاكرات وطقوس الحبّ وأعياد الخصْب التمّوزيّة.
■ سركون بولص المطلّ علينا من فوق أسوار مدينة «أين»
في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، زار المغرب الشاعر العراقي الراحل سركون بولص، وأتيح لنا، بتدبير فاره من قوّة سومرية عطوفة، أن نلتقي ببيت الشاعر محمد بنيس في المحمدية. يحضرني، كما لو كان أمس فحسب، ابتهاج سركون وهو يعانقني ويخبرني، فوراً، بعفويته الفيّاضة، بإعجابه برواية «العشاء السفلي» التي قرأها في لندن في منتصف سفرٍ كان قد قام به، قبل لقائنا بحوالي شهرين، من مهجره الأميركي بسان فرانسيسكو لزيارة ما تبقى من أهله في عراقٍ كان قد فقد بوصلته في رمال الشرق الأوسط المتحركة، بعد زهاء عشرين عاماً من الغياب. ويحضرني أيضاً لمعاني وجهه الآشوري — الذي خبر وعثاء الصّحارى وأوجاع المرافئ ودهشة المجهول — وهو يهديني ديوانه الباذخ «الوصول إلى مدينة أين»، بعدما كتب في صفحته الداخلية الأولى: «الوصول إلى أخي في الروح محمد الشركي، على شرف المغائر وطوطم المغامرة». بعد ثلاثة أيام قضيناها برفقة الشاعر بنيس، رافقني سركون إلى فاس حيث كان ينتظره مقياس آخر من الافتتان. وقف مشدوهاً أمام الأسوار وهدير أزمنتها، وسحرته روائح البهارات والطيوب المنبعثة من حوانيت العطّارين في المدينة القديمة. وفي طريقنا إلى مقهى الناعورة بجنان السبيل لشرب شاي منعنع، أوقفته تحت تينة معمّرة ضاربة بجذورها في سرّة جدارٍ تاريخي. رفع بصره إليها يتأمّل أعجوبتها ثم خرج يعاين موضعها الملغز وسط السّور، والتفت إليّ مفتوناً بالشجرة المثمرة الوارفة المنفلتة من صدْعٍ غامضٍ في حجارة الجدار، ثم قال لي: «كيف يغيب مثل هذا السّحر عن كثير من الكتاب والشعراء المغاربة؟ كيف لا يجرؤون على تدمير البداهة كما تجرّأت هذه التّينة على تدمير بداهة الصّخْر؟». سؤالان لا يزال صداهما عالقاً هناك، بين صدوع أسوار فاس، التي كتب قصيدتها بعد عودته إلى مهجره الأميركي، وخرائط مدينة «أيْن» التي يسهر فيها حالياً كما يشتهي موْته الزاخر بالحياة كمدائن آشور.
■ فيروز: رأفة الأرض ولوعتها
لم تبلغ فيروز ثمانين عاماً. فيروز، كفيزياء الصوت النبوئي، لا عمر لها. مثله اخترقت جدار الزمن وظلّت سطوتها منفلتة من إسار خطوط الطول. هي لبنان العمق، لبنان جبران خليل جبران الذي صرخ من مقامه الأميركي في اللبنانيين — كأنه كان يرى ببصيرته شتاتهم الطائفي الرّاهن وتفرّق دمهم السّياسي بين قبائل الداخل والخارج القريب والبعيد ـ «لكم لبنانكم ولي لبناني». وهو لبنان الذي ارتقى سلالم صوت فيروز وانتشر في جهات الأرض. خلال سنوات الحرب الأهلية الخمس عشرة، كان وكلاء الموت بمختلف المليشيات يقنصون بعضهم البعض في نهارات بيروت المسربلة بالدخان، وفي الليالي يتحررون من أحقادهم وحساباتهم ويفيئون إلى صوت فيروز الرئيف الذي التفّ حوله إجماع يفتقده السّاسة والحكّام بمرارة. وقبل بضعة أعوام، أخبرتني صديقة لبنانية على صلة بها أنّ الفنانة الجوهرية تشترط، منذ عقود، على من يزورونها في بيتها عدم التقاط صورٍ لها، فقلت لها: معها حق. فيروز ليست صورة. فحتّى في وقفتها المهيبة على المسارح، وفي سموق نظرتها المنشدّة إلى البعيد — نفْس البعيد الجبراني — تحسّ بها منخطفةً وغائبةً تماماً في صوتها الذي هو رأفة الأرض ولوعتها.
■ عبد الكريم: جيولوجيا مزمنة في المغرب والعالم
حلّت يوم 6 فبراير الذكرى الثالثة والخمسون لوفاة عبد الكريم الخطّابي جسمانيّاً، واستمراره العالي فيزيائيّاً ورمزيّاً وتاريخياً. لم ينل الموت سوى من الذين اعتبروه ميتاً واعتقدوا أنّهم نفضوا أيديهم الملتبسة من أمره الكاشف. وبدل أن تحجبه غربته في قبر بعيد عن أجدير، رفعته وحوّلته إلى قامة سامقة تكسّرت عندها الحسابات الظّرفيّة، مثلما تكسّرت بين الأجراف الريفيّة المهيبة، التي أنجبته، جيوشٌ وترسانات وقوى أذّلتها ودوّختها محاولته الجسورة (ممّا هو موثّقٌ ومدقّقٌ ومرقّمٌ في كتاب عبد الكريم «ملحمة الذّهب والدم» الذي ألفته الصحافية المقتدرة زكية داود، وصدرت ترجمته بتوقيعي سنة 2007 ضمن منشورات وزارة الثقافة). لقد جعل الخطّابي الاستعمار الإسباني يجثو على ركبتيه في أنوال ويغوص في هزيمة زلزالية توالت موجاتها الارتداديّة داخل الأراضي الإيبيريّة والفرنسيّة والمغربيّة، وانتشرتْ رجّاتها حتّى الشّرق البعيد والغرب الأميركي الأبعد، بما مثّله عبد الكريم الكوني من مرتكز ملهم لرموز ثوريّة من عيار تشي غيفارا وهوشي منه وماو تسي تونغ. لذلك، يظلّ دفين مقبرة الشهداء بالقاهرة ممْعناً في الحياة، وساخراً بشموخ من مسافات الحجب التي ظنّتْه جسداً يطوى فيما هو تركيبة جيولوجية مزمنة وراسخة في المغرب وفي العالم.
■ رابعة العدويّة: الانخطاف إلى «الحبيب الأكبر»
بثمانية قرون قبل القدّيسة تيريزا الأفيلية، التي اختطفها — دون أن يعيدها إلى مكانها — عشقها المطلق لـ «الحبيب السّماوي» حدّ اشتهائها النّهائي الفناء فيه، تسامقت رابعة العدويّة مشتعلة بتجربة حدوديّة عبرت فيها من جموح صاخب وعربيد إلى التّخوم القصيّة لحب إلهي مضفور بحروف طالعة من ليل الأحشاء. هي التي كانت فتنة العالم في سهراتها القديمة المحتدمة، لم تعد تسكن هذا العالم بعدما انخطفت، حسّياً وروحيّاً، إلى رحاب «الحبيب الأكبر»، لا ترافقها من متاع الأرض سوى كلمات معراجية ترتقيها كل ليلة نحو الوجه الماورائي، متضرّعة إليه من قلب عزلة غير بشرية أحرقت عند أجرافها كل مراكبها الأرضية في أبيات اشتهرت بها وتنْسب أيضاً إلى أبي فراس الحمداني: «تصاعد أنفاسي إليك جواب/ وكلّ إشاراتي إليك خطاب/ وإن لاحت الأسرار فهي رسائل/ فهل لرسالات المحبّ جواب/ فليتك تحلو والحياة مريرة/ وليتك ترضى والأنام غضاب/ وليت الذي بيني وبينك عامر/ وبيني وبين العالمين خراب/ إذا صحّ منك الودّ فالكلّ هيّن/ وكلّ الذي فوق التّراب تراب/ فيا ليت شربي من وردك صافيا/ وشربي من ماء الفرات سراب».
■ كورتاثار وكارول دانلوب: ثنائي غرامي كوني
لدى العديد من القبائل الهندية في أميركا اللاتينية توضع الولادات واللقاءات المصيريّة تحت علامة نجمية أو نباتية أو حيوانية تكون لها بمثابة رقية مقدسة تشملها بضوئها السري وتدرأ عنها الأخطار. لكنّ لقاء الكاتب الأرجنتيني الكبير خوليو كورتاثار (صاحب كتب «مانويل» و«كل النيران نار»، و«الأسلحة السرية» و«لشدّما أحببنا غليندا») بالكاتبة والمصوّرة الكنديّة كارول دانلوب (صاحبة «ميلاني في المرآة» و«العزلة غير المكتملة») يجدر وضعه تحت علامة التانغو، هذه الرّقصة الملحميّة ذات التّجاذبات المرهفة والتّناغمات العالية بين الشريكين المتحاورين في زمنها. وكانت الكتابة المتوهّجة هي رقصة التّانغو الكبرى التي جمعت كورتاثار وكارول، مثلما جمع بينهما انتصارهما للحركات التقدّميّة في بلدان أميركا الوسطى والجنوبيّة، وولعهما بالموسيقى وبالحياة كلعب طفولي.. وحينما بدآ العيش معاً في باريس أواسط السبعينيات من القرن الماضي ـ وهو العيش المشترك الذي توّجاه بالزواج بعد سنوات ـ كان كلاهما قد مرّ بتجربتين زوجيتين، وفي روحه ومساره أخاديد وجودية عميقة وظلمات وأضواء وحدائق ونيران. وذات يوم من شهر مايو 1982، قرّرا معاً خوض تجربة جيو- شعريّة (هي أيضاً لعبة طفوليّة عالية) تمثّلت في تخطيطهما وتنفيذهما لرحلة استثنائيّة بسيّارتهما الفولكسفاغن — التي أعادا تسميتها بالمناسبة «فافنر» تيمّنا بتنّين فاغنر — عبر الطريق السيّار الرّابط بين باريس ومرسيليا على امتداد ثلاثة وثلاثين يوماً. وهذا الرّقم هو عدد الأعوام التي كانت كارول تصغره بها، مثلما هو ـ يا للصّدفة أو الضّرورة الرّوحانيّة! ـ عدد السنوات الّتي عاشها المسيح. وقد تقيّد «ربّانا الطّريق الكونيّ» (هكذا سمّيا نفسيهما في الكتاب الذي يحمل نفس العنوان ووثّقا فيه هذا السّفر البرّاني-الجوّاني) باستكشاف وتدوين وتصوير مختلف تمظهرات الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية والتاريخية على جانبي الطريق، وتسجيل ما اعترضهما من مخاطر صادرة في معظمها عن خشونة بعض سائقي الشّاحنات وبعض رجال الدّرك. وعند بلوغهما مرسيليا، بكت كارول من شدّة الفرح والتّأثّر، دون أن تعلم أنّها ستموت بعد ذلك بوقت قصير، تاركة لكورتاثار مهمّة إنهاء كتابهما المشترك بمفرده، قبل أن يهتصره نفس الدّاء الوبيل الذي أودى برفيقته الباذخة ويلحق بها بعد سنتين من رحيلها ويدفن بجوارها في مقبرة مونبارناس حيث لا بدّ أنهما استأنفا سفرهما في الليل الماورائي المفتوح.
■ إدمون عمران المالح وزوجته ماري سيسيل ديفور
في فترة ترجمتي لـ «الـمجرى الثابت»، دعاني الراحل إدمون عمران المليح إلى زيارته بالصْويرة لقضاء بضْعة أيام برفقته وزوجته الراحلة ماري سيسيل، حيث كانا يقيمان في رياض الفنان التشكيلي الحسين الميلودي في زنقة الخضر غيلان. لمّا دخلنا الرياض، استرعت انتباهي جرّة كبيرة الحجم تتوسّط الحديقة الصغيرة الداخليّة. سألت ماري سيسيل عنها فأخبرتني أنهما جلباها، هي وإدمون، من خْميس الزمامرة على متن سيارتهما الصّغيرة ليهْدياها إلى الموضع الذي رأيتها فيه. قلت لها: «هل تعلمين أنّها تشبه تماماً خابية الموتى المصرية التي كان الكهنة المحنّطون يضعون فيها أحشاء الفرعون خلال طقوس التحنيط؟ كانوا يستعملون أربع خواب مختلفة الأغطية، وكلّ واحدة منها مكرّسةٌ لإحدى القوى الْإلهيّة وإحدى الجهات الأربع، فكانت خابية الجنوب مكرّسةً لإيزيس وتحفظ الْكبد، وخابية الشّمال لتفتيس وتحفظ القلب، وخابية الشّرق تحت حماية نيثْ وتحفظ الأمعاء، وخابية الغرب تحت شفاعة سلقيس وتحفظ الرّئتين.. «استمعت إليّ ماري سيسيل باهْتمامٍ عميقٍ وقالت لي: «شكراً لأنّك منحْت هذه الخابية زمناً آخر غير مسْموع».
■ كاتب ياسين: «نريد سيدة هذه البلاد»
بعد مرور أكثر من خمس وعشرين سنة على مغادرته زمن الأرض، يظلّ المبدع الجزائري العميق كاتب ياسين اسماً مفصليّاً حقّق امتداداً عربيّاً وعالمياً بروايته الفخمة والأليمة والمتوهّجة «نجمة»، المستحقة لهذا الاسم العميق والمضيء. هو الذي جنّت أمّه لاعتقادها أنه قتل في مظاهرات سْطيف (1945)، فيما كان معتقلاً وعمره لا يتجاوز ست عشرة سنة، سيتاح له بعد خروجه من السجن أن يعثر في الحبّ الكبير لفتاة من قريباته على الخميرة الكيانية التي تفاعلت مع الثورة المفتوحة وأنضجت دواخله. مثله مثل نجمة التي تخلّقت بذرتها في إحدى المغائر، تخلّق هو ككاتب ثائر داخل عزلة اللغة الفرنسية نفسها، خائضاً حرباً قبائلية عميقة بين أجراف كلماتها، ومنجزاً ثورة رمزية داخل الثورة التاريخية. لأنه أدرك أن الاجتثاث الممنهج للرّموز الهوياتية، الذي كان يمارسه (ولا يزال بصورة أشدّ وأفتك) النظام الاستعماري وآلياته الجبّارة ومرتزقته المحلّيون المنتفعون به، أخطر وأكثر تدميراً — في مقياس التاريخ الطويل — من قتل الأجساد ودكّ المدن، لأنّ الرّمز هو الأساس الكياني الذي ترتكز عليه الحيوات الفردية والجماعية، وتنهض عليه المجالات جميعها، ويشعل الضوء في ليل المعنى. من جهة هذا التورّط الغائر، ينبغي قراءة صرخته في أحد نصوصه الشعرية: «نريد سيدة هذه البلاد/ وليس خليلاتها».
■ فاطمة المرنيسي: «رسالة شهرزاد هي أن السّحر بداخلك»
لأنّ فاطمة المرنيسي لم ترحل، آثرت ألا أكتب عنها عند وفاتها الفيزيائيّة. رغبت في أن أنأى بالكلمات عن النبرة الجنائزية التي كانت ستصطبغ بها حتماً، فيما هي تتوجّه إلى عالمة اجتماعٍ زاخرةٍ، وأستاذة أجيالٍ مقتدرة، وسيّدةٍ جليلة صاخبة بالحياة. لا يمكن تأبين ابنة الحياة، خاصّةً أنّ أغلب التّأبين، في المسلكيّات الثقافية والسياسية على السواء، تبرئة للذمة، وسعْي غاشم إلى الاستعادة القسْريّة لوجوهٍ كبيرةٍ حرّرها الموت ليلحقها بأعمارها الثانية التي لا تنتهي. لذلك تنفلت فاطمة المرنيسي من كلّ اسْتردادٍ لتبقى منطلقةً وجامحةً وغير مهادنةٍ، تماماً كالأسئلة الحارقة والحفريّات الشاهقة التي أنجزتها في أراضٍ ممنوعةٍ ومدجّجةٍ بأعتى الرّقابات البطريركيّة، ولتظلّ أعمالها الغزيرة كاشفةً آليات «الجنس كهندسةٍ اجتماعيّة»، ومضيئةً قامات «السلطانات المنسيّات»، ورافعةً الحجاب عن «الحريم السياسي في الإسلام» وعن «الحريم في الغرب»، غير مبالية بالطّلقات التحذيريّة والرشقات المباشرة التي وجّهها لها حرس الأنساق والحدود، لأنّ «الحدود خط وهْميّ في رؤوس المحاربين» على حدّ قولها، هي التي كتبتْ أنّ «الكرامة هي أنْ يكون لك حلم… حلم قويّ يمنحك رؤْيا وعالماً لك مكانك فيه»، وأنّ «رسالة شهرزاد هي أنّ السّحْر بداخلك». أذْكر أوّل لقاءٍ لي بها منذ سنوات بعيدة، في سياق عشاءٍ ثقافي، حيث شاءت الصّدفة – التي غالباً ما تكون تمظهراً لقانونٍ عميق – أن نجلس متجاورين إلى المائدة. وإذا بها تفاجئني، بكلّ تلقائيّةٍ ونبْل، بأنّها أعجبت بنصٍّ لي كنت نشرته قبل أيّام أجبت به عن سؤالٍ وجّهته جريدة الاتحاد الاشتراكي إليّ وإلى بعض الأسماء الإبداعيّة حول «علاقة الكتابة الأدبيّة بالأمّ». وما لبثت أن لاحظت أنّنا قلّما نأكل، فسألتني إن كنْت أكلْت شيئاً قبل مجيئي، ولمّا أجبْتها بالإيجاب، قالت لي ضاحكةً: «أنا أيْضاً أكلت قبل مجيئي.. إيّاك أن تأتي إلى مثل هذه المآدب قبل أن تأكل قليلاً.. لا تنس هذا أبداً». لم أنس هذه الوصيّة أبداً، لأنّني لا أنْسى الوصايا المهْداة من طرف الوجوه العميقة السّاهرة من عيار وجه فاطمة المرنيسي.
■ امرؤ القيس: الأب الأكبر الحداثي للشعرية العربيّة
امرؤ القيْس، الذي تهدر حتّى الآن، في قلب كلماته وكلمات قلبه، جغرافيا الأرض العربيّة الأولى، وتسمع بين تضاريس معلّقته حوافر جواده المكرّ المفرّ، ويتضوّع من حروف غرامياته الوثنيّة العطر الصّحْراويّ لحبيبته «عنيْزة» التي باتت ممتدّةً في الزّمن بفضل شعره، والّذي حوّل البحث عن الثّأْر لأبيه الملك المغتال إلى مسار ملْحميّ وسط عصبيّات القبائل، ونثر ذهب قصائده في كلّ فجّ عميق، واستنبت أفخم الورود وأبقاها في البراري والقفار، وانتهى متقرّح الجلْد بحلّة مسمومة «أهداه» إياها ملك الرّوم بإيعاز من غريمه الطّمّاح، وأدركه الموت قرب قبر امرأة ملكيّة في سفح جبل عسيب فخاطبها: «أجارتنا إنّ المزار قريب / وإنّي مقيم ما أقام عسيب.. أجارتنا إنّا غريبان هاهنا/ وكلّ غريب للْغريب نسيب».. امْرؤ القيْس هذا ليس شاعراً جاهليّاً، بل الأب الأكْبر الحداثيّ للشّعْريّة العربيّة، وعصْره ليْس جاهليّةً، لأنّ الجاهليّة الجهْلاء هي الزّاحفة الآن، بأمواجها المزمجرة كأمواج التْسونامي، على العالم العربي من مشرق انحطاطه إلى مغربه.
■ ابن خلدون: رافع الحجاب عن بنيات التاريخ العربي العنيف
في قلعة ابن سلامة، الشهيرة بمغاراتها الأموميّة، اعتكف عبد الرحمن ابن خلدون طويلاً لكتابة «المقدّمة» التي كانت، ولا تزال، ضوءاً رفيعاً وقلْباً سميعاً لهدير العصبيّات والقبائل التي أنتجت وتواصل، مشرقاً ومغرباً، إنتاج التّاريخ العربي المروّع الذي نحن شهوده الآن. في هذه القلعة، لاذ بعزلته الصّخريّة المهيبة ليرفع الحجاب عن بنيات الهول ووكلائه ومرتزقته. وفي هدأة ليلها الطّويل، كتب هذه الجملة المحيلة على ما ينفّذه فعلاً هؤلاء: «إذا أردت أن تتحكّم في الجاهلين، فغلّف كلّ باطل بغلاف دينيّ». وإذا دخلت أرض هؤلاء المتحكّمين «فوافق أو نافق أو غادر البلاد» كأنّه كتب هذه الكلمات قبل لحظات فقط.. كأنّه ساهرٌ في ليْلنا هذا.
■ فديريكو غارثيا لوركا: أريد أن أنام نوم التّفاح..
كأنه أحد الأجساد المجندلة، الصارخة بملء أفواه الحياة المغْدورة بالموت، في الأسفل المدلهم للوحة غرنيكا لبيكاسو. لأنّ السّياق التّاريخي المروّع الذي أمسكت به هذه اللوحة القيامية وحفرته بالخطوط والألوان على جدار الزمن هو نفسه الذي ألقى بفديريكو غارثيا لوركا من علياء حلمه إلى الإسفلت البارد لسنة 1936 الوخيمة. كانت حياته تتدلّى يانعةً منْ شرفة ربيعه الثامن والثّلاثين حين اعتقله زبانية الدكتاتور فرانكو بتهمة موالاته للجمهوريّة وأعدموه رمياً بالرّصاص على التّلال القريبة من غرناطة، دون أن يتمّ العثور لاحقاً على جثمانه البرّي، تماماً كما تنبّأ بذلك قلبه الغجري المستبصر حين كتب في إحدى قصائده: «وعرفت أنّني قتلْت/ وبحثوا عنْ جثّتي في المقاهي والمدافن والكنائس/ فتحوا البراميل والخزائن/ سرقوا ثلاث جثث/ ونزعوا أسنانها الذّهبيّة/ ولكنّهم لم يجدوني قط». لوركا، الشّاعر والكاتب المسرحي، مبدع «حكايات غجرية»، و«عرس الدم»، و«بيت برناردا ألْبا»، هو الروح الخضْراء، الاحتفالية والتراجيدية معاً، للأندلس العميقة بزيتونها المقدس، وأقمارها المدوّخة، وقيثاراتها المثيرة للأوجاع العالية، ومصارعي ثيرانها بين حافات الحياة والموت. لذلك، لم يكن غريباً أن تخذله نيويورك بناطحاتها الجليديّة وفولاذها المتعملق وصخبها غير البشريّ، وأنْ يقفل عائداً إلى وطنه الزاخر بالرّوح الملحميّة والمفاتن المتوسّطية ذات السطوة الوقّادة، وطنه حيث يرقد الآن، كفتى أسطوري، في سرداب مجهول تنفلت منه كلّ ليلة كلماته التّالية: «أريد أنْ أغْفو برهةً،/ برهةً، دقيقةً، دهراً،/ لكن ليعْلم الجميع أنّي لست ميّتاً،/ وأنّي أحمل بيْن شفتيّ إسطبلاً من ذهب،/ لأنّي أريد أنْ أنام نوم التّفاح».
■ وجه أسمهان الكنعاني وصوتها الذّهبي..
يبدو القدر الشخصي للفنانة أسمهان كما لو كان مستقطعاً من صفحات الأوديسا. كأنّها حوريّة ألقت بها إحْدى عواصف بوسايدون ـ إله البحر القديم – إلى يابسة الصخب والعنف، قبل أن يستردّها إليه في النهاية. لأنّها عبرت من الماء إلى الماء. فقد ولدت على ظهر سفينة في عرض المتوسّط، بحر هوميروس العالي، ولقيت مصرعها في «ترعة» مائية ابتلعت سيارتها في الريف المصري. وبين هذين الحدين المائيين، كان على وجهها الكنعاني وصوتها الذهبي أن يجتازا، خلال عمر قصير كأعمار الشهب، اختبارات مرحلة مفصليّة تقاطع فيها المسار الوجودي والفني لهذه الشعلة السامقة مع مسارات ملتبسة، عاطفية و«استخباراتيّة» ألقت بظلالها لاحقاً على «حادث» غرقها. وفي اللاّزمن «الفنّيّ» الذي نحن شهوده الآن، حيث يتكالب ويتصايح أشباه الفنانين وأشباه الفنّانات، هنا وهناك، على وقع انحطاط الذّوق العام وانبطاح جزء كبير من الإعلام أمام الأعتاب المدنّسة للمسْتشْهرين والوكلاء «الفنّيين» ومتعهّدي الحفلات، تظلّ أسمهان، بصوتها الملتاع الطّالع من الأحشاء القصيّة للجوى والهوى، دوْحةً باسقةً ضاربةً بجذورها المزدوجة في مطهر الرّوح وفردوسها معاً.. دوحة مزمنة توبّخ بيداءنا الرّاهنة التي تصأى فيها الثّعالب العابرة حول فرائسها العابرة. لأنّ الأعماق وحدها تبْقى..
■ وجه ميزارْ (مفْتتح رواية «العشاء السفلي)
هذه الرواية – القصيدة نص عابر للأجناس الأدبية، يجد جذوره في «هيپّيريون» هولدرلين، وبعض نماذجه العربية في «رامة والتنين» لإدوار الخراط، و«كهوف هيدراهوداهوس» لسليم بركات.. و«العشاء السفلي» لمحمد الشركي من بين أمثل النصوص التي تمثل هذا المنحى الأسلوبي مغربياً وعربياً، بل ربما كان هذا الكتاب أهم نص سردي في الأدب المغربي الحديث. في هذا العمل، اشتغال على أساطير المغرب بجميع أبعادها (الأمازيغية/ العربية/ الرومانية) وحتى على أساطير المشرق، في لغة شعرية قوامها توقيع الجمل، الاشتغال على الفضاء، اللعب بمعجم النباتات (في ذلك شيء من سان-جون بيرس).
أما الثيمة، فهي، على بساطتها، إشكالية: قصة حب بين ميزار ومغران، لكن العلاقة ملتبسة: هل هي أمه بما أنّها مرضعته؟ حبيبته؟ (هنا أيضاً لا يمكن للقارئ النبيه إلا أن يتذكر «نجمة» كاتب ياسين، الذي يشكل بدوره واحدة من مرجعيات الشرﯕـي). كان زنا المحارم دوماً، عبر التاريخ، حصناً لصون الجنس البشري من الانقراض. في هذا النص، كلّ شيْءٍ يتعشّق، كلّ شيْءٍ (ر.و)
■ ■ ■
أمرٌ كان، وأمر يكون، وأمر لا يكون أبداً. فأمر كان.. محبتي لك، وأمرٌ يكون.. تراني، وأمرٌ لا يكون.. لا تعرفني معرفة أبداً.
[النفري]
أمر كان، وأبداً يعود.
لنترك الأبراج المرصعة بأملاح الشمس الغائبة، والقباب المضرجة بالطحلب الغسقي، ولننحدر نحوك، أنت الطالعة في ليلنا.
ميزار،
ذكراك تزوْبع الجسد وتخطف الفكر إلى إقليم حتمي.
ذكراك: نهر أورفيوسي أرقد في قرارته وأمضغ أعشابه المخصبة والسامة إلى حدود الهذيان.
أعرف الآن، في ليلة القطب هذه، أن ليلتك المدارية قد انتهت، وأنه لا بد من إعادة بنائك إذا أردت مجابهة الفجر القادم بدونك.
هل هذا ممكن؟
هل أنت عائدة إليّ عبر ليل اللغة الكبير، ليلها الشاسع الذي لا ينيره سوى الموت؟
أهبك هذه السهرة المرصّعة بحمق مبدئها وحمق جميع المبادئ، أهبك أرقاً باذخاً لا يعنيه حساب.
أهبك جسدي وشمسي وجوامعي وقلاعي وقبائلي المدفونة في أضرحة الشهوة والسلطة.
أهبك السيوف ودم الآلهة والخيام.
أمامي الآن، بجوار أصيص البابونج، رسالتك التي تلقيت عبرها خبر عودتك، رسالتك المضرجة بقطرات دمك. كأنك إذْ أرسلتها دون تأريخ، وضعت مشهداً بكامله خارج النهار، في الخلفية السرية التي تحكمه. كأنك قبْل كتابتها قلت لي: «إسْمعْني بأذنٍ أخرى، انْتقلْ إلى حيث تكلمت».
كانت رسالتك دعوة غير مسبوقة، وموقظة لخيال وجه بعيد: «أنا ميزار يا مغران.. أنت لا تذكرني.. هل تذكرني؟ أنا حاضنتك التي كنت تحفر وشم وجهها بأظافرك الطفولية، وكنت تحل شعْري بالليل.. أيها الطفل الوحشي، كم أدْميتني! لقد عدت إلى الدار الكبيرة بقصبة النوار وليس لي سوى الليلة الآتية.. تعال لأراك».
بدتْ رسالتك مرْفقةً بعبق قديم، بحناء برية ومزيج من الأعشاب القمرية الأخرى، لكن وجهك بدا متعذراً على الإمساك. أطللت على حافة جسدي، فرأيتك نائية، أسفل جذوري المظلمة. ولم أر وجهك.
سأقول لك إن الوجه طقس غياب لا هوادة فيه.
سأقول لك إنني نسيت وجهك لأنني لم أره كاملاً في السابق، لم أره كما كان ينبغي.
يحضرني عطرٌ مّا، لونٌ يميل دائماً للأخضر، لحنٌ فيه حنين غابوي، وتحضرني رزنامة الصور الأبدية: البئر، الناعورة، شجرة التين، سقيفة الدالية، الشمعة الخضراء، البهو السفلي، النبات الشهوي فوق أسوار الدروب، مآزر النساء.
تحضرني يدٌ رخوة وموشومة، يدك المنسية دون شك، تمسك بي وتعرفني على العالم بتواطؤ فرحان: هذه شمس، تلك خبيزى، ذلك نيلوفرماء، هذه فراشة ليل.
لكن تحضرني رائحة لبنية لا تقاس، رائحة شاسعة لا يحدها سوى الليل، مزيج من اللعاب الأنثوي والعسل المحروق. رائحة اشتبكتْ في ذاكرتي بآثار أخرى: خصلات شعر فاحم وطويل على الوسادة المطرزة، أثواب ساتان بيضاء وشفافة، وجسد ما، هائل، ينحني ويغسل الزليج الأخضر.
تلك الرائحة شممتها في رسالتك، في قطرات دمك العابرة للزمن.
وضعت رسالتك بجوار أصيص البابونج، وخرجت. عبرت مقبرة ابن عربي عند الغسق، القبور ثملة بالأعشاب البرية وأزهار الصبار، وثمة ديدان حباحب تلمع تحت التعريشات القاتمة.
في عمق المقبرة، قرب ضريح لسان الدين بن الخطيب، داهمني إحساس مترف، إحساس مضرج برغبة مجهولة، فتوقفت عن السّيْر وانْتحيْت قبراً مترباً بجوار الضريح وجلست.
أمامي، كانت طوبوغرافيا الموت جارفة: فضاء مترع بالجفون المغلقة في أرحام المرايا، فضاء مسكون بشهوةٍ ما لمست من قبل، عربدات عطور وأملاح.
كانت قبة الضريح مكسوة بالطحالب القمرية ولعاب فراشات الليل الضارية، والصمت يؤازر جدرانه. الصمت العميق الأبدي. صمت الموت السيد.
لقد أخبرتك بالمشهد الذي حدث بعد ذلك: فتح باب الضريح، وخرج لسان الدين من رماده. خرج مثلما يخرج ظل من مرآة، وكانت لحيته لا تزال كثة وخضراء. خرج وأشرف على فاس، واهبة القتل الذي هز الضيافة، ثم تمشى قليلاً حتى بلغ شجرة عسل بري، وتوقف قربها.
كان يوليني جانباً من وجهه، بينما اختفى الجانب الآخر في ضوء الغسق المعتم. بدا مشمولاً بمدار آخر، والهواء الشرقي يهز أكفانه إلى مستوى أعذاق العسل العالية ويخفضها. حين أحس بي، التفت ببطء وظل صامتاً. كانت عيناه المضرجتان بملح العشب الفوسفوري تلمعان بنظرة ماورائية، نظرة صاعدة من أعماق الموت.
اعتقدت أنه لن يتكلم، فإذا به يهتز بضحكة غريبة، ضحكة شاملة حتى أخذ يرتعش. قال تعال نشربْ شاياً في باب الضريح، فباب المحروق لا يزال كما عبرته.
أعددنا الشاي بنعناع المقابر، وجلسنا في العتبة المفضية إلى الداخل. لاحت لي الستائر الخضراء وشاهدة الرخام.
قال عبرته في فجر ناءٍ، غب مطر خريفي، وأعراش اللبلاب خاوية. كان في الذاكرة ليل عميق وجسد أندلسي، وكانت السلطة ليلاً آخر، تغادره في غرناطة فيدركك في فاس. لكنني ما نسيت جسدها الراقد هناك، في سقيفة العليق الأحمر، والقمر الإيبيري يغسله. ما نسيت وجهها في ليلة الوداع.. كأن ضيافة فاس كانت مسبوقة بوجه غير مسموع، كأن النهاية كانت منذ البدء محلومة. عبرت باب المحروق والتيجان رماد، وكان ماء الغبش يقطر من الأسوار. رأيت البخار الألوفي مخضراً في الأزقة القاتمة، ورائحة الأبازير تسكن المنعطفات. وفي دار الإقامة، وهي الدار التي لا تبعد عن دار ابن خلدون سوى بضع خطوات، كانت الأغطية تتلطخ كل ليلة بالدم والحبر. كان الموت معي منذ البدء، على هيئة أندلس عميقة.
[فاس، أغسطس 85 – مارس 86]
سيرة موجزة
1958: الميلاد في مدينة فاس.
1980: إجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في فاس.
1987: العشاء السفلي (رواية) ـ 2001 كهف سهوار ودمها (شعر)، 2006: الحبق والعتبات (دفتر ملحوظات نقدية) ـ 2007: السراديب (شعر).
■ ترجمات: الطاهر بن جلون: ليلة القدر (1987) ـ جورج أوفيد: اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية، ج1 (1987)؛ ج2 (1988) ـ عبد اللطيف اللعبي: تجاعيد الأسد (1989) ــ محمد العلوي البلغيثي: فاس مقام العابرين (1990) ـ الطاهر بن جلون: طفل الرمال (1992) ــ إدمون عمران المالح: المجرى الثابت (1993)، زكية داود: عبد الكريم: ملحمة الذّهب والدّم (2007). تشكّل ترجمات محمد الشرﯕـي هجرةً شبه كاملة للنصوص الأعجمية نحو جذورها العربية، توطيناً للنص الفرنسي في تربته العربية، في لغةٍ شفيفة موقّعةٍ، حدّ غيرة الطاهر بن جلون على نصه الفرنسي من صنعة الشرﯕـي العربية.
كلمات
العدد ٣٢٤٩ السبت ١٢ آب ٢٠١٧
(ملحق كلمات) العدد ٣٢٤٩ السبت ١٢ آب ٢٠١٧