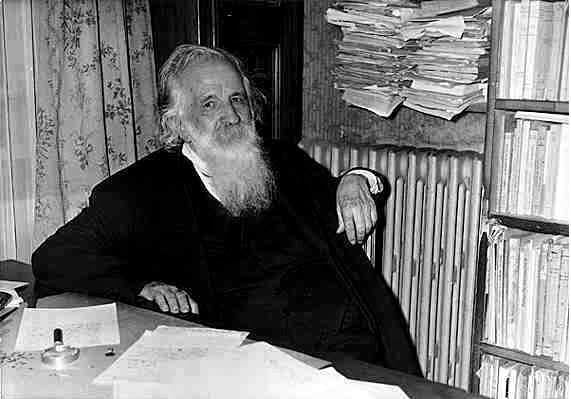مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي

راهن العلوم الاجتماعية في المشرق العربي: الطابع الاحتفالي… الذاكرة الفقيرة… المقاولة البحثية/ محمد تركي الربيعو
يعد كتاب «مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، الذي أشرف على تحريره كل من السوسيولوجي الفلسطيني ساري حنفي، والسوسيولوجيين الجزائريين نورية بن غبريط، ومجاهدي مصطفى، واحداً من الكتب المهمة التي تطرح تساؤلات حول حجم إنتاج علم الاجتماع ومكانته داخل الجامعات ومراكز الأبحاث العربية، عبر معاينات دقيقة ودراسات حية استقاها الباحثون المشاركون من تحقيقات ميدانية، أو عبر معرفة وخبرة بنشأة وإنتاج وواقع الحقل الأنثروبولوجي والاجتماعي داخل بعض الأكاديميات العربية. ونظراً لكون الكتاب واسعاً ويشمل كافة بلدان العالم العربي، فإننا سنقتصر في عرضنا هذا على إنتاج علم الاجتماع داخل الساحة المشرقية العربية (مصر، العراق، فلسطين)، خاصة أن هذا الإنتاج لم يحظ بالتحليل إلا نادراً مقارنة بما كتب من دراسات وأبحاث حول عمل الأنثربولوجيين والسوسيولوجيين في المغرب العربي. ونشير هنا مثلاً إلى الإسهام العلمي الرفيع الذي قدمه الأنثروبولوجي المغربي حسن رشيق في سياق قراءته لتاريخ الممارسات الاجتماعية والأنثروبولوجية في المغرب، وهو الأمر الذي تطرقنا له في مقالة سابقة على الصفحة نفسها تحت عنوان «حسن رشيق: رؤية جديدة للمقدس الإسلامي بين الاحترام والانتهاك».
ومما يسجله المحررون من ملاحظات في سياق تقديمهم للكتاب، هو تميز علاقة الباحثين والمثقفين العرب بالحقل السوسيولوجي بعد مرحلة الاستقلال التي مرت بها البلدان العربية بثلاث سمات أساسية:
الأولى – غالباً ما نظر علماء الاجتماع إلى دورهم بوصفه ينحصر، فحسب، في كيفية خدمة الدولة أو الأمة أو المشروع الحديث التي تنفذه أجهزته. الأمر الذي أدى لاحقاً إلى انهماك العلوم الاجتماعية في حل المشكلات التقنية عوض انتقادها.
الثانية – إن الصورة التي رسمها المثقف العربي عن نفسه، ساهمت في عدم الاهتمام الكافي بالسوسيولوجيا. فالمثقف وفق الرؤية التي رسمها لنفسه، هو منظر يتحدث عن التقليد والحداثة، والاستبداد، والهوية، والوحدة العربية والعولمة. لكنه يتجنب اللجوء إلى المجتمع بحثاً عن معطيات تجريبية.
أما السمة الثالثة فتتعلق بالدور السلبي الذي أخذت تحدثه بعض الجهات المانحة داخل الحقل البحثي السوسيولوجي، والذي بات يتركز عادة على دعم المؤسسات غير الحكومية (بدل الجامعات) وهو الأمر الذي أسس لحالة جديدة داخل الساحة البحثية يدعوها ساري حنفي بحالة «المقاولين البحثيين». فبدلاً من تقديم المنح الجديدة للجامعات الحكومية، غدت هذه الجامعات مجرد أمكنة لتخريج طلاب ليس لهم صلة بالمجال البحثي، في حين أخذت الجهات غير الحكومية نتيجة للدعم السخي من بعض المنظمات تتحول إلى مؤسسات تديرها نخبة جديدة عابرة للحدود تقيم صلات مع نخبة معولمة.
السوسيولوجيا الاحتفالية في مصر:
من جانب آخر، يرى السوسيولوجي المصري أحمد موسى بدوي أن مشكلات الإنتاج العلمي في السياق العربي ليست مرهونة فقط بالعوائق البنيوية. فمثلاً عندما تأسس علم الاجتماع في مصر، كان المجتمع المصري على عتبة التحول، ولكنه لم يزل مجتمعاً تقليدياً، فلم يخبر التحولات الكبرى التي أدت إلى ظهور علم الاجتماع في أوروبا، فالإقطاع الزراعي كان النظام الاقتصادي السائد، ونظام الحكم كان ملكيا وراثيا، وحركة التصنيع في مهدها، ونظام التعليم محدودا، ملائما لمحدودية فرص الحراك الاجتماعي. في هذا السياق، يصبح المجتمع المصري موضوعاً للأنثروبولوجيا الاجتماعية أكثر منه لعلم الاجتماع. ومن هنا فقد ظهر علم الاجتماع وكأنه بلا موضوع يدرسه، كما بدا للعديد من المشتغلين في هذا العلم، في لحظة التأسيس أنه علم للتأمل والتفكير في مشكلات المجتمع استنباطياً أكثر منه استقرائياً.
إذن، انشغل جيل الرواد المصريين الأوائل وتلامذتهم بقضايا «ذات طابع نظري تختلط فيها الفلسفة بالأخلاق والتربية، كما هو الحال في المدرسة الفرنسية». كما لم يواكب الجيل الأول وسلفه – بحسب بدوي- التغير المتسارع الذي شهدته السوسيولوجيا في الأكاديميات الأوروبية والأمريكية وظلت بعيدة عن الواقع ورضيت بما قسمه لها الرواد. من هنا فقد ورث هذا السلف السوسيولوجيا الإستاتيكية من جيل الرواد، ودهمته ثورة يوليو/تموز بإيقاعها السريع في أحداث التحولات الكبرى، فكان انفعال علماء الاجتماع بالثورة احتفالياً، وظهرت السوسيولوجيا مندهشة بجمال هذا الواقع وكماله وقوته وتنظيمه، فخرج العلم عن أهدافه كموجه ومنبه ومرشد للقرار السياسي.
ويلحظ القارئ لمؤلفات هذه الفترة – بحسب بدوي – أن الكتابة السوسيولوجية في مصر، لم تعد تنتمي إلى نظام معرفي مستقر، ولم يعد من وظيفتها الكشف عن أسباب التخلف، والبحث عن سبل التقدم، وترشيد الفعل السياسي. ففي الوقت الذي شهد فيه المجتمع المصري التحولات، اختبأ علم الاجتماع في عباءة الثورة، لأن رواد هذه الفترة ورثوا علماً إستاتيكياً غير قادر على استقراء هذه التحولات، ما أدى إلى انهيار علم الاجتماع وفقد جدواه المجتمعية وخروجه من حسابات متخذي القرار. ورغم أن بوادر جديدة بدأت تلوح في الأفق مع بداية السبعينيات داخل الحقل السوسيولوجي المصري، وذلك بعد عودة المبعوثين من (فرنسا وأمريكا وألمانيا ودول أوروبا الشرقية). وبداية الإرهاصات الأولى لـ»المرحلة النقدية» من خلال الرسالة التي تقدم بها أحمد زايد (1976) للماجستير حول «الاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع الغربي» وظهور كتاب محمود عودة «علم الاجتماع بين الاتجاهات الرومانسية والراديكالية (1977) وكتاب عبد الباسط عبد المعطي اتجاهات نظرية في علم الاجتماع (1981)، (مثّلت هذه الأعمال اتجاهاً جديداً في علم الاجتماع المصري)، بيد أن القرارات السياسية التي تمثلت في التدافع لإنشاء الجامعات والمعاهد من دون إعداد جيد، ترتب عليها نقص حاد في مدرسي السوسيولوجيا، أدى الى كارثتين: الأولى هي تدهور عمليات اكتساب المعرفة، والثانية هي التهاون في منح الدرجات العلمية لسد العجز في الكوادر.
الذاكرة الفقيرة لسوسيولوجيا العراق:
وفي دراسة أخرى، تشير السوسيولوجية العراقية لاهاي عبد الحسين، من خلال استطلاع ميداني شمل عدداً من الطلبة المقيدين لنيل الدكتوراه (وعددهم عشرة) في مجالي علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية؛ إلى أنه في أحد الأسئلة التي طرحت على هؤلاء الطلبة تم تقديم عينة من علماء الاجتماع والأنثربولوجيا المعروفين في العراق ممن ساهموا في تأسيس علم الاجتماع في العراق في الخمسينيات والستينيات، وطلب من الباحثين أن يعبروا عن آرائهم في ما يتعلق بكل واحد منهم. فكانت المفاجأة بتصريح أكثر من طالب أنه لا يعرف الطاهر والكعبي والتكريتي، وحتى النوري (وهي اسماء مؤسسة لعلم الاجتماع العراقي). وكتب أحد الباحثين جملة مفادها «إن ما يجمع هؤلاء العلماء الخمسة إنما هو انقطاع الصلة تقريباً بينهم وبين الجيل الحالي».
وفي سؤال آخر حول إسهام علم الاجتماع في العراق في فهم قضايا المجتمع العراقي وتحليلها وتفسيرها، امتنع أربعة من الطلبة الباحثين عن الجواب تماماً، ووصف الخامس والسادس المساهمة بأنها ضعيفة وطوباوية، وأنها لم تنجح بتقديم حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها المجتمع، بينما قال آخر إن «السرد التاريخي» يأخذ مساحة كبيرة في طروحاتهم، وإن هناك تراجعاً وتردداً يظهر في أعمالهم نتيجة ضغط الأنظمة السياسية والحكومات العراقية السائدة. وعبر باحث آخر عن أن التفسير غالباً ما ينحو باتجاه القبلية والعشائرية والعادات والتقاليد التي تسيطر على المجتمع من الماضي حتى الوقت الحاضر، وأن محاولات التحليل غالباً ما تظهر خجولة وضعيفة. وهو رأي توافقه عليه لاهاي عبد الحسين لأن السوسيولوجيا العراقية لم تصل بعد إلى مستوى الإنتاج الفكري المتميز والمستقل لتقدم مفهومات مميزة تساعد على فهم الواقع بكل تجلياته المعقدة. وينعكس هذا بدوره على انسحاب المحاولات التحليلة إلى أفكار نمطية شائعة، بل ومعروفة حتى بالنسبة إلى الأشخاص غير المختصين، كما هو الحال في الاتكاء على عوامل القبلية والعشائرية والعادات والتقاليد السائدة، فعلم الاجتماع الحديث تحرك بعيداً من هذه الافكار المطروقة محاولاً تطوير مقاربات نظرية ومنهجية جديدة تحدد على نحو أدق أسباب، أو على الأقل، القوى القرينة لظواهر محددة.
ويُلاحظ أيضاً بحسب، لاهاي الحسين، أن طلبة علم الاجتماع في العراق ما زالوا يناقشون كثيراً من القضايا في ضوء أفكار علماء الاجتماع الكلاسيكيين من أمثال أوغست كونت، وإميل دوركهايم، وماكس فيبر، وغيرهم، ويلمون بالنزر اليسير من أفكار علماء الاجتماع المعاصرين، وفي مقدمتهم تالكوت باسونز، روبرت ميرتون، من دون إعمال جدي للمنهج النقدي، الأمر الذي يؤدي بهم إلى محاولة تطبيق أفكار هؤلاء العلماء (ممن انتقدوا في عقر دارهم) من دون تمحيص يذكر. وفي ما يتعلق بالعمل الذي يرغب الباحثون في الحصول عليه بعد نيل الشهادة، فقد كان كالمتوقع، العمل بالتدريس في جامعة أو كلية، في ما أشار اثنان من الطلبة العشرة الباحثين إلى رغبتهم في العمل في وظيفة محلل سياسي وباحث، إلى جانب العمل كتدريسي أو أكاديمي.
«المقاولون البحثيون» والإنتاج المعرفي الاجتماعي الفلسطيني:
في سياق آخر، يرى السوسيولوجي الفلسطيني ساري حنفي، أنه مع مطلع تسعينيات القرن الماضي حدث تحول جوهري على مستوى طبيعة الاقتصاد السياسي للمساعدات داخل قطاع المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، الأمر الذي نتجت عنه أشكال جديدة للرأسمال الاجتماعي والسياسي.
وأدى ذلك إلى تشجيع المراكز البحثية وإقامتها على حساب المساعدات التي تمنح للجامعات. والنتيجة كانت هي إفقار الجامعات الفلسطينية وعجزها عن إيجاد موارد مناسبة للبحث، لتغدو مجرد أمكنة لتخريج طلاب ليس لهم صلة بالمجال البحثي. ونتج عن هذه العملية إضعاف الدولة وسلطاتها في آخر الأمر. كما أسهم هذا التحول المتعلق بارتباط المنظمات غير الحكومية المحلية بقنوات تقديم المساعدات في نمو فاعلين جدد في هذا القطاع، وهو ما أسفر عن تغييرات في الهياكل المفاهيمية والمؤسسية للمنظمات غير الحكومية. وبناء على ذلك، تولت إدارة هذه المنظمات غير الحكومية نخبة جديدة عابرة للحدود تقيم صلات مع نخبة معولمة. وبناء على التحولات السابقة، يرى حنفي أنه بات يمكن اليوم التمييز بين ثلاث فئات من الباحثين الاجتماعيين العاملين حالياً في فلسطين: تضم الفئة الأولى؛ باحثين اجتماعيين ملتزمين في حل المشكلات المجتمعية. وتحتوي الفئة الثانية أشخاصاً لا يؤمنون بإسناد دور ريادي للدولة في مشروع تحديث المجتمع الفلسطيني، بل يبحثون عن جهات فاعلة جديدة في المجتمع المدني لإكمال هذا المشروع. بينما تشمل الفئة الثالثة والأخيرة خبراء مهتمين بالبحوث السوسيولوجية، كونها أداة إنمائية لإدارة الأزمة الاجتماعية، لكن من دون الانخراط في بحوث عميقة وبحوث نظرية نقدية.
ووفقاً لحنفي، فإن تنافس هذه الفئات الثلاث على الموارد، جعل البحث مدفوعاً بالتزام مبالغ بباراديغم الهوية على حساب النقد الاجتماعي، حيث تميز التحليل السوسيولوجي المعاصر بتشديد زائد على العوامل الخارجية، وعلى الدور السلبي الذي أدّاه الاستعمار في المجتمع الفلسطيني وبتقليل أهمية العوامل الداخلية، والتناقضات في هذا المجتمع، وإضافة إلى ما تقدم، لا تعكس مواضيع الدراسات المقتبسة من الغرب التي يروج لها المانحون، مثل إحلال الديمقراطية أو الرضا الشعبي، الصيرورات الداخلية المرتبطة بالمجتمع الفلسطيني الحالي. وليس هناك في الوقت عينه تشجيع على دراسة المواضيع المحلية الجديدة. ونتيجة لهذا التناقض، يتوقع حنفي أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه حالياً، وبقاء المراكز البحثية منفصلة عن الجامعات في فلسطين، يمكن للمرء أن يتوقع ميداناً بحثياً من دون باحثين محترفين في آخر الأمر.
٭ باحث سوري
القدس العربي