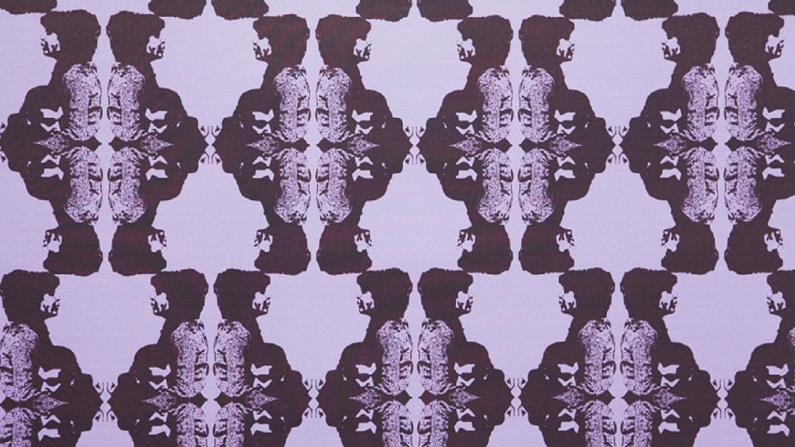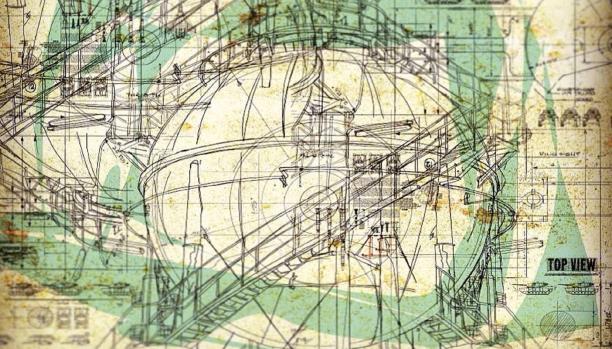مع الشاعر ضد الوزير
رامي الأمين
هذه المقالة منحازة. أنحاز فيها سلفاً إلى الشاعر. الشاعر أولاً. والشاعر أخيراً. والشاعر بينهما. والشاعر ليس الحق، بل قد يكون مخطئاً أحياناً، وأنحاز إليه. أتخلى هنا عن موضوعية يتوخّاها الصحافيون عادة، لأسقط، سقوطاً حراً، في الإنحياز. فأنْ أخيَّر بين شاعر وسياسي، أياً يكن الشاعر وأياً يكن السياسي، فلا مناص عندي من اختيار الشاعر. فكيف اذا كان الشاعر بول شاوول، والسياسي كابي ليّون. الأخير قد لا يكون كثيرون سمعوا به، لكنه، وبمشيئة ميشال عون، وزير ثقافة من وزراء عون العشرة في حكومة نجيب ميقاتي. الوزير حصة من حصص الزعيم، جنديّ في جيش الجنرال، وله ما له من امتيازات وسلطة وسلطان، في السياسة وسواها، وهو “إصلاحيّ تغييريّ” على ما يدّعي، و”فخور بانتمائه إلى التيار الوطني الحرّ”، على ما قال في ردّ على مقال في الصحافة الجزائرية اتهمه بمنع وصول دعوة وجهتها وزارة الثقافة الجزائرية الى الشاعر بول شاوول لحضور معرض الكتاب في الجزائر، ومناقشة قضايا الثورات العربية. فالوزير، الغاضب هو الآخر، يسدّد ثأراً لجنراله بعدما نال منه بول شاوول كتابةً، فنال الجنرال منه بقانون المطبوعات، الذي لا يقلّ تعسّفاً عن أحكام المحاكم الإستثنائية في قضايا العملاء.
أنحاز إلى بول شاوول، ليس كما ينحاز إليه بعضهم، وليس كما ينحاز هو إلى نفسه. فلا مآل سياسيّاً لي من الإنحياز، ولا أجندات. وأنحاز إليه من دون أن أنحاز إلى المنحازين إليه. أنحاز إليه بوصفه الشاعر، لا السياسي، والشاعر في السياسة متوتر غاضب، يكتب بقسوة ولا يجامل. وقد يكون هذا خطأً بالنسبة إلى بعضهم. لكنه ليس سوى ذلك الحق الذي يهبه الشعر إلى الشاعر. الحق في الصراخ والهجاء وحتى المديح من دون اعتبار أو حساب، طالما أنه يفعل ذلك بالكلمات. بالكلمات وحدها. كيف يكون الشاعر مهذباً ودقيقاً وموضوعياً وحيادياً، وهو “على قلق كأن الريح تحته”؟ كيف يكون الشاعر صادقاً، إذا كان مثالياً، لا تشوبه شائبة ولا تعكّر صورته بذاءة أو جنون أو نرجسية؟ ثم كيف يكون الشاعر شاعراً “سارقاً للنار”، ولا يكون ذا رأي منحاز إلى الحرية في كل مكان، في زمن الإنسان المتغلب على الأفكار، والمتمرّد عليها؟ قد يقول بعضهم إن بول شاوول أسير أفكاره ومواقفه المنحازة إلى طرف دون آخر. لن أقول إنهم مخطئون. لكن ما يحق للشاعر لا يحق لغيره، طالما أن عبارة كـ”العصر العربي العظيم القائد، هو عصر الشعوب المنتفضة، والحريات، والكرامة، والديموقراطية، وهو عالم لا يتسع لا لأنظمة الاستبداد ولا لعبيد هذه الأنظمة وعملائها” لا تستثني أحداً من الأنظمة العربية. وطالما أنه ينزلق في الهجاء لكن لا ينزلق في المديح والتملّق، وطالما أنه لم يحمل في حياته إلا كتبه، ولم ينقل البندقية من كتف إلى كتف، لأنه لا يعرف شكل البندقية، التي سعى عون وغيره إلى توحيدها بدل توحيد الناس ضدها.
أنحاز إلى بول شاوول ضد وزير الثقافة الذي يرفع دعوى ضد شاعر، لا لشيء، سوى لأن رأي الشاعر فيه أقسى من أن يتحمله الوزير، المعتاد على لغة التهذيب العالي التي يخاطبنا بها جنراله في مؤتمراته الصحافية، “من الزنّار ونازل”، وصولاً إلى “الحذاء ونازل”. أنحاز إلى بول شاوول ضد “ثقافة” تدّعي المعرفة المطلقة والحق المطلق والثبات المطلق والنقاء المطلق والصلاح المطلق، على حساب كل “آخر”، بما في ذلك الآخر المتكوّن داخلها، فتطرد المتمردين عليها، وتنهيهم وتخوّنهم، وتنبذهم مع الآخرين ممن تتهمهم بالعمالة المطلقة والفساد المطلق والباطل المطلق، في شيء من النازية المطلقة والفاشية المطلقة.
قد لا يُخفَّف الحكم عن بول شاوول إذا صدر ضده من محكمة المطبوعات، فهو ليس عميلاً لإسرائيل، ولم يكن يوماً في صفّ إسرائيل، أو اليمين اللبناني الذي كان مع ميشال عون إلى جانب إسرائيل. هو محض شاعر طاردته الطوائف من مكان إلى آخر، ويطارده ميشال عون ووزراؤه لأنه كتب مقالاً أو قال رأياً، ويتناسون الفساد الذي منذ وُجدوا يهددون بكشف ملفاته في البلد، كتهديد النظام السوري الدائم بالردّ على إسرائيل في “المكان والزمان المناسبين”. كأن الفساد، بأمه وأبيه، يتمظهر في بول شاوول، ذلك الذي لا يكاد يغادر مقهاه في الحمرا، إلا إلى مكتبه في الجريدة، ومنها إلى البيت “بلا أثر يذكر” على الناس وإيقاعهم الصاخب وحيواتهم المتداخلة. هنيئاً لميشال عون وتيّاره اكتشافهم استناداً إلى “بوصلة الدم”، الفساد وملفاته ومؤامراته التي يحوكها بول شاوول في ركن المقهى، ومنها ملفّ “دفتر سيجارة”، و”ووجه يسقط ولا يصل”، و”كشهر طويل من العشق”، إضافة إلى آلاف الترجمات والدراسات في الشعر والمسرح والأدب، التي على الأرجح لم يقرأ منها وزير ثقافتنا حرفاً واحداً.