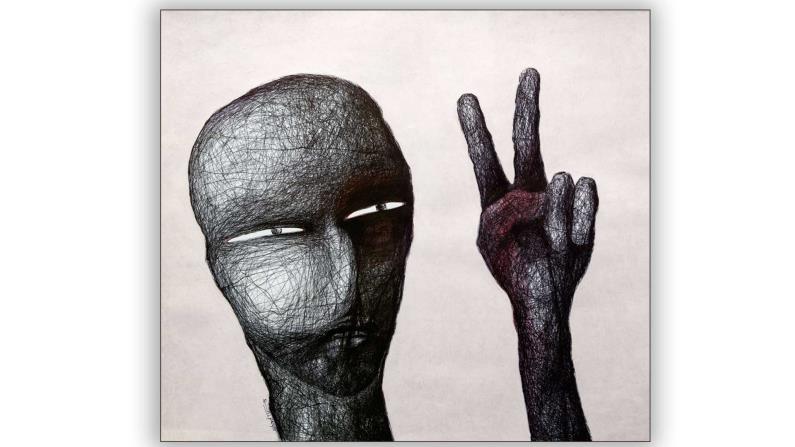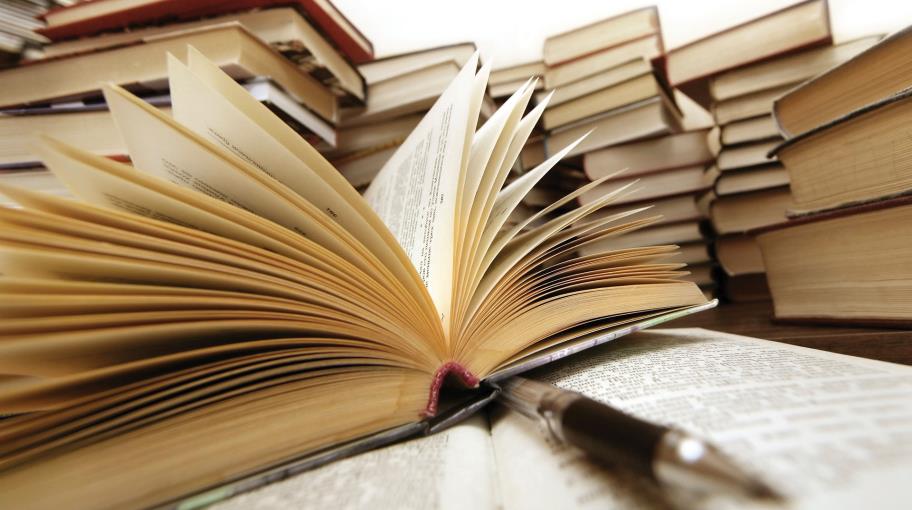ملف السفير عن بهاء طاهر
اكتشاف إنسان
اسكندر حبش
لا زلت أذكر بالتأكيد، تلك اللحظة التي اكتشفت فيها اسم بهاء طاهر للمرّة الأولى. بالرغم من متابعتي للرواية المصرية، وبالرغم من أن الكثير من أسماء كتّابها كان حاضرا في مشهدي الكتابي، إلا أنني اكتشفته بشكل متأخر نسبياً. كان ذلك مع صدور روايته «خالتي صفية والدير». لم أحتج لكثير وقت لأجد أن مناخ هذا الكاتب يقترب كثيراً من هواجسي، بمعنى أني وجدت عنده ما كنت أبحث عنه في تلك الفترة، من أسئلة في الكتابة والقراءة.
لا أقول جديداً، ربما، فيما لو اعتبرت، أن أول ما شدّني إلى تلك الرواية، حضور «الشخصية»، إذ كنت أجد أن الكثير من الكتّاب في عصرنا تخلوا عن بناء شخصيات فعلية في الرواية. من هنا وجدت أن صفية تشبه تلك «البطلات» اللواتي صغن لنا الكثير من وجهات النظر إلى الحياة. بهذا المعنى اقترب بهاء من فكرة «كلاسيكية» في الكتابة ـ إذا جاز القول، على الرغم من أنه لم يكتب الرواية الكلاسيكية بالطبع، بل ذهب فعلا إلى التجديد الحقيقي ـ وهي، أيّ الفكرة، بناء شخصية تبقى حاضرة معك على الرغم من تقدم السنين. كنت أجد، أن شخصية تلك «البطلة»، تساوي معادلاً روائياً لشخصية ذكرية أخرى أتحفتنا بها الرواية المصرية، وهي شخصية عبد الجواد في ثلاثية محفوظ، وأقصد بالمعادل هنا، هذه القدرة على إبداع شخص يحمل إلينا الكثير من الإسقاطات التي تذهب في شتى الأرجاء والتي تطرح علينا أو بالأحرى تجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة.
في أيّ حال، كانت هذه الرواية فاتحة لقراءات أخرى، ولا بدّ من القول إن استعادة «دار الآداب» (في بيروت) لنشر الكثير من روايات بهاء، تركتني أدخل إلى هذا العالم السحري الذي اكتشفته مع كتب مثل «قالت ضحى»، «نقطة النور»، «شرق النخيل»، «حب في المنفى» وغيرها، وصولاً إلى «واحة الغروب» التي حازت «جائزة البوكر» العربية في دورتها الأولى. وأحب أن أشير هنا، وهذا رأي شخصي بالتأكيد، أن فوز بهاء، أعطى فعلاً مصداقية لهذه الجائزة، قبل أن تبدأ الأسماء اللاحقة، المختارة، في جعل الجائزة، لعبة عادية، لا تفعل شيئاً، سوى إبعادي عن الكتب المتوجة.
في أيّ حال، إن كان لا بدّ من توصيف ما، أجد أن تجربة بهاء طاهر، واحدة من التجارب الحقيقية (كي لا أقول الكبرى) في الرواية، ولا أقصد بالطبع في «الرواية العربية» فقط، إذ فعلاً لا أفهم لماذا نقوم بهذا التقسيم اللغوي. ما أجده، أن الرواية هي رواية، وبأي لغة كُتبت. وما فعله بهاء عبر هذه التجربة المتميزة، كان كتابة فعلية، تعيد فعلاً الثقة بالأدب بكونه مجالاً حيوياً لكل الأسئلة «الوجودية» (ولا أستعمل هذه الكلمة إلا بمعناها المجرد).
وإذا شكلت قراءة بهاء اكتشافاً أدبياً، أجد أن لقاءاتي القليلة معه، شكلت اكتشافاً إنسانياً آخر، مدهشاً. المرة الأولى حدثت في بيروت، وكان يقيم ندوة في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب. كان لقاء عابراً وسريعاً، لم يدم إلا للحظات. من هنا أتى اللقاء بعد سنوات طويلة في القاهرة، (2005) بمثابة دخول إلى هذا القلب الإنساني الكبير. حدث ذلك في معرض القاهرة للكتاب. كنت برفقة الروائي الفرنسي أوليفييه رولان، وقد أصرّ بهاء على دعوتنا إلى الغداء، لكن قبل ذلك شدّد على أن نذهب إلى «مكتبة ومقهى الديوان» (في الزمالك، وكانت فتحت أبوابها منذ فترة قصيرة). أنهينا القهوة، وخرجنا، لكن بهاء تأخر في اللحاق بنا، فعدت إلى الداخل لاستعجاله وبخاصة أن الوقت يداهمنا، إذ علينا أن نكون في المعرض من أجل الندوة التي تضمني ورولان. كان بهاء منهمكا في التوقيع على كتاب ما، فعدت إلى الخارج وقلت لأوليفييه إنه منهمك في التوقيع لسيدة عجوز. بعد دقائق خرج بهاء طاهر برفقة هذه السيدة، وشخصين آخرين، ليقول لنا «أقدم لكما نادين غورديمير» (نوبل للآداب). تسمّر أوليفييه مكانه، ماداً يده للمصافحة من دون أن يتفوه بكلمة، بينما لم أعرف ماذا أفعل وأنا أقف قبالة هذه السيدة. بقيت مفتوح الفم متعجباً، ولم تخرج الكلمات إلا بعد جهد جهيد. ولم يخطر على بالي أن أضرب موعداً معها، لحوار صحافي، إلا بعد أن كانت قد مضت. قلت لنفسي، سأحدثها خلال ندوتها في المعرض، لعلّ وعسى.
في تلك الفترة القاهرية الصغيرة، دارت الكثير من الأحاديث، التي تجد كأنها تبدأ من زمن ماض بعيد، أي وكأنك تستكمل حديثاً انقطع ذات فترة، بالرغم من أنها المرة الأولى التي تلتقي فيها شخصاً وتتحدث إليه. ما أقصده في ذلك كله، أني ولا مرة شعرت عند بهاء بهذه اللعبة التي يلعبها آخرون في اعتبار أنفسهم نجوماً، بل لا تشعر سوى بتواضع هذا الكائن الإنساني المدهش.
عاد هذا اللقاء وتجدد منذ سنوات قليلة، في بيروت خلال ندوة الرواية العربية التي نُظمت خلال معرض الكتاب العربي وضمن نشاطات بيروت عاصمة عالمية للكتاب. لا أخفي أن سعادتي كانت كبيرة حين طُلب مني أن أدير الندوة التي ضمت، إلى جانب بهاء، كلاّ من إميلي نصر الله والحبيب السالمي. كانت فرصة لإعادة وصل الحديث من حيث انقطع. والحديث لا يعني القراءة التي استمرت. وربما هنا، فيما أكتبه الآن عن بهاء، ليس سوى محاولة أخرى للحديث مع كاتب أقدّر وأحترم. لهذا ليس نقداً ما تقدم، بل تحية صغيرة لكاتب لا تزال أعماله تثير فيَّ الدهشة الجميلة.
أبناء رفاعة وجدل الثقافة والحرية
حاتم حافظ
(1)
حتى صرت مراهقا لم أكن قد قرأت لبهاء طاهر، بل لم أكن أعرفه تقريبا، لم أكن قد قرأت لأي من كتاب جيله أيضا. كنت مشغولا وقتها بتوفيق الحكيم الذي صاحبته للتعرف الى أسماء كابن عربي وابن عبد ربه والجاحظ والأصفهاني. حين نال نجيب محفوظ جائزة نوبل وكنت وقتها في الرابعة عشرة قرأت له للمرة الأولى رواية لم تعجبني (الحقيقة أني لم أفهمها) فأجلت قراءته. في الفترة نفسها وقع في يدي كتاب صغير بينما كنت أقلب في الكتب القديمة بسور الأزبكية، قرأت عنوانه فاستحسنت إيقاعه الشعري ورومانسيته. كان كتاب «بالأمس حلمت بك» الذي قرأته فور أن عدت للبيت متجاهلا كل الكتب التي اصطحبتها معي. بعد قراءة القصة الأولى والتي حملت العنوان نفسه قررت إعلان ندمي على ضياع السنوات العشر الماضية وهي عمري بعد تعلم القراءة!
(2)
في صيف بعيد عرفت أن أستاذي دكتور حسن عطية يرغب في إرسال بعض الأوراق لبهاء طاهر لتوقيعها. كانوا بصدد تأسيس جمعية لنقاد المسرح وتم اختيار بهاء طاهر كرئيس شرفي لها. بادرت بالتطوع للمهمة، حتى أني لم أخبر أيا من زملائي في قسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية. كنت أرغب في رؤية كاتبي المفضل، في رؤيته للمرة الأولى، دون شريك. في الموعد المحدد كنت أمام الباب بحي الزمالك. أدخلني أحدهم إلى غرفة صغيرة مفتوحة على الصالة وتطل شرفتها على حديقة ما. كانت شقة بسيطة للغاية أثاثها قديم بعض الشيء وثمة كتب قليلة وشت بأن الغرفة ليست غرفة القراءة والكتابة، وكان يمكن سماع موسيقى كلاسيكية قادمة من غرفة أخرى. بعد دقائق قليلة رأيته قادما من الداخل مرحبا بي بطريقة أبناء الريف حين يبادرونك «زارنا النبي»! من يعرف بهاء طاهر جيدا يعرف أنه أحد الجديرين القلائل بالبنوة لرفاعة الطهطاوي، الشيخ الأزهري الذي سافر لفرنسا ليعود بكتابه الفذ «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» محاولا صياغة مستقبل المصريين مرتكزا على تراثهم الثقافي المحلي وعلى المنجز الحضاري الكبير للغرب، لهذا فإن الترحيب الريفي على خلفية موسيقية كلاسيكية كهذه لن تكون مستغربة أبدا.
بهاء طاهر نفسه نشر كتابا بعنوان «أبناء رفاعة» عام 1990 ووضع له عنوانا فرعيا «الثقافة والحرية» ملخصا إجابته الشخصية، وإجابة رفاعة وأبنائه، على سؤال المستقبل. الكتاب كانت له ضرورة ثقافية كبيرة فقد تزامن مع صعود الإرهاب والأفكار التكفيرية المؤسسة للإرهاب، لهذا كان العنوان في حاجة لتأكيد على الثقافة والحرية، أو كما عبّر هو نفسه في مقدمة الكتاب على «ثقافة الحرية».
في الكتاب أيضا ثمة هاجس حول الهوية، وحول إعادة اكتشاف الإجابات التي صاغها أبناء رفاعة للأسئلة القديمة الجديدة، سؤال الهوية وسؤال الحداثة وسؤال المستقبل. هاجس الشيخ الأزهري كان نفسه هاجس أبنائه كان نفسه هاجس بهاء طاهر، وهو الهاجس الذي تسرب لعدد من كتابات بهاء طاهر الإبداعية قبل كتابه وبعده. هاجس الشرق والغرب، الذات والآخر، ثقافتنا وثقافتهم، النحن والهُم، من أول «أنا الملك جئت» وحتى «لم أعرف أن الطواويس تطير». ثمة أشخاص يرون أنفسهم في مرآة الآخر طوال الوقت، ويحاولون صياغة هويتهم باستلهام التاريخ بعد عصرنته، باستعادة التاريخ ليحيا في المستقبل، استعادة ليس لها علاقة بالحنين للماضي، ولا بخلق تصورات وهمية عن التاريخ، وإنما لها علاقة بفكرة الامتداد، بمد الجسور بين ما كان وما سيكون، دون أن يجعل لما كان سلطة ما على ما سيكون. لها علاقة بإعادة النظر فيما كان لا للتشكك فيه لاستبعاده ولكن لاستعادته نقيا بلا زيف وبلا مبالغة كي يتمكن من الصمود في الحاضر. لنقل إن كتابة بهاء طاهر مسكونة بهاجس يتعلق بكيفية تجاوز هذه الثنائية أساسا، بين الماضي والحاضر.
في اختياره لترجمة رواية البرازيلي باولو كويلو الأشهر «الخيميائي» أو «ساحر الصحراء» تجدد لمعنى بهاء طاهر. الرواية الشهيرة تدفعك للتفكير في اكتشاف ذاتك، في اكتشاف أن الكنز الذي بين يديك وتحت أقدامك لن يمكنك اكتشافه إلا عبر رحلة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا مرورا بالعالم. هل ترجم الرواية لأنها رواية مهمة أم لأنها تدفع باتجاه اكتشاف الذات، تدفع باتجاه الثقافة والحرية؟ بطل الرواية يرحل للبحث عن كنز سوف يكتشف في النهاية أنه برحيله قد تركه هنا، لكنه يعرف أن اكتشافه للكنز لم يكن له أي معنى لولا رحيله عنه، لولا الرحلة التي خاضها للبحث عنه، لولا رحلة التحرر منه لاستعادته. الثقافة والحرية مجددا. الرواية التي صدرت عام 1988 وصدرت ترجمتها عام 1996 هي نفسها تشبه بعض أعمال بهاء طاهر، لا يمكن لأحد أن يخطئ التقارب بينها وبين قصة «أنا الملك جئت» 1985 ولا بينها وبين روايته «واحة الغروب» 2006. الرواية المترجمة فيما يبدو كانت رواية أخطأت طريقها للبرازيل فيما كان من المفترض أن يكتبها بهاء طاهر!
في العملين المشار إليهما وفي غيرهما ثمة اتصال بين الشرق والغرب، اتصال يترتب عليه مرارات في كثير من الأحيان خصوصا في الأعمال الأولى. اتصال يبحث عن طريقة للاستمرار، ينجح أحيانا حين يكتشف الأرضية الإنسانية التي تجمع الجميع، حتى ولو كانت الأرضية الإنسانية هذه لها وجع المأساة، مأساة البشر. لهذا سوف يحل الإسكندر الأكبر باعتباره الوسيط الحضاري بين حضارتين، وسوف تحل الإسكندرية باعتبارها جغرافيا الاتصال. الإسكندر يحضر بقوة في كتاب بهاء طاهر «أبناء رفاعة» قادما من كتب طه حسين أحد أهم أبناء رفاعة، وبالمناسبة ثم إشارة شديدة الذكاء إلى الأزهريين الذين تعلموا في فرنسا من الشيخ رفاعة للشيخ طه حسين، كما لو كان الإسكندر هو نموذج عكسي للفرنسي الذي يتعلم في الأزهر.
العجيب في كتاب «أبناء رفاعة» الذي صدرت طبعته الثانية عام 2009 في أنه لا يسجل فحسب تصاعد ثقافة الحرية كما يوحي العنوان، ولكنه أيضا يسجل هبوط ثقافة الحرية حتى ينتهي لفصل معنون بـ «خلاصة ونتيجة: كيف وصلنا إلى الإخوان؟» هذا قبل أن صعود الجماعة للحكم في مصر بعامين ونصف!
في تحليل بهاء طاهر، والذي أظنه صحيحا، أن المشروع الليبرالي المشار إليه باعتباره حاضن ثقافة الحرية تعرض لهزتين، الأولى بالاستعمار الذي عطّل المشروع والثانية بقيام ثورة يوليو، رغم أن الهزة الثانية لم يكن توابعها بالدرجة نفسها. ففي مرحلتها الأولى تم تكريم رموز الليبرالية كطه حسين مع حرمانه من استكمال مشروعه للنهضة الثقافية والذي وضع برنامجه في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» 1938 وبدأ في تنفيذه حين صار وزيرا للمعارف عام 1950. أما في المرحلة الثانية فقد صارت الدولة في مواجهة مباشرة مع مثقفيها، حين لاحق نظام السادات كل رموز الثقافة والاستنارة بل إنه استأجر كتابا مخصوصين لشتم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ! وهي المرحلة التي تسببت في استحضار شبح الأصولية لمهاجمة خصوم السادات، هذا قبل أن ينقلب السحر على الساحر!
بهاء طاهر كحداثي مستنير يرى أن الحل في طرد شبح الأصولية عبر تقدم الطليعة التنويرية الجماهير، يقول «ما نحتاج إليه أن ينهض من جديد أنصار الدولة المدنية المؤمنون بأنها هي التي قدمت وما زالت قادرة على أن تقدم خيرا كثيرا لهذا الوطن، وأن يطرحوا برنامجا معاكسا في الاتجاه ومساويا في الأهمية لفكر الإخوان، دون أن تلاحقهم أجهزة الدولة وتقمعهم».
(3)
وبالعودة للثقافة والحرية، فهما في ظني مفتاحا فهم حياة ونشاط بهاء طاهر الإبداعي والثقافي والسياسي. نجد أن في رواياته وقصصه ثمة محاولة دائمة لمساندة إرادة الكلام، لمساندة إرادة الكلام عند الشخصيات بإزاء إرادة كلام السلطة. إرادة الكلام عند السلطة، الاجتماعية والسياسية، ترغب في قمع إرادات الكلام عند البشر، ومن ثم فإن شخصيات بهاء طاهر تندفع لتحقيق إرادتها في الكلام مقاومة أشكال السلطة التي ترغب في إسكات الجميع، «خالتي صفية والدير» و«الحب في المنفى» و«واحة الغروب» كلها تشي بأن الشخصيات سوف تستمر في الكلام متحدية كافة مؤسسات القمع سواء تلك التي يصنعها الاجتماع أو تلك التي تصنعها القوة.
يمكن فهم دور بهاء طاهر السياسي أيضا في بعديه الثقافي والتحرري. بهاء طاهر على امتداد حياته لم يشارك في السياسة في بعدها الحزبي، وإنما في بعدها التحرري والثقافي، فقد كان واجهة العمل السياسي المقاوم لنظام مبارك البوليسي في حركة كفاية التي تأسست عام 2004، داعيا لمقاومة هذا النظام بكافة السبل، ولهذا السبب فإنه أحد الكبار الذين لم يتسرب إليهم اليأس من نجاح الثورة، أحد الكبار الذين لم يتسلل إليهم الشعور بالعجز أمام تغول السلطة الدينية للتيارات الأصولية التي وصلت لحكم مصر، ربما لأنه كان يعرف الداء ويعرف أن الثورة المصرية، رغم تعثرها، قد عرّت الأصولية تماما وفضحت شعاراتها.
قبل أيام افتتح مؤتمر المثقفين وألقى بيانه الختامي ووقع على استمارة تمرد الداعية لسحب الثقة من محمد مرسي. في كلمته قال إن الأصولية لن يمكنها إزاحة الخيال، وإن الثورة ستنتصر لا محالة لأنها ثورة للحرية، وإن من يهاجمون الثقافة سوف يذهبون إلى مزبلة التاريخ فهي جديرة بهم. وقال فيها أيضا إن الهجمة على المثقفين لها سابقة انتهت بانتصار الثقافة. فقد كان بعض كتاب الصحف المدفوعين من نظام السادات يهاجمون كل المثقفين المعارضين للسادات وسياساته بل إن النظام موّل مجلة خصصت صفحاتها لسب نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، كما أشرنا أعلاه، وقد انتهى أمر هؤلاء وأمر المجلة وبقي محفوظ والحكيم، بل إن بهاء طاهر نفسه اضطر للسفر وقتها بعد منعه من الكتابة، وأزيد أنه قد انتهى أمر مانعيه من الكتابة وبقي بهاء طاهر!
(4)
لا يمكن اختزال مشروع بهاء طاهر في كتبه، ليس فحسب بسبب قلتها «17 كتابا على مدار 40 عاما منها 10 كتب إبداعية فقط» ولكن أيضا لأنه في الأوقات التي لم يكن يكتب فيها كان يعمل فيها، خصوصا فترة عمله كمخرج بإذاعة البرنامج الثقافي والتي قدم خلالها عددا ضخما من المسرحيات العالمية التي قدمت للمستمع العربي للمرة الأولى. لهذا يمكن القول إن معنى بهاء طاهر في عدم التفريق بين العمل من أجل الثقافة والعمل من أجل الحرية، فلا ثقافة بغير حرية ولا حرية بغير ثقافة.
(روائي ومسرحي مصري)
«إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»
احمد الفخراني
منذ سبع سنوات على ما أذكر، كتبت شهادة ساذجة عن بهاء طاهر، لجريدة أخبار الأدب، قبل أن تحتل من قبل الإخوان المسلمين، لتصير أكثر سذاجة مما كتبته حينها، المركب تغرق والقافلة تسير، وكما يعرف الجميع الأديب الذي ينبح لا يعض، وخيرت الشاطر على غلاف أخبار الأدب الآن بدلا من بهاء طاهر، وما زال النيل يجرى إلى حين، ولم يحل أحد السؤال الأكثر جوهرية في السبع سنوات الماضية، الذي هتفه عوكل: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟.
صديقي وأستاذي بهاء طاهر، أعرف أنك أحببت الشهادة القديمة، كنت صادقا على الأقل برغم حرجي من ذكرها الآن، والتي خلاصتها أن طفلا ساذجا جاء من الإسكندرية إلى القاهرة ليمشي مذعورا من الكباري العلوية؟ ثم رآك صدفة مطمئنا في جلستك فتحلى بالشجاعة!!!
الطفل كبر قليلا، الكباري العلوية صارت حياته، أعلق بها وتعلق بي، لم تعد مخيفة، لم تعد جميلة أو قبيحة، لم تعد شيئا، صارت حياتي، وحياتك، وكل شيء؟
هل كانت القاهرة في الثمانينيات وديعة، أم أنها كانت بداية الشراسة المتخيلة؟ هل تخيلت أنها ستصير أشرس وأنها ستأكل قاطنيها، كانت تلك هي الصورة النمطية في ذهني حينها، بعد الآن، لكن لا شيء على الإطلاق تخطت معنى القبح والدمامة، سقط ربما ما تكتب لأجله، لا شيء يدعو للخوف من السيارات المسرعة، فهي في الغالب عالقة في الطريق إلى الجحيم، لا تخطو للأمام ولا للوراء، وجوهنا تخطت الأمر.
أعلم أنك تخشى أخونة الثقافة؟ لا أعلم في الواقع أي ثقافة، جسد ميت ينهشه جسد ميت، لا فارق، المثقف الذي يظن أن انقطاع التيار الكهربائي، المياه أقل أهمية من أخونة الجسد الميت، ما زال كمحمود عبد الظاهر مأمور قسم سيوة في «واحة الغروب»، يعاني الانفصام والتمزق»نصف طيب ونصف شرير نصف وطني ونصف خائن، نصف شجاع ونصف جبان نصف مؤمن ونصف عاشق، دائما في منتصف شيء ما»، وأزيد نصف وجه لا قبيح ولا جميل، لا شيء يدعو للخوف، فالشيء المخيف قد حدث، التفاحة العفنة لا يمكن أن تتعفن أكثر، لكن الآلة التي بلا وجه، لا زالت تقذف اليقين، يقين الثوار بالثورة، والمثقف بأهميته، لا زال يجلد ذاته، من دون أن يرى السؤال الجوهري: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟
يقول فاروق شوشة في مداخلة تلفزونية: إن الشعب المصري قد يصبر على انقطاع المياه، على الفقر، على الكوارث..لكنه سيقوم منتفضا دفاعا عن دار الأوبرا، لأنها تمثل «نقطة النور» في حياته.
في أي دولة يعيش المثقف الذي نقدته في أعمالك ولا زال يطالعنا؟ هل اكتفى من جلد ذاته، وممارسة التيه في أدغاله، ماذا لو انتصر مثقف يؤمن أن المصري يرى دار الأوبرا أهم من حياته اليومية الصعبة.
لو تملك مقاليد الأمور، اعتقد أنه سيفترض شيئا ما أكثر قبحا من فراغ الإخوان، سيحاول فرض تصوره الخاص على «هوياتنا»، سيقف ليتساءل هل مصر فرعونية أم اغريقية أم اسلامية أم قبطية؟ من دون أن يفكر ربما، أن سيد قطب لم يختلف عن جمال عبد الناصر، وأن المدرسة التي تفترض فينا شخصا واحدا يسير بخطة معدة سلفا لإنتاج شيء مبهم، لا فارق فلينتصر الإخوان، لو أديرت المعركة بمنطق محمود عبد الظاهر.
في قالت ضحى: لا يبكي المثقف الماركسي انحسار دوره، بل فقدانه لهمينته أمام هيمنة أخرى للإسلامي والنفطي والغربي، لا لشيء الا أن دوره قد همش. يقف ليختلف مع المستبد الإسلامي، من دون أن يعي أنه يشاركه نفس الخطيئة: ترويج الغرب/الآخر كعميل، شرس، قاتل، وأن المؤامرات الكونية لم تنقطع عن الدولة.
ربما يا صديقي بهاء، والدنا في الكتابة، التي تعلمنا منك احترامها، لو أنك كتبت رواية الآن عن مثقف، لجعلته يتوقف عن الأسئلة الوجودية الكبرى، عن انفصامه، عن ترويجه لهوية واحدة قاصمة لا يجب أن نحيد عنها، لجعلته رجلا يمكن أن يتساءل مسطولا: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ القاهرة، لا سبيل الا الاعتراف بأنها بلا وجه، أي فراغ يتلبسها، لو أنك كنت ستكتب عنها الآن، ربما لرأيت جاذبية وجمالاً في هذا، بلد بلا دماء لتراق، الفراغ سينتصر!
(روائي مصري)
كلام شخصي
هالة جلال
مكتبة أبي الكبيرة، تلامس سقف الغرفة وأنا قامتي لا تسمح إلا ببلوغ الثلاثة رفوف الواطئة المخصصة للأدب والشعر العربي هناك عرفت بهاء طاهر، في عمر مبكر، قرأت (قالت ضحي) لأول مرة قبل أن أعرف شيئاً عن القراءة أو اللغة أو الادب… كانت صور تقفز أمام عيوني كلما قرأت رواياته.. تخيلتها أفلاما قبل أن أدرس السينما أو أقرر العمل فيها، أسمع شريط كاسيت في بيتنا فيقول أبي:
– «ده بهاء».
– «ودي بنته».
كان صوته الرخيم يسأل ابنته عايزة إيه يا حبيبتي؟ والطفلة ترد تاتا سيت… يضحك ابي ويفسر كانت تريد شوكلاته وبسكويت، كانت هذه الشرائط التي يسجلها أبي وأصدقاؤه تتضمن غناء لمحمد حمام في مجلس خاص, قصائد شعرية، نكت، وكانت مليئة بالبهجة والحميمية، كان أبي يسمع هذه الشرائط كلما افتقد اصدقاءه.
هذه السنوات التي لم نر فيها بهاء طاهر كنت اسمعهم يقولون إنه مضطر إلى أن يكون خارج البلاد…. لم أكن أفهم تماما لماذا، وانما اعرف بحكم الخبرة الصغيرة مع العائلة انه لا بد أغضب السلطة.
تابعت قصة أرض شرق النخيل عندما نشرت حلقات في صباح الخير وأعطاها لويس جريس الذي كان رئيس التحرير اسم هو جملة في الرواية «لو نموت معاً».
في اليوم الذي قررت فيه أن أنشئ مكتبتي الخاصة لأستقل عن مكتبة أبي بدأت بشراء روايات بهاء طاهر وأعدت قراءتـــه وكان أبي يدعـــوني لاستخدام نســـخ مكتـــبته بإلحـــاح ليوفـــــر امـــوالي الضـــئيلة ولكـــني كـــنت أرفـــض.
كان معيار هام بالنسبة لي لتصنيف البشر ان يكونوا يعرفون بهاء طاهر أم لا، ويحبون رواياته أم لا.
نعم كنت متعسفة في هذا العمر ولا أساوم علي أي شيء وخاصة روايات بهاء طاهر.
عندما عرفت أنه عاد الى القاهرة رتبت مواعيد له مستخدمة علاقة أبي به ليقابل كل اصدقائي المحبين لرواياته والذين كان بينهم سينمائيون يحلمون بتحويلها لأفلام وبعضهم كان بالفعل استخدم رواية له وكتبها كسيناريو لمشروع تخرجه من معهد السينما، مشاريع كلها لم تتحقق افلام وإنما حققت التعارف عليه وعلى العالم من عيونه.
في حدث جلل تعشى في بيتنا في رأس السنة.. قضينا الليلة كلها أبي وأمي وخالي ابراهيم وأنا ومها وهدي وبهاء طاهر نتراهن إن كانت أميركا ستضرب العراق أم لا، سنوات مرت على هذا العشاء الذي جعلني أقرر ان اصنع فيلماً عنه بسبب كل ما حكي في هذه الليلة، حصلت على هذه المنحة من المؤسسة الثقافية السويسرية وذهبت لجنيف وزيوخ واستعرت كاميرا واشتريت شرائط وحملتها على كتفي أدور في المدن والزوايا التي أستوحي منها وفيها قصصه التي شكلت خيالي في الصبا، كان يعرض دائماً ان يحمل معي الكاميرا وأنا أداعبه قائلة هل رأيت أحمد رمزي يحمل كاميرا يوماً لمساعد فريق العمل، انا فريق العمل كله، عرفني على اصدقائه وفتح بيته وكان كريما في اخلاقه وطباعه وكل شيء، عرفت جميل عطية ابراهيم معه وقضينا اياما مرحة شاقة بسبب وزن الكاميرا وانما لا تُنسى من فرط الدفء والمحبة، عدت للقاهرة لأنتهي من الفيلم الذي حضر بهاء طاهر عرضه وعرض في التلفزيون المصري الفيلم بعنوان «رحلة». كان شعور عجيب كأني رأيت حلماً يتحقق أو كأني في يقظتي زرت حلما أحبه لقد أخذني لكل ركن كتب عنه «الحديقة الحجرية»، فن الحب في المنفى، محطة الاتوبيس في «بالامس حلمت بك»، القصة غير العادية في مجموعة «انا الملك جئت». الآن كلما رأيت بهاء طاهر أخجل ولا أعرف ماذا أقول له انا مديونة له (بين آخرين) بتشكيل وعيي الادبي والوجداني في سنوات مبكرة جدا من عمري.
(مخرجة سينمائية مصرية)
في صراع المثقف والواعظ صارت الغلبة بعد 1967 للواعظ
بهاء طاهر: الإخوان أعداء التفكير
محمد شعير
رسم إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني الراحل صورة للمثقف باعتبارها ذلك الشخص الإشكالي المزعج والمقلق دائماً للسلطة..: «مهمته أن يطرح علناً للمناقشة أسئلة محرجة ويجابه المعتقد التقليدي والتصلب العقائدي بدلاً من أن ينتجهما… ويكون شخصاً ليس من السهل استيعابه، وأن يكون مبرر وجوده تمثيل كل تلك الفئات من الناس والقضايا التي تنسى ويغفل أمرها على نحو روتيني». كان يتساءل دائماً هل يمكن أن نجد في ثقافتنا العربية ذلك النوع من المثقفين؟
قد يتبادر إلى الذهن شخصيات عديدة.. ولكن بالتأكيد سيحتلّ بهاء طاهر المقدمة.
ورث بهاء من والده الشيخ الأزهري النهم الشديد للقراءة والاعتزاز بالنفس، ورث عن والدته الحساسية المفرطة أحياناً.. حساسية جعلته يرفض لسنوات قبل الثورة مطالعة الجرائد ومتابعة نشرات الأخبار، وتحديداً بعد أن ضربت إسرائيل غزة.. وقتها أصيب بالاكتئاب الشديد لعجزه عن أن يفعل شيئاً بينما يقتل الأطفال بالقنابل يوماً وراء آخر ويلف العالم صمت عن الجرائم… في ذلك الوقت لم يتخلّف بهاء عن الكتابة ليفضح هذا الصمت، أو المشاركة في التظاهرات باعتبارها «واجباً وطنياً». نال نصيبه من القنابل المسيلة للدموع أو العنف المفرط من جانب السلطة أحياناً.. حتى قبل أيام من اندلاع الثورة المصرية. في تظاهرة للمثقفين بالشموع احتجاجاً على تفجير كنيسة القديسين (يناير 2011) هجم الجنود والضباط على المحتجين، ووقع بهاء أرضاً، وعندما ذهبنا غاضبين إلى الضابط المتوتر: كيف يحدث ذلك مع كاتب كبير حصل على جائزة تحمل اسم رئيسهم مبارك. قال الضابط إنه لم يقصد، ولكن الأوامر الصادرة لهم تمنع التظاهر هذه الأيام (بعد الثورة التونسية) والتصدي لها بقوة… ثم صمت قليلاً: «بس مين بهاء طاهر والغاضبين من أجله؟!».
في أول ايام الثورة (25 يناير) أصيب بهاء طاهر بجلطة في ساقه. لم يعرف الكثيرون بالأمر لأن صاحب «الحب في المنفى» كثيراً ما كان يتحامل على ساقه المتعبة ويتواجد في الميدان. الأسبوع الماضي تقريباً، كان ينهي جلسات العلاج الطبيعي ويتجه، أيضاً مستنداً على عصاه، لمساندة المثقفين ودفاعهم عن الثقافة، لم يتردد أن يستقيل من المجلس الأعلى للثقافة ويتنازل عن جائزة مبارك في أثناء الـ 18 يوماً لأنه لا يتشرف بجائزة تحمل اسم «ديكتاتور يقتل الشباب في الميدان»..
الموقف نفسه الآن يعيده بهاء باستقالته من المجلس الأعلى للثقافة بعد تعيين وزير ثقافة مهمته «تجريف الثقافة المصرية»… بهاء لم يتردد الأيام الماضية على أن يخرج من بيته في درجة حرارة مرتفعة كي يساند شباب الثورة والفن في وقفاتهم ضد «تجريف الثقافة»… لم يتردّد في «احتلال مكتب الوزير» والاعتصام به للمطالبة برحيله.. لم يبحث عن صوره «كأفندي».. او ما يجرّه عليه هذا الموقف من مشكلات فيما بعد.
بهاء طاهر مشاغب شاب يحمل عصاً يتوكأ عليها. هو لا يفعل ذلك انطلاقاً من موقف «رومانسي» لدور المثقف.. يقول: «أنا مجرد مواطن عادي عليه دور معين، له رأي في شؤون بلده».
في سنوات السبعينيات واجهت الثقافة المصرية تقريباً الوضع ذاته.. الرئيس السادات ينظر للمثقفين بريبة.. يختار المنفى كثيرون في تغريبة اعتبرت «التغريبة الكبرى» في الثقافة المصرية.. كان ممنوعاً نشر أي أعمال لأهم كتاب مصر بل من الممنوع ذكر أسمائهم في الصحف أو الإشارة إليها… أغلقت كل مجلات الثقافة «اليسارية».. مثل الطليعة وغيرها… هاجر المثقفون بأقلامهم وبأجسادهم، وقائع عندما يتذكرها صاحب «الحب في المنفى» يشعر بالتفاؤل لأن «الثقافة خرجت منتصرة في هذه المعركة، رغم اننا كنا قوة ضعيفة في مواجهة سلطة دولة بأكملها، وسلطة الوعاظ الذين جلبهم السادات من دول الخليج»… يضحك: «كان هناك مجلة اسمها الجديد، يرأس تحريرها رشاد رشدي كانت تخصص أعداداً خاصة لشتيمة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ.. ولكن لم تبق المجلة ولا الشتامون.. وبقي الحكيم ومحفوظ». المشهد الحالي هو تكرار لمشهد قديم إذن، مشهد بائس.. ولكنه أكثر خطراً: «لأن سلاح الدين هذه المرة يستخدم بشكل بائس، عندما يصف شخص أدب نجيب محفوظ بأنه أدب «دعارة».. ويستخدم الدين كحجة وسط جمهور ليس لديه ثقافة كافية للفرز يأتي من هنا الخطر». يضحك بهاء طاهر قبل أن يوضح: «قرأت مجموعة قصصية لعبد الجليل الشرنوبي الذي كان منضماً لجماعة الإخوان وكان رئيساً لتحرير موقع «إخوان اونلاين».. كتب في مجموعته أنه عوقب في الجماعة، لأنهم وجدوا لديه روايتي «الحب في المنفى» ونصحوه وقتها ألا يعاود قراءة مثل هذه الكتب مرة أخرى… هذه جماعة تدرب أعضاءها على السمع والطاعة.. وليس لديها علاقة بالثقافة، وآخر فرد فيها كان لديه علاقة بالثقافة هو سيد قطب في مرحلته الليبرالية، التي اعتبرها تاريخاً لم يكن.. الثقافة تفكير.. وهم ضد التفكير، ولا يريدون سوى السمع والطاعة».
وصف بهاء طاهر أيام الثورة.. وما تلاها بـ: «أيام الأمل والحيرة» وهو العنوان الذي اختاره لأحدث كتبه.. ولايزال يرى أننا نعيش هذا الوصف بعد وصول الإخوان إلى السلطة أيضاً يقول: «الثورة فتحت طاقات من التوقّعات والآمال الهائلة، حتى أنني قلت يوم تنحّى مبارك أنني فرحت فرحة تكفي عشر حيوات، لا حياة واحدة.. ولكن ما حدث بعد ذلك وضعنا جميعاً في حيرة، حتى أننا لا نعرف ما الذي يحدث في مصر ولا سبيل الخروج منه». يوضح فكرته: «هناك أمل لأن هناك قوة دافعة لهذه الثورة، كلما بدت أنها تموت، تبعث من جديد.. الآن هناك تململ لدى كل فئات المجتمع: القضاة غاضبون، والإعلام، والمثقفون، والشارع.. ولكن كل يعمل منفرداً، لا يوجد مسعى لتوحيد الجهود لنخوض معركة حقيقية تؤدي إلى النصر أو النصر أيضاً، لأن الثورة ستحقق أهدافها لقوة إيمان شباب الثورة.. وكل الثورات يحدث فيها انتصار وانكسار ولكنها تنجح في النهاية».
المثقف والمناصب
بعد الثورة رفض بهاء طاهر منصب وزير الثقافة، هو يؤمن أن المثقف لا ينبغي أن يكون في وزارة ما، يكفيه أن يكتب ويقول كلمته. سألته: ولكن طه حسين قبِل الوزارة في وقت من الأوقات؟ يجيب: «لست في مرحلة وحالة صحية تسمح لي بهذا المنصب. أنا أعيش الآن مرحلة كناسة الدكان، لا أطمع في منصب ولا أرغب في إثارة..». سألته: ولكن لو قبلت وزارة الثقافة ما الخطط التي كنت ستقوم بتطبيقها؟ يصمت قليلاً قبل أن يجيب: الخطط التي يمكن أن أقوم بتطبيقها هي تطبيق حرفي لوصايا طه حسين في «مستقبل الثقافة في مصر»… هل الأمر كارثة أن نعود إلى أفكار مضى عليها أكثر من 80 عاماً وكأن المجتمع لم يتطور أو يتحرك؟ يجيب: «ليس من العار أن نعترف أن هناك عقليات جبارة، تعيش ويستمر دورها طويلاً في المجتمع حتى بعد موتها، ولكن لو أردت أن أنفذ أفكار عميد الأدب العربي سأنفذها في ضوء المعطيات الجديدة، حيث وسائل الاتصال التي لم تكن موجودة أيامه.. ولكن الأهم أن الفكرة الرئيسية للعميد هي: «تعليم من أجل الديموقراطية» وهو ما ينبغي أن نعمل جميعاً من أجله الآن».
إهمال الثقافة في المجتمعات العربية، وتراجع دورها هو ما جعل الساحة خالية للثقافة السلفية والإخوانية… لذا يرى: «إنها معجزة أن يكون هناك جمهور للأدب وسط الطغيان الإعلامي الترفيهي، والرياضي، ووسط التعليم البالغ الرداءة، والأزمات الاقتصادية التي تجعل الكتاب في أدنى اهتمامات المواطن العادي.. حقيقة لا أعرف حلاً لهذا اللغز؟».
المثقف والأمير
قضية المثقف والأمير.. تحتلّ مكانة بارزة في مشروع بهاء طاهر الإبداعي والفكري.. هل هي خيانة المثقفين التي أوصلتنا إلى الإخوان المسلمين؟ أم أن المجتمع تتنازعه دائماً العلاقة بين الجنرال والفقيه؟ سألته وأجاب:
في الحقيقة، المجتمع يتنازعه صراع بين المثقف والواعظ، ولكن منذ السبعينيات أصبحت الغلبة للواعظ. بفضل المثقف أصبحنا مجتمعاً مدنياً، وبدأ ذلك بالاستقلال عن الخلافة العثمانية وفكرة الحكم الديني، ثم بدأت الحديث عن فكرة «المواطنة» التي أسهم فيها رفاعة الطهطاوي، الذي أكد أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات مهما كان دينهم. ثم جاء محمد عبده ليؤكد أنه لا ولاية لأحد على عقيدة مسلم إلا ضميره، ثم كانت النقلة الحاسمة بالاعتراف بحقوق المرأة وكانت أيضاً على يد محمد عبده وقاسم أمين. كل هذه كانت مقدمات للدولة الحديثة التي انتقلنا إليها مع تسرب أفكار الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وهي نقلة ساهم فيها المثقفون أمثال طه حسين ويوسف إدريس وآخرين، أجيال متعاقبة أسست للدولة المدنية، ولكن بداية من نكسة 67 بدأ المجتمع ينحّي المثقف جانباً لمصلحة الواعظ، بدعم قوي من الحاكم وتحديداً عندما تولى السادات الحكم.
ولكن أنت تعيد الأمر إلى نكسة 67؟
عبد الناصر كان مضطراً لذلك، لأنه كان يريد أن يبعث في الناس نوعاً من الأمل والإيمان بالقضية الوطنية التي لا يمكن الخلاف عليها، ومن هنا أسبغ بُعداً دينياً على القضية الوطنية، وهذا حدث في روسيا مع الغزو النازي، بدأ هناك نوع من المصالحة مع الكنيسة الأرثوذكسية التي لم يكن مُعترفاً بها، يعني في فترات الهزيمة يعود الناس إلى الدين دائماً. ولكن في أيام عبد الناصر لم تكن هناك محاولة لفرض هذه الرؤية الوهابية على الثقافة والمجتمع المصري. الذي فعل ذلك السادات خطوة خطوة حتى وصلنا الآن إلى الإخوان. ما أريد أن أؤكد عليه أن الخلاف الجذري على مدى القرن كان بين المثقف والواعظ، واستطاع المثقف على مدى عشرات السنين أن يُحدث نقلة هائلة لننتقل من دولة قرون وسطى إلى دولة حديثة، ولكن مع هزيمة 67 والانقلاب على مبادئ الثورة المصرية أصبح للواعظ الغلبة، ورجعنا مرة أخرى الآن إلى مفاهيم الخلافة العثمانية التي كانت «استعماراً دينياً من نوع غريب»، حسب وصف جمال حمدان.. ولو لم يكن لهذا الغزو قشرة دينية لحاربه المصريون كما حاربوا التتار.
أسأله: ولكن المثقف لم يكن سوى مفكر للجنرال، لم يكن يستطيع أن يحقق حداثة للمجتمع إلا مستنداً على سلطة الباشا أو الجنرال ولذا لم تبنِ الحداثة سلطة في الواقع مع الجمهور بقدر ما كانت تستند إلى سلطة قاهرة وقامعة؟
لن أختلف معك كثيراً، ولكن سأسألك سؤالاً: ماذا كان سيصبح محمد علي لولا وجود رفاعة الطهطاوي إلى جواره؟ وسأجيب أيضاً: سيكون مجرد حاكم مثل علي بك الكبير أو خورشيد باشا، لولا رفاعة ما كان محمد علي. الأمر الآخر رفاعة سافر إلى فرنسا في بعثة لتحديث الجيش المصري، إذن اقترنت حكاية النهضة بتكوين الجيش الوطني، وعلى مدى تاريخ مصر سنجد تناغماً بين الجيش والحركة الوطنية. ولكن لولا وجود رفاعة بجوار محمد علي لأصبح المجتمع مثل اليمن والحجاز وهي مجتمعات لم يحدث فيها ذلك التلاقح بين الحاكم الوطني والمثقف الوطني.
أزمة سيد قطب
تؤمن إذن أن المثقف يمكن أن يكون ناصحاً للأمير أو جسراً يعبر عليه الأمير لتحقيق طموحاته؟
ولكن ألا يمكن أن يعمل المثقف في مشروعه منفصلاً عن السلطة بدون الاستناد إليها؟
يحدث ذلك أحياناً، وبعد وقت قد تدرك السلطة أهمية مشروع هذا المثقف، ولكن للأسف لم يحدث ذلك كثيراً، مثلاً مشروع جمال حمدان في «شخصية مصر» لم يلتفت إليه أي حاكم، ولم يدرك أهميته.
وهل تعتقد أن المثقف محكوم بالأسلاك الشائكة في علاقته بالسلطة لا ينبغي أن يتجاوز هذه الأسلاك؟ مثلاً عندما كتب طه حسين كتابه «في الأدب الجاهلي» استند إلى سلطة تخلت عنه فرفض أن يعيد نشر كتابه، هل لا يخوض المثقف معركته من أجل الحرية إلى النهاية؟
هناك فرق بين التراجع عن الأفكار وبين المناورة. على مدى التاريخ الإسلامي لا يوجد من تراجع عن أفكاره إلا فقهاء السلطان الذين لا يذكرهم أحد بينما أبو حنيفة مثلاً تحمّل السجن والتعذيب، وفي فرنسا موليير كان جوهر أعماله ضد استبداد لويس الرابع عشر، ولكن كانت لديه مناورة في علاقته به. أي ينبغي أن نفرق بين المناورة والتراجع. ولكن أظن أن السلطة المصرية ارتكبت أكبر جرم في ما يتعلق بالثقافة وهو اللامبالاة، كان من حقنا أن نتحدث ونكتب كما نشاء ولكن لم يكن لكلمتنا أي أهمية. حتى أنني كتبت مرة أنني أحنّ إلى عصر الرقابة، لأن وجود الرقابة يعني أن لكلامك أهمية ما تزعج السلطة، ولكن اللامبالاة الكاملة في عصر مبارك تجاه ما نكتب لا تعني سوى أن كلامنا كان مجرد «طق حنك».
في دولة الخلافة التي تستند إلى مرجعية دينية زائفة عمّ «الخراب إقليم مصر» هذا الوصف للمؤرخ الشهير الجبرتي واصفاً ما جرى في مصر، وكاد المصريون يندثرون فعلاً لا مجازاً بسبب المجاعات والأوبئة وبارت الأرض الزراعية بسبب إهمال الحكم أعمال الري والصرف، ولهروب الفلاحين من أرضهم، فراراً من جباة الضرائب الفاحشة والمتكررة. وهذا أيضاً ما يشير إليه بهاء طاهر في كتابه الهام «أبناء رفاعة» الذي يحاول أن يجيب فيه على السؤال: كيف وصلنا إلى الإخوان؟
هو لم يفاجأ بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من بعدها، كان احد همومه الرئيسية في الكتابة عن التصدع التدريجي، أو بالأحرى عن التحطيم الممنهج لمقومات الدولة المدنية والصعود المنتظم لتيار الإسلام السياسي يقول: الحقيقة الجوهرية، كما قلت هي أن الدولة المدنية المصرية تآكلت شيئاً فشيئاً. لقد قضينا قرابة قرنين من الزمان لبناء هذه الدولة التي أخرجتنا من عصور الظلام والتبعية التي غرقت فيها مصر قروناً طويلة، وتحقق ذلك بفضل جهود العشرات من أفضل العقول التي أنجبها هذا الوطن، وبفضل جهاد وتضحيات أجيال متعاقبة من المصريين الذين خاضوا حروباً وثورات شعبية للوصول إلى الاستقلال والحرية والمواطنة والاستنارة والعلم واسترداد كرامة المرأة في المجتمع، تآكلت هذه الدولة بفعل فاعل أو فاعلين معروفين على امتداد نصف القرن الأخير. ولم يكن الإخوان بعيدين أبداً عن هذا الانقلاب على الدولة المدنية، فقد ظلوا يعملون بدأب على مدى ثمانين عاما بوسائل مختلفة لم تخلُ في بعض مراحلها من السلاح والعنف للوصول إلى الحكم وتطبيق حلمهم في إقامة الدولة الدينية، وقد تحالفوا مرة أخرى مع السادات في السبعينيات، لكنهم كانوا أكثر ذكاء. ركزوا جهدهم على التغيير الاجتماعي البطيء ينشر رسالتهم وقيمهم المحافظة وسط الجماهير بالتدرّج في المدارس والجامعات والنقابات المهنية والإعلام في الريف والأحياء الشعبية، ويسر لهم ذلك بطبيعة الحال استنادهم إلى موارد مالية هائلة أتاحت لهم إقامة المشاريع الاقتصادية وبناء المدارس والمستشفيات.. الخ ونجحت هذه الخطة في بسط سيطرتهم شبه الكاملة على قطاعات المجتمع الذي تغيرت قيمه ومفاهيمه لتطابق فلسفتهم في الحياة. وبينما كانت السلطة السياسية في عهد مبارك تشنّ عليهم هجمات غشيمة متتالية، كانوا هم يحققون نصراً تلو الآخر في بسط سيطرتهم علي المجتمع. وكتبت مقالاً أيامها أقول فيه إن انتقالهم من حكم المجتمع إلى حكم الدولة هو مسألة وقت لا غير.. وساعدهم النظام الذي حارب الفكر اليساري والوسطي والليبرالي على حد سواء بكفاءة عالية، فلم يبق إلا الإخوان.
طاهر يرى أن الإخوان يعيشون الآن في أزمة يسمّيها أزمة سيد قطب: «الجماعة عرفت قيادتين استجابتا لحركة التاريخ المصري، حسن البنا أسس الجماعة وكانت استجابة للتغيرات التي حدثت للحركة الوطنية المصرية في فترة ما بين الحربين، ثم سيد قطب الذي أدخل مفاهيم الجهاد والتغيير بالقوة، البنا حمى الإخوان، ولكن ما فعله سيد قطب أدى إلى نوع من التشرذم، فالمجموعة التي تدير الجماعة الآن يسمونهم «العشرات» حيث قبض عليهم في الستينيات وقضوا في السجون عشر سنين، وهذه المجموعة خرج بسببها قيادات عدة من الجماعة مثل كمال الهلباوي، وأبوالفتوح، واستمرار هذه المجموعة سيؤدي إلى أن تفقد الجماعة ميزتها. وأعتقد أن الجماعة تحتاج الآن إلى مفكر من نوع خاص يجدد أفكارها ويقودها في مرحلة ما بعد الحداثة.. وأظن ليس لديهم هذه القيادة، وبالتالي أتوقع أن يصبح الإخوان جماعة عادية أقرب إلى التنظيمات السرية الكبيرة غير مؤثرة، وتقوم على أساس الولاء.
لا يكتب بهاء طاهر الآن، توقف تقريباً في العمل على روايته الجديدة لأن الكتابة كما يقول: «تحتاج لنوع من الاستقرار النفسي المفقود هذه الأيام بل منذ اكثر من عامين». في ذهنه مجموعة قصصية جديدة، كتب بعض قصصها، وهو عاشق لفن القصة، يراه فناً مظلوماً الآن. يقول: «الناس تفهم أن القصة مجرد حدوتة، هي ليست كذلك، أنا أريد وأنا أكتبها أن تكون اللغة والحدث مكثفين بما يقرب القصة من الشعر، لا أقصد اللغة الشعرية، ولكن أن يكون النثر نفسه شعراً». عندما يكتب بهاء طاهر، يضطر أحياناً إلى كتابة الجملة الواحدة عشرات المرات، حتى تصل إلى درجة من السهولة والبساطة.. يقول: «معركتى الأساسية مع اللغة».. ويوضح: «أسعى إلى لغة شفافة بسيطة ليس فيها نوع من «فرد العضلات اللغوية»، أو «استخدام محسنات بديعية شكلية» ومع ذلك تحتوي على شحنة جمالية تغذي القارئ.. لن تجد في كل كتاباتي كلمة واحدة يسأل القارئ عن معناها.. ولكن هذه السهولة والبساطة هي أصعب درجات الكتابة، وهذا ما كان يعنيه ابن المقفع عندما قال: «الذي إذا قرأه من لا يعرف ظن أنه يحسن مثله». أسأله عن مستقبل الأدب بعد ثورة يناير؟
يجيب: تولستوي تحدث في إبداعه عن غزو نابليون لروسيا بعد 50 سنة في روايته «الحرب والسلام..»، لن يحدث تعبير أتوماتيكي للحظة. فما يكتب الآن من شهادات «لا أعتبره إبداعاً ثورياً»، وهو خامة للأدب الذي سوف يكتب مستقبلاً. ولكن هناك التعبير المباشر للحالة جاء في قصيدة الأبنودي «الميدان» وكان تعبيرًا تلقائيًا وصادقًا عن مثقف مصري ناحية وطنه وهي أمثلة بالغة الندرة واستثنائية. وقرأت أعمالاً أخرى حاولت أن تفعل ذلك، ولكنها لا تحقق التأثير نفسه.. والتعبير الجيد عن الثورة سيتأخر. أسأله: منذ «الخطوبة» مجموعتك القصصية الأولى.. وحتى مجموعتك القصصية «لم أكن أعرف أن الطواويس تطير».. وما بينهما من قصص وروايات.. ما الثابت في تجربتك وما المتغيّر فيها؟
يجيب: لا متغيرات تقريباً، هناك ثابت وحيد فقط… «ألا أكتب إلا عندما يكون لديّ ما يستحقّ أن يُقال… كما قال ابن المقفع من قبل: «ما يأتيني لا يرضيني وما يرضيني لا يأتيني».. لذا لست كاتباً غزير الإنتاج، ما لم يكن لدي جديد فأعتبر أن الصمت فضيلة.
(القاهرة)