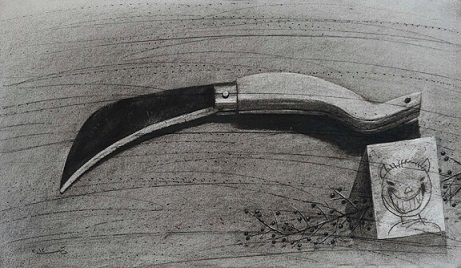منعطف النظام السوري: طوق نجاة عربي؟

صبحي حديدي
ما الذي يجعل بشار الأسد يختار أندرو غليغان، الصحافي البريطاني الذي يُعدّ بين الأشدّ عداء للعرب وانحيازاً لإسرائيل، لكي يجري معه حواراً هو الأوّل مع الإعلام الغربي منذ انطلاقة الانتفاضة السورية، أواسط أذار (مارس الماضي)؟ ولماذا توجّب أن تكون الصحيفة هي الـ’صنداي تلغراف’ التي لا يُعرف عنها، ولا عن قرينتها الأمّ، الـ’دايلي تلغراف’، إلا كلّ تأييد أعمى لإسرائيل والصهيونية العالمية واليمين المحافظ؟ وكيف استقرّ الأسد على هذا الصحافي، وهذه الصحيفة، متناسياً أنها كانت منبر الشتائم الأقذع ضدّ حلفائه في صفّ ‘الممانعة’ و’المقاومة’؛ فلم تقف خلف العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان صيف 2006، فحسب، بل أنحت باللائمة الشديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت لأنه لم يذهب أبعد، فيدمّر أكثر وأشرس؟
ثمة الكثير من الإجابات، بالطبع، ومعظمها يرتدي صفة منطقية بسيطة للغاية، تنهض من معطيات سلام الأمر الواقع مع نظام ‘الحركة التصحيحية’، في عهد الأسد الأب ثمّ وريثه، حيث سادت في جبهة الجولان المحتل حال اللاحرب التي لا تستتبع أيّ تنازلات إسرائيلية ذات معنى، وذلك منذ حرب 1973 وما أعقبها من اتفاقيات فصل القوات. وهكذا، تنبثق إجابة أولى من يقين إسرائيلي، تتبناه بالضرورة الدوائر الصهيونية العالمية، وبات معروفاً وغير مسكوت عنه البتة، بأنّ النظام السوري الراهن هو الأفضل، سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً؛ وبديله (خاصة عند انتصار الانتفاضة، وإقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي، ذي قاعدة شعبية متينة، وجيش وطني يُعنى بمسائل الدفاع عن البلد وليس حماية الاستبداد والفساد…) سوف يكون كابوس ‘الربيع العربي’ الأكثر ضرراً لإسرائيل.
إجابة ثانية تنجم عن ‘تراث’ الخدمات التي قدّمتها ‘الحركة التصحيحية’، على نحو مباشر وصريح وغير مستتر في أحيان كثيرة، إلى سياسات إسرائيل ذات الطابع الستراتيجي، وليس التكتيكي الصرف وحده، فضلاً عن السياسات الأمريكية والأطلسية. اللائحة هنا تبدأ من لبنان وضرب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية وحرب المخيمات، ولا تنتهي عند مشاركة قوّات النظام في تحالف ‘عاصفة الصحراء’ قبيل غزو العراق، كما أنها تمرّ بهذا الدور الوسيط الراهن الذي يسدي أفضل العون لإسرائيل: علاقة النظام مع إيران و’حزب الله’، بما ترفعه من فزّاعة ‘ممانعة’ زائفة، لكنها تمكّن تل أبيب من استدراج المزيد من المساعدت المالية والأسلحة المتطوّرة الأمريكية. السذّج وحدهم، وفي صفوف ‘الممانعين’ أكثر من غيرهم، كانوا بحاجة إلى تصريحات رامي مخلوف، ابن خال الأسد وكبير تماسيح الفساد في سورية، حول ارتباط المصير بين النظام وإسرائيل، لكي يدركوا أنّ وراء الأكمة ما وراءها، وأنّ بعض ‘الممانعة’ يخدم إسرائيل أوّلاً، وثانياً، وعاشراً!
إجابة ثالثة يثيرها ذلك الرماد الذي يُذرّ في العيون، حول ‘علمانية’ النظام، مقابل ‘إسلامية’ الانتفاضة؛ الأمر الذي يفضي إلى المعادلة التالية، التبسيطية تماماً، ولكن تلك التي تثير رهاباً شعبوياً عالياً في الغرب: أليست هذه الأنظمة الفاسدة، العسكرية أو الوراثية أو الدكتاتورية، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، أفضل من جماعة ‘الإخوان المسلمين’، وتطبيق ‘الشريعة’ الإسلامية، وفرض الحجاب والنقاب؛ ثمّ الطامة الكبرى، المتمثلة في ‘الجهاد’ و’القاعدة’ و’الإرهاب’؟ الطريف، والأخبث الذي يصبح أحطّ تفكيراً وأعلى استغفالاً للعقول، أن يأتيك مَن يقول، دون أن يرفّ له جفن: صحيح أنّ بشار الأسد دكتاتور، ولكنه ليس ذلك الدكتاتور الذي تألفه في أوساط حكّام العرب، فهو أقام في بريطانيا سنتين (أي أنه، كما يُراد منّا أن نفهم، عاش بما يكفي لكي يتثقف ويتهذّب ويتعلّم آداب السلوك الغربية!)، ويرتدي الجينز، ويسكن بيتاً متواضعاً في دمشق، ولا يصادفك في الطريق إلى زيارته إلا حارس واحد!
هنا، تثبيتاً لتفاصيل الاستغفال السابقة، ما كتبه غليغان في الـ’صنداي تلغراف’، الأسبوع الماضي: ‘المرأة الشابة التي رتبت اللقاء اصطحبتني في سيارتها الشخصية، فقادتها طيلة عشر دقائق قبل أن نبلغ ما بدا شارعاً جانبياً غير مطروق تحفّ به الشجيرات. لم يكن هنالك أمن مرئي، ولا حتى بوّابة، ما عدا ذلك الحارس الذي كان أشبه بالإنكشاري، الواقف أمام محرس. تقدّمنا صوب بناء من طابق واحد، بحجم بيت ريفي، وكان الرئيس ينتظرنا في قاعة الدخول. جلسنا، نحن الثلاثة فقط، على أريكة جلدية في مكتب صغير. كان الرئيس يرتدي الجينز’. وبمعزل عن حكاية الحارس الإنكشاري، الطالعة من الثقافة الشرقية الوحيدة التي يلوح أنّ غليغان قد اكتسبها، فإنّ أيّ سوري سوف يسقط مغشياً عليه من الضحك إزاء هذه الوصف لإجراءات الأمن المحيطة بإقامة الأسد، فهذا المستوى من الحراسة لا يليق بأدنى ضابط في أي فرع من فروع المخابرات في الأزمنة العادية، فكيف اليوم إذْ يعيش النظام مأزقه الأقصى؟
ما سيرويه غليغان بعدئذ ليس أقلّ سخرية من العقول، لأنه ينقل على لسان الأسد تفسير الأخير لشرعيته الشعبية، وليس تلك الانتخابية فقط: ‘أوّل عناصر الشرعية الشعبية هي حياتك الشخصية. من المهمّ جداً كيف تعيش. أنا أعيش حياة طبيعية. أقود سيارتي الشخصية، ولدينا جيران، وأوصل أطفالي إلى المدرسة، لهذا أنا أحظى بشعبية. من المهم جداً أن تعيش هكذا، فهذا هو اسلوب الحياة السوري’. والصحافي العبقري يخرج إلى قلب دمشق لكي يلتمس أسلوب الحياة ذاك، فيجد الشوارع تعجّ بالناس، والمطاعم مفتوحة، والخمور متوفرة، ورجال الدين المسيحيين أمام كنائسهم بلا خوف… فلا يتبقى عنده شكّ في أنّ النظام ‘علماني’، ‘قوي’، و’مستقرّ’!
من جانبه كان الأسد، في أوّل حديث له مع صحافي غربي منذ انطلاق الانتفاضة، يتابع إيصال رسائل مشابهة لتلك التي أرسلها ابن خالته، رامي مخلوف، في الأسابيع الأولى من الانتفاضة، ولكن على نحو أكثر استهدافاً لهواجس الغرب، حكومات وشعوباً في الواقع، وأعلى نبرة من حيث توصيف المخاوف والهواجس، فضلاً عن نصب الفزّاعات. هنا بعض أبرزها: 1): التحذير، المبطّن بالوعيد، من مغبّة التدخل العسكري في سورية، حيث لن يعيد الغرب إنتاج افغانستان جديدة واحدة، بل ‘عشرات الأفغانستانات’؛ و2) التذكير بأنّ نظامه يقاتل ‘القاعدة’ والإسلاميين، وبالتالي من مصلحة الغرب أن يقف على الحياد، هذا إذا لم ينخرط في المعركة مع النظام؛ و3): التدخّل في شؤون النظام ‘سوف يحرق المنطقة بأسرها’، وإذا كانت ‘الخطة تسعى إلى تقسيم سورية، فإنّ هذا يعني تقسيم المنطقة بأسرها’، هنا أيضاً. سورية هي ‘محور المنطقة، فإذا شئتم العبث بالأرض فسوف تتسببون في هزّة أرضية’؛ و4): البلدان الغربية سوف تصعّد الضغوطات على النظام، ‘بالتأكيد’، كما يشدد الأسد، قبل أن يردّ بهجوم معاكس يذكّر بحديثه الشهير مع صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ قبيل الانتفاضة: لكنّ سورية مختلفة، في كلّ اعتبار، عن مصر وتونس واليمن. التاريخ مختلف. والسياسة مختلفة’.
الرسائل إلى الداخل السوري متعددة بدورها، ولعلّ أبرزها ـ وأدعاها إلى التأمّل من جانب بعض أطراف المعارضة السورية، للمفارقة الصارخة ـ أنّ الأسد ليس لديه وقت للمعارضة، فضلاً عن أنه لا يعرف ماهية المجلس الوطني السوري، ويعرف في المقابل أنّ هذا المجلس لا يمثّل الشعب السوري (الذي، غنيّ عن الاستطراد، منح الشعبية والشرعية للأسد وحده، إلى الأبد!). كذلك فإنّ إيقاع ‘الإصلاحات’ ليس بطيئاً كما يظنّ البعض، إذْ أنّ توقيع قانون ‘إصلاحي’ يستغرق 15 ثانية، أمّا تطبيقه فهنا المعضلة، وهنا تتدخّل العوامل ‘الموضوعية’، و’تعقيدات المجتمع السوري’. المجازفة الأخرى، حسب الأسد، هي عدم انتظار ‘نضج الرؤية’، والمسارعة إلى إصدار قانون ‘إصلاحي’ لا يناسب المجتمع، فتبدأ عندها ‘الانقسامات’، خاصة وأنّ مطالب الناس اقتصادية ومعاشية، وليست سياسية بالدرجة الأولى، في يقينه. كذلك فإنّ الانتفاضة الراهنة هي ‘صراع بين النزعة الإسلامية والقومية العربية العلمانية’، ولهذا يضيف الأسد: ‘نحن نقاتل الإخوان المسلمين منذ خمسينيات القرن الماضي، وما نزال نقاتلهم’، مفترضاً أنّ نظام ‘الحركة التصحيحية’ لم يبدأ سنة 1970، حين استولى الأسد الأب على السلطة، بل قبل عشرين سنة قبلها!
لافت، مع ذلك، أنّ الأسد اختار هذا التوقيت بالذات لكي يوجّه رسائله إلى الخارج والداخل، عن طريق هذا الصحافي، وهذه الصحيفة؛ ومن الحكمة عدم عزل الواقعة عن متغيرات الحراك الشعبي والأوضاع الميدانية على الأرض، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية التي كان أبرزها مقتل معمر القذافي وسقوط نظامه، ثمّ بدء عمليات انسحاب جيش الاحتلال الأمريكي من العراق، وتزايد التلميحات الغربية إلى عدم انتفاء الخيارات العسكرية في سورية. فعلى نقيض ممّا يرّوج النظام، مثلما كان دأبه بين فينة وأخرى طيلة أشهر الانتفاضة، أخذت خيارات الحلّ الأمني والعسكري تضيق أكثر فأكثر حتى وصلت إلى طريق مسدود من حيث حصيلتها الردعية والقمعية، رغم تشديد العنف إلى مستويات جديدة قصوى، واستخدام مختلف صنوف الأسلحة. كذلك صارت الانشقاقات، على تواضعها وتشتت بؤرها وصعوبات تحصينها من البطش المضاد، عامل إنهاك جديد للوحدات العسكرية الموالية التي يستخدمها النظام بصفة حصرية.
ورغم أنّ موافقة النظام على خطة عمل الجامعة العربية لم تكن مفاجئة، خاصة وأنّ الخطة تجبّ تماماً بنود المبادرة العربية التي احتوت على تفاصيل إجرائية وتطبيقية ورقابية على مراحل، فإنّ ملابسات تلك الموافقة تشير إلى أنّ النظام لم يفلح في الفرار من ورطة مزدوجة: إذا لم يوافق، وتعرّض بالتالي إلى أكثر من حرج على صعيد حلفائه، وقد صاروا قلّة قليلة؛ أو إذا وافق ولم يطبّق شيئاً، أو أوحى بتطبيق القليل فقط من بنود الخطة. ومن الواضح أنّ الجامعة العربية، وهي مجمع تناقضات الأنظمة العربية جمعاء، وآخر مَنْ يساند الانتفاضات العربية، لم تكن في وارد التحرّك هذه المرّة، وعلى هذا النحو، لولا أنّ الإشارات الغربية باتت أوضح حول ‘تدويل’ مأزق النظام السوري، مترافقة مع عجز النظام عن كسر الانتفاضة، وفشله في إقناع القوى الإقليمية والدولية الكبرى بأنه قادر على الحسم في أي وقت قريب.
بهذا المعنى فإنّ خطة الجامعة العربية قد تكون طوق نجاة للنظام قبل الشعب السوري، ولكن من واجب الانتفاضة السورية أن تمسك بالطوق قبل إلقائه إلى الغريق، فلا تحاوره حول شروط انتشاله بقدر ما تتفاوض حول أنساق تفكيك النظام بأسره، وصولاً إلى إسقاطه التدريجي التامّ، بمؤسساته ورموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والتجارية كافة. هذه، في الإجمال، سياقات تشير إلى برهة قوّة للشعب، ومنعطف انهيار للنظام، وتفرض على جميع تنسيقيات الانتفاضة ونشطائها، إسوة بأطياف المعارضة في الداخل والخارج، تفعيل الحراك الشعبي أكثر من أي وقت مضى، والارتقاء إلى مستوى امتلاك المبادرة بدل انتظار نتائجها. فليس دون أسباب وجيهة أنّ الأسد يهرع اليوم إلى حضن صهيوني عتيق مثل الـ’صنداي تلغراف’، وأن يلقى فيه الكثير من الرعاية والدفء والحنان!
‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس