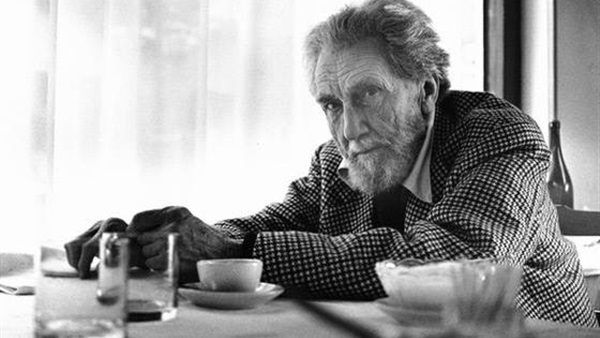هذا هو خِيـارنا الوحيـد/ صلاح بوسريف

تجارب الجيش في السلطة، كلها كانت فاسدةً. لا نزال في العالم العربي نُعاني من السياسات الاستبدادية للأنظمة العسكرية، التي كانت سبباً في كثير من التخلف الذي نعيشه اليوم، وليس ما يجرى في واقعنا العربي الراهن، ببعيد عن هذا الوضع المأساوي، الكارثي، الذي خلَّفَتْه لنا هذه الأنظمة المُتلاشية، رغم أنها ادَّعَتْ الثورة ضدَّ ‘الأنظمة الرجعية، الاستبدادية’، أو أنها جاءت باعتبارها البديل الثوري، الذي سينقل الناس من واقع الظلم و الحيف الاجتماعيين، إلى واقع ‘الرَّفاه’، والعيش الكريم.
كانت الاشتراكية، هي مُشْتَرَك ثورات الجيش، وبدا، آنذاك، أنَّ هذه الثورات،أو الشعارات التي تبنَّاها المنقلبون على الأنظمة الملكية، في كل من مصر، والعراق، وسوريا واليمن، وليبيا، وحتى في الجزائر، هي ما يُعَبِّر عن رغبة الشَّعوب في التغيير، وهو ما ستُدافِع عنه النُّخَب المختلفة، من مثقفين، وسياسيين، ممن رَأَوْا في هذه ‘الثورات’ البديل الذي كانوا راغبين فيه.
ربما استجابت هذه الثورات العسكرية، في أول أمرها لبعض المطالب العامة التي كانت سبباً في شعبيتها، وانتشارها الجماهيري، خصوصاً في ما أبْدَتْه من مواقف تجاه ‘الأنظمة الاستعمارية الإمبريالية’، و دعمها لحركات التحرُّر العربية، وانحيازها المطلق للمقاومة الفلسطينية. وربما كانت طبيعة المرحلة، تقتضي وجود أنظمة بهذا الثقل العسكري، وبهذا النوع من المواقف التي هي تعبير عن المواقف الشعبية العامة، أو استجابةً لها بالأحرى. لكن، عطب هذه الأنظمة العسكرية، رغم ارتدائها للزَّيّ المدني، في ما بعد، هو احتكارُها للسلطة، واستبعادُها للتعددية السياسية، وهيمنة الحزب الواحد على كل دواليب الدولة، وقطاعاتها، ناهيك عن التَّوَجُّه البوليسي، الاستخباراتي، الذي لم يعد يكتفي بحماية الداخل من الخارج، بل وبحماية الداخل من الدَّاخل، أي من ‘أعداء الثورة!’، و ‘العملاء!’، والمقصود بهم كل المعارضين لهذه الأنظمة، والمُنتقدين لسياساتها الاستفرادية القمعية، وهو ما أفضى لتحويل هذه الأنظمة، إلى أنظمة قمعية، قهريةٍ، لا يُسْمَح فيها بأي نوع من النقد، أو الاحتجاج، أو التظاهُر. وقد كان المثقفون، بين من عاشُوا مرارة هذه التجربة، خصوصاً من ظلَّ منهم خارج التبعية المطلقة، والعمياء، لهذه الأنظمة. ولعلَّ في بعض روايات نجيب محفوظ، رغم طابعها الرمزي، أو ما كان يُضفيه عليها من أقنعة، تكفي لفضح ما كانت تعيشه هذه ‘الثورات’ من إخفاق وفشل، وما أصبح يعيشه الناس، في ظلها، من قمع وقهر، واستبداد.
فبقدر ما أرفض عودة الجيش للسلطة، أو حَشْر نفسه في الشأن العام، أو الشأن السياسي، باعتبار دوره الجسيم في حماية أمن، وحدود البلاد، وضمان سيادتها، بقدر ما أعتبر أنَّ الدِّين، نفسَه، أو تدخُّل الدِّين في شأن السياسة، هو أيضاً، غير مقبول، لأنه سيكون نوعاً من الاستبداد الديني، أو استعمال الدين كسلاح لِمُصادَرة الفكر، ولِمُصادَرَة الرأي، ولكبح وقهر حرية التعبير، وهو ما كشفت عنه تجاربٌ من هذا القبيل، سواء في بعض الدول التي تستعمل الدين كذريعة، لاستبعاد الديمقراطية، أو رفضها، بالاحتكام لِما تُسَمِّيه بـ ‘شرع الله’، أو ‘أحكام الشريعة’، أو بعض الأنظمة التي تستعمل الدين، وفق تأويلها له طبعاً، كغِطاء لشرعيتها السياسية.
التجارب الأخيرة التي رأيناها، في كل من مصر وتونس، وما أعلنه سلفيو ‘إقليم برقة’ بليبيا من اعتبار الشريعة مصدر التشريع الوحيد، في ‘دويلتهم’ التي أعلنوا عن إقامتها، في شبه انفصال عن الدولة الأم، تفضح، بالملموس، استبداد الدِّين، حين يلبس قميص السياسة، أو حين يَتِمّ إقحام الدِّين في السياسة، واستعماله لتبرير الاستفراد بالسلطة.
حكم ‘الإخوان المسلمين’ في مصر، وحكم ‘حزب النهضة’ الإسلامي، في تونس، دون الحديث عن التجربة الفاشلة لحكم ‘حزب العدالة والتنمية’ في المغرب، هما تعبير عن الأفق الضَّيِّق لهذه الأحزاب الدعوية، التي تنخرط في السياسة، وهي تعبير عن غياب مشروع مجتمعي، سياسي، واضح المعالم، وقابل للإنجاز، ثم، أيضاً، افتقار هذه الأحزاب الدعوية الإسلاموية، للخبرة في تسيير، وتدبير الشأن العام. فما راكمه الإخوان من أخطاء، ومن إخفاقات، في ظرف وجيز، واستفرادهم بالسلطة، وسعيهم لأخونة الدولة، والهيمنة على مؤسساتها الحيوية، واستصدار الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي للإعلان الدستوري، بمجرد استلامه لمنصبه، ودخوله في حرب مع القضاء، ومع الإعلام، وفي بعد مع المثقفين، تكفي لإشعار الشعب بالخطر القادم، ولخروج الناس للشارع، ومطالبة الإخوان بالرحيل.
أليست هذه الأسباب، هي الأسباب نفسها التي من أجلها خرجت الشعوب لتُطالب برحيل الأنظمة العسكرية، والبوليسية، التي كانت تستفرد بكل السُّلَط، وترفض رأي الشعب، وتُصادر حقَّه في التصويت، وفي التعبير عن فكره ورأيه؟
سيقول لي بعض الذين ينتصرون، أو يتعاطفون مع الإخوان، أو الإسلامويين، ولما يُسَمُّونَه بـ ‘دولة الخلافة’:
ـ إنَّ الإخوان، وصلوا إلى السلطة بالانتخاب.
ـ لا أعترض على هذا الجواب، وهو حقيقة لا ينكرها إلاَّ جاحِد، أو أعمى. ولكن، مرسي لم ينزل إلى السلطة من السماء، ولم يأخذها من الله، وفق ما كان الإخوان يوهمون الناس به في تجَمُّعات رابعة العدوية، التي أصبح فيها هدم الكعبة، أو ركن من أركان الإسلام، الذي هو الحج، أهون من إسقاط مرسي من الحكم، كما قال مرشد الإخوان، وهو يُقْسِم بالله لتأكيد صحَّة كلامه. الذين انتخبو مرسي، لم يكونوا الإخوان وحدهم. فتحالف فئات واسعة من الشعب المصري، من التنظيمات الثورية الشبابية، ومن الأحزاب الليبرالية، واليسارية، وتصويتهم لصالح مرسي، كان نوعاً من قطع الطريق على أحمد شفيق، الذي هو تعبير عن نظام مبارك، وعن رغبة الجيش، آنذاك. فالإخوان، سيَتَنكَّرون لكل شيء، رغم ما كانوا يطلقونه من وُعُود، وما أبْدَوْهُ من رغبة في التحالف، والتعاون، والشراكة مع حلفائهم، ممن ليسوا معهم في نفس الخندق، وما كانوا أبْدَوْه من رغبة في عدم التَّرَشُّح للرئاسة، وغيرها من الأمور التي كانت تشي بهينة الحزب الواحد على السلطة، وبعودة مصر للاستبداد، لكن هذه المرة، سيكون الاستبداد دينياً، أو باسم الدِّين.
الجيش، هذه المرة استجاب لإرادة الشعب، أو لصوت الأغلبية، ولم يخرج من تلقاء ذاته لقلب نظام الحُكْم، أو لتغيير النظام، بنظام آخر. فما جمعته ‘حركة تمرد’ من توقيعات، فاقت عدد الذين صوتوا لصالح مرسي، وخروج أكثر من ثلاثين مليون مواطن مصري للشوارع، للمطابة برحيل مرسي، هو تعبير عن رفض شعبي واسع، لحكم الإخوان، ولتجربتهم الفاشلة في الحكم، التي كانت تأخذ البلاد نحو ديكتاتورية، هي، ربما، أكثر إرهاباً، واسْتِحْكاماً، من ديكتاتورية الجيش.
لا أحد ممن خرجوا للشوارع للمطالبة برأس مرسي، يرغب في حكم العسكر، أو كان يُسَلِّم السلطة للجيش، في طبَق من ذهب. فجميع الذين ثاروا ضد الإخوان، واستبداد الإخوان، لم يكونوا يريدون استبدال حكم الجيش، بحكم المُرْشِد، فالحُكْم المدني الديمقراطى، هو الخيار الوحيد الذي يريده الشعب، أو يريده الذين ثاروا ضد مبارك، وضد مرسي. فالدولة المدنية الحديثة، التي تحتكم في نظامها للقوانين، والتشريعات الحديثة، ولحقوق الإنسان، وإرادة الشعوب، في اختيار حُكَّامِها، أو الانقلاب عليهم، متى بدا أنهم غير صالحين للحُكم، هي ما يرغب فيه هؤلاء، ممن انتصر لهم الجيش، الذي كان يعرف ما كان سيؤول إليه وضعُهم في مواجهة الإخوان لهم، في مقابل بقائهم في السلطة، وقلب فكر وعقيدة الإنسان، بشكل جذري، وكُلِّيّ. انظر قرار وزير التعليم الإخواني، بحذف الفلسفة، أو اعتبارها مادة غير إلزامية في التعليم الثانوي، في مقابل الفكر الإسلامي! أليس العداء للفلسفة، هو عداء للفكر النقدي، ولحرية الاختيار، وللإنسان المتأمِّل، المُفَكِّر، القَلِق، والمُتسائل؟
القدس العربي