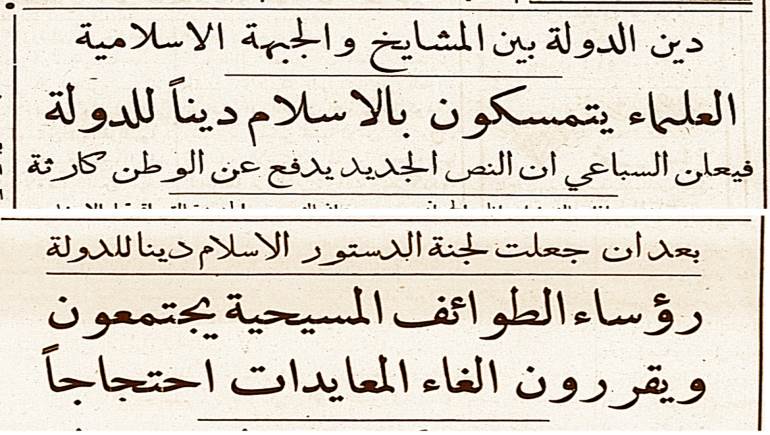هل تنتهي «الداعشية» بانتهاء «دولتها»؟/ ماجد الشيخ

قبل ثلاث سنوات من الآن، كان المدعو أبو بكر البغدادي يعلن قيام ما سمّاه «دولة الخلافة» من على منبر جامع النوري الكبير التاريخي، الذي شيد في مدينة الموصل عام 1173 بأمر من نور الدين زنكي، بعد أن سيطر على المدينة. وها هم جنود «دولة الخلافة» وبعد أن اشتد الخناق عليهم، يقومون بتفجير المكان الذي كان منطلق الإعلان عن دولتهم المزعومة، إضافة إلى تفجير مئذنة الحدباء التاريخية، إيذاناً بانتهاء حلم الخليفة والخلافة سواء بسواء.
هل انتهت «دولة الخلافة» المزعومة التي علّقها المدحورون من سلطة بعض الجيوش العربية وأجهزتها الأمنية بين السماء والأرض، أملاً باستعادة سلطة لهم ولمن ساندهم وتواطأ معهم من استخبارات الدنيا؟ وفي حين أن وهم الخلافة هذا، لم يدم أكثر من ثلاث سنوات عجاف، قتل خلالها مئات الآلاف من البشر، كل ذنبهم أنهم لم يمتثلوا لسلطة «الخليفة» وجنوده الملاعين، ممن يعانون من متلازمات مرضية عديدة، انتزعت منهم عقولهم وقلوبهم وهيئاتهم الإنسانية، محولة إياهم إلى روبوتات لا تجيد القتل الرحيم مطلقاً، وها هي شرور أعمالهم بدأت تودي بهم إلى التهلكة، وهم يُطردون أو يهلكون في الموصل، فيما تتواصل حملة اجتثاثهم من الرقة.
بين رمضان 2014 ورمضان 2017 ثلاث سنوات «عاشت» فيها «دولة الخلافة» وأماتت بمسلكياتها الوحشية خلقاً كثيرين، لكن سلطات ما قبل تلك «الدولة» وما بعدها ستواصل مسلسل القتل، وفق ما درجت عليه السلطة بطبيعتها، والكهنوتية منها تحديداً، دفاعاً عن ذاتها أولاً، ومصالحها ثانياً، وتشبثها بهيمنتها التسلطية ثالثاً.
وهكذا وسط فتن الخراب السلطوي التديّني، تذهب الخرابات «الداعشية» و «المتدعشة» وأضرابهما على جانبي التمذهب الديني والسياسوي، إلى التمسك بالسلطة، أو الاحتفاظ بها، وإن لم تفلح ذهبت إلى تدميرها، أو محاولة ذلك، في حال أوشكت أن تضيع أو تفلت من أيدي «أهل الخراب»، الذين يزدادون تشبثاً بها، حتى ولو أدى الأمر إلى الانقلاب عليها وتأسيس سلطة لهم «جديدة» تماماً، تناقض أشكال الهيمنة والسيطرة السلطوية القديمة، على ما فعل ضباط الجيوش التي انهارت أنظمتها السياسية أو توشك على الانهيار، كما هو حال الجيشين العراقي والسوري، وفي العديد من أنظمة المنطقة التي استعصت على التغيير الشعبي أو الثوري، وأجهضت حراكاتها الجماهيرية، فما كان من «السلطة العميقة» إلا أن شكلت الغلاف البديل والسميك في إسنادها السلطة.
أما الوضع الفلسطيني العام فمأزوم هو الآخر وسط صراعاته السلطوية وما ذررته وفرخت من أزمات، أصابت كامل الكيانات السياسية والتجمعات الفلسطينية على امتداد الوطن وفي الشتات.
المسلكيات «الداعشية» الأخيرة التي رأيناها تتجسد على أيدي «جنود الخلافة»، كانت تناظرها على الدوام مسلكيات لجنود هذه السلطة أو تلك على مدى أزمان التسلط الاستبدادي، والحكم باسم السياسة أو الدين، لا فرق في جوهر الأمر، حيث السلطة الفاجرة لا ترعوي ولا تنصاع لقانون محلي أو دولي، أو حتى لتقاليد أهلية أو قبلية، طالما أن لا سلطة معتبرة، من تقاليدها الأساس محاسبة ومراقبة مسلكيات من يفترض فيهم أن يكونوا المثال الأعلى لتطبيق معايير النزاهة والعدل والمساواة والقيم الإنسانية المشتركة، واحترام مواطنية المواطن في بلد يحكمه القانون، حيث يتساوى أمامه كل الناس ويساوي هو بالطبع في الحقوق والواجبات بين كل الناس، لا فروق شكلية أو جوهرية في ما بينهم، لا جنسياً ولا طائفياً أو مذهبياً أو إثنياً وعرقياً.
وهذا تحديداً هو مثال العيش الكريم والحرية كثمرة لمساواة مفتقدة وديموقراطية مشتهاة، تتوق إليها مجتمعاتنا ودولنا، وهي تقف عند عتبات انحدارها أو صعودها، نحو سلم القيم والأخلاقيات المفترض أننا نتشارك فيها مع الثقافات والأمم والحضارات التي كان لنا نصيبنا من المساهمات الخلاقة فيها، قبل أن يشملنا الانحدار لنعود القهقرى نكوصاً وانحطاطاً، فيصبح الماضي سيد المثالات والنماذج التي يسعى بعضنا الى الغرق فيها، والى الهروب إليها من حاضر ناشز، لا يقود إلى أي مستقبل.
كل هذا وسط الخراب التديّني، ما عاد يمكنه استعادة أمل الألق والحلم بحياة إنسانية تقف فيها السلطة على حيادها المفترض نسبياً، وسط سلوك بشري يعتاد على ممارسة الحرية كما ينبغي، طالما أن ليس هنالك ما يؤذي مشاعر وأحاسيس الآخرين، ولا يتدخل في جوهر خصوصياتهم المعيارية المتعارف عليها، ولا يؤثر قسراً وإكراهاً في رؤاهم تجاه بعضهم البعض، أو تجاه الآخر في شكل عام.
ووسط الخراب «الداعشي» العميم، حتى ما بعد سقوط «دولة الخلافة الداعشية» سيبقى هناك بقايا «متدعشين» هنا وهناك، يواصلون سرديات التآمر والقتل والإجرام بصبغته «الداعشية»، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً، أفراداً وجماعات ومجتمعات، مواصلة التأهب لمواجهة كامل الانحرافات التدينية وما يشابهها من انحرافات قوى التكفير والتطرف والإرهاب، حتى لا تقوى شوكتها، وكي لا يعاد بناء سردية «داعشية» جديدة في فضاءات بلادنا الموبوءة بسرديات وطبائع استبداد متنوعة ومتعددة، جميعها لا تقبل الآخر الديني أو السياسي، وتعادي العالم بأكمله.
قبل «داعش» مثل «داعشيو» أنظمة الاستبداد السلطوية النموذج الفاقع على وجود الأفران والمحارق والمقابر والتمثيل بالجثث، وستبقى هذه الحالة مع اختفاء «داعش» كدولة أو كتنظيم أو كفقه أيديولوجي متوحش، يغالي في مناصبة الآخر ليس مجرد التعادي والتضاد معه، بل وسلوك دروب الإبادة بحقه. وما بعد «داعش» أو في ظل استمرار فقهه الوحشي، سوف تستمر بعض المسلكيات «الداعشية» بتداعياتها تطل بين الحين والآخر، لتنتقل هنا أو هناك أو هنالك.
لقد مثل السلوك «الداعشي» طوال السنوات الثلاث الماضية صدمة ترويعية هائلة لكل العالم، وحتى في دواخل بلداننا، لم تنج مجتمعاتنا من مضايقات «داعشية» على أيدي بعض السياسيين وإقطاعهم وزعاماتهم وأزلامهم والسلطات الموازية والعميقة وأشباهها، وهي تفرض عليهم إرادتها ورغباتها، حتى وصلنا في بعض بلداننا إلى أن يجري حشر وقولبة الديموقراطية (ديموقراطية صندوق الاقتراع) في قالب «قانوني» يتوافق مع رغبات هذا السياسي أو ذاك، عبر تلغيم قانون الانتخاب وجعله متوافقاً وآلية اختيار السياسي لناخبيه، لا انتخاب الناس لممثليهم.
وتلك مهزلة المهازل، و «داعشية» مختارة ومنتقاة، حين يراد للناس أن «تختار» من لا يلتفت إلى مصالحها وتطلعاتها، بل يُطلب منها أن تصفق للاستبداد السياسي، كما صفقت وتصفق بعض قوى «الإسلام السياسي» وفرقه التدينية لبعض فقهاء التقويل وفقه التوحش التكفيري، والشعارات التي لا تحوز قابلية العقل لها، بقدر ما قاد ويقود إليها عقل الاستتباع النقلي، وهو يتعدى على الدين، وعلى كامل محاولات التفقه به، وعلى التشريع، من دون أن يرف له جفن، كما فعل التدين «الداعشي» وأمثاله من تدين التطرف والتكفير والإرهاب، وكما يفعل الاستبداد السياسي وهو يقود مجتمعات الدولة عندنا للعودة إلى تقديس طواطم السلطة الاستبدادية الغاصبة، وما جلبته طوال السنين المواضي من تغييب سلطة العقل وإحلال عقل السلطة البراغماتية مكانه، حتى بتنا على ما هو حالنا اليوم، نشهد احتلال السلطة للفضاء العام واختلال السياسة مع اختلال العقل السياسي السلطوي، وإصراره على إنتاج وتوليد ما لا ينفع السياسة ولا الناس ولا الدولة ولا السلطة المعيارية المناقضة لطبائع الاستبداد السلطوي، الحالم بمد أمجاد امبراطوريته الخانقة نحو فضاء سلطوي أكثر اتساعاً –سياسياً ودينياً– على ما حاول فعله «دواعش» هذا الزمان… وفشلوا.
هل انتهت «الداعشية» بانتهاء «دولتها»؟ أم أن «داعشية» ما قبل «داعش»، ستواصل مسلكياتها المتوحشة في ظل سلطة استبدادية قمعها الوحشي أقرب إلى «التدعيش» المنفلت، في وقت لم تكن «داعشيتها» أقرب إلى القمع المنضبط؟ وفي كل الأحوال نادراً ما قد نجد خاصة في بلادنا سلطة تجافي «الحقيقة الداعشية» التي رأينا وعايشنا صورتها البشعة على امتداد السنوات الثلاث، حيث امتدت مفاعيل فقه التوحش من مركز وأطراف «دولة الخلافة» إلى أكثر من اتجاه على امتداد العالم.
* كاتب فلسطيني
الحياة