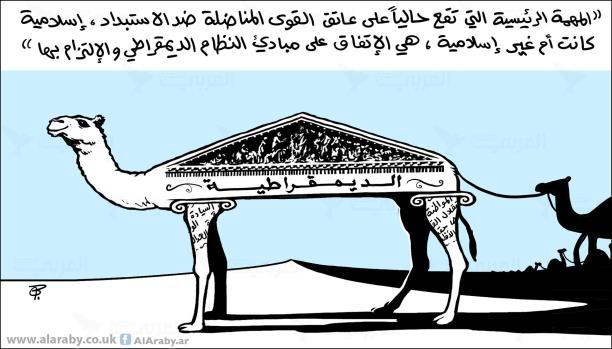هُوية الأَمكنةِ في المشرقِ العربيّ والعِمارةُ المحليَّةُ المقاوِمَة
رهيف فياض
«الكونيَّة» والتحوُّلاتُ الراهنة.
تسودُ في عالم اليوم ظاهرةُ «الكونيَّة» «Universalization»، التي يَعْتبِرُها البعضُ في بلدانِ المركزِ الغربيِّ، تقدُّماً استثنائياً للجنس البشريِّ. في حين يَرى فيها بعضُنا في البلدان التابعةِ، تهديماً للثقافاتِ التقليديَّةِ، وتهديماً «للنواةِ المُبدعةِ للثقافاتِ العظيمة» كما لاحظ بول ريكور.
ويُصبِحُ البُنيانُ في هذا السياق ِ، مشروطاً بالاستخدامِ المُفرِطِ للتكنولوجيا، الذي يقيِّدُ الإمكانيَاتِ الفعليَّة لكِتابةِ شكلٍ مدينيٍّ ذي معنى. فالقيودُ التي يفرِضُها رأسُ المالِ الكبيرِ والمُضارَباتُ العِقاريَّةُ، تحدُّ من قُدرةِ التنظيمِ المدينيِّ، بحَيْثُ ينحصرُ تدخُلُهُ بالتعاملِ مع عناصِرَ تُحدِّدها بصورةٍ مسبقةٍ، متطلباتُ الإنتاجِ، لتسهيلِ التسويقِ وإدامةِ السيطرةِ الاجتماعيَّة. وتَبدو الممارسةُ المعماريَّةُ اليومَ محكومةً بالسيطرةِ المُبالغَةِ «للهاي تك» عليها، من جهة، وبتأمينِ «غلافٍ» للمباني فيه من المشهديَّةِ والإبهارِ، ما يُخفِّفُ من سَطْوَةِ هذه السيطرةِ، وما يقنِّعُ هذه الوقَائِعَ الحسيَّة الخَشِنَة.
لقد كانَ مُمكناً لثلاثينَ سنةٍ خلَتْ، المحافظة على قدرٍ من السيطرةِ الإيجابيةِ، على شكلِِ النسيج المدينيِّ وعلى معناه. أما اليوم، فقد تغيَّرت المراكزُ المتروبوليَّة في كثيرٍ من بلدانِ العالمِ المتقدِّمِ، كما تغيَّرَتْ أيضاً مَراكزُ المدنِ التاريخيَّةِ عندنا، أخصُّ منها بحسرةٍ موجِعةٍ مدينتي «بيروت» دون ذكرِِ طفراتِ البنيانِِِ، في مُدُنِ النفطِ الخليجيَّة.
لقد طَغتْ بالتدرُّجِ، على المتبقِّي من نسيجِ القرنِ التاسع عشر في هذهِ المُدن، الأداتان المُتعايشَتان للتمدُّد الميغالوبولي وهما، الانتشارُ الحرُّ للمباني البرجيَّةِ، والأوتوستراداتُ المدينيَّة المتلويَّةُ في أَحشاءِِ النسيج ِ المدينيِّ العتيق. فالأداةُ الأولى أدَّت لوحدها إلى ارتفاعٍ في أسعارِ الأراضي. أما الأداةُ الثانيةُ، فقد دفَعتْ هذا الارتفاعَ إلى مناسيبَ مُذهلة. لقد دُمِّر مركزُ المدينةِ النموذجيِّ، وأَعلَنتْ «الحضارةُ الكونيَّة» انتصارَها، مُعلنةً في الوقتِ ذاتهِ، هَزيمَة الثَقافاتِ المحليَّةِ، ومنها ثقافتُنا.
2
والتياراتُ المعماريَّةُ المُعَولَمة الرئيسة التي سادَت خلال العقودِ الثلاثةِ الماضيةِ، تبنَّت طروحاتٍ مدمِّرةً لنسيجِ المدنِ ولناسِها. ويتعلَّقُ المعماريُّون المُعَوْلَمون راهناً، بلغةٍ معماريَّةٍ ترجِعُ بصُورِها إلى الحُلم الصناعيِّ الذي سادَ في بدايةِ القرنِ العشرين. وقد أنتَجَ هذا التعلُّقُ، طُرُزاً معماريَّةً مطبوعةً بالذِكْرَياتِ المُستَرجَعةِ، ذكرياتُ المُفحِّماتِ، والسُفُنِ، والمناطيدِ الموَجَّهْةِ …، وغيرها. وتُوقِظُ هذهِ الطُرُز المعماريَّةُ، الرغبة في إنتاجِ تشكيلةٍ من المصنَّعاتِ، لا يَجْمعُها سوى كونُها لا علاقَةَ لها «بالأرضِ الأمِّ»، بالترابِ.
إنها نوعٌ من «النيومكننة»، تنتشرُ اليومَ وترتكِزُ على مَفاهيمَ تقنيَّةٍ فجَّةٍ، في تصوُّرها للمسكَنِ الإنسانيِّ. تمعْدَنَتْ مُدنُنا معَها وتزجَّجت. فهي كتلٌ ضخمةٌ متراصَّةٌ متتابعةٌ دون أي معنى، تَتَباهَى بهيكَلِها الإنشائيِّ الهَجينِ غالباً، والمعدنيِّ الراقِصِ حيناً، والشاهق ِ الارتفاعِ أحياناً. نبرِّدُها في المناخاتِ الحَارَّة، وندفِّئُها في المناخاتِ الباردَة. والمسَاكنُ فيها أشْبَهُ بالأقفاصِ، تسجُنُ ناسَهَا خلفَ زُجَاجِها الملوَّنِ الملصوق ِ.
وإذا طلبْنا من مجموعةٍ من هؤلاءِ المعماريِّين المُعَولمين أن يتصوَّروا مبنىً «مستقبلياً لعالمِ الغدِ» كما يقولون، فإن النتيجةَ ستكونُ واحدةً، وهي خُطيطةٌ «طليعيَّةٌ» كما يَرونَها، يُمكِنُ أن يَرسُمَها بنائيٌُ روسيٌّ عاشَ في الرُّبعِ الأولِ من القرنِ العشرين، مِيلنيكُوف، أو تَاتلين، أو تشِيرَنيكُوف، أو واحدٌ غيرهم…. لا فرق.
ومنذُ منتصفِ السبعينياتِ من القرنِ المَاضي، سيطرَتْ تفاصيلُ التِكنُولوجيا المتقدِّمة أو «الهاي تك» على البُنى في كلِّ المنشآت. والحضورُ الأيقونيُّ لهذه التَفَاصيل يُشكِّلُ اليومَ الركيزةَ لنهجٍ أكاديميٍّ متحجِّرٍ هو المُوازي راهناً، للنهجِ الأكاديميِّ الجامِدِ في مدرسةِ «البوزار» الباريسيَّة.
وكلُّ نقدٍ جذريٍّ للعِمارة المُعَولمةِ الراهِنَة، هو نقدٌ يرفضُ النظرةَ الأيقونيَّة إلى التِكنُولوجيا والصِّناعة. كما يرفُضُ البحثَ عن الشكلِ لذاتِه، أو لاستعمالِه وسيلةً للإبهارِ والتَرويج. فيُدينُ مُحاولاتِ التمديدِ للحداثةِ المُتهالِكَة، ومحاولاتِ التمديدِ المُماثِلةِ للبنائيَّةِ الروسيَّةِ العَتيقةِ، ويَرى أنَّ هذه التوجُّهات، إنما تقودُ إلى نِسْيَانِ المشهدِ المبنيِّ والطبيعيِّ على السواءِ، وإلى تدميرِ ما تبقَّى من النسيجِ المدينيِّ الإنسانيِّ، وإلى غيابِ الالتزامِِ بقضايا المجتمع.
3
العِمارةُ المحليَّةُ، مكوناتٌ، ومعاييرُ رئيسة.
I خاصيَّاتُ المكان.
في ضَوءِ هذهِ القراءةِ للتحوُّلاتِ في العِمارة راهناً، ربَّما أمكَنَ تأكيدُ القُدرةِ على إِقامةِ عمارةٍ محليَّةٍ مُختلفةٍ، هي ناتجُ ممارسةٍ نقديَّةٍ مزدوجة، تُبعِدُها بشكلٍ متساوٍ عن طُوباوِيَّةِ الالتحاقِ بالتقدُّم التكنولوجيِّ من جهة، وعنِ الموقِف الذي قد يدفعُ باتجاهِ العودةِ إلى الأشكالِ التي سَادَتْ في الماضي ما قبل الصناعي. فلا قُدسيَّة «للهاي تك»، ولا عَوَدةَ إلى حنينٍ تاريخانيٍّ تزيينيٍّ مُزيَّف. وحدَها الممارسةُ النقديَّةُ المزدوجةُ هذه، تملكُ القُدرةَ على ابتكارِ عِمارةٍ محليَّةٍ مقاومةٍ تحكي ثقافةً وهُويَّةً، ولا تَخشَى اللجوءَ الخَفِرَ إلى التقنيَّاتِ «الكونيَّةِ» عندَ الضرورة. إنها محليَّةٌ ناقِدةٌ، وهي الجسرُ الذي ستعبرُه بالضَّرورةِ، كلُّ عِمارةٍ إنسانيَّةٍ للمُستَقْبل.
وتَعملُ المحليَّةُ الناقدةُ هذه، على تطويعِ المؤثِّراتِ الثقافيَّةُ المسمَّاة عالميةً، وصهرِها معَ ميزاتِ مكانٍ محدَّدٍ، مُستلهِمةً مكوِّناتٍ تفصيلية في هذا المكانِ، كالعَتمةِ أو الضَوءِ وجودته، والطوبوغرافيا فيه بكلِّ مكوِّناتها، والتوجيهِ ومسارِِ الشمسِ، والتهوِئَةِ، والرؤيةِ والمشهدِ، ودرجةِ الحرارةِ والرطوبة. وربَّما استلهمَتْ أيضاً تقليداً نابعاً من خاصياتٍ إنشائيَّةٍ عَرَفَها المكانُ، أو تقليداً آخر لصيقَ لَعِبٍ معقَّدٍ لكتلٍ غَمرَها ضوؤه، مستعيراً صيغةً للمعمار لوكوربوزييه.
وأهمُّ من هذا وذاك، البناءُ على خاصياتٍ نابعةٍ من طرق ِ حياةِ الناس في المكان، ومن عاداتِهم وتقاليدِهم.
II المحلية الناقدة، والتأثيرُ المزدوجُ.
فالمحليَّةُ الناقِدةُ إذاً، هي بالضرورةِ نقيضُ التفكيرِ المبسَّطِ، الراغِبِ في بَعثِ الأشكالِِ المفترضةِ لطرزٍ تقليديٍّ ضاعَ. وهي تَرى، أننا خاضِعونَ بداهةً لتأثيرٍ مزدوجٍ، غربيٍّ يدَّعى مركزيَّة عالميَّةً مُسيطِرة، ووطنيٍّ أو إقليميٍّ محلِّي. وربَّما صحَّ ما يراهُ البعضُ، أن لا خيارَ لنا اليومَ إلا أن نعتَرِفَ بضرورةِ تفاعُلِهما.
ولا أحدَ يَعرفُ كيفَ ستكونُ الحضارةُ الغربيَّة، يكتُبُ بول ريكور (Paul Ricoeur)، عندما تلتقي فعلاً مع حضاراتٍ أُخرى مُختلفة، لا معَ هذا المخزونِ لدينا اليومَ، عَبْرَ الفتوحاتِ والإلحاق ِ والتبعيَّةِ والسَّيطرة.
لأنَّ هذا اللقاءَ، على منسوبِ حوارٍ فعليٍّ أصيلٍ، لم يحصَلْ بعدُ، وما زلنا نُمارسُ دوغمائيَّة الحقيقةِ الواحدةِ، غيرُ قَادرِين على اقتحامِ الشكِّ الذي توقَّفْنا عنده، يُتابعُ بول ريكور (Paul Ricoeur). فالحضارةُ الغربيَّةُ، يقولُ المعمارُ الهولنديُّ ألدو فان آيك، تُطَابِقُ ذاتَها عادةً مع «الحضارة» (مع ال التعريف)، انطلاقاً من فرضيَّةٍ فوقيَّةٍ، هي أنَّ الذي لا يُشبِهُها هو مُعطى إكزوتيكيٍّ غريب.
لا!
لم يتوقَّفْ المركزُ الغربيُّ عندَ الشكِّ بمركزيَّتِهِ، بل اعتنَقَ بقناعةٍ دوغمائيَّة، تملُّكَهُ باسمِ الجنسِ البشريِّ بكامِلهِ، الثقافةَ الواحدةَ، والحضارة الواحدةَ، وكلَّ الحقيقةِ، أي الحقيقةَ الواحدة.
والمحليَّة الناقِدَةُ في الفكرِ وفي العِمارةِ، وقد تخلَّصت من كلِّ حنينٍ متخلِّفٍ مَرَضيٍّ، هي محليَّةٌ ناقدةٌ تحرُّرية. إنها التعبيرُ الأبرزُ عن فكرٍ ينهضُ في منطقةٍ محدَّدةٍ، ولا نَجِدُه في أيَّةِ منطقةٍ أخرى، ويتناغَمُ مع كلِّ مكوِّناتِها. فهو ينبَعُ مِنْها، ويلتصِقُ بالمُعطى البيئي والجغرافي والمناخيِّ فيها، أُكرِّر مُضْطرّاً، ويتفرَّع من بنيتها الاقتصاديَّة الاجتماعية، ومن قدُراتِها التقنيَّة والتكنولوجيَّة، ومن إرثها الأخلاقي والثقافي.
إنها محليَّةٌ ناقدةٌ تحرُّريَّة.
4
المكانُ واللاَّمكان. المقاومةُ، ومقاومةُ «المكانِ الشكل».
I اللاَّمكان.
يقودُنا الكلامُ عن المحليَّةِ الناقِدةِ، إلى التوقُّفِ عند مفهومِ اللامكان. يقترنُ مفهومُ اللاَّمكان، بتمدُّدِ المدينةِ غيرِ المنضَبِطِ، وبتخطِّيها الحُدودِ الطبيعيَّةَ لموقِعِها. إنها «الميغالوبوليس»، كما عُرِّفت منذُ السِتّينيات من القرنِ الماضي، والتي لم يعُد من الممكِنِ تحديدُ الأمكنة فيها ، والحفاظُ على أشكالٍ مدينيَّةٍ يُمكنُ تعريفُها.
فلبنانُ على سبيلِ المثال، بلدٌ صغيرٌ مساحة وسكاناً، إلا أنَّ عاصمَتهُ بيروت في تمدُّدِها، تأخذ منحىً «ميغالوبولياً». لقد تسلَّقت بيروتُ الجبالَ التي تحوطُها وألحقَتها بها، بدونِ أيِّ هدفٍ تنظيميٍّ مدينيٍّ ظاهرٍ. وردَمتِ البحرَ في أكثرِ من موقعٍ. فلم يَعُد للتخطيطِ المدينيِّ فيها أيُّ معنى. ولم يعدْ لخطابِه النظريِّ أيةُ علاقةٍ بالحقائق ِ العملانيَّةِ التي تصنعُ الوقائعَ الجَديدة. وربَّما استَطَعْنا القولَ أيضاً، إن أيَّ مخطَّطٍ بسيطٍ لاستعمالِ الأَراضي، قد فَقدَ معناهُ هو الآخر. لقد أَصبَحَت كلُّ شَبكاتِ الطرقاتِ والأوتوستراداتِ المدينيَّة وسائطَ عبورٍ، وأدواتَ اتصالٍ بين بعضِ النقاطِ الحسَّاسة في المدينةِ وخارجَها، كالمطارِ، ومنطقةِ الفنادقِِ في وسط بيروت، والمُولاتِ، ومراكز التسوُّق المتكاثرة. أما الأرصِفَةُ، والحيِّز العامُ، والحدائقُ، وشبكاتُ البنى التحتيَّةِ، فهي إما غائبةٌ بشكلٍ دراميٍّ، أو لاهثةٌ لتلْحَقَ بعضَ المَباني البرجِيَّةِ التي تَنمو كالفِطرِ هُنا وهناك. لم تعُد مجالاتُ المدينةِ مقروءَةً، ولم يعدْ تعريفُ حدودِها ممكناً.
هل أن الحدودَ الشرقيَّةَ لبيروت هي الجبالُ التي تحوطُها؟ أم أنَّها بدايةُ امتدادِ القِمَمِ، حيثُ يُنهي البنيانُ المدينيُّ تسلُّقَه؟ وحدودُها البحريَّة؟ هي حيثُ تنتهي اليابسةُ؟ أم أَنها حيثُ تبدأُ مياهُ البحرِ؟ ومتى ستَنْتَهي أعمالُ الردمِ؟ لنُحدِّد بدايةَ مياهِ البحر؟ وهناكَ من قالَ ساخراً، إنَّه مع استمرارِ أعمالِ الردمِ، سيَلتَصِقُ لبنانُ بُقبرُصَ الجارة. يمكن القولُ، أن كلَّ ذلكَ يؤدِّي إلى غيابِ الأمكنةِ، إي إلى تعميمِ «اللامكان».
II المكانُ، ومقاومةُ «المكانِ – الشكل».
أن نُوجَدَ، وأن نَبْني، وأن نَسْكُنَ، وأن نَعيشَ ونعمَلَ في جماعاتٍ متعاونةٍ وموحَّدةٍ، إن هذا المسارَ للجنس البشريِّ، من الوجودِ البسيطِ للإنسانِ الفردِ، إلى ارتقائه وصولاً إلى الحياةِ الجماعيَّة المِعطاء، منتجَةِ القوَّةِ والسُلطةِ، ومنتَجةِ «المدنِ الدول» عَبْرَ التاريخ،
إن هذا المَسار، لا يُمكِنُه أن يتحقَّق إلا في مكانٍ محدِّدٍ بوضوحٍ، نُعرِّفُ خَصائصَهُ ونعرِّفُ ميزاتِ الجماعة التي تعيشُ فيه. فوجودُ المكانِ المحدَّد بوضوحٍ، هو بدورِه ضرورةٌ لمواجهةِ «غِياب الأمكنة»، وتعميم «اللامكان». وهو الشرطُ المُسبَقُ الذي يسمحُ بابتكارِ عِمارةٍ مُقاومة. فالمكانُ هنا يُصبح في التعريف «مكانٌ شكلٌ»، بمخزونٍ سياسيٍّ مقاومٍ. وهو شرطٌ رئيسٌ لظهورِ العِمارة المُقاوِمَة، تماماً كما كان المكانُ المحدَّدُ لعيشِ الناس جماعةً متراصَّة متوحِّدة، شرطاً رئيساً لإنتاجِ القوةِ والسلطةِ الشرعيَّة الضروريَّةِ «للمدينة الدولة»، بجوهَرها السياسيِّ.
ـ 5 ـ
العِمارةُ المحليَّة المُقاوِمة، ووعيُ المكان.
I العِمارةُ المحليَّة المُقاوِمة.
سَادَتْ، وتسودُ الآنَ في الفكرِ المعماريِّ الحداثويِّ، مقولةُ الأَرضِ المحروقةِ أو الطاولةِ المسطَّحةِ الفارِغَة. وتقودُ هذه المقولةُ بداهةً، إلى الإمعانِ في استعمالِ الآليات الكبيرةِ، لتَسويةِ المواقِعِ وللتشييد. كما تقُودُ أيضاً إلى اعتبارِ الموقعِِ المسطَّح، المُعطى الطبيعيّ الأمثل تقنيَّاً واقتصادياً لِعقْلنَةِ البُنيان وذلك في كلِّ المواقعِ، دون الالتفاتِ إلى طبيعةِ تكوينها وإلى طُوبُّوغرافيَّتِها. والتضادُّ هنا أساسيٌّ، بين الرؤى والتكنولوجيَّاتِ المسمَّاة «كونيَّة»، وبين الثقافاتِ المحليَّةِ الأصِيْلَة. فجَعلُ المواقعِِ غيرِ المنتَظِمَةِ طُوبُوغرافياً مُسطَّحة باستعمالِ الجرَّافات، هو نهجٌ تكنوقراطيٌّ فجٌّ، يهدُفُ إلى إنتاجِ الشرطِ المثاليِّ المطلقِِ «لغيابِ المكانِ» أي بتعبيرٍ آخرٍ، لإنتاجِ اللاَمكان، كما يقولُ مارك أوجيه.
في حين، أنَّ تجليلَ الموقِعِ المذكورِ كما كان يَجري في مُعظَمِ الأراضي اللبنانية على سبيلِ المثالِ، لنَصِلَ إلى مبنى متدرِّجِ الشكلِ، هو التزامٌ بما يُمكِنُ أن أُسَمِّيه «زراعة الموقِعِ»، وفق تعريفِ ماريو بوتَّا. إنَّها مقاربةٌ تَنْبَعُ من الثقافةِ الخاصَّةِ بالمنطقة. فقد حُفِرَ تاريخُها بالمضمونَيْن الطُّوبوغرافيِّ والزراعيِّ، في شكلِ المبنى المتدرِّجِ، ولهذا الحفرِ مناسيبُ متعدِّدة في دلالاته. فهو يجسِّد تاريخَ المكانِ قبل تحوُّله إلى بنيانٍ، كما يُجسِّدُ ماضِيه الطوبوغرافيِّ وزراعَتَه وتحولاتِهِ اللاحقة، عَبْرَ هذا التراكُمِ طبقات، دون السقوطِ في سياقٍ حنينيٍّ عاطفيّ.
والمَنْحى الذي اعتُمِدَ في مسألةِ الطوبوغرافيا، يُمكِنُ اعتمادُهُ في حالةِ النسيجِِ المدينيِّ الموجودِِ، أو في حالةِ المؤثِّراتِ المناخيَّةِ، أو في حالةِ جودةِ الضوءِ المحليِّ، وانعكَاسَاتِه المتغيِّرة. فالدَمْجُ الحسَّاسُ لكلِّ هذِه العوامِلِ، عليهِ أن يَكونَ مُقاوِماً بالضرورةِ للاستعمالِ الأَقصى للتكنولُوجيا المُتقدِّمة أو الهاي تك المسمَّاة «كونية»، كما جاءَ في بدايةِ هذا النص.
II وعيُ المكان.
ويُصْبِحُ هذا المَنحى أكثرُ وضوحاً في حالةِ التحكُّم بالضوءِ وبالمناخِ الذي يَجعلُ من النافذةِ الموروثَةِ، المكوِّنَ الأكثرَ حساسيَّة، حيثُ تلتقي القوَّتان الطبيعيَّتان، الضوءُ والمناخُ، المؤثِّرتَان في صياغةِ الغلافِ الخارجيِّ للمَبنى. فلتنظِيمِ النوافذِ في هذا الغِلافِ، القُدرةُ الفطريَّةُ على حفرِ العِمارةِ بانسجامٍ كليٍّ مع الطابعِ المحليِّ للمكانِ حيثُ تقُوم.
فإلى زمنٍ قريبٍ، كَانتْ المُمارسَاتُ المُتْحفيَّةُ، تشجِّعُ الإضاءةَ الحَصْريَّة لصالاتِ العرض بالضوءِ الاصطناعيِّ. وقد ساهَمَ هذا التعْليبُ، في تَحويل العملِ الفنيِّ إلى سلعةٍ، وتآمَرَ لجعلِ العملِ الفنيِّ معروضاً خارجَ الأمكنةِ، أي في «اللامكان». ونقيضُ هذا اللامكان، يكونُ بتأمينِ إضاءَةِ صالاتِ العرضِ بالضوءِ الطبيعيِّ، عَبْرَ آلياتٍ تُجنِّبُ المَعروضاتِ الأثَر السلبيَّ لضوءِ الشمسِ. معَ الانتباهِ إلى أنَّ الضوء الطبيعيَّ يتغيَّرُ بعواملِ الوقتِ، والفصلِ …، وغيرها. ومثلُ هذا الانتباهِ، من شأنِهِ أن يؤمِّنَ ظُهُورَ صالاتِ العرضِ بشاعريَّةٍ مصَفَّاةٍ، يتوازى فيها التفاعُلُ بين الثقافةِ والطبيعةِ، بين الفنِّ والضوء. وانطلاقاً من مبدأ التصفيةِ الشاعريَّةِ هذه، تُلحظُ النوافذُ في الواجهاتِ غائرةً هنا، أو بارزةً هُناك، أو محميَّةً بكاسراتٍ للشمسِ هنالك.
وما قياساتُ هذه الفتحاتِ النوافِذ، وتنظيمُها في الواجهاتِ، سوى تعبيرُ الثقافَةِ المحليَّةِ التلقائيِّ. III استمرارُ المقاومةِ و«التكتونِك».
يَظْهرُ المكيِّفُ المُستَعملُ في كلِّ الأزمِنةِ وفي كلِّ الأماكن، باعتبارِه الخصْمَ الرئيسَ لكلِّ ثقافةٍ محليَّةٍ أَصيلة. وربَّما استطعنا القولَ، إن العِمارةَ في بحثِها عن الاستقلاليَّةِ، وعن روحِها المقاوِمة وهي تُواجِهُ مَسَائلَ المناخِ، والضوءِ، والمُعطى الجغرافيِّ والطُوبُوغرافيا،
ربَّما استطعنا القولَ مع كِنِتْ فرامبتون، إن في هذه العمارةِ بعضُ المشهديَّة التي لا تعْطيها استقلاليَّتها الكامِلة، وروحَ المقاومةِ التي تنشُدُها. وإن المبدأ الأوَّل في الاستقلالِ المعماريِّ، وفقَ فرامبتون دائماً، إنما يكمُنَ في ما سمَّاه «التكتونِك» (Tectonic).
ربما كانَ في هذا التعبيرِ شيءٌ من التقنيَّةِ، أو أنَّ فيهِ محاولة لاكتشافِ الروابطِ الحديثةِ بين البُنيانِ وبين هيكله الإنشائيِّ، أو أنَّ فيه بعضُ البحثِ عن شاعريَّةِ البنيان. إلاَّ أن المَعاجمَ تَرقَى بالمُفردةِ لتجعلَها لصيقة «البنائيِّ والمعماريِّ»، أو لتُعطيها بُعدَ «فنِّ التشييد وإقامةِ العِمارةِ الجميلة»، متطابقة هنا مع تعريفِ فيولِّيه لودوك، أَنَّ العِمارةَ هي فنُّ البنيان.
ترقى المعاجمُ بالمفردةِ إذاً، لتجعلَ منها فنَّ المكان كما يقولُ كريستيان نوربرغ شولتز. أو أنه فنُّ المكانِ المحدَّد بوضوحٍ، كما نفهمُ ما يقولُهُ كِنِتْ فرَامبتون.
ـ 6 ـ
من المرئيِّ إلى الملموس.
المكانُ الشكلُ، والمبنى المتدرِّجُ الذي يُحفَر فيه مرئياً التاريخُ المحليُّ الطوبوغرافيُّ والزراعيُّ، والدلالاتُ الثقافيَّةُ مرئيةٌ في نوافِذ الواجهاتِ، والتحكُّمُ بالضوءِ الطبيعيِّ مرئيٌّ في قياساتِ هذه النوافذِ وفي تَموضُعِها، والتحكُّم بتأثير ضوءِ الشمسِ مرئيُّ في كاسراتِ الشمسِ تصطفُّ أمامَ الفَتَحاتِ الزجاجيَّة الواسعة، في كل ذلكَ دلالاتٌ مشهديَّةٌ واضحةٌ، وقراءةٌ للبيئةِ التي تَحوطُ، بمُصطلحاتٍ يقترِحُها المشهدُ وحدُه.
الأولويةُ المعطاةُ للمشهدِ أو للرؤيةِ، هي ضروريَّة لقراءةِ المقوِّمات الطبيعيةِ للمكانِ، ولإدراكِ المُكَوِّناتِ البنيانيَّة والمِعمارية أو «التكتونية» فيه، بالعودةِ دائماً إلى كِنِتْ فرامبتُون.
نستعملُ هذه الأولويةَ، للتذكيرِ بأن الملموسَ يشكِّل بعداً هاماً في فهم «المكان الشكل»، وفي إدراكِ الشكلِ المبنيِّ. ولكلٍّ منَّا في ذهنِهِ مجموعةٌ كاملةٌ من الإدراكاتِ الحسيَّةِ يسجِّلُها جَسَدُه، وبعضُ هذه الإدراكاتِ الحسيَّة تكادُ تكون ملموسةً، أخصُّ منها حجارةُ البنيان.
بيتُ طفولتي بالعَقد الحجريِّ و«اليوكُ» بتَجَاويفهِ الكثِيرة، ومدخلهُ المنخفضُ، ووقعُ أقدامي على حِجارة أرضِه، كلُّ ما فيه وُضِع في مكانهِ، ليكونَ ملموساً أكثر منه بصرياً مرئياً.
الحجارةُ الظاهرةُ تسجُنُ عادةً، أما حجارةُ بيتي التي أُداعبها بعينيَّ تزرعُ فيَّ حريَّتي، وتُشْعِرني بعلاقةٍ حميمةٍ مع المصطَبةِ في الخارجِ، ومع شجرةِ الصَّنوبرِ الوَارفةِ خَلف النافذة.
يُشعرني وقعُ أقدامي وأنا أجتازُ المَصْطَبَةَ الحجريَّةَ إلى الدربِ التُرابيِّ المُوصِلِ إلى الكُرومِ، بليونةِ الانتقالِ من خُشُونَةِ الصَّخرِ إلى طَراوة التراب، ويُصبح كلُّ المُحيطِ ملموساً. يتفتَّتُ بين أصابِعي ترابُ الدربِ وأنا أنظرُ إليه، وتخدشُ كفِّي حِجارةُ البيتِ وأنا أُداعِبُها بناظريَّ.
في بيت طفولتي الحجريِّ، المرئيُّ ملموسٌ يفكُ أَسْري، فيجعَلُ من السِّجنِ الافتراضيِّ الذي يشعرُ به جسَدي مجالَ انفتاحٍ يربُطني بالجدارِ المقابلِ الذي ألمُسُ خشونتهُ عن بعد. المُقَاربَةُ المحليَّة الناقِدةُ، تُكمِلُ تجرَبتنا البصريَّة عَبْرَ إكمالِ إدراكنا لِمَا حَولَنا. وهي تحاولُ بذلكَ أن توازِنَ الأولويَّة المُعطاةَ إلى البعدِ المرئيِّ، وتواجِه المنحَى الغربيَّ الذي يفسِّرُ المحيطَ بتعابيرَ منظوريَّةٍ حصريَّا. فالمنظورُ وفق هذهِ الحصْريَّةِ، يعني عقلنَةَ المشهد. إنَّه يفترضُ إلغاءً لأحاسيسَ أُخرى يُنعِشُها المحيطُ فينا، مثلَ الرائحةِ، والسَمعِ، والمذاق ِ، والمسافةِ.
إن هذا التحديدَ الحَصْريِّ المفروضَ ذاتياً، يُوصِلُ إلى ما يمكنُ أن نسمِّيه الابتعاد أو غياب الاقتراب. ولمواجهةِ غِياب الاقترابِ هذا، يواجِهُ الملموسُ المشهديَّ الحصريَّ، ويَدفعُ إلى الإدراكِ الكاملِ عَبْرَ اللمسِ، بما يُعيد المِعمارَ إلى شاعريَّةِ البُنيان.
فالملموسُ والبنياني المعماريُّ أي «التكتونك» مُجتمِعَان، يَملِكَان القدرةَ ليَرقيا بالمظهرِ المجرَّد للتقنيِّ، إلى المنسوبِ الذي يُصبِحُ فيه «للمكان الشكلِ»، القدرةَ على التصدِّي لهُجُومِ التحديثِ المُعولمَ.
VII
نَقِفُ مذهولينَ أمامَ هذا الهُجومِ، حينَ نرى الانتشارَ الكونيَّ لثقافةٍ وَضيعةٍ. إنَّها ثقافةٌ بدائيَّةٌ، تلفُّ العالمَ اليوم. السينما السخيفةُ ذاتُها، والأزياءُ المنمَّطة ذاتُها، وجراحةُ التجميلِ ذاتُها، والحرصُ على نحتِ الجسَدِ ذاتهُ، وسيطرةُ الألومينيوم المُعْتِمِِ ذاتُها، والمصنَّعات البلاستيكيَّة الملوَّنةُ ذاتُها، وتشويهُ اللغةِ عَبْرَ الإعلانِ ذاتُه.
إنَّها مقاربةٌ جماهيريَّةٌ لثقافةِ الاسْتِهلاكِ المُسيطِرةِ. يقفُ الناسُ فيها عند منسوبٍ هو «دونَ الثقافيِّ».
وكأنَّ المطلوبَ منَّا في بلدانِ الإطرافِ ونحنُ نعمَلُ لتجديدِ أوطانِنا، كي نتَعايشَ مع كلِّ هذا السُخْفِ والوضِيْعةِ،
وكأنَّ المطلوبَ منَّا أن نَنْسى ماضِِينا، ونَرمِي تاريخَنا في البحرِ، ونتخلَّى عن ثقافَتِنا.
لا!
لن نَنْسىَ ماضِينا،
ولن نَرمِي تَاريخَنا في البحرِ،
وسنرقَى بثقافَتِنا، وسننتجُ شيئاً آخر، مُختلِفاً.
[ القيت في جامعة بيروت العربية