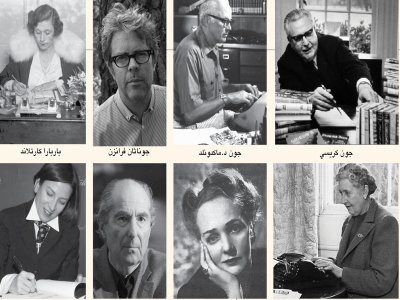ولد ميت على دراجة من عظام/ محمد رشّو

كان يصفني بأني بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس، لكني لم أكن أحسب ما يقوله إطراء بل وجه آخر لما كان يقوله أبي: حكيك متل ضرطات الخيول.
ففيما كنت مزاجياً حاداً عنيفاً، فأقول مثلاً: “الكتابة السورية جميعها تنوس بين الإنشاء والباروك”، أو “لا رواية سورية تُقرأ من دون الحاجة إلى علب بيبسي كولا لهضمها”، أو “الموسيقى هي الجاز فقط”، كان هو محدّثاً بارعاً ومسلياً يتنقل بين قصص سعيد حورانية وقصائد رياض الصالح الحسين وأفلام محمد ملص وموسيقى أديب الدايخ وجميل هورو وصبري مدلل وصباح فخري. كنت أراه عبقريا يمشي ومن حوله هالة غير مرئية.
في حي الفرنسيسكان، ذات مرة، توقف لبرهة أمام المبنى ذي القرميد الأحمر، أشار بيده إلى الصليب على السطح وأنشد: أنظروا إليه لقد تفسخّ جسده ولا يزال يحمل راية الحرية.
وبينما كان أبوه يرى فيه عاقاً فاشلاً ثرثاراً نال شهادة البكالوريا بعد أربع دورات، فجرّه بالقوة إلى ورشة الألمنيوم، كنا نراه فيلسوفاً.
كنا نعقد جلسات الشلة في مكانين من منزله بالسريان الجديدة انتزعهما بالقوة أو الاتفاق مع العائلة: في البلكون صيفا، حيث نطل على أشجار الصنوبر والسيارات التي تعبر الخط الدائري الشمالي، أو في المطبخ.
تتجمع العائلة أمام التلفاز في الصالة، أو في غرف النوم: الأب والأم، الشقيقان والشقيقة التي تبدو قبيحة على رغم أنها تشبهه تماماً وتحمل ملامحه الجميلة نفسها، وهذا يحصل كثيرا بين الأخوة. لم نرها سوى مرات قليلة. كانت ترتدي نظارات طبية، صامتة، بلهاء، لا تنطق سوى كلمة واحدة حين تُستفز: عكه، أي خراء، ولا تنطقها دِراكاً بل رشاً: عكه عكه عكه.
كنا، نحن ضيوف منزلهم، نحشر أجسادنا في الكراسي، ونحشر الكرسي في أحد المكانين حول طاولة مشروب صغيرة ونتكلم.
كان يحب روشين اليزيدية حباً يراه هو رهانه على الحياة، نراه نحن أصدقاءه يائساً. فاليزيديون يمتنعون عن تزويج بناتهم لأي شخص من دين آخر. حين فاتح عائلة روشين، سدّ عليه الأب المنافذ، وحين أخبره بأنه شيوعي ولا دين أصلاً ومستعد أن يحجّ إلى لالش ويفعل ما يريدونه، ردّ الأب بصرامة أشد: ربما لم تعد مسلماً كما تظن، لكن مهما فعلت لن تصبح إيزيدياً. لم تكن تنقصه الغرابة أحياناً، فحين يسكر كان لا ينصت إلا إلى تلاوة عبد الباسط عبد الصمد.
في الليلة التي سبقت فراره مع روشين إلى لبنان سراً، كان الوقت قد تأخر كثيراً. أخذنا نشرب البيرة المكسيكانو في مطبخ العائلة. كانت تمطر، وكنا نكسر الموالح ونمصّها، فيما هو ينشد قصائد رياض الصالح الحسين عن الموتى. ثم أخذ يتحدث لأكثر من ساعة عن الموت المشتهى في فيلم “الليل”.
بينما كنا نشرب نخب بعضنا، وكان يتحدث جزلاً، قاطعه أحدنا بحماقة :
حكي بس حكي، يا أخي ليش ما بتترك روشين؟
سكت تماماً وظل يحدق في السائل البني الذي يرغي في الكأس أمامه. ثم بهدوء فكّ سحاب بنطاله وأخرج قضيبه وأخذ يتأمل حيوانه الصغير بحنان .
لم تكن حركة إغراء أو استعراض فرويدية. لم يداعب حيوانه الذي لم ينتصب. فقط كان ينظر إليه كصديق حميم فقد عزيزا، ولا يجد ما يعزيه.
ليلتها حدثت مصادفة أن باب المطبخ ترك مفتوحاً، وكانت الأخت البلهاء قد أستيقظت لأمر ما، ربما ذهبت إلى التواليت. وبينما كانت تعبر الممر أطلت برأسها وشعرها الطويل من باب المطبخ في اللحظة التي كان الأخ يتأمل حيوانه، فما كان منها إلا أن أطلقت رصاصاتها بشكل شيطاني: عكه عكه عكه عكه.
لم نلتق بعدها البتة، كان قد عاد إلى حلب وأستأجر منزلاً بعيداً عن السريان، وعاش مع روشين حياة سرية لا تمت بصلة بمعارفهما السابقين، مخافة انتقام أحد ما من أهلها. هذا ما عرفته منه حين أصبحنا أصدقاء على الـ”فايسبوك” منذ سنة، وأصبح كل منا في جهة من جهات الأرض بسبب هذه الحرب اللعينة.
كان وزنه قد زاد مقدار أربعين كلغ، وأصبح أصلع، لكنه كان لا يزال حالماً بحياة أخرى مشتهاة.
ألتقيته قبل شهر على “السكايب”. كان منهاراً تماماً. أخبرني أنه كان على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا وغرقت قبالة الشواطئ الإيطالية. بناته الأربع فُقدن في البحر. روشين أنقِذت، لكنها منهارة تماما وتسعف مرتين في اليوم في المشفى بسويسرا. أما هو فكان في مالطا، يبكي على “السكايب” ويقول: لَكْ بس أشوفون ولو ميتات.
بعدها فقدتُ أثره تماماً. فقط منذ أسبوع، رأيته وقد نزّل بوستات على الـ”فايسبوك” – هو أو غيره ، لست أدري – إذ لم يرد على رسائلي الخاصة. لم يبق أمامي سوى صوره وصور العائلة وبوستاته الأخيرة وجميعها قصائد عن الموتى. أقرأها الآن بعد ما يقارب عشرين سنة من كتابتها، وكأنما المرة الأولى أقرأ عن الفنان الميت الذي ينظر إلى عظم الكتف الذي ربما يصلح لصنع طائر. عن الجميلة الميتة التي نظفت قبرها وجلست لتحلم بثوبها الأزرق. عن الولد الميت الذي يدور في فناء قبره ممتطياً دراجة من العظام. وعن العاشق، العاشق الميت الذي يحفر تراب القبر بالأظفار والأسنان، ليصل إلى من يحب.
* * *
حين تعرّت هالة الفيصل
حين تعرّت هالة الفيصل في ساحة سكواير تايمس بنيويورك، احتجاجاً على حرب أميركا في العراق، حصل نديم على صورها من موقع أميركي على الأنترنت. قال وهو يريني عبارة “stop the war” المكتوبة بالأحمر على الظهر العاري نزولاً حتى خط المؤخرة: مناهضة الإمبريالية لكِ، أما الجسد فلي.
كان عازباً على مشارف الخمسين. يسكن في منزل واسع ورثه عن العائلة في محطة بغداد. لا يقوم بعمل محدد، يعتمد على ما ترسله إليه شقيقته المقيمة في أميركا. يسكر مع شلة أصدقاء أو وحيداً، ينام، يقرأ، وأحياناً يعتزل في الشقة شهراً، ويخرج غالباً لينزّه كلبه. مرة قال لي: “أحياناً، حين أخرج، أرى محلاً جديداً افتتح، وآخر أغلق أبوابه، فأشعر كأنني صرت في حيٍّ آخر”.
رأسماله غرامياته. مع مرور السنوات حوّل إحدى غرف البيت متحفا للجنس، حيث جمع وصنّف ورتّب ما توفّر له من صور وأفلام وكتب تخصّ الإيروتيكا، ثم توصّل إلى استنتاجات من قبيل: “الجسد الأوروبي مهما كان جميلاً ومتناسقاً، يبقى الجسد عندنا أشدّ إثارة”، أو “إن وضعية 69 هي الوضعية الوحيدة العادلة لتبادل الحب”.
في الحرب بدا أشدّ ضراوة في علاقاته. وبينما كانت الطائرات تقصف، كان، ليبرهن أن الحياة أقوى، يكثر من مشاهدة فيلم “المطلوب رجل واحد”، متجنبا أي إشارة للاشتباكات أو الحواجز أو القتل والخطف، بل ويجادل كما لو أنه يعود ذاك الشاب اللامع الذي تخرّج بإمتياز وكان يحضّر أطروحة لنيل الدكتوراه في تاريخ الفن، ويراهن بحماسة على أن المشهد الذي تخرج فيه إغراء عارية تماماً من النهر وتتمايل على حصى قرب الضفة، هو الأشد إثارة في تاريخ سينما البورنو، وأن إغراء تضاهي جينا جيمسون. حين ذهبت لوداعه قبل خروجي من حلب يائساً، كان سكران، والكهرباء مقطوعة. استقبلني بلمبة صغيرة تُشحن مسبقا، قادني في الممر، ثم أطفأها. تتبعته بصعوبة نحو الشرفة المطلة بزاوية حادة على الحديقة العامة. أجلسني قربه حول ترابيزة بلاستيكية، وقال: أظنك كنتَ على صواب، ليس بالجنس وحده يحيا الإنسان.
إبتسمت إبتسامة بدت، بالتأكيد، غير مرئية في تلك العتمة. أظن أنه أحس بها، فتصنّعت البراءة، لأني كنت فقدت الإيمان بكل شيء، ولم أخبره بقراري.
كان قد استُدعي صباح ذلك اليوم كشاهد في قضية طلاق تخصّ صديقاً له، وذلك أمام محكمة ثورية شكلّت على عجل من حرفيين – أحدهم كان حداداً، يدعى دفزنكار، أي ذو الفم الصدئ – يحتكمون إلى العُرف والمزاج ويجهلون القوانين جهلاً مطلقاً. بينما كان صديقي يدلي بشهادته، فتح أحدهم باب القاعة ونادى: نان هات، أي وصل الخبز.
لم تمضِ ثوان حتى صار وحده في القاعة يتأمل الكراسي والأثاث، إذ خرج القضاة ولجنة الحكم وتركوه وحيداً، ليعودوا بعد خمس دقائق، كلُّ منهم يحمل ربطة من الخبز أو ربطتين، بل أن بعضهم فتح الربطة وأخذ يتناول رغيفاً.
في تلك اللحظات لم يكن أمام صديقي سوى أن يبتسم ويراقب ويلعن في سرّه ذاك الصديق الذي طلّق زوجته، ثم نظر إليّ وهو يبكي، كأنه لا يزال في قاعة المحكمة، وصرخ: أَو لَكْ هدا إبن الحرام لمّا بينيك ما بيتذكرني، ولمّا بيطلّق بيقول تعْ خلّصني، أُو لَكْ…
* * *
سيلفيا
قالت بصوتٍ أمومي، مع أنها في عمره: الله يرحمو يا ابني، على الرغم من أنه كان يقول دائما: “كنت أفضّل الممتلئات” plus size model، جميلات القرون الوسطى، الودودات الولودات، كما أتخيلهن، ذوات الأفخاذ، اللواتي يمتلئ الفم باللعاب حين نشدّ على حرف (تش) ونلفظها بالكردية “إي بقالتش”. لكني كنت أتعثر دائما بالمعروقات، السوداويات، المكتئبات، الخجولات اللواتي عانين من حبِّ الشباب طويلاً، ولعل أشدهنّ غرابة تلك التي تعلقتُ بها قبل ذهابي إلى الجيش بستة أشهر، وكانت تسمّي نفسها سيلفيا. خطر في بالي كثيراً أن أسألها: هل تعرفين تيد هيوز، أو هل قرأتِ رسائل عيد الميلاد؟ لكنني لم أفعل.
سيلفيا كانت نحيلة ترتدي الملابس الضيقة وكل ما يخص الإيمو من إكسسوارات ورتوش: الملابس السوداء، الشعر المسبل المتروك منسدلاً على الوجه، سماعات الهيدفون في الأذن، وطوق جميل من القماش بمربعات بيضاء وسوداء صغيرة ما زلت أحتفظ به. كنا معاً نحيا في سماء من الأغاني العاطفية: “أنت لي، أنا لك، لا أستطيع لا أستطيع، سأنتظرك: خوزيا هيفي بيك باتانا”، أغني لها، وتغني لي عن رجل يدعى محمد، أو ممد، كما ينطقه الأتراك، ويذهب إلى الحرب ولا يعود. كانت كلما وصلت إلى اللازمة التي تقول: “آآخ ممدم، جانم ممدم”، ضغطت على يدي وبكت.
كانت سيلفيا تعمل عند كوافيرة نسائية، مما كان يرتب علينا أن نمضي يوم الاثنين فقط معا، نجوب حلب من الأشرفية إلى السبيل، ومن ساحة سعدالله الجابري إلى الحديقة العامة، إلى العزيزية، فالسليمانية. هي إلى جانبي تمشي بكتفين منحنيتين، يداها في جيوب البنطلون، وتنظر إلى مقدمة حذائها، فيما أضع يدي على كتفها، سابحين في غيمة الموسيقى التي تخفف من وطأة البدن وترفع الكائن عن الأرض. نظل نمشي حتى العاشرة مساء، فتعود هي إلى بيتها الذي يشاركها فيها ستة أخوة وأربع أخوات والأب الذي لم تلفظ إسمه، بل كانت تسميه “بيناموس”، أي عديم الشرف.
بيناموس كان يمت إلينا بصلة قرابة بعيدة. سكرجي، طلّق زوجته، وكان معلم أراكيل في مقهى شعبي في بستان كليب. لكن أمي كانت تقول إنه ليس أقل من قواد، يسوق الزعران وأولاد الكلب أمثاله إلى غرف القحبات في فنادق باب الفرج.
ذات جنازة عائلية، وبينما كنا نحفر القبر، اقترب منا وجلس على حافة وأخذ يراقبنا. لم يكن مبالياً لا بالميت ولا بالجنازة. لكنه حين بدأ الشيخ يلقّن الميت، لم يتمالك نفسه فأجهش بالبكاء. أستغربنا ما حدث، وبينما نحن ننظر إليه بطرف أعيننا، مد يده إلى جيب جاكيته ليخرج ما يجفف به وجهه، لكن لم تظفر يده بسوى فضيحة تحولت نكتة لكثرة ما تداولناها: أخرج كلسوناً نسائياً، أبيض اللون، برسومات على شكل قلوب وفراشات حمراء، فما كان من عمتي سوى أن أثبتت حكمتها مرة أخرى. اقتربت منه وأخفت الكلسون بحركة سحرية، ناولته مناديل كلينكس، وربتت كتفه.
النهار