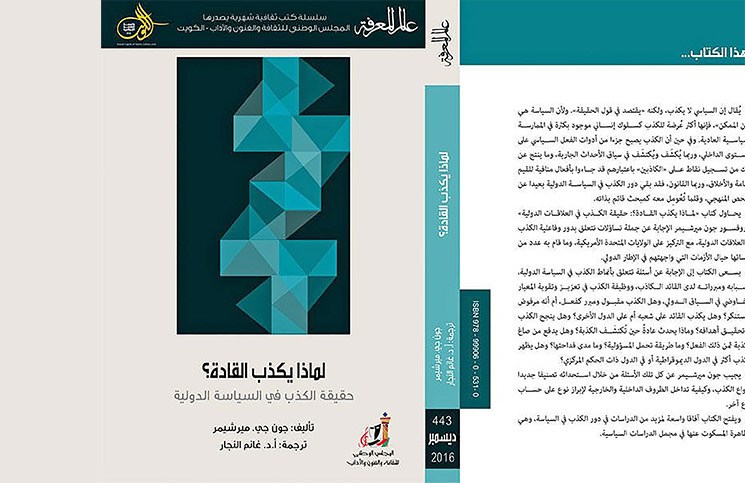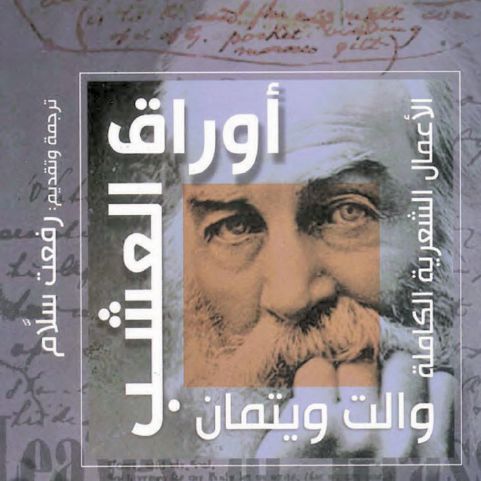السلطة و«الإسلام الهادئ» في سوريا خلال القرن العشرين/ محمد تركي الربيعو

شهدت فترة التنظيمات التي عرفتها الدولة العثمانية (1839-1876) عدداً من الإجراءات الإدارية والسياسية التي هدفت إلى صياغة مفهوم جديد للمجال العام العثماني. إذ نظرت النخب العثمانية إلى المجتمع ككيان غير واعي بذاته، فوجدت ضرورة إعادة صياغته من أعلى (الدولة) عبر إعادة تشكيل العامة ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية ومراقبتها بشكل وثيق.
وعلى مستوى مدينة دمشق، فقد شهدت المدينة كحال باقي الولايات العثمانية فترة من الإصلاحات الإدارية والقانونية، التي سعت من بين عدة أمور إلى إعادة ترتيب دور المشايخ داخل المجال العام الجديد، الذي أخذ يتشكل بعيد فترة الأحداث الطائفية التي شهدتها المدينة سنة 1860، إذ استغلت الدولة العثمانية هذه الأحداث – وفقاً لرأي المؤرخ السوري زهير غزال في كتابه «الاقتصاد السياسي لدمشق في القرن التاسع عشر»- لفرض التقنيات السياسية والإدارية التي سنتها التنظيمات العثمانية.
مع ذلك فإن تأثير الإصلاحات التي جاءت بها التنظيمات على الوضع الاجتماعي للمشايخ في سوريا لم يكن سلبياً، بل على العكس من ذلك شهد التنفيذ الفعلي لما جاءت به الإصلاحات زيادة في نفوذ العلماء. فالمجالس المحلية وبحكم وظائفها المتعددة من إدارية ومالية وقانونية، كانت تتمتع بمكانة جيدة، إذ كان يشرف عليها الأعيان والعلماء. وبفضل مشاركتهم في المجلس الذي كان يتمتع أيضاً بسلطات قضائية، استطاع العلماء لفترة من الزمن تخطي التقييدات القضائية أثناء التطبيق العملي. غير أن هذا الوضع بدأ يتغير بعيد الحرب العالمية الأولى. ونحن هنا أمام قراءتين بخصوص وضع المشايخ ومكانتهم بعد تشكل الدول الحديثة في سوريا. الأولى ترى أن الإصلاحات الإدارية التي قامت بها الدولة العثمانية في أواخر حياتها على مستوى التعليم العام، ساهمت في أفول التعليم الديني ونهاية تحكم رجال الدين في تأهيل العاملين في الدولة. ولذلك ومع بدايات القرن العشرين شهدت دمشق ظهور نمط جديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهؤلاء الفاعلون هم من لعبوا دوراً أساسياً بعيد فترة الحرب العالمية الأولى داخل الحياة السياسة والمؤسساتية للدولة.
ويعد يوهانس رايسنر في كتابه «الحركة الإسلامية في سوريا» أحد الداعمين لهذه الرؤية. إذ يرى أنه بعيد الحرب العالمية الأولى أُزيح العلماء ليس فقط من قطاعي التربية والتعليم والقانون، بل أيضاً من الوظائف الإدارية. أما في السياسة فلم يكن لهم بعد الحرب العالمية الأولى أي دور يذكر. ولتأكيد وجهة نظره هذه يشير رايسنر إلى لوائح مهن البرلمانيين في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 1919 إلى 1954، التي يظهر من خلالها أن عدد العلماء في البرلمان كان يراوح ما بين واحد إلى اثنين. ووفقاً لرايسنر فإن الحركات الصوفية في سوريا شهدت حالة من انحسار النفوذ لصالح جمعيات شبه سياسية إصلاحية، ولاحقاً لصالح الحركات الإسلامية التي أخذت شيئاً فشيئاً تسعى إلى استرجاع المكانة الأساسية التي كان يتمتع بها الإسلام داخل المجتمع، وهذا ما شكل تحدياً للمشايخ والطرق الصوفية في سوريا بشكل خاص. مع ذلك فإن العلاقة بين المشايخ من جهة والإصلاحية السلفية ولاحقاً الإخوان من جهة أخرى، اتسمت بحالة من التقلب يرجعها عبد الصمد بلحاج – باحث في إحدى الجامعات البلجيكية – في دراسته «الصوفيون والإخوان المسلمون في سورية.. البوطي ومدرسته» والمنشورة في كتاب «الإسلام النائم» إلى العلاقة المزدوجة التي نشأت بين الطرق الصوفية والسلفية الإصلاحية في سوريا منذ بدايات العصر الحديث. وفي هذا الصدد يميز بلحاج بين مرحلتين: الأولى مرحلة التعايش التي مال من خلالها جيل السلفيين الإصلاحيين الأول مثل حسن الرزق (ت1912) وأحمد الصابوني (ت1916) وسليم البخاري (ت1928) إلى مهادنة الطرق الصوفية والتركيز على التربية والصحافة، لتأسيس خطاب جديد موجه إلى الشباب المتعلم المنتمي إلى الطبقة الوسطى.
أما المرحلة الثانية فقد شهدت بداية الصدام في الثلاثينيات مع جيل توفيق الشيشكلي (ت1940) ومحمد سعيد الجابري (ت1948). والسبب فيه أن الإصلاحيين باتوا أكثر اهتماماً بالنشاط الاجتماعي والسياسي المباشر بوصفه رد فعل على الاستعمار الفرنسي. وبالتالي صار تقويمهم جذرياً لكل جماعة لا تشاركهم الحماس نفسه. لذلك كثر هجوم السلفية الإصلاحية على عقيدة الصوفية وممارساتها تحت تأثير السلفية الحنبلية، خاصة على الرفاعية والقادرية. ورغم أنه لاحقاً وبعيد تشكيل حركة الاخوان المسلمين في سوريا برئاسة مصطفى السباعي (1945-46) سعى الأخير إلى إيجاد مصالحة بين المؤسسات الإسلامية الجديدة ومؤسسة المشايخ التقليدية في سوريا. وعاد هذا التوافق ليعبر عن ذاته من جديد بعيد وصول البعث إلى الحكم سنة 1963، إلا أنه سرعان ما شهد حالة من الافتراق بعد أحداث الثمانينيات في سوريا. هذا ما يتعلق بالقراءة الأولى.
أما القراءة الثانية بخصوص دور علماء الدين في سوريا بعيد الحرب العالمية الأولى، فهي تعتقد – كما عبر عنها الباحث البلجيكي في جامعة أدنبره توماس بيريه في دراسته «الاتجاه الإسلامي الاستثنائي في سوريا» وفي أطروحته الأساسية «البعث والإسلام في سوريا: سلالة الأسد في مواجهة العلماء»– أن تجاهل دور العلماء في سوريا المعاصرة لا يعود إلى انحسار دورهم، بل هو ناتج بالأساس عن رؤية أكاديمية تجاهلت النشاط الإسلامي الأكثر هدوءاً لصالح الاهتمام بدور الحركات السياسية الإسلامية. ولذلك يرى بيريه أن إعادة قراءة التاريخ المعاصر لسوريا تؤكد أن العلماء كانوا الفاعلين الأكثر نفوذاً في ما يتعلق بعملية الأسلمة الاجتماعية في سوريا القرن العشرين. فمنذ العشرينيات فصاعداً، رد العلماء على انتشار القيم العلمانية عبر إنشاء المدارس الإسلامية، وتحديث عملية تدريب العلماء الشباب من أجل تعزيز الرقابة الدينية على المجتمع، وتكوين شبكة قائمة على المساجد تعمل على تهذيب الناس العاديين، خاصة طلاب وخريجي المدارس العلمانية الحديثة.
ويشير بيريه في هذا السياق إلى شخصيات مهمة مثل علي الدقر وكامل القصاب وراغب الطباخ وهاشم الخطيب، الذين أسسوا الجمعية الغراء والتوجيه الإسلامي والمدرسة الخسروية، ومن رحم هذا الجيل ظهر جيل الخمسينيات والستينيات الذي اهتم بإنشاء المدارس والمعاهد الشرعية مثل، حسن حبنكة وأحمد كفتارو وعبد الكريم الرفاعي في دمشق، ومحمد النبهان وعبد الله سراج الدين في حلب. في المقابل اقتصر الدور التبشيري للإخوان المسلمين على بعض الأوساط الاجتماعية والمدينية، إذ أنها كانت حركة نخبوية ينصب اهتمامها بالسياسات العليا من السياسة الخارجية إلى الإصلاح الزراعي. وبالتالي يرى بيريه أن الصحوة الإسلامية التي شهدتها سوريا منذ الستينيات فصاعداً كانت ظاهرة قادها العلماء بامتياز – بعكس بعض القراءات التي عادة ما تربط الأمر بتأثير الحركات الإسلامية داخل الطبقة الوسطى خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وانطلاقاً من هذه القراءة البديلة يعتقد بيريه أن العلماء في سوريا لم يكونوا أقل إسلاموية من الإخوان المسلمين، فقد دعوا في حقيقة الأمر وبصراحة إلى إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة، كما كانوا أكثر تصلباً من الإخوان المسلمين في النقاش حول الدستور خلال عقد الخمسينيات، إذ قاموا بالهجوم على السباعي إثر تراجعه عن تضمين مادة «الإسلام دين الدولة» في الدستور. ولذلك فإن مشروع العلماء بقي يدعم فكرة أسلمة المجتمع والدولة، من دون المساس ببنية النظام السياسي، كونهم كانوا يعتقدون أن العلمانية وليست السلطوية هي العائق الأساسي في سبيل تحقيق أهدافهم (بيريه). وبالتالي فإن الخلاف بين المشايخ والحركات الإسلامية كان يكمن في تفضيل العلماء لمفاهيم بيير بورديو وفق تعبير بيريه (من خلال إدارة سلع الخلاص وتقديم كل ما يتعلق بالدين، وتوضيح الطريق الأمثل للمؤمنين) بدلاً من أفكار ماكس فيبر التي تأثر بها الإسلاميون (والتي تعني المشاركة في السياسة ومحاولة احتكار العنف الشرعي، كما تفعل كل الأحزاب السياسية). ولعل الاختلاف في الرؤية السابقة هو ما حكم علاقة الإخوان بالعلماء والحركات الصوفية في سوريا بعيد مرحلة السبعينيات. إذ أن منهج العلماء في الإصلاح بقي يقوم على التربية الروحية كوسيلة أساسية لمواجهة البعث، ولذلك شهد نشاط الحركات الصوفية في دمشق ازدياداً ملحوظاً في الستينيات والسبعينيات تحت قيادة عبد الكريم الرفاعي (ت1973) ومحمد عوض. في المقابل وجدت بعض الأطراف الإخوانية في خيار المواجهة النهج الأمثل للتعامل مع نظام البعث خلال سنوات 1979- 1982 وقد ساندها في هذه الرؤية بعض أبناء الحركات الصوفية مثل الشاذلية والرفاعية، وأدت المواجهة إلى تفتيت بعض الجماعات (مثل جماعة حبنكة وجماعة زيد وجماعة أبي ذر في حلب). في مقابل ذلك عارض بعض مشايخ دمشق مثل أحمد كفتارو وصالح الفرفور ورمضان البوطي وبعض تلامذة محمد النبهان في حلب فكرة الخروج على الحاكم – انطلاقاً من الاعتبارات السابقة وتفضيلهم لحركة الأسلمة من الأسفل- وقد بقي هذا النهج هو السائد لدى العلماء، وهو ما سعى النظام السوري إلى تثبيته، خاصة مع قدوم الأسد الابن الذي شهدت فترته الأولى ضغوطات شديدة على نظامه بعد الغزو الأمريكي للعراق واغتيال رفيق الحريري، ورغم ازدياد المطالب آنذاك بالحقوق المدنية والسياسية، فإن العلماء الكبار في سوريا بمن فيهم المعروفون بعدم تعاطفهم مع النظام مثل الشيخ أسامة الرفاعي، لم يدعموا هذه المطالب، بل فضلوا التأقلم مع السياسات الدينية الجديدة التي جاء بها النظام في فترة الأسد الابن، والتي أتاحت لبعض الشبكات الدينية (مثل حركة زيد) وغيرها من الجمعيات الإغاثية الإسلامية إعادة النشاط داخل الأوساط الاجتماعية السورية، في ظل عجز المؤسسات الحكومية عن تقديم خدمات اجتماعية. وقد أدرك العلماء في تلك الفترة أن هناك فرصا جديدة للعمل الديني/الاجتماعي، وأنه يمكن استغلال ضعف النظام وقبوله بسياسات أكثر مرونة في سبيل خدمة المشروع الديني/الاجتماعي الذي يرومه العلماء في سوريا. (يمكن العودة إلى دراسة صعود جماعة زيد/توماس بيريه وكيتيل سيلفيك).
ومع قدوم موجة الاحتجاجات في سوريا بدا للبوطي أن الخيار الأمثل يكمن في ممارسة النهج السابق، عبر الحصول على مكاسب قطاعية في مقابل تقديم الدعم للأسد، مثل إطلاق قناة فضائية إسلامية وإنشاء معهد جديد للغات، إلا أن بعض علماء دمشق لم يوافق على هذه السياسة (كما في حالة الشيخ كريم راجح وأسامة الرفاعي) الذين امتدحوا المتظاهرين ودعموا الثورة، ورغم محاولة هؤلاء العلماء تشكيل جسم من المشايخ مساند للمعارضة (وهو ما تمثل في المجلس الإسلامي الأعلى) إلا أنهم افتقدوا الحيوية السابقة، لأسباب متعددة؛ أولها – لم تكن تجربتهم السياسية في أجسام المعارضة عبر ممثليهم ناجحة بحكم عدم خبرتهم. ثانياً – كانت سياسات المشايخ تقوم في السابق على فكرة الانطلاق من الوسط المحلي ومحاولة التوسع داخل هذا الوسط، في حين شكّل خروجهم خارج البلاد انقطاعاً عن هذا الوسط، الذي كان بالأساس رافداً أساسياً يمدّهم بالفاعلين داخل شبكاتهم، حتى بالتمويل، وهو ما أفقد هؤلاء العلماء الحيوية الاجتماعية والدينية التي كانوا يتمتعون بها داخل سوريا. ولعل العوامل السابقة بالإضافة إلى عوامل أخرى هو ما تحسسه واعترف به العديد من أوساط المشايخ وشبكاتهم في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رؤيتهم لقدرة النظام على البقاء وتصاعد نفوذ التيارات السلفية، وهو الأمر الذي عبر عنه مؤخراً أحد أبناء علماء دمشق الكبار في تعليق له على موقف البوطي من الثورة عندما قال بما معناه «ربما لم يكن هو المخطئ وإنما نحن من أخطأنا في تقديرنا للأحداث».
٭ كاتب سوري
القدس العربي