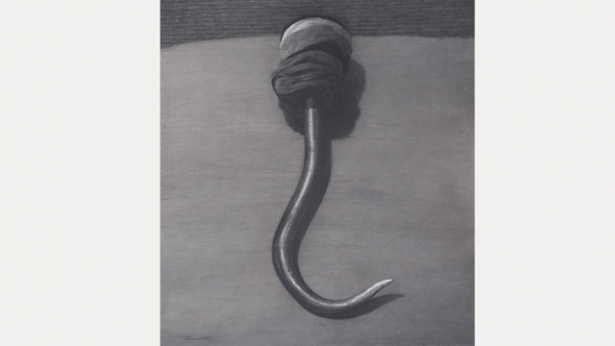عن معركة عفرين – مقالات مختارة –

تركيا والطريق إلى “غصن الزيتون” في عفرين/ ماجد عزام
بدت عملية غصن الزيتون العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية، وكأنها تختصر ليس فقط المشهد الحالي، وإنما المتغيرات في سورية منذ اندلاع الثورة، بداية من تواطؤ النظام مع حزب العمال الكردستاني، لطعن الثورة والالتفاف عليها، ثم رفض أميركا (باراك أوباما ودونالد ترامب) تسليح الجيش الحر، أو إقامة منطقة آمنة للاجئين والثوار، وتحولها فيما بعد لدعم تنظيم هذا الحزب ومتفرعاته، لكلفته السياسية الرخيصة، ولنهب الثروات السورية، وإبقاء خيار التقسيم حاضراً ولو على الورق وقابلاً للتنفيذ. ففي أيّ لحظة، وفي الوقت نفسه، عدم الصدام مع روسيا وإيران، وإبقاء رجلهم، أو صبيّهم المريض بشار الأسد في السلطة. وقبل ذلك وبعده، التأكيد على حقيقة بقاء الدولة التركية وحدها إلى جانب الثورة السورية والشعب السوري وقواه الحية في السياق السياسي والعسكري، ثم نزوعها إلى الدفاع المباشر والاستباقي عن مصالحها، المتماهية إلى حد بعيد مع مصالح السوريين ببساطة، كون تركيا تفكر بعقل أكثري غير أقلوي. ولأنها جزء أصيل ومركزي من نسيج المنطقة، تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وفيها حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة، تستمد شرعيتها من شعبها، وتدافع بالتالي عن مصالحه وأمنه واستقراره، ومستعدة دائماً للجلوس أمامه في امتحان الصندوق والقبول بحكمه.
عفرين مدينة سورية مختلطة، سلمها النظام إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) السوري باكراً جداً 2012 في سياق طعن الثورة السورية. إخراج الأكراد من دائرة الثورة إلى دائرة الحياد، وحتى التواطؤ مع النظام، كما رأينا ونرى في الحسكة والشيخ مقصود، والأهم تمثّل بالضغط أو ابتزاز تركيا لوقف دعمها للثورة السورية، والمطالب المحقة والعادلة لهذه الثورة، وإعطاء عفرين إلى ذلك الحزب الكردي يماثل إعطاء مناطق حدودية مع العراق والأردن ولبنان لجبهة النصرة وتنظيم داعش، فيما بعد لزيادة الضغط الأمني على دول الجوار، وتخييرهم بين دعم النظام لاستعادة الاستقرار أو مواجهة الفوضى في أبعادها السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية، مع تدفق موجات اللاجئين الهاربين من جرائم النظام وبراميله المتفجرة.
أما حزب الاتحاد الديمقراطي (بي كاكا السوري) فيمثّل الجناح السوري لحزب العمال
“قوات سورية الديمقراطية” أداة واشنطن لإبقاء خيار التقسيم حاضرًا”
الكردستاني التركي الموسوم إرهابياً في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا، ودول عديدة، وقادته في غالبيتهم العظمى من أكراد تركيا، لا يتحدثون الكردية ولا العربية، قرويون جاؤوا من جبال قنديل، معقل حزب العمال شمال العراق، كما قال ويقول دائماً رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، وكما أقر هيثم مناع نفسه (قناة رداو 15 إبريل/ نيسان 2017)، وهو الذي كان يوما رئيس ما تسمى قوات سورية الديمقراطية، والاسم الحركي لبي كا كا السوري. وللمفارقة، هذا الاسم أيضاً من اختراع المبعوث الأميركي لمكافحة “داعش”، بيرتماكغورك الذي استعان عن سبق إصرار بإرهابيين موصوفين في سورية والعراق، في مواجهة إرهاب “داعش” في سياق استسهال مواجهة العرض، من دون المرض.
مع إطلاق النظام وحلفائه في العراق وحش “داعش” من أجل الوصول إلى معادلة الأسد أو التنظيم، قدّم “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي) نفسه أداة أو عنصرا فعالا في المعركة ضد التنظيم. وهنا استخدمته إدارة أوباما أداة رخيصة بدلاً من الجيش الحر الذي رفض القبول بشروط واشنطن، بعدم محاربة الأسد، أصل المرض، والتركيز على عرض “داعش”. وحشدت واشنطن وراءها العالم في معركة عين العرب كوباني (معظم سكانها ما زالوا لاجئين فى تركيا)، ورفضت التفاهم مع تركيا أو الاعتماد على الجيش الحر. وحتى بشأن البشمركة واستعدادهم لإرسال آلاف المقاتلين لتحرير المدينة، عاندت واشنطن، وأصرت على الاعتماد على “بي كاكا”، لمصالح ضيّقة وآنية ضمن استراتيجيتها لقتال “داعش” في سياق سياستها المنكفئة مع عدم ممانعة تسليم المنطقة للشرطي الإيراني، المتوتر، لملء الفراغ الناتج عن ذلك، شرط الإذعان والخضوع لخطوطها الحمر، ومنها عدم تهديد أمن إسرائيل، وعدم تهديد حرية الملاحة في بحار المنطقة ومضائقها.
تصرفت مليشيات الحزب كالغزاة والغرباء في معركتي منبج والرقة، المتشابهتين تماماً مع معركة الموصل، حيث تدمير المدن على يد الغرباء، وتشريد أهلها لتغيير التركيبة الديمغرافية، وممارسة التطهير العرقي، وذلك كله بحجة محاربة “داعش” والقضاء عليه.
وكان تنظيم “قوات سورية الديمقراطية” أيضاً أداة واشنطن لإبقاء خيار التقسيم حاضرا، ولو نظرياً كما السيطرة على ثروات السوريين في المناطق الغنية بالنفط والثروات الطبيعية، أو نهبها، خصوصا في شرق الفرات، مع بقاء نظام الأسد، ولو ضعيفاً نازفاً مهاناً، مع رفض دعم الثورة أو الدفع بانتصار الكتلة الأكثرية الثائرة في وجه النظام العصابة.
وتقدم مدينة تل رفعت المتاخمة لعفرين، هي الأخرى، أيضاً نموذجا أو فكرة عن طبيعة “بي كاكا السوري” أو حقيقته، حيث تم استغلال غارات الاحتلال الروسي في 2016، والأسلحة الأميركية، ودعم النظام اللوجستي الفج والعلني لاحتلال قرية عربية خالصة مع قرى أخرى محيطة بها، بينما كان الجيش الحر منشغلاً بقتال “داعش”، وهو الجهة الوحيدة التي تقاتل هذا التنظيم الإرهابي، كما النظام أصل المرض وسبب اندلاع الثورة.
وعمد التنظيم (بي كاكا السوري) كذلك إلى استنساخ ممارسات النظام المتضمنة التغيير
“استنسخ حزب الاتحاد الديمقراطي ممارسات النظام في التغيير الديمغرافي والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري”
الديمغرافي والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري وابتزاز المواطنين مالياً، كما إقصاء أي صوت معارض لسياستهم الاستبدادية الشمولية، وخنقه وتغييبه. وبالتالي إيجاد كيان أو سلطة تشبه الأنظمة الشيوعية الساقطة، ولكن هذه المرة وللمفارقة بدعم أمبريالي أميركي، وعلى كل المستويات، حتى مع رفع الحزب شعاراته الشيوعية الجوفاء.
وعموما، لا يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأكراد بأي حال، وهو مستبد متسلط عليهم بالقوة الجبرية والدعم الخارجي، والأكراد أخوة للعرب والأتراك، وكانوا تاريخياً جزءا من الأكثرية الكبرى في الحوض العربي الإسلامي الممتد من ماليزيا إلى طنجة، ومنذ صلاح الدين إلى سعيد بيران وبديع الزمان النورسي وشكري القوتلي ومشعل تمو، لم يتعاط الأكراد بنفس أقلوي، وهم أصحاب مطالب محقة ومشروعة، ولكن ضمن القضية العادلة للشعب السوري، وليس مع أعدائه على اختلاف مسمياتهم وأشكالهم.
وقد استشعرت تركيا، من جهتها، الخطر منذ بداية الثورة، سواء من ممارسات النظام وجرائمه، ورفضه أي تساوق أو تجاوب مع مطالب الشعب المحقة والعادلة. كما استشعرت الخطر من “بي كاكا السوري” و”داعش”، وطالبت بإقامة مناطق آمنة محمية للاجئين والثوار، وواجهت لامبالاة من حلفائها، أو من يفترض أنهم حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومبكراً جداً، طلبت القيادة السياسية التركية من القيادة العسكرية وضع خطط للتدخل، وفرض المنطقة الآمنة بالقوة، لكنها قوبلت بالرفض والتلكؤ والتردد من بعض القادة العسكريين، حتى أن قائد القوات الخاصة السابق، سميح ترزي، يكاد يختصر القصة كلها. كان يفترض به أن يضع خططاً لفرض المنطقة الآمنة، وإجهاض مخططات “داعش” و”بي كاكا” والنظام لطعن الثورة وتركيا في بداياته الأولى منذ العام 2014، لكنه كان فى الحقيقة أحد قادة جماعة فتح الله غولن وأحد قادة الانقلاب الفاشل في 2016، وقتله الجندي عمر خالص دمير، ما مثّل أحد العوامل المهمة في إفشال الانقلاب، وبالتالي عودة القيادة العسكرية إلى وصاية السياسية المنتخبة، كما يجب أن يكون عليه الحال في أي دولة ديمقراطية.
كان إفشال محاولة الانقلاب نقطة مفصلية في تاريخ تركيا الحديث كله، داخلياً وخارجياً، وانعكس مباشرة على السياسة التركية في سورية، حيث باتت القيادة أكثر قدرةً على اتخاذ قراراتها وتنفيذها، فعمدت إلى المبادرة والتمرد على القيود والمحدّدات الأميركية، ووضع واشنطن تحت الأمر الواقع، مع تنفيذ عملية درع الفرات، بعد شهر من تجاوز الانقلاب، العملية التي كانت النموذج الناجح الوحيد في محاربة “داعش”، حيث لا تدمير للمدن، ولا تشريد لأهلها، ولا تطهير عرقيا، وقد أجهزت كذلك إلى حد كبير على فكرة إقامة كيان لـ “بي كاكا السوري”، يمتد على حدودها الجنوبية.
في هذا السياق، كانت عفرين الأمل الأخير للانفصاليين من أجل الربط مع الكيان الشوفيني
“كان الأكراد تاريخياً جزءاً من الأكثرية الكبرى في الحوض العربي الإسلامي الممتد من ماليزيا إلى طنجة”
الاستبدادي في شرق الفرات، وإيجاد منفذ له إلى البحر المتوسط غرباً، ما يعطيه أفضلية استراتيجية في الداخل والخارج. وهذا من أسباب معركة “غصن الزيتون” عفرين، إضافة طبعاً إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الأراضي التركية، والذي كان أحد أسباب أن يسلمها النظام لـ “بي كاكا” لتهديد الأمن التركي وحياة المواطنين في ولايات هاتاي وكليس.
المهم، وكما في نموذج درع الفرات المقابل والمنافس لنموذج منبج وعين العرب والرقة والموصل، سيتم تحرير مدينة عفرين وقراها من محتليها ومستبديها. وبات الأمر مسألة وقت فقط منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”، وسيجري تعميم نموذج “درع الفرات” عليها، وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها في أبعادها وتجلياتها المختلفة، كما حصل في مثلث جرابلس الباب الراعي.
بعد ذلك، سيتم التوجه إلى مدينة منبج (غرب الفرات) التي تحتلها قوات سورية الديمقراطية، ويظهر فيها كذلك وجهه الاستبدادي القمعي البشع والبغيض، وهو أمر محسوم أيضاً، خصوصا مع عدم تنفيذ الوعود الأميركية لتركيا بانسحاب التنظيم منها. وأكثر من ذلك، يجري التفكير جدياً في تحرير مناطق أخرى شرق الفرات من قبضة التنظيم، مثل عين العرب كوباني، تل أبيض، على طريق إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية بطول 120 إلى 130 كلم مع عمق 30 كلم تمنع التقسيم فى سورية، أو تكريس الأمر الواقع، وتقضي في السياق على الفكرة الأميركية بإقامة جيش حدودي لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي، يضغط على تركيا ويعزلها عن عمقها ومصالحها فى سورية والمنطقة.
وكما في “درع الفرات”، فإن عملية غصن الزيتون عفرين أثبتت، مرة أخرى، أن الجيش الحر قوة جدية موثوقة مهنية وفاعلة، ولا يمكن الاستغناء عنها، في مواجهة “داعش” أو ما تبقى منه، أو في الحفاظ على وحدة التراب السوري، وإجهاض المشاريع الانفصالية، تمهيداً للمشاركة الفاعلة في ترسيم مستقبل سورية.
وأكدت عملية “غصن الزيتون” – عفرين كذلك تخلي روسيا عن “بي كاكا السوري”، واعتباره أداة أميركية، لا يمكن التضحية بالعلاقات الاستراتيجية مع تركيا من أجله، وليس ذلك فقط، فإن واشنطن أيضاً تخلت عنه في عفرين، وستفعل ذلك مضطرة في منبج، وستمنعه من الوجود غرب الفرات، والتقوقع شرطيا في المناطق الشرقية التي تراها واشنطن حيويةً ومهمةً، لمصالحها الضيّقة في سورية والمنطقة.
عموماً، أكدت عملية غصن الزيتون – عفرين الدور التركي الإقليمي، وصعوبة تجاهل أنقرة في القضية السورية، أو المستجدات الإقليمية بشكل عام، كما أكدت ثقة القيادة التركية بنفسها على أعتاب عام 2019 الحاسم، ليس فقط لجهة اليقين من تحقيق أهداف العملية، وإنما بعدم التأثر سلباً في الحزمة الانتخابية المحلية الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ظل التأييد الشعبي الجارف والحاسم للعملية، والثقة بقدرة القيادة المنتخبة على الدفاع عن المصالح التركية، والاستقرار الداخلي والإقليمى على حد سواء.
العربي الجديد
لماذا لا ترسِّم الحدود بين عرب سورية وأكرادها؟/ عمر قدور
الهجوم الحالي على عفرين ليس المناسبة الأولى لاندلاع العداوة العربية الكردية. قبله في تل أبيض أنكر الأكراد انتهاكات وحدات الحماية الكردية بحق السكان العرب، وأنكروا أيضاً ما أعلنته قوات التحالف من أنها قصفت في مناسبات عدة مدنيين خطاً بناء على إحداثيات أُعطيت لها من وحدات الحماية. قبل ذلك، لم يتخذ العرب موقفاً يشجب اعتداء فصيل عربي على منطقة كردية في الجزيرة، والقلّة منهم التي شجبت الاعتداء على عفرين هي قلة غير مرغوب في وجودها من الطرفين، مثلما هو وضع نظيرتها الكردية التي تتعرض للتخوين مع كل موسم أو من دونه.
في الظاهر فقط، لا توجد مطالبات بالانفصال بين الجانبين، جانب لأنه اعتاد الهيمنة وجانب آخر لأن واقع عدم وجود تواصل ديموغرافي بين المناطق الكردية يمنع المطالبة به. هذا لا يمنع انتعاش نقاش تفصيلي لا معنى له سوى رسم الحدود بين الطرفين، ولا تعني المغالاة في المطامع من أي جانب إلا استبطاناً لانفصالٍ واقعٍ، ولجدران لامرئية تزداد سماكة في انتظار الظروف التي تجعلها مرئية.
على سبيل المثال فقط، أن يسمّي الأكراد «عرب الغمر» بالمستعمرين، وهم الذين نقلتهم السلطة بعد غمر قراهم وأراضيهم ببحيرة سد الفرات، وأن يتبرع عرب باعتبار الأكراد المحرومين من الجنسية لاجئين من تركيا لا يستحقونها، فهذا نوع من رسم الحدود بين الطرفين. الأمر هنا يتعدى كلاماً يُلقى هنا أو هناك، فما يُكتب في الإعلام من الطرفين مسيّس بغالبيته، ولا يتوخى إيراد معلومات قريبة من الواقع، ولا يندر أن نجد كتابات تنكر أحقية الوجود الكردي، أو كتابات تنكر أحقية الوجود العربي على الإطلاق.
لا يصح النظر إلى فائض العداوة على أنه وعي أزمة طارئ، فالمظلومية الكردية لم تتشكل في سنوات الصراع الأخير، وهي لا تشبه الصراع الذي يخوضه سوريون آخرون، والانقسام الكردي- العربي مختلف عن الانقسامات المجتمعية الأخرى. غالبية الأحزاب الكردية تطالب بالحقوق القومية للشعب الكردي، هذا يختلف كلياً عن صراع يخوضه سوريون آخرون يتعلق أساساً بنوعية الحكم وعدالة تمثيله، أو يتعلق بمخاوف من الهيمنة السابقة أو اللاحقة، وفي كل الأحوال لا يُطرح موضوع التقسيم من قبلهم على النحو المعلن أو المضمر في ما يخص الأكراد.
يجدر بالذكر، في سياق المظلومية، أن النشطاء الأكراد لم يبذلوا أدنى جهد تجاه سوريين آخرين من أجل قضيتهم، بينما انصبت جهودهم على كسب التعاطف الغربي، أو حتى التنويه بالتعاطف العربي غير السوري. السوري المتعاطف مع الأكراد غير مرغوب فيه لأنه يعكر الصفاء المطلق للمظلومية، إذا لم يُردِف تعاطفه بهجاء لاذع للعروبة. في كل الأحوال، مهما كان التعاطف سخياً فهو في أحسن أحواله الفردية يعبّر عن كرم أخلاقي، ولا يحتمل بالضرورة وعياً سياسياً مؤثراً، لأن الأخير يحكمه وعي بالمصالح ونقاش تفصيلي فيها يقيم المقارنة بين مختلف الاحتمالات.
في ميزان المصالح مثلاً، يحضر عادة القول بوجود مطامع في الثروات الطبيعية في أماكن الوجود الكردي، وهذا كان ليصحّ (بصرف النظر عن مصادر قوله) لو أن السوريين أدمنوا نهب تلك الخيرات، ولو لم تكن ثروة عائلة الأسد قد بلغت مستوى خرافياً من نهب البلد بأكمله. بلغة المصالح أيضاً، سيكون من مصلحة بلد ضعيف منهك من الصراع إقامة أفضل علاقات السلم وحسن الجوار، هذا لا يتفق مع نظرة الأكراد إلى تركيا بوصفها إسرائيلهم، وقد يؤدي إلى وضع مشابه للحملات العسكرية التركية المتكررة على جبال قنديل في إقليم كردستان.
انفصال أكراد سورية يعني، في ما يعنيه، التخلص من العبء الإقليمي للقضية، وجعل الأمور التي تتعلق بالقضية الكردية (سلماً أو حرباً) من اختصاصهم وحدهم من دون وصاية سوريين آخرين. هنا ليس من شأن أي سوري آخر النقاش في قدرة الكيان الوليد على مجابهة الصعوبات، ولا حتى من شأنه التفكير في معضلة عدم وجود تواصل جغرافي بين المناطق الكردية إلا من باب التعاطي معها وفق قواعد حسن الجوار.
تالياً، لن يكون من شأن أي سوري آخر ما إذا الكيان الوليد سيُحكم من بعث كردي، أو الاستدلال بتعثر تجربة إقليم كردستان المجاور. هذا كله، في حالة الانفصال، يندرج في إطار الوصاية على تجربة ينبغي أن تحظى باستقلالها.
الفيديرالية ليست حلاً للقضية الكردية في سورية، قد تكون نموذجاً جيداً لما يتبقى من البلاد، أما في ما يخص الأكراد فلا تعني سوى التكاذب الســـياسي. لدينا في الواقع الفيديرالية التي أقامتها الميليشيات الكردية من طرف واحد، ونعلم كيف سيطرت على مناطق ذات غالبية عربية بالقوة ولم تمنح السكان حقهم في حكم ذاتهم، بل أنشأت هيئات أشــبه بالجبهة الوطنية التقدمية التي أنشأها حافظ الأسد بينما كان البعث مستفرداً بالحكم، ولدينا فوق ذلك العديد من الانتهاكات مثل التهجير والتكريد، والأهم من ذلك نظرة عرب تلك المناطق إلى الميليشيات الكردية بوصفها قوة احتلال.
والفيديرالية ذاتها يصعب قيامها على أسس سليمة من دون ترسيم للحدود يتوافق مع الواقع السكاني، وبما أن فكرة الترسيم ستكون واردة في كل الأحوال، فقد يكون من الأحسن رسمها على قاعدة الانفصال، ولا بأس باستخلاص الدرس من تجربة خلاف إقليم كردستان وبغداد حول الحدود. ذلك لن يكون سهلاً على أية حال، ولا ضمانة في أن الترسيم ضمن الفيديرالية سيكون خالياً من العنف، أو أن يكون العنف أقل من نظيره في حالة الانفصال، إلا إذا كان العنف مضبوطاً خارجياً في الحالتين.
من المعروف كلاسيكياً أن الدولة الحديثة تبنى على إرادة العيش المشترك، هذا شرط لازم وغير كافٍ لأسباب خارجية وداخلية. فالظروف الخارجية تضـــغط للإبـــقاء على الوضـــع الراهن، وداخـــلياً تتــحفز قوة الأمر الواقع الكردية لتحصل بالفيديرالية على ما ليس من حقها لو طالبت بالانفصال.
لعل تفكيك هذا الوضع المفخخ يبدأ بأن يجرؤ السوريون من غير الأكراد على التفكير في التحرر من القضية الكردية، هذا مؤلم لوجدان نسبة كبيرة منهم، لكن لا يندر أن تكون المشاعر على خطأ.
الحياة
معركة عفرين: معوقات الحسم العسكري وآفاق المعركة/ رائد الحامد
لهدفٍ معلن لا يتضمن احتلال أجزاء من سوريا أو قتل مواطنين أكراد، أعلن الرئيس التركي بدء عملية «غصن الزيتون» عصر السبت 20 يناير 2018 لاستئصال أي وجود لمقاتلي تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين، ثم منطقة منبج في مرحلة لاحقة، وتطهير كامل الشريط الحدودي وصولا إلى حدود العراق، لإبعاد التهديدات عن الحدود والداخل التركي، كجزء من استراتيجية الحفاظ على الأمن القومي التركي.
لا يحتاج المراقبون لكثير من الجهد لمعرفة الاستراتيجيات التركية في ما يتعلق بالمحافظة على أمنها القومي، على طول الشريط الحدودي مع سوريا؛ وتركز تركيا على الحد من تهديدين اثنين يتمثل التهديد الأول في تهديد تنظيم «الدولة» على أمنها الداخلي ومدنها الحدودية، قبل أن تنجح القوات التركية بمساندة الفصائل السورية الحليفة في إبعاد هذا التهديد المباشر عن حدودها، غداة سيطرتها على بلدات الراعي واعزاز وجرابلس في شتاء وصيف عام 2016.
أما التهديد الثاني بعد تدني مستوى خطر التهديد الأول إلى حد ما، فيمثله وجود قوات سوريا الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ونزوع هذه الوحدات لإقامة منطقة خاضعة لسيطرتها يمكن أن تقيم عليها كيان سياسي كردي مستقل أو شبه مستقل، أو أن تشكل منطلقا لشن هجمات على المدن الحدودية والداخل التركي. وتصنف تركيا وحدات الحماية الشعبية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية كمنظمة إرهابية مرتبطة تنظيميا بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حربا مع القوات التركية منذ عام 1984 وحتى اليوم؛ كما أن الولايات المتحدة وضعت حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب، إضافة إلى دول عربية عدة وإيران ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها. وتؤكد الولايات المتحدة على أنها لن تقدم أي دعم للقوات الكردية الموجودة في عفرين في حال شنت المعارضة السورية المسلحة بمؤازرة تركية هجوما لاستعادة بلدة عفرين، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. كما أن مسؤولين أمريكيين أكدوا في الآونة الأخيرة على عدم حاجة الولايات المتحدة لوحدات الحماية الشعبية المتواجدة في عموم غرب نهر الفرات في عملية ملاحقة تنظيم «الدولة» على الأراضي السورية.
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سوف لن يشارك في المعركة المتوقعة في عفرين؛ وتقتصر مهمة قوات التحالف في العمل على هزيمة تنظيم «الدولة» بشكل كامل، والتأسيس لمتطلبات الاستقرار في مرحلة ما بعد التنظيم، بما يكفل عدم ظهوره مرة أخرى، وتتركز عمليات الدعم الذي تقدمه قوات التحالف بعد انتهاء معركة البوكمال على التغلب على ما تبقى من جيوب للتنظيم في شرق الفرات. في الحقيقة، بدا التحضير لمعركة عفرين منذ مارس 2017 في دلالة على أهمية إخلاء المنطقة من المقاتلين الأكراد، للأمن القومي التركي، وتزامنت تلك التحضيرات مع إعلان تركيا عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية درع الفرات والمباشرة بالمرحلة الثانية التي اتخذت مسمى عملية سيف الفرات، التي بدأت الاستعدادات بنشر قوات تركية إضافية على الحدود في شمال غرب سوريا، لتأمين خطوط التماس بين فصائل المعارضة المسلحة ووحدات الحماية الشعبية، وبلغت ذروة الاستعدادات في أكتوبر 2017 بالتزامن مع نشر قوات إضافية للمعارضة المسلحة الحليفة لتركيا في شمال حلب، من أجل التحضير لعملية مستقبلية تهدف إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية من المدينة الواقعة ضمن مناطق غرب نهر الفرات، وتتبنى تركيا استراتيجية مرحلية معلنة لا تسمح بموجبها بأي وجود لمقاتلين أكراد في هذه المناطق.
ولا ترى روسيا ما يستوجب الوقوف ضد الإجراءات التركية للحفاظ على أمنها القومي، حيث أقدمت على إخلاء جنودها ومستشاريها من خطوط التماس في عفرين ومنبج إلى عمق مناطق سيطرة النظام، لتعزيز مواقعها بما يحقق مكاسب مضافة لقوات النظام الحليفة لها في الدفاع عن مناطق سيطرتها من هجمات قد تشنها المعارضة السورية المسلحة مستقبلا.
وبعد عملية «غصن الزيتون» وجدت وحدات الحماية الشعبية نفسها أمام خيارات ضيقة في الرد على الهجوم البري، من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات خاصة تركية ظهيرة لها، مشفوعة بقصف تركي بري وجوي، ما يرجح احتمالات عقد تفاهمات روسية تركية لانسحاب مقاتليها من عفرين إلى شرق نهر الفرات. تهدف تركيا من عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين شمال غرب مدينة حلب إلى توسيع المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، الذي تسيطر وحدات الحماية الشعبية على نحو ثلثي المسافة منه بين الحدود التركية السورية العراقية المشتركة شمال شرقي محافظة الحسكة ومنطقة عفرين، أقصى شمال غرب محافظة حلب على الحدود السورية التركية. ويعد الشريط الحدودي من وجهة النظر التركية «ممرا للإرهاب» الذي ركز مسؤولون أتراك من بينهم الرئيس التركي الذي انتقد مطلع ديسمبر الماضي الخطة الأمريكية الموجهة ضد بلاده في «إقامة ممر إرهابي في شمال سوريا، واستمرار تسليح وحدات الحماية الشعبية في الوقت الذي لم يبق فيه تنظيم «الدولة» في المنطقة».
في ما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لنظيره التركي أنه «أمر بوقف توريدات السلاح إلى وحدات الحماية الشعبية».
ولا يُتوقع حسم عسكري قريب لمعركة عفرين، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية بالمعركة؛ وتزداد صعوبة الحسم العسكري عملياتيا نتيجة عوامل الكثافة السكانية للسكان الأصليين في المدينة التي زادت باطراد بعد موجات متتالية من النزوح إليها، وكذلك الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة الوعرة في بعض محاورها والطينية المعرقلة لحركة الآليات في محاور أخرى من محيط المدينة المحاصر كليا من جميع الجهات، مع حصار أقل إحكاما من المحور الجنوبي الشرقي الذي تسيطر عليه قوات النظام. ووفقا لتصريحات تركية فإن من بين الأهداف الأساسية للعملية هي محاصرة مقاتلي وحدات الحماية الشعبية، ومنعهم من مغادرة المدينة تمهيدا للقضاء عليهم؛ لكن هدفا كهذا لا يبدو من الأهداف السهلة نظرا للتحصينات الدفاعية والعمق السكاني لمقاتلين نسبة كبيرة منهم من أبناء المدينة، توزعوا في الأحياء وعلى مقتربات المدينة للدفاع عنها بتجهيزات قتالية أشارت معلومات إلى صواريخ مضادة للدبابات ومدافع متوسطة المدى وألغام وأسلحة أخرى من بينها صواريخ محمولة على الكتف، مضادة للطائرات تضاربت الأنباء حول حقيقة امتلاكهم إياها، كما ان وسائل الإعلام لم تتحدث عن استخدامها حتى هذه الساعات.
في كل الأحوال سيكون لطول أمد الحرب حافزا اضطراريا للطرفين لتقديم تنازلات متبادلة مهما كانت مؤلمة، طالما انهما سيتوصلان حتما إلى قناعة مشتركة باستحالة الحسم العسكري، من حيث قدرة وحدات الحماية الشعبية على هزيمة فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش التركي، ومنع سقوط المدينة، واقتناع القيادة التركية باستحالة القضاء على نحو 20 الف مقاتل كردي في عفرين، وان استمرار الحرب طويلا سيكون له ثمن باهظ على الجيش التركي، وعلى المدنيين في عفرين الذين سيكونون هم الأكثر تضررا من استمرار المعارك، ورفض المجتمع الدولي لوقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع.
كاتب عراقي
القدس العربي
ماذا يريد أكراد سوريا؟/ رانيا مصطفى
هذا ما جناه الأكراد
من حق أكراد سوريا، كما أكراد العراق وإيران وتركيا، أن يحلموا بالدولة القومية الكردية، أو أقلّها، بإقامة حكم ذاتي يخصّهم. لا مشكلة في أن مشاعرهم القومية تميل إلى ذلك؛ المشكلة أنّ الأحزاب الكردية، بسياساتها القومية، العاطفية المتسرعة تارة، والانتهازية المُزايِدة تارة أخرى، أو بكونها أيادٍ لتدخلات خارجية، أميركية وروسية وإيرانية، وكذلك النظام، تُدمِّرُ فرص الأكراد بالعيش المشترك مع بقية السوريين، تنافسهم في ذلك الفصائل المرتبطة بالدول الخارجية.
عانى كل السوريين من سياسات القمع والنهب والتهميش، وكان ذلك سببا للقيام بثورتهم ضد النظام. كان ظلمه للأكراد مضاعفا (منع الحقوق الثقافية، ومشكلة الجنسية لدى جزء من أكراد)، مما جعلهم يشاركون في الثورة إلى جانب العرب. النظام انسحب باكرا من مناطق الشمال الشرقي، وسلّمها للبايادي وميليشياته المسلحة، الذي قام بالنيابة عنه بقمع المشاركين في الثورة، عربا وكردا، وقتل واعتقل البعض، وهجّر الكثيرين، ومنهم العديد من ناشطي المجلس الوطني الكردي.
الأحزاب الكردية قامت بتضخيم المظلومية الكردية وتحويلها من مظالمَ ضدّ النظام، وضدّ ممارسات الحكومات التي سبقته، إلى مظالم ضدّ العرب الذين يشكّلون أغلبية سكانية في مناطق الجزيرة السورية والشمال، ووصفهم بالمحتلين لأراضي كردستان المتوهَّمة، والتي تمّ خلق حجج تفيد بأحقيتهم بها، والقول بأن الأكراد يشكلون أغلبية عددية في تلك المناطق، الأمر الذي تدحضه كل الإحصائيات، وتبيّن أنّ تلك الادعاءات تشمل الأكراد المتواجدين في دمشق وبقية المحافظات السورية، والمندمجين بشكل كامل مع المجتمعات العربية.
المئات من صفحات فيسبوك، التي يديرها جيش إلكتروني كردي، أُنشِئت لتأييد تلك الادعاءات، ونشر الكراهية والعنصرية القومية ضد العرب، وتضخيم المظالم الكردية. وبالتالي كان من السهل على البايادي أن يستولي على أراضي بلدات عربية ويُهجّر أهلها، وأن يتصرف كحاكم متفردٍ بكانتون يخصّه، في ظل صمت كردي عام، بما فيه أحزاب المجلس الوطني الكردي، التي كانت تندد فقط بالانتهاكات التي يتعرض لها أكراد على أيدي البايادي؛ بعض المثقفين الأكراد اكتفوا بالتنديد ببعض المجازر بحق العرب، بسبب نشر صور فاضحة للتنكيل بجثث القتلى.
سيطرة الجهادية الإسلامية، داعش والنصرة وأحرار الشام وغيرها، على مناطق المعارضة عزّزت النقمة الكردية ضد العرب، وأبعدت الأكراد عن الثورة، كما أبعدت التوجهات الوطنية. يضاف إلى ذلك أن تلك الفصائل، الإسلامية وغير الإسلامية، كلها مرهونة لإرادة الداعمين، خاصة الداعم التركي، الذي يرفض تواجد كيان كردي على حدوده.
في ظل ضياع المشروع الوطني للثورة، وارتهان سوريا للصراع الدولي والإقليمي، التجأت قوات البايادي إلى أميركا، التي دعمتها تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية، لمحاربة تنظيم داعش.
منذ تحرير عين العرب (كوباني) من تنظيم داعش، اعتقدت قيادة البايادي أن أميركا ستمضي في دعم المشروع الكردي الخاص في سوريا، بعد القضاء على التنظيم؛ وأغلب الأكراد توهّموا ذلك، وحتى بعد تخلي أميركا عن مسعود البارزاني حين أعلن نيّته الانفصال. قوات قسد هي أدوات أميركا في السيطرة على الرقة ومناطق شرق الفرات، حيث أقامت قواعدها العسكرية. وراحت قوات البايادي تتصرف وكأنها حاكمة لتلك المناطق، وتمارس انتهاكات وتشديدات أمنية ضد العرب الذين يشكّلون أغلبية ساحقة فيها، إضافة إلى النازحين من مناطق أخرى؛ مما ولّد احتقانا عربيا ضد الأكراد أيضا.
سيطرت قوات حماية الشعب الكردية على عفرين، ذات الغالبية الكردية، لكنّها لم تسلّمها لحكم محلي، لا هي ولا مناطق ريف حلب العربية، كمنبج وتل رفعت وغيرهما، وأعلنت نيّتها التقدم حتى البحر المتوسط. أميركا لم تدعمها في مطامحها تلك، بسبب وجود توافقات تركية روسية إيرانية، حيث تم تسليم جرابلس لتركيا وحلب للنظام وروسيا وإيران.
أردوغان، الذي لا يريد تواجد فرع البيكيكي على حدوده، بدأ عمليته العسكرية في عفرين ضد البايادي، وأعلن عن نيته السيطرة على منبج، والتوجه شرقا حتى الحدود العراقية، مستغلا النقمة العربية الجديدة ضد الأكراد بسبب انتهاكات البايادي لهم. وهو يسعى إلى كسب تأييد دولي، خاصة أميركا وفرنسا، عبر إقناعهما بأنه سيوفر مناطق آمنة لعودة المدنيين.
انخراط فصائل الجيش الحر في هذا العمل العسكري عقّد الوضع كثيرا. المعارضة السياسية ممثَّلة بالائتلاف الوطني، أيّدت العملية العسكرية، رغم معارضة المجلس الوطني الكردي المشارك فيه لذلك التأييد، وانسحاب بعض أعضائه. هذا الموقف من الائتلاف، وكذلك مشاركة الفصائل العربية لمصلحة تركيا، هو موقف انفعالي خاطئ؛ بالدرجة الأولى لأنه يزكّي المزيد من الأحقاد القومية بين العرب والكرد، وكذلك لأنه يزيد من حالة التشرذم، بتمكين تركيا من مدّ نفوذها في مناطق استراتيجية بالنسبة إليها، مقابل سيطرة النظام وروسيا على أجزاء من إدلب، تطبيقا لاتفاق سوتشي بين روسيا وإيران وتركيا.
العرب
الولايات المتحدة… تركيا… وعملية عفرين/ د. بشير موسى نافع
طبقاً لدوائر إعلامية تركية، مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تلقى إبراهيم كالن، الناطق باسم الرئيس التركي، اتصالاً من سكرتير مجلس الأمن القومي الأمريكي، جنرال ماكماستر، مساء 26 كانون الثاني/يناير. خلال الاتصال، أكد ماكماستر على أن الولايات المتحدة ستوقف امدادات السلاح لحزب الاتحاد الديمقراطي، الكردي السوري، وقوات حماية الشعب، التابعة للحزب. هذه هي المرة الثانية التي قدمت فيها إدارة ترامب لتركيا مثل هذا الوعد. في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان الرئيس نفسه، دونالد ترامب، من أخبر نظيره التركي، طيب إردوغان، أن إدارته لن تقدم المزيد من السلاح للمسلحين الأكراد السوريين، مثيراً حالة من الاحتفال في الإعلام التركي. بعد محادثة الرئيسين الهاتفية بأيام قليلة، رصدت قافلة إمدادات عسكرية أمريكية تقطع الحدود العراقية ـ السورية في طريقها للوحدات الكردية في منطقة الرقة. فهل يمكن لأنقرة أخذ وعود ماكماستر هذه المرة على محمل الجد؟
الحقيقة، أن تركيا لم تر في الموقف الأمريكي من المسألة السورية، منذ 2011، سوى الأكاذيب والخذلان. ولم يكن هذا هو المتوقع في أنقرة على الإطلاق؛ ليس فقط لأن تحالف الناتو يجمع الدولتين منذ مطلع الخمسينات، ولكن أيضاً لأن تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، اقتصادية ـ مالية، ثقافية، وعسكرية. في المرحلة الأولى من الأزمة السورية، قبل التدخل الروسي المباشر، عندما أصبحت سوريا مسرحاً هائلاً للصراع بين المعارضين المسلحين، من جهة، وقوات النظام والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، من جهة أخرى، رفضت إدارة أوباما التدخل لصالح الشعب السوري. وحتى قبل ظهور النصرة وداعش، ترددت واشنطن في تقديم أي دعم جوهري للثورة، أو السماح لحلفائها في الإقليم توفير السلاح النوعي للثوار، على الأقل بما يسمح مواجهة وحشية طيران النظام. وما أن بدأ صعود داعش والنصرة على حساب جماعات المعارضة الأخرى، حتى تخلت إدارة أوباما كلية عن هدف التخلص من نظام الأسد، لتتبعها، خلال فترة قصيرة، السعودية وعدد من دول الدول العربية الأخرى.
في نهاية أيلول/سبتمبر 2015، أصبحت روسيا طرفاً مباشراً في الصراع على سوريا، وتغيرت بالتالي معادلة القوة بصورة كبيرة. وبدلاً من أن تتقدم الولايات المتحدة لتعديل ميزان القوى، تركت تركيا منفردة في مواجهة الروس. أعلنت إدارة أوباما أن مهمتها في سوريا محصورة بمكافحة الإرهاب، وأسست مجموعة تنسيق عملياتي مع موسكو لتجنب صدام محتمل بين الطرفين على أرض وفي سماء سوريا. وعندما وقع الصدام التركي ـ الروسي، بإسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لم تتلق أنقرة سوى دعم لفظي من واشنطن ودعوات أمريكية لمنع التصعيد. سوغت إدارة أوباما موقف عدم الاكتراث بأن سوريا لم تكن أبداً منطقة اهتمام استراتيجي للسياسية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن موقف عدم الاكتراث سرعان ما تحول إلى تباعد عدائي، عندما بدأت واشنطن في دعم الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني.
لم يكن الاتحاد الديمقراطي قوة رئيسية في المناطق الكردية السورية في بدايات الثورة. ولكن الحزب اتبع سياسة دموية لإقصاء القوى الكردية المتآلفة في المجلس الوطني الكردي، والممثلة في الإئتلاف السوري المعارض. ومع 2014 – 2015، عندما انطلقت معركة تحرير بلدة عين العرب (كوباني) الكردية من سيطرة داعش، أبدى الاتحاد الديمقراطي وميليشياته الاستعداد للتعاون مع الأمريكيين لدحر داعش. وبدأت بالتالي العلاقة التحالفية غير السوية بين واشنطن والاتحاد الديمقراطي.
خلال 2014، وحتى صيف 2015، انخرطت الحكومة التركية والعمال الكردستاني في عملية سلمية؛ ولم يكن ثمة قلق كبير في أنقرة من الصعود المستمر لامتدادات الحزب السورية. وقد لعبت تركيا دوراً مسانداً لتحرير عين العرب من داعش، حتى وهي تعلم أن القوة الكردية المسلحة الرئيسية في العملية تتبع للاتحاد الديمقراطي. ولكن كسر العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في آب/أغسطس 2015، ونهاية العملية السلمية في تركيا، ولد قلقاً متصاعداً من هيمنة امتدادات العمال الكردستاني على الساحة الكردية السورية. خلال الشهور التالية، توفرت أدلة متزايدة لدى الأتراك على تعاون وثيق بين العمال الكردستاني في تركيا ووحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي في سوريا، ليس فقط على صعيد التدريب والاتصال، ولكن أيضاً فيما يتعلق بإمدادات السلاح والمتفجرات. وحتى أشتون كارتر، وزير دفاع أوباما، خلال جلسة استماع بالكونغرس في نيسان/ابريل 2016، لم يستطع إنكار العلاقة العضوية بين حلفاء إدارته من الأكراد في سوريا والعمال الكردستاني في تركيا.
ساعد الدعم العسكري الأمريكي، سلاحاً وتدريباً، الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب على تحقيق سيطرة كاملة على المناطق الكردية في شمال شرق سورية، وفي شمالها الغربي. راقبت تركيا، بقلق بالغ، تطور العلاقة بين الاتحاد الديمقراطي والأمريكيين في شمال سوريا الشرقي، وأعلنت بوضوح أنها لن تسمح بانتشار كردي مسلحة غربي الفرات. وسرعان ما ولد الدعم الأمريكي للأكراد السوريين مشكلة من نوع آخر.
فبالرغم من أن هناك مناطق تواجد كردي ملموس في سوريا، لا يتمتع الأكراد بأغلبية قاطعة في هذه المناطق. ولذا، وكلما كان ذلك ضرورياً أو ممكناً، اتبعت القوات الكردية المسلحة في سوريا سياسة تطهير عرقي ضد العرب والتركمان، بهدف توسيع نطاق منطقة الحكم الذاتي، التي أعلنها الاتحاد الديمقراطي في الشمال السوري. ولكن، وطالما استمر الأكراد في تحمل عبء المواجهة مع داعش، وتجنب الأمريكيون دفع جنودهم إلى ساحة المعركة، غضت واشنطن النظر عن المخاوف التركية وعن سياسة التطهير العرقي التي اتبعها الأكراد. في المقابل، وفي محاولة خداع ساذجة، دفع جنرال رايموند توماس، قائد القوات الخاصة في سوريا، وبرت ماكغورك، مبعوث الرئيس أوباما للتحالف ضد داعش، الاتحاد الديمقراطي، في تشرين الأول/اكتوبر 2015، إلى تشكيل ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم أكراداً وعرباً، كمظلة لقوات حماية الشعب وميليشيات الاتحاد الديمقراطي الأخرى.
في نهاية تموز/يوليو 2016، طلب الرئيس أوباما من إردوغان، في اتصال هاتفي، السماح بمشاركة القوات الكردية في تحرير منبج، المدينة العربية، من داعش، على أن تعود الوحدات الكردية المسلحة إلى مواقعها شرقي الفرات مباشرة بعد تحرير المدينة. دحرت داعش من منبج في مطلع آب/أغسطس، ولكن وعود أوباما لم تتحقق. وبالرغم من الإلحاح التركي، لم تزل وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر على المدينة. تماماً كما أن تحرير الرقة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وضع المدينة العربية تحت السيطرة الكردية. وفي هذا الإثناء، كان الاتحاد الديمقراطي نجح، على خلفية فوضى الفصائل في الشمال السوري، وبفعل وجود قوات حماية الشعب في منبج، في تأسيس خطوط إمداد منتظمة للوحدات الكردية في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا، التي تحولت خلال العام الماضي إلى قلعة حصينة للحزب وميليشياته. بمعنى، أن إدارة ترامب، وبالرغم من الانتقادات التي توجهها لسياسة أوباما السورية، لم تغير شيئاً من هذه السياسة، حتى بعد وعد ترامب الشهير لإردوغان بوقف إمدادات السلاح لميليشيات الاتحاد الديمقراطي.
أدى سحب الصواريخ الأمريكية من تركيا، بدون معرفة الحكومة التركية، خلال الأزمة الكوبية، في مطلع الستينات، ورسالة جونسون لأنقرة في منتصف الستينات بخصوص قبرص، إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسة الخارجية التركية. نجم عن تلك المراجعة تحسن ملموس في العلاقات مع الاتحاد السوفييتي، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي. إصرار أنقرة على تنفيذ عملية عفرين، والتقارب مع روسيا، بما في ذلك شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400، مؤشرات على أن التحالف التركي ـ الأمريكي لم يعد كما كان.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
الهجوم التركي.. أحدث حلقات المقتلة السورية/ دلال البزري
الوحش الذي أفلت عقاله في سورية يبدو كسلاسل حديدية مترابطة، كدورات من المعارك المتتالية، المتجاورة، وعبثاً تحاول إيجاد فاتحتها، أو جذرها: هل هي بقرار بشار الأسد إطلاق النار على المتظاهرين السلميين منذ سبع سنوات؟ أم في طبيعة “البعث” نفسه، وحركته “التصحيحية” التي كرّست والد بشار حاكماً مطلقاً على سورية، بقوة جرّافات القتل الجماعي والفردي وأشكال الإخضاع التي باتت معروفة؟ أم إن أصولها تعود إلى الانتداب الفرنسي، أو مظالم الحكم العثماني، أو الفتوحات الإسلامية، أو الرومانية.. وصولاً إلى أبونا آدم وأمنا حواء، اللذين لم يربيا أولادهما بطريقة صحيحة، فكانت حكاية قتل ابنهما قايين ابنهما الثاني هابيل؟ لا نفع ربما لتساؤلٍ كهذا. ولكنه على الأقل يتابع هول السلاسل المديدة للمقتلة الكبرى الواقعة في سورية.
لنتفق على نقطة بدء كي لا نضيع في التأريخ للمآسي السورية القديمة – الجديدة. نبدأ من لحظة انفجار انتفاضة السوريين السلميين ضد بشار الأسد، وارث حكمه عن أبيه. أول رصاصة أطلقتها قواته على تلك التظاهرات هي نقطة الانطلاق. ومن بعدها، ندخل في أتون السلسلة المتسارع، الأشد تسارعاً ربما من كل المواقع السابقة. حيث يقتل سوريون سوريين آخرين، يستبيحون بذلك قتلهم على يد أي كان. في هذه البداية من السلسلة، يتسلح سوريون عفوياً، فيردّون على القتل بحماية أنفسهم منه. ولا يمضي وقت طويل، حتى تتشكّل المجموعات المسلحة، ذات الطابع الجهادي أو السلفي بغالبيتها، وبجنسيات الأرض كلها، تغرق المجموعات الأخرى غير الدينية بسطوتها ومالها، فتكون أولى النوافذ نحو القتل الدولي والإقليمي.
هكذا يسهل على بشار الأسد الاستنجاد بمليشيات إيران ومستشاريها العسكريين، ليقتلوا بتصويب واضح على السوريين، ويهجروا ويحاصروا ويُخضِعوا ويجوعوا؛ ويقتربوا من الحدود في
“يتسلح سوريون عفويا، فيردون على القتل بحماية أنفسهم منه”
الجولان، المحتلة أصلاً، بالحجة الكاذبة اياها، فتكون الردود الإسرائيلية، في عمق الأراضي السورية، بهجماتٍ دقيقة على ثكناتهم أو قوافلهم الناقلة للسلاح. لم تكن هذه الدورة كافية عسكرياً، لم تختتم، لأنها لم تتمكّن من حسم ميزان القوى. فكان الروس، بطائراتهم وصواريخهم، يقتلون مزيدا من السوريين. وكان الرد الأميركي عليهم، غير المعروف إن كان تكتيكاً أم إستراتيجية، بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لا يختلف بتصويباته عن الذين سبقوا أميركا. من يتذكّر شعارات تلك المرحلة غير البعيدة؟ كان القول الشائع بين جميع القتلة إنهم بصدد “معركة ضد الإرهاب”. على أساس أن نهاية هذه المعركة ستكون نهاية الحرب في سورية.
ولكن: نسوا منطقة متفجرة، وقضية متفجرة، كانت تدور رحاها ليس بعيداً جداً، في شمال شرق سورية. المسألة الكردية، ذات الجذور العميقة والحق المسلوب، في لعبة الأمم الكبرى المتحاصصة. الكرد السوريون، أو بالأحرى قيادتهم الأقوى ميدانياً، “نأت بنفسها” عن تلك الحرب، فأسّست إدارتها الذاتية. وساعدها بشار على هذا النأي، متذاكياً، موارباً، مثل أبيه، اعتقد أنه سوف يتفرغ للكرد لحظة تنتهي المعركة ضد الإرهاب التي خاضوا أكبر محاورها، وأبدوا فيها فعالية قتالية عالية وتماسكا وتنظيما مفقودين عند نظرائهم من العرب. الجحافل التركية أعفت بشار الأسد من المهمة، فدخلت في السلسلة، بعدما خاصم رئيسها أردوغان الفرع التركي من الكرد، وحوّله عن النضال السلمي، فانتقل إلى شمال شرق سورية، لعله بذلك يحصل على أرض تحيي شيئاً من الدولة الكردية الموعودة منذ مائة عام. ولكن أردوغان لا يستسلم بسهولة. رفع أرنبا منفرداً، فدخل بقيادة أركانه، وجنوده الأنفار السوريين (الجيش الحر) وأعلن أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهْ. وأن الحزب الذي شارك بفاعلية ضد الإرهاب هو بالأصل إرهابي مرتبط حميمياً بالفرع التركي الذي نزلت عليه اللعنات، بعدما كان الحوار معه وصل إلى مبالغ متقدمة.
وإذا أردتَ إجمال اللوحة، بعد هذه الحلقة الجديدة، التي لم توقف نشاط الحلقات السابقة عليها.. يمكنكَ القول إن سورية الآن تشهد “حرب الجميع على الجميع”. تلك الحالة البدائية التي وصفها الفيلسوف الإنكليزي، توماس هوبس، بتشاؤم واضح، من أن الإنسان في حالته “الطبيعية”، أي من دون أنظمة ولا قوانين ولا سلطة رادعة، هو في حالة حرب دائمة، لا يسلم من العوز والخراب والتهجير والترحال والجهل، والحرمان من الابتكار والتأريخ والتذكر.. إلخ. لكن ما لم يلحظه هوبس، ما لم يتنبأ به، وهو ابن القرن السابع عشر، أن “حرب الجميع على الجميع” يمكن أن ترتدي تلويناتٍ خاصة، كالحاصل في السورية منها.
ليس الجميع متساوين في هذه الحرب. مهما قلنا عن سقوط قتلى من بين الروس أو الأتراك أو الإيرانيين أو اللبنانيين أو العراقيين أو الأفغان من مليشياتهم، أو حتى الفرنسيين أو البريطانيين أو القوقازيين أو الصينيين من بين الجهاديين.. فإن عدد قتلاهم ولاجئيهم سخيف أمام هول عدد السوريين منهم، فضلاً عن بلدانهم التي إذا عادوا إليها سالمين ولو مكبَّلين، فلن يصدَموا بمشهد خرابها، كالذي نال من سورية.
والحلقة الجديدة من سلسلة القتل لا تختلف عن سابقاتها: عملية “غصن الزيتون” يقودها
“أول رصاصة أطلقتها قوات النظام السوري على تلك التظاهرات هي نقطة الانطلاق لفهم كل ما يجري اليوم في سورية”
الأتراك بطائراتهم وصواريخهم، ولكن بمشاةٍ من السوريين، يقتلون وجهاً لوجه سوريين من المجموعة الكردية التي اعتقدت أن العالم سيكافئها بعدما قاتلت الإرهاب بجدارة. معادلة توماس هوبس هنا تحتاج إلى تعديل غير طفيف. إنها ليست حرب الجميع على الجميع فحسب، إنما هي حرب بين أشقياء السوريين، فوق رأسهم قيادات مضبوطة، حاسِبة، يقينية.
وما يجمع هذه القيادات كلها أنها تدخل في الحرب على سورية بهموم كلها “وجودية”، متوّجة بأكاليل أمجادها الغابرة. الروس بقيصريتهم التليدة، الإيرانيون بفارسيتهم الإمبراطورية، الأتراك بعثمانيتهم السلطانية، ناهيك عن الأميركيين بعودتهم، مع ترامب، إلى عصر العظمة الأميركية البيضاء.. في موقعة عفرين أخيرا، قيست هذه الأحلام الإمبرطورية بدقة الحسابات، بشطارة الخائضين بلعبة الشطرنج على الرقعة السورية، البعيدة عن بلادهم المحروسة. قال الأميركيون، داعمو الكرد، في الهجمة التركية كلاماً خجولاً ومتناقضاً. الروس الذين اعتُبروا حلفاء ضمنيين للكرد انسبحوا واستنكروا الهجمة التركية برخاوة غير معهودة (قارن مثلاً مع إسقاط الأتراك طائرة روسية منذ ثلاثة أعوام، وشراسة ردّ بوتين على ما اعتبره “طعنة” تركية في ظهره)، والإيرانيون ابتعدوا، ربما لأن “اشتغالا” كهذا يفيدهم لناحية كردهم. فهم برعوا، مع الأتراك، في إطلاق حرية الهجوم على كركوك، وتقويض الدولة الكردية العراقية الناشئة.. ومثلهم الإسرائيليون الذين لا تتعارض المقتلة مع استراتيجيتهم. إذ لن يجدوا في الدنيا كلها أعداء وأصحاب حق على هذه الدرجة من الشقاء.
أما ما يجمع ضحايا هذه الموقعة، فهو سذاجة اعتقادهم بأن واحدا من “حلفائهم”، الإقليميين أو الدوليين، يقف معهم كرمى عيون ثورتهم، أو يقاسمونهم توقهم للحرية. الكرد الآن، العرب الآن وفي ما مضى، منذ مئة عام + ثلاث سنوات، عندما وعد البريطانيون الشريف حسين بالاستقلال عن العثمانيين إذا قاتل هؤلاء إلى جانبهم، يحصل على مملكة الوحدة والاستقلال. وكانوا، أي البريطانيين، في الأثناء نفسها يعدّون لوعد بلفور الذي مزّق الأرض الموعودة بالوحدة والاستقلال. الحرب على عفرين اليوم تستحضر ثورة الشريف حسين. والدرس غير المحفوظ، لا عربياً ولا كردياً، من أن”الحلفاء” الدوليين، وغير الدوليين، إنما هم أصحاب مصالح عليا، يصرفونها كـ”التزامات”، برهة، دائماً قصيرة، كفيلة بالكشف السريع عن نفض أيديهم منها.
العربي الجديد
«عرب الغَمر» في جزيرة الأكراد/ حازم الامين
حين أشار صديقي الكردي بيده إلى القرية العربية الواقعة على شمال الطريق بين مدينتي القامشلي وعامودا الكرديتين السوريتين، طلب مني أن ألاحظ التمييز الذي خضعت له القرى الكردية من قبل النظام السوري. قال إن في كل قرية عربية مسجداً ومدرسة ومقراً لحزب البعث، بينما القرى الكردية حُرمت من كل تقديمات الدولة. والحال أنني لم أتمكن من تحديد التمييز، على رغم أنني لاحظت فوارق، ذاك أن بؤساً هائلاً يجمع بين نمطين من القرى هو أول ما يلوح لعابر بالقرب منها. القرى العربية اسمنتية المنازل وعارية الجدران، ولا تقيها من شمس الصحراء الحارقة أي شجرة أو جدول ماء، فيما بيوت القرى الكردية ذاوية وزائلة، ولا يبعث قِدَم جدرانها على شعور بهيبة العمر بقدر ما يؤشر إلى تفتت وتآكل. وهي بدورها قرى عارية أصاب الجفاف منازلها، فيما لم يصل الإسفلت إلى طرقها وممراتها.
مناسبة هذه الاستعادة تجدّد السجال المتوتر العربي- الكردي حول «عرب الغمر» على هامش الحرب في مدينة عفرين. و «عرب الغمر» هم أبناء العشائر العربية الذين ساقهم نظام البعث من الرقة وريفها ومناطق سورية أخرى، وزرعهم في مناطق ذات غالبية كردية. وأطلق أكراد الجزيرة على تلك القرى التي أنشأها النظام لـ «عرب الغمر» اسم المستعمرات، فيما اختار النظام لها أسماء استلّها من قاموس البعث من نوع «أم الربيعين» و «القحطانية» و «المالكية».
الأكراد أطلقوا على جيرانهم الجدد اسم «المستعمرين»، فيما أطلق عليهم معارضو النظام من العرب اسم «المقتلعين». شبهة العلاقة مع النظام رافقتهم، ذاك أنهم عربه الذين استعان بهم لكبح الغلبة الكردية في تلك المنطقة، وهذا صحيح إلى حدٍ كبير. لكن حقيقة أنهم ضحاياه واضحة أيضاً، فهم أبناء المناطق التي طاف عليها نهر الفرات بعد إنشاء سد البعث، وتحولت قراهم إلى بحيرة. وهم أيضاً من خارج هوية النظام المذهبية، وهم، إذ وردوا في أدبياته بصفتهم «عرباً أقحاحاً»، فهو أبقاهم في بؤسهم وفقرهم على نحو ما أبقى أكراده في البؤس والحرمان.
لا يجمع «عرب الغَمر» بأكراد الجزيرة الكثير من القواسم المشتركة. نمطا عيش مختلفان تماماً. لكن ما يجمعهما على نحو لا تخطئه العين هو أنهما، وعلى مر تجربة التجاور القسري، كانا ضحيتي النظام. وهنا يمكن الاجتهاد قليلاً، ذاك أن تفاوتاً في صورة الضحية لم يساعد على التوافق. التفاوت بين من أرضه محتلة وبين من هو مقتلع من أرضه. بين من هو ممنوع من اسمه ولغته وثقافته، وبين من هو مستدرج لأن يكون في صلب نظام لا يمت إليه بأي قرابة أو مصلحة.
نحن هنا حيال سجال بين ضحيتين، ومن بلغ قبل الآخر صورة الضحية. ربما من العدالة أن يعترف العرب للأكراد بأنهم كانوا السباقين إلى صورة الضحية، لكن العدل يقضي أيضاً بأن ينال العرب قدراً من الاعتراف الكردي بحقيقة أنهم ضحايا أيضاً. لكن هذا الاقتراح لا يبدو واقعياً، وهو قد يثير السخرية بمثاليته، ذاك أن وقائع كثيرة حصلت على ضفتي هذه المأساة. العرب كانوا ضحايا البعث، لكنهم كانوا أداته أيضاً، وها هم الأكراد يكررون التجربة. والعكس صحيح أيضاً، ذاك أن رواية زرع النظام «أعرابه» في جزيرة الأكراد، تُقابل برواية عربية كان البعث وراءها أيضاً، وهي أن سكان الجزيرة من الأكراد هم ممن قذفت بهم الحرب العالمية الأولى من تركيا إلى سورية. وهنا تأخذ المأساة بعداً جديداً لا يبدو أن الوعي البعثي بعيد عنها.
وبين «عرب الغمر» و «عرب المستعمرات»، وبين الأصول التركية لأكراد الجزيرة، لن يكون الشفاء سهلاً، وسيكون «داعش» كما البعث قبله، فرصة لمزيد من الضغائن ومحاولات الانتقام. وفكرة تماهي الضحية مع الجلاد ستجد مختبراً هائلاً لصحتها وسط هذا الحطام المديد.
الحياة
الأكراد وبؤس الجغرافيا/ حسين عبد العزيز
الجغرافيا السياسية لا تستشير أحداً، وتفرض منطقها وحضورها على الجميع، حتى في أشد اللحظات التاريخية حرجاً، حين يظن بعضهم أن مكتسبات سياسية أو عسكرية هنا أو هناك يمكنها أن تتجاهل قوتها وكينونتها، وربما عطالتها الداخلية. هذا هو واقع الوعي السياسي الكردي في منطقتنا، وفي سورية خصوصاً منذ بدء الثورة واستحالتها إلى أزمة، حين أغفلوا حقائق الجغرافيا، وأغفلوا الاعتبارات والمقاييس التي تفرضها، ومنها المقاييس المحلية والإقليمية لمسألتهم القومية.
لم يعِ الأكراد أن قضيتهم محكومة بالجغرافيا الميؤوس منها، وأن الدول الإقليمية الأربع التي يتوزعون فيها لا تسمح بقيام دولة كردية، أو حكم ذاتي أقرب إلى الدولة. وأخطأ حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل القوة السياسية الكبرى للأكراد السوريين مرات: حين رفض الانضواء تحت الثورة، ونيل حقوقه ضمن حقوق المواطنة الجامعة. وحين مارس عملية تغيير ديمغرافي بالقوة في مناطق ذات إرث عربي عميق. وحين أصرّ ويصر على إقامة فيدرالية في بيئة محلية وإقليمية لا تسمحان بإقامتها. وأخيراً حين أعلن وذراعه العسكرية خوض معركة عفرين. لم يقرأ الحزب حقيقة المواقف الدولية من هذه المعركة، وطبيعة التحالفات الإقليمية ـ الدولية القائمة وتداخلاتها، فلم يدرك أن الروس سيتنازلون لتركيا عن عفرين، لأسباب متعلقة بالمسار السياسي الذي يخطونه، ولأسباب مرتبطة بطبيعة التنافس مع الولايات المتحدة. ولم يدركوا أن الولايات المتحدة لن تخوض معركة عسكرية، وإن كانت جانبية، مع تركيا لأجل عفرين. ولم يدركوا أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى الخيار التركي العسكري، وتحويل هذه المنطقة مع منطقة “درع الفرات” إلى مقصد للاجئين السوريين في تركيا، وإزاحة ستارة قاتمة على العلاقات التركية الأوروبية. ولم يدركوا أخيراً أن النظام السوري سيخذلهم.
أدى فائض القوة العسكرية لدى الأكراد في سورية، مع وفرة قومية في الوعي، إلى حالة من العمى السياسي، فضربوا عرض الحائط الأبعاد الإقليمية ـ الدولية للصراع السوري بأشكاله
“لم يعِ الأكراد أن قضيتهم محكومة بالجغرافيا الميؤوس منها، وأن الدول الإقليمية الأربع التي يتوزعون فيها لا تسمح بقيام دولة كردية، أو حكم ذاتي أقرب إلى الدولة”
المتنوعة، إلى درجة أنهم نسوا أن دورهم مربوط ومصنوع ضمن الحسابات الدولية، ونسوا أيضاً أن الولايات المتحدة ليست قوة مطلقة قادرة على فعل كل شيء، وأنها تقبل أن يحققوا إنجازات ذات حدود محلية، ولا تقبل أن يحققوا مكاسب تتجاوز الأبعاد المحلية.
بعبارة أخرى، اعتقد الأكراد أن الولايات المتحدة وحدها القادرة على تحقيق حلمهم في بناء كيان سياسي وجغرافي، وهذا وعي زائف، فواشنطن تستخدم هذه القضية لربط الأكراد بهم مباشرة، ضمن عملية التبادل الوظيفي للأدوار. وفي الإعلان الأميركي إن عفرين ليست مشمولة بمناطق التحالف الدولي دلالات سياسية تكفي لمن يرغب في قراءة المشهد الدولي للصراع السوري، فهذه المنطقة خارج الاهتمام الأميركي، بغض النظر إن كانت مهمة للمشروع الكردي أم لا.
سيطرة الوحدات الكردية على مناطق جغرافية واسعة مليئة بثروات طبيعية أدى إلى امتلاك حضور اقتصادي، هو الأول من نوعه في تاريخ الأكراد السوريين، وترافق ذلك مع حضور عسكري أميركي على الأرض لا أحد يستطيع الاقتراب منه، ثم ترافق ذلك مع هيمنة إدارية/ سياسية مطلقة على الأرض التي تشكل في الوعي الكردي أهمية كبرى. وليس مصادفةً أن التوزيع الجغرافي للإدارة الذاتية في سورية يتطابق مع مفهوم الكومونات الذي رافق المخيلة الماركسية لحزب العمال الكردستاني خلال نضاله في الثمانينات.
من هنا، يمكن فهم تمسّك الأكراد بالأرض، ومنها أرض عفرين، وعدم التخلي عنها مهما كانت قيمتها. ويعولون في عدم التخلي عن هذه المدينة إلى مقومات الصمود التي تمتلكها عفرين، كونها تحتوي كثافة كردية عالية، وقاعدة لتدريب المقاتلين، فضلاً عن وعورة تضاريسها. وفي حال استطاعت الوحدات الكردية عرقلة فصائل المعارضة والقوات التركية وإنزال خسائر بشرية في صفوفهما، فإنها قد تحصل على تدخل دولي لصالحها. وتدرك أنقرة هذه المعادلة جيداً، وهو ما يفسر ربما بطء العمليات العسكرية، إما لتعبيد الطرق المؤدية إلى المدينة وتنظيفها وإحكام السيطرة عليها، أو لانتظار تبلور صفقةٍ ما مع واشنطن، يحصل الأتراك بموجبها على حصةٍ تعوّضهم عن مدينة عفرين.
في كل الأحوال، كشفت معركة عفرين مأزق القضية الكردية، ومأزق الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في التعامل معها، ومأزق الأكراد أنفسهم في التعاطي مع قضيتهم التي هي قضية الشعب السوري كله في نيل حقوقه وحريته. وواضح أن معركة عفرين مبكرة جداً في الصراع المحلي ـ الإقليمي ضد التطلعات الكردية، وستكون المراحل المقبلة أكثر عنفاً، وربما تساهم في إعادة إرباك المشهد العسكري السوري، إذا لم يتم التعاطي مع المسألة ضمن اعتبارات الحقوق الكردية، واعتبارات مصالح دول المنطقة.
العربي الجديد
رقعة سوتشي وعفرين.. البيدق سوري/ عمر الشيخ
ربما يبدو لعملية عفرين العسكرية التي تديرها تركيا، في شمال سورية، بمشاركة خجولة من فصائل تابعة للجيش السوري الحر، شكل الورطة، أكثر منها ورقة لجهة وجود إحدى الدول الضامنة في الملف السوري على الأرض مع حلفائها من المعارضة، ومن جهة أخرى للتخلص من الكيان الكردي السوري الموجود هناك، أحد خصوم تركيا، والذي استغنت عن دعمه روسيا ومن خلفها النظام السوري، إضافة إلى الولايات المتحدة التي صرّح المتحدث باسم التحالف الدولي فيها إن “عفرين خارج مناطق التحالف الدولي”. كلام ربما تعتبره تركيا “علامة رضا” لإطلاق تلك العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية الواقعة تحت سيطرة “وحدات حماية الشعب”، بينما يعبر الروس عن “قلقهم” بشأن هذا التحرك التركي، فيرد المتحدث باسم الحكومة التركية قائلاً: “سوف تضع عملية عفرين العسكرية نصب عينيها احترام وحدة
“ترى موسكو أن الأتراك أفشلوا مؤتمر سوتشي، وسوف يكون ردها على مناطق “خفض التصعيد”، بينما تستمر تركيا في عملياتها في عفرين”
أراضي سورية وسيادتها ووحدتها السياسية، وسيجري الالتزام بهذه المبادئ طوال مدة العملية”، ثم كما حدث في مناطق “درع الفرات” سوف يقتسم العلم التركي كل الهيئات المحلية والسياسية والاجتماعية “المحرّرة” في عفرين كلها، تقديراً للتدخل التركي مع المعارضة السورية.
والسؤال هنا: لماذا تواجه عفرين هذه العزلة الدولية في مواجهة مصيرها، باعتبارها جزءا مستقلا جغرافياً وسياسياً خارج الثورة السورية؟ فالفصائل المعارضة تعتبر إدارتها “مليشيات انفصالية”، وتركيا تراها “منظمات إرهابية”، بينما دولياً ثمّة من اكتفى “بالقلق”! لمصيرها الحالي، وتحولت المدينة إلى ساحة تصفيةٍ بين تركيا والإدارة الذاتية للأكراد، بالتوازي مع انشغال موسكو بتحضيرات “مؤتمر سوتشي” إلى جانب قصفها الجوي المستمر مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، وريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. ولعل حدة المعارك في المنطقة الأخيرة أفضت لسيطرة النظام على مطار أبو الظهور العسكري، وبالتالي ضمان قاعدة جوية روسية جديدة لطرح سيناريوهات إدلب المقبلة.
من المرجّح أن موسكو تعلم بنوايا أنقرة، وما تهدف إليه من العملية التي ضخت لها تركيا إعلامياً تبريراتٍ متواصلة من نوع “ضرورات مكافحة الإرهاب”، وكان تجاوب الروس بسحب قواتهم العسكرية “منعاً لاستفزازات محتملة واستبعاد الخطر الذي قد يهدّد حياة الجنود الروس العاملين بفريق المصالحة هناك”، حسب ما صرحت وزارة الدفاع الروسية، ولكن ما يدور في الأروقة يختلف تماماً عن هذه الادعاءات، لأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان في زيارة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أرض سوتشي، وسبقتها زيارة لبشار الأسد بين 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، الأمر الذي يعكس مدى التنسيق والاتفاق على اقتسام المناطق بين الدول الضامنة – المحتلة للأراضي السورية، ناهيك عن خطابات تركيا المزعومة التي أُرسلت، عند بدء عملية اجتياح عفرين، ووجهت في حينها إلى عدة دول مؤثرة في الحرب السورية، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وإيران، إضافة إلى سفارة النظام في تركيا. لكن، من المستغرب أن هناك اتفاقاً على أخذ مناطق سورية جديدة إلى دوامة الصراع الدولي، وهو أمر لم يعد من خيارات السوريين، بل أصبح أمراً واقعاً تلعب عليه توازنات القوى المستفيدة من ديمومة القتل والدمار. وهنا نتوقف عند آخر تحرّك صدامي حدث لرتل عسكري تركي قرب مناطق “خفض التصعيد” في ريف حلب في بلدة العيس، حيث تم استهداف الرتل التركي من قوات النظام، استهداف يحمل رسائل روسية جديدة لتركيا والمعارضة السورية، أبرزها نهاية مؤتمر سوتشي. وبرأي موسكو أن الأتراك أفشلوه، وسوف يكون ردها على مناطق “خفض التصعيد”، بينما تستمر تركيا في عملياتها في عفرين. ولكن يحظر عليها الحديث مجدّداً عن أي اتفاق آخر من مزاعم “أستانة” لوقف إطلاق النار، إذ أصبحت رقعة المواجهات العسكرية على الأرض هي الحكم، وذلك ما تدركه تركيا تماماً.
بين حين وآخر، يطل أردوغان، ليؤكد أن بلاده تعمل إلى جانب “الجيش الحر”، وهذا أمر يدفعها بالتأكيد إلى رفع العلم التركي إلى جانب علم “الحر” في مناطق سورية، كانت تحت إدارة الحكم الذاتي الكردي بتنسيق روسي، وهذا ما لم يغفره حلفاء تركيا من الفصائل المعارضة، فتحرّك هؤلاء بات أقرب إلى المصالح التركية منذ “درع الفرات” حتى نهاية معارك عفرين التي ستحمل تأكيداتٍ كثيرة على أن الضحية الوحيدة في ذلك هي اقتسام المناطق حسب التوافقات الدولية، بغض النظر عن “المراهقة” السياسية التي دفعت الأكراد في عفرين إلى محرقة القومية في التلوث بصراع دولي، لن يتوقف عند الحجر والبشر، فالميدان هو البوصلة الدموية والبيدق على الرقعة التفاوضية يأخذ شكل السوري على ما يبدو..!
(كاتب سوري)
العربي الجديد
سيناريو التسوية بين واشنطن وأنقرة: أمريكا في شرق الفرات… وتركيا في غربه/ د. عصام نعمان
الصراع السياسي والعسكري ما زال محتدماً في سوريا وعليها. واشنطن تؤجج الصراع العسكري من خلال وكلائها الميدانيين. حلفاؤها الكُرد في شرق الفرات متربصون بالجيش السوري غرب النهر وبالجيش التركي شمال منطقة عفرين غرب البلاد. موسكو تركّز جهودها على إنجاح مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه أكثر من 1600 شخص ينتمون إلى مختلف الفئات والجماعات والطوائف والمذاهب والإثنيات والأحزاب السورية، لكنها تبقى مستنفَرَة لدعم الجيش السوري إذا ما تطلّبت جهوده العسكرية ذلك.
غير أن احتدام الصراع السياسي والعسكري لا تُوقف اتصالات ومحادثات تجري بين اللاعبين الكبار والصغار، كما لا تحجب مخططات يجري إعدادها لإيجاد تسوية للصراع تخدم مصالح الكبار قبل الصغار بطبيعة الحال.
في هذا المجال، يتبلور مشروع سيناريو للتسوية بين واشنطن وأنقرة. جوهر المشروع تمكينُ تركيا من إقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا بعمق 30 كيلومتراً غربيّ الفرات، على أن تبقى القوات التركية وحلفاؤها بمنأى عن مناطق البلاد شرقيّ النهر. هذا يعني أن تضع أنقرة يدها على كل مناطق سوريا الشمالية من عفرين في الغرب إلى محيط منبج في الشرق، وأن تبقى لواشنطن وحلفائها الكُرد اليد العليا على مناطق محافظتي الرقة والحسكة شمال شرق البلاد.
حكومة انقرة كانت حاولت منذ سنتين إقامة هذه «المنطقة الآمنة» المقترحة، لكن تحرير حلب من وكلاء تركيا وأمريكا الميدانيين من جهة، ومعارضة الكُرد السوريين، بدعم من امريكا، من جهة أخرى حالا دون تنفيذ هذا المخطط التقسيمي. الآن، بعدما انهار تنظيم «داعش» في معظم انحاء سوريا وتمكّن الكرد، بمساعدة أمريكا، من السيطرة على محافظة الحسكة ومعظم محافظة الرقة ومنطقة عفرين، وقيام أنقرة بتجريد حملة عسكرية للاستيلاء على عفرين، وتهديدها بالتقدم للسيطرة على منبج ايضاً، حيث لامريكا قوات برية ومدرعات ومطارات، عدّلت واشنطن موقفها فأخذت تنادي بإقامة شريط حدودي دفاعي بين شمال سوريا وجنوب تركيا يؤمّن هذه الأخيرة، لكن أنقرة طالبت واشنطن بسحب قواتها فورا من منبج.
انقرة رحبت ضمناً بالمبادرة الأمريكية، لكنها لم توافق عليها علناً… بعد، السبب، لأنها لا تثق بواشنطن، كما لمّح إلى ذلك وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في تعليقه على المبادرة المذكورة. ذلك أن انقرة تعتقد أن واشنطن تموّل وتسلّح «قوات حماية الشعب» الكردية، وأنها وعدت قادتها بأمرين: عدم السماح للجيش السوري، كما للجيش التركي، بالسيطرة على مناطق شمال سوريا بعد طرد التنظيمات الإرهابية منها، كما وعدتهم بالدعم السياسي اللازم لإقامة كيان كردي منفصل عن دمشق في شمال شرق سوريا.
إزاء الخطر الماثل بتقدّم الجيش التركي وحلفائه («الجيش الحر» وبعض الفصائل المحلية المسلحة المتحالفة معه) داخل منطقة عفرين، قامت إدارة الحكم الذاتي التي يقودها الكُرد في المنطقة، بدعوة الحكومة السورية «للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي».
دعوةُ الكُرد العفرانيين هذه مضحكة ومرتجلة في آن، مضحكة كون الكرد هم البادئين في انتهاك سيادة سوريا بتعاونهم العسكري مع تركيا وأمريكا. مرتجلة كون استنجادهم بالجيش السوري لحمايتهم لم يتضمن أي التزامات أو إجراءات
محددة لتأمين قيامه بالمهمة المطلوبة. غير أن ذلك لا يمنع كلا الطرفين من تدارك الخطر المحدق والقصور الكردي، باتخاذ قادة الكرد جميعاً في الحسكة قراراً حاسماً بالانفصال عن امريكا وتركيا معاً.
ماذا عن واشنطن وموسكو ودمشق؟
واشنطن منخرطة، على ما يبدو، في تنفيذ استراتيجيتها الهجومية الجديدة، التي أعلنها وزير دفاعها جيمس ماتيس أخيراً، وتتلخص بمجابهة الصين وروسيا بوصفهما «قوتين رجعيتين» بدءاً بسوريا وصولاً إلى الشرق الاقصى. إلى ذلك، تنهمك ادارة ترامب بمخطط لتصفية قضية فلسطين، بتكريس القدس عاصمة لـِ»إسرائيل» وعدم استئناف دفع المساعدات المالية التي قطعتها عن الفلسطينيين، إلاّ بشرط عودتهم إلى المفاوضات، مع القبول بإقصاء القدس عن طاولتها. فوق ذلك، تسعى إدارة ترامب إلى إبقاء قواتها في شمال شرق سوريا كاحتياط لدعم الكرد السوريين في الاستحصال على كيان سياسي لهم منفصل عن دمشق وذلك في إطار مخطط متعدد الجوانب لتفكيك سوريا إلى جمهوريات موزٍ تقوم على اسس قَبَلية ومذهبية وإثنية، وقد جرى تعزيز هذا المخطط بوثيقة قدمتها امريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن إلى مؤتمر فيينا الأخير، تدعو إلى إقامة نظام كونفدرالي فيها.
موسكو ما زالت ملتزمة دعم سوريا لاستعادة سيطرتها وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وقد نددت مؤخراً بمساعي أمريكا لتقسيم سوريا، وهي جادة في مساعيها لإنجاح مؤتمر سوتشي بغية إنتاج حل سياسي، مدخله التصويت الشعبي على مستقبل البلاد. هذه السياسة بكل جوانبها ترشح موسكو لصراع سياسي طويل الامد مع واشنطن المعادية لحكم الرئيس بشار الاسد، التي تقود، بمشاركة فرنسا، حملة مسعورة لاتهام سوريا بأنها مسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبها.
سوريا تعي كل هذه الأخطار والتحديات المحدقة بها، وهي جادة في مواجهتها سياسياً وعسكرياً بالتعاون مع إيران وبالتحالف الميداني مع قوى المقاومة اللبنانية والعراقية. في هذا الإطار تجاري دمشق موسكو في مساعيها الدبلوماسية الحثيثة، سواء في أستانة أو سوتشي لإيجاد تسوية سياسية للصراع المحتدم، لكنها تصرّ على متابعة حربٍ لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية والقوى المضادة، الدولية الاقليمية، التي تتواطأ على تقسيمها، أو على انتزاع مناطق نفوذ لها فيها. لذا لن تهرع دمشق إلى تحريك جيشها في الوقت الحاضر لنجدة كرد عفرين ضد الجيش التركي وحلفائه، بل ستقوم بدعوة الكرد المتمردين في شرق البلاد وغربها الساعين لإقامة نظام فيدرالي في البلاد، إلى وقف تعاونهم مع امريكا ودعوتها بالتالي إلى سحب قواتها المتواجدة والمتربصة شرق الفرات، وإلى التفاهم مع دمشق، على أسس سياسية ودستورية لحل سياسي ديمقراطي يؤمّن مشاركة الكرد في الحياة السياسية وسلطات الدولة المدنية المنشودة بالتساوي التام مع سائر المواطنين السوريين.
الصراع محتدم وطويل، وكذلك المساعي الرامية إلى تطويقه.
كاتب لبناني
القدس العربي-
هجوم تركيا على المسلحين الأكراد في شمال سوريا/ ميشائيل مارتنس
غصن الزيتون “المسموم” في عفرين ومنبج السوريتين
حملة عسكرية تركية على وحدات “حماية الشعب” الكردية السورية، الحليفة للروس والأمريكان، والـتي تعتبرها تركيا “إرهابية”. لكن ما تأثير تخلي الروس والأمريكان عن عفرين على الوحدات الكردية الشريكة؟ المحلل الألماني ميشائيل مارتنس يرى أن من مكاسب موسكو الواضحة في هذه المعركة هو الخلاف بين واشنطن وأنقرة. أما الأمريكان فالوحدات الكردية لا تبدو لهم مهمة إلا عند ظهور نسخة جديدة من تنظيم “الدولة الإسلامية”.
عندما يتعلق الأمر بتقرير مصير الأكراد، تتعامل أنقرة وفق شعار: التصدِّي للبدايات ومنعها. إذ إنَّ الحكومة التركية ترفض استقلال الأكراد السوريين، وليس هذا فحسب، بل إنَّ تركيا تفعل كلَّ ما في وسعها -بما في ذلك أيضًا استخدام القوة العسكرية- لمنع إقامة منطقة كردية تتمتَّع بحكم ذاتي داخل دولة سورية تتشكِّل في المستقبل.
وهكذا تسعى تركيا إلى قمع كلِّ ما يمكن أن يشجِّع السكَّان الأكراد في جنوب شرق الأناضول على تقليد غيرهم من الأكراد في مناطق أخرى. وهذا هو أيضًا هدف الحملة العسكرية التركية الثانية في سوريا، والتي بدأت يوم السبت (في 20 / 01 / 2018).
لقد سبقت هذه الحملة العسكرية حملة أولى كان اسمها “درع الفرات”، واستمرت رسميًا من شهر آب/أغسطس 2016 إلى شهر آذار/مارس 2017، وكانت موجهة ضدَّ إرهابيي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية (YPG) في المناطق الحدودية مع تركيا في شمال سوريا. وذلك لأنَّ وحدات حماية الشعب الكردية تعتبر من وجهة النظر التركية جماعة إرهابية أيضًا.
والحملة العسكرية الثانية اسمها الآن عملية “غصن الزيتون” وتستهدف الأكراد فقط. وعلى الرغم من أنَّ وسائل الإعلام الحكومية التركية تدَّعي أنَّ هذه الحملة تستهدف من جديد كلاً من تنظيم “الدولة الإسلامية” ووحداث حماية الشعب، بيد أنَّ التقارير تناقض نفسها. ففي هذه التقارير يتم تصوير منطقة عفرين، المستهدفة من هذه الحملة العسكرية في البداية، على أنَّها منطقة تسيطر عليها بالكامل “وحدات حماية الشعب” ومنطقة تعاني في الوقت نفسه من “الإرهاب”.
في الواقع إنَّ محافظة عفرين بمركزها الذي يحمل الاسم نفسه تعتبر واحدة من ثلاث محافظات في شمال سوريا، تخضع لسيطرة الأكراد منذ عدة أعوام، ولا يوجد فيها أي مكان لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
صحيح أنَّ تنظيم “الدولة الإسلامية” كان في عام 2014 قد أوشك على الاستيلاء على عين العرب (كوباني)، وهي واحدة من المحافظات الكردية الثلاثة في شمال سوريا، ولكن تم دحره من هذه المنطقة.
يمكن الاستدلال بشكل غير مباشر على حقيقة عدم تعرُّض عفرين لأية تهديدات من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” أيضًا من البيانات الأمريكية، التي صدرت في الأيَّام الأخيرة. وفي هذه البيانات يؤكِّد الأمريكيون على أنَّ واشنطن متحالفة في الواقع مع الأكراد السوريين في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلَّا أنَّ هذا التحالف لا ينطبق على منطقة عفرين. وذلك -مثلما يُفترض- بسبب عدم وجود أفراد عصابات إسلاموية يمكن أن تكون هناك حاجة لقتالهم.
“تحييد” الجماعات الإرهابية
في عرض تركيا الرسمي تبدو الأمور مختلفة. فبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة في أنقرة فإنَّ القوَّات التركية تخوض منذ الساعة الخامسة من مساء يوم السبت معركة تهدف إلى “تحييد” الجماعات الإرهابية وإنقاذ “شعب المنطقة الصديق والشقيق من قمع الإرهابيين واضطهادهم”. صحيح أنَّ التقارير الرسمية وشبه الرسمية لا تدَّعي حرفيًا أنَّ هذا الشعب الشقيق قد طلب بنفسه من تركيا أن تنقذه، بيد أنَّ ذلك يخرج بهذا المعنى من البيانات الرسمية.
نقلت صحيفة “حُرِّيَّتْ” التركية عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه قوله إنَّ الهدف من عملية “غصن الزيتون” هو تمكين أهالي عفرين من حكم أنفسهم بأنفسهم وبناء مؤسَّساتهم الديمقراطية بعد إخراج “وحدات حماية الشعب”. ولكن يبقى من غير المعروف إن كانت هذه المؤسَّسات الديمقراطية في عفرين من المفترض أن يتم بناؤها على غرار ما حدث في الأعوام الأخيرة في تركيا رجب طيب إردوغان.
وعلى الرغم من أنَّ أفراد وحدات حماية الشعب ينحدرون أصلاً في الواقع من التنظيم الإرهابي الكردي “حزب العمال الكردستاني” (PKK)، إلَّا أنَّ هذه الوحدات قد أسَّست هياكل ديمقراطية مقبولة في المناطق التي تفرض سيطرتها عليها داخل الأراضي السورية – على الأقل بالمقارنة مع المناطق الأخرى المجاورة. ونموذج إدارتها الذاتية الإقليمية مع وجود نسبة مرتفعة من مشاركة النساء في السياسة، يتناقض تقريبًا مع كلِّ ما تسعى إليه الحكومة التركية.
لقد كان من الواضح أنَّ عفرين يمكن أن يتم استهدافها من قِبَل الأتراك، منذ أن أقام الأكراد هناك إدارتهم الذاتية إثر الانهيار الجزئي لسلطة الدكتاتور السوري بشار الأسد.
عندما جاء وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى تركيا في شهر آب/أغسطس 2017، من أجل التنسيق مع شريكه التركي في حلف الناتو لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، استغل إردوغان هذه الفرصة ليوضِّح أنَّ بلاده لن تسمح أبدًا بأن ينشأ “ممر إرهابي” كردي في سوريا. وإذا ظهر مثل هذا الخطر “فعندئذ سنتدخَّل”، مثلما قال إردوغان – وعلى وجه التحديد: “تصميمنا بشأن عفرين لم يتغيَّر. وخططنا مستمرة كما هو مقرَّر”.
روسيا تبدي تضامنها مع تركيا
هناك عدة أسباب جعلت تركيا تحتاج خمسة أشهر لتنفيد خططها بعد الإعلان الرئاسي عن الهجوم المخطط له. فمن ناحية لقد كان الأمريكيون يعارضون بشدة الهجوم على عفرين في العام السابق [2017]، لأنَّهم كانوا في حاجة ماسة لمساعدة المقاتلين الأكراد في المعركة ضدَّ تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل معقله محافظة الرقة، وهي معركة لم تكن قد حُسِمَت بعد في تلك الفترة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت تركيا بحاجة إلى دعم روسيا أو على الأقل موافقتها من أجل القيام بعملية ضدَّ عفرين، وخاصة من أجل الغارات الجوية. فموسكو لم تنشر فقط على وجه التحديد نظام الدفاع الصاروخي S-400 في سوريا، بل لقد نشرت منذ عام 2017 عددًا غير معروف من المراقبين العسكريين الروس في عفرين أيضًا.
ولم يكن من باب الصدفة أن يسافر رئيس أركان الجيش التركي خُلوصي آكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان إلى موسكو لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الروسية. وقد كان هدف زيارتها هذه على ما يبدو فقط من أجل ضبط الموقف الروسي تجاه الهجوم التركي في عفرين.
المكاسب التي تراها روسيا في ذلك واضحة: صحيح أنَّ موسكو قد دعمت أيضًا الميليشيات الكردية في سوريا، وأنَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعرب عدة مرات في الأعوام الأخيرة عن تفهُّم بلاده لمساعي الأكراد من أجل الاستقلال السياسي، وذلك بغية إزعاج أنقرة، ولكن في الوقت نفسه فإنَّ قوَّات “وحدات حماية الشعب” الكردية تُعَدُّ حليفة للأمريكيين، الأمر الذي يجعل محاربة الأكراد من قِبَل الأتراك مربحة بالفعل في منطق الربح والخسارة الروسي، وذلك لأنَّ محاربتهم من قِبَل تركيا يمكن أن تُعمِّق النزاع بين الحليفين في حلف الناتو واشنطن وأنقرة.
انتظار الرد الأمريكي
وعلى أية حال تشير البيانات الروسية إلى أنَّ زيارة رئيس أركان الجيش التركي إلى موسكو كانت ناجحة. حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ هذه الأزمة قد تمت إثارتها من خلال “خطوات استفزازية” من جانب الولايات المتَّحدة الأمريكية، وانتقدت “الإمدادات العشوائية بالأسلحة الحديثة إلى المجموعات المؤيِّدة للولايات المتَّحدة الأمريكية في شمال سوريا”.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت موسكو أنَّها سحبت مراقبيها العسكريين وجنودها من المنطقة المحيطة بعفرين، وهذا شرط مسبق مهم من أجل الهجوم التركي، إذ لا يوجد شيء يمكن أن يضر بمصالح تركيا أكثر من أن يُقتل في الأعمال القتالية غير الأكراد مواطنون روس أيضًا. فأنقرة لم تنسَ رد فعل موسكو الشديد على إسقاط تركيا لمقاتلة روسية في أواخر عام 2015 – مما أدَّى إلى مقاطعة السياحة في تركيا وحظر استيراد البضائع التركية والتهديد بمواجهة عسكرية في سوريا.
والآن بإمكان روسيا أن تراقب بهدوء كيف سيكون الردُّ الأمريكي على مهاجمة تركيا القوَّات الكردية المساندة للأمريكيين والتي تعتبر الأكثر فعالية في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا. نقلت وسائل الإعلام التركية عن متحدِّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قوله إنَّ التحالف بقيادة الولايات المتَّحدة الأمريكية لا يجري أية عمليات في عفرين، لأنَّه يركِّز على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، الأمر الذي اعتبرته أنقرة كضوء أخضر للهجوم التركي.
بيد أنَّ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إنَّ بلاده تخطط للبقاء في سوريا في هذا الوقت من أجل منع ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” من جديد.
وإذا ما ظهرت مثل هذه النسخة الجديدة من تنظيم “الدولة الإسلامية” على أرض الحرب السورية الخصبة، فعنذئذ من الممكن أن تصبح الوحدات الكردية مهمة مرة أخرى بالنسبة للأمريكيين.
ولكن كيف سيؤثِّر الأمر على معنويات وحدات حماية الشعب الكردية وولائها لشركائها الأمريكيين والروس في المناطق الشرقية في سوريا، عندما يتخلون عن مركز وحدات حماية الشعب الأمامي -عفرين الواقعة غرباً- لصالح تركيا؟
ميشائيل مارتنس
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: فرانكفورتر ألغماينه تسياتونغ / موقع قنطرة 2018
ar.Qantara.de
ما بعد عفرين أهي حرب بين نيران صديقة؟/ د. مثنى عبدالله
في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي أردوغان عزمه توسيع تدخل بلاده العسكري في سوريا ضد المقاتلين الأكراد. قال إن العملية العسكرية في الأراضي السورية ستشمل بعد عفرين منبج ثم شرقا حتى الحدود العراقية. وإذا ما أخذنا بالاعتبار وجود المئات من الجيش الامريكي في منبج، رفقة حلفائهم «وحدات حماية الشعب الكردية»، فهذا يعني أن الحلفاء سيكونون وجها لوجه في ساحة المعركة، وأن أي خطأ غير مقصود أو مفتعل سيؤدي إلى مواجهة عسكرية بينهما.
هنالك أزمة فعلية بين البلدين العضوين في حلف الناتو، وهي ليست وليدة التدخل العسكري التركي الأخير، الذي جاء تتويجا لسلسلة طويلة من الاختلافات الجذرية على أكثر من صعيد بين الطرفين. ومع ذلك فإن المواجهة مستبعدة بينهما، لأن المصالح المشتركة وحاجة كل طرف إلى الآخر أكبر من أن تحصل مواجهة مقصودة ومخطط لها. كما أن الأهمية السياسية والاستراتيجية لتركيا في العقل السياسي الامريكي، هي العامل الفاعل في تحديد أي موقف من سياسات الرئيس أردوغان. يضاف إليه أن واشنطن لا تملك أوراق ضغط على أنقرة من أجل كبح جماح عملياتها العسكرية الحالية على الأرض السورية، على الرغم من أن الغضب التركي من الولايات المتحدة وصل إلى حدود غير مسبوقة، فأنقرة ترى أن تحركات واشنطن على الساحة السورية هي ضد التوجهات التركية. فمنذ عام 2014 تخلت أمريكا عن تدريب الجيش السوري الحر حليف تركيا، واختارت دعم الأكراد في كوباني، واستخدامهم كورقة في السيطرة على 30 في المئة من الجغرافية السورية.
ولقد اتبع الرئيس السابق أوباما سياسة استخدام قوى محلية على الارض، وكانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية، هي القوى الاكثر فاعلية على الأرض. حينها كظمت أنقرة غيضها ونظرت إلى هذا الأمر بامتعاض شديد، ولم تخف موقفها في أن ما تقوم به واشنطن هو تهديد للأمن القومي التركي. ثم جاء الرئيس ترامب وبقيت السياسة الامريكية حيال تركيا والاكراد في المسار نفسه، بل إنها تطورت لصالح الاكراد بالضد من مصالح تركيا، خاصة بعد إعلان أمريكا عن نيتها تدريب قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل أغلبهم من الاكراد الذين تصفهم تركيا بالإرهابيين. وقد برر أشتون كارتر وزير الدفاع الامريكي دعمهم للاكراد في سوريا، لتحقيق هزيمة مستدامة ضد تنظيم «الدولة»، من خلال تخويل الناس الذين يعيشون في تلك الاراضي بحكم أنفسهم. كما صرح ريكس تيلرسون وزير الخارجية بأن أمريكا تستمع إلى مخاوف تركيا وتأخذها على محمل الجد. بينما يُعرب ترامب عن قلقه من التصعيد في عفرين، ويؤكد أن بلاده لم تزود الاكراد بالاسلحة. وعندما طلب أردوغان على لسان المتحدث باسمه سحب جميع الأسلحة من أيدي القوات الكردية، رفضت واشنطن ذلك مُعزية الأمر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تضم مقاتلين عربا وليسوا أكرادا فقط، وأن القتال ضد تنظيم «الدولة» لا يزال نشيطا في سوريا، ما يتطلب استمرار الشراكة مع الاكراد. كل هذه مواقف أمريكية متضاربة كما تراها أنقرة، وهو ما يزيدها إصرارا على المضي قُدما في عمليتها العسكرية. لكن ما الذي تريده أنقرة من استهداف عفرين؟
لقد تحركت أنقره نحو مدينة عفرين لانها هدف سهل، فالمدينة محاصرة من قبل القوات التركية شمالا، وشرقا من حليفها الجيش السوري الحر. وأن السيطرة عليها تعني قطع الطريق على الأكراد من التوسع شمال غرب سوريا لربط منطقة درع الفرات بأدلب. كما أن العملية ستتيح لأنقرة التوسع شرقا نحو مدينة منبج العمود الفقري لوحدات حماية الشعب الكردية. ومع ذلك فإن أهداف العملية ما زالت غامضة وتفتقر إلى دقة التحديد. هل ستكتفي أنقرة بمحاصرة المدينة والضغط على القوات الكردية لمغادرتها؟ أم أن عفرين مجرد بوابة لإحداث تسويات بين كل اللاعبين في المشهد السوري؟ قد تكون هذه وتلك موجودة في عقل صانع القرار السياسي والعسكري التركي، فهدف الامن القومي التركي الرئيسي هو منع قيام كيان كردي على حدودها، وتأمين منطقة نفوذ لها، والجغرافية السورية باتت مقسمة بين اللاعبين.
بادية الجزيرة شرق الفرات باتت منطقة نفوذ أمريكي.. وبادية الشام منطقة نفوذ روسي إيراني. فلماذا لا تكون عفرين وجبل الكرد وصولا إلى رأس البسيط حصة أنقرة؟ هكذا يتساءل العقل السياسي التركي، خاصة بعد أن انسحب الروس منها وأعطوا الضوء الاخضر لدخولها. وفي هذه النقطة بالذات نرى أن تركيا عقدت صفقة مع روسيا (إدلب مقابل عفرين). أدلب كانت منطقة نفوذ تركي بواسطة الجيش السوري الحر، الذي كان يسيطر عليها، والذي تعرض مؤخرا لهجمات من الجيش النظامي مدعوم بالطيران الروسي. فبحثت تركيا عن منطقة نفوذ أخرى فكانت عفرين. وفي خضم معركة البحث عن النفوذ هذه، الذي تحاول كل الاطراف الفوز بما تريد، تجتمع وتتقاطع الأجندات بعضها مع بعض. الروس يريدون زيادة سعير الخلاف التركي الامريكي خدمة لمصالحهم، فانسحبوا من أمام القوات التركية في عفرين. الاتراك يريدون تفجير حرب تركية كردية لزعزعة جهود واشنطن في شرق سوريا، فتضطر لإعادة النظر بعلاقتها مع قوات حماية الشعب الكردية، وهذا ما تريده موسكو بالضبط كي تقول بأن الامريكان يخذلون حلفاءهم ويتخلون عنهم. وهنا يظهر وجود حساب سياسي مشترك بين الروس والاتراك في عملية عفرين، قوامه الضغط على الامريكان لتخفيض وجودهم العسكري في سوريا، والضغط على الاكراد كي يتخلوا عن شمال سوريا، لأن الروس يريدون كل المناطق من جرابلس إلى البوكمال تحت سيطرة النظام، وقد طلبوا من الاكراد تسليم عفرين للقوات الحكومية، لكنهم جوبهوا بالرفض. فكان أن أعطوا الضوء الأخضر للاتراك لدخولها، وها هم الاكراد اليوم يستنجدون بالنظام ويعلنون استعدادهم للتخلي عن المنطقة له.
قد يقول قائل لماذا تقبل تركيا أن تكون إحدى أدوات تنفيذ الاجندة الروسية في سوريا؟ في الحقيقة أن تركيا جاهزة لفعل كل شيء من أجل هزيمة قوات حماية الشعب الكردية والحفاظ على أمنها القومي، وحتى عندما تخلّت عن حلب وطلبت من المعارضة الانسحاب منها، كان الهدف التركي هو منع الاكراد من وصل مناطق سيطرتهم في عفرين بعين العرب كوباني.
الخاسر الوحيد في هذه اللعبة السياسية هو الطرف الكردي، فمنذ عقود والاكراد لا يُشكلون سوى عامل مناورة في السياسة الدولية، ويتم التخلي عنهم بسهولة عند إتمام الصفقة. هذا الموقف يثلج قلب أنقرة فيدفعها للتقدم من عفرين إلى منبج، وشمال العراق، والجزيرة وعين العرب كوباني لاحقا. كما أن موافقة الروس والايرانيين والعمل الامريكي الحثيث من خلف الكواليس، لطمأنة تركيا ومحاولة إرضائها، كلها في جيب صانع القرار التركي. أما النظام في سوريا فهو الوحيد المفعول به في هذه المعادلة، ولا يمانع الاتراك من التفاهم معه في مراحل لاحقة، بعد تحقيق أهدافهم. فربُ السياسة المصالح الدائمة وليست العداوات الدائمة.
باحث سياسي عراقي
القدس العربي
تركيا والطريق إلى “غصن الزيتون” في عفرين/ ماجد عزام
بدت عملية غصن الزيتون العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية، وكأنها تختصر ليس فقط المشهد الحالي، وإنما المتغيرات في سورية منذ اندلاع الثورة، بداية من تواطؤ النظام مع حزب العمال الكردستاني، لطعن الثورة والالتفاف عليها، ثم رفض أميركا (باراك أوباما ودونالد ترامب) تسليح الجيش الحر، أو إقامة منطقة آمنة للاجئين والثوار، وتحولها فيما بعد لدعم تنظيم هذا الحزب ومتفرعاته، لكلفته السياسية الرخيصة، ولنهب الثروات السورية، وإبقاء خيار التقسيم حاضراً ولو على الورق وقابلاً للتنفيذ. ففي أيّ لحظة، وفي الوقت نفسه، عدم الصدام مع روسيا وإيران، وإبقاء رجلهم، أو صبيّهم المريض بشار الأسد في السلطة. وقبل ذلك وبعده، التأكيد على حقيقة بقاء الدولة التركية وحدها إلى جانب الثورة السورية والشعب السوري وقواه الحية في السياق السياسي والعسكري، ثم نزوعها إلى الدفاع المباشر والاستباقي عن مصالحها، المتماهية إلى حد بعيد مع مصالح السوريين ببساطة، كون تركيا تفكر بعقل أكثري غير أقلوي. ولأنها جزء أصيل ومركزي من نسيج المنطقة، تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وفيها حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة، تستمد شرعيتها من شعبها، وتدافع بالتالي عن مصالحه وأمنه واستقراره، ومستعدة دائماً للجلوس أمامه في امتحان الصندوق والقبول بحكمه.
عفرين مدينة سورية مختلطة، سلمها النظام إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) السوري باكراً جداً 2012 في سياق طعن الثورة السورية. إخراج الأكراد من دائرة الثورة إلى دائرة الحياد، وحتى التواطؤ مع النظام، كما رأينا ونرى في الحسكة والشيخ مقصود، والأهم تمثّل بالضغط أو ابتزاز تركيا لوقف دعمها للثورة السورية، والمطالب المحقة والعادلة لهذه الثورة، وإعطاء عفرين إلى ذلك الحزب الكردي يماثل إعطاء مناطق حدودية مع العراق والأردن ولبنان لجبهة النصرة وتنظيم داعش، فيما بعد لزيادة الضغط الأمني على دول الجوار، وتخييرهم بين دعم النظام لاستعادة الاستقرار أو مواجهة الفوضى في أبعادها السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية، مع تدفق موجات اللاجئين الهاربين من جرائم النظام وبراميله المتفجرة.
أما حزب الاتحاد الديمقراطي (بي كاكا السوري) فيمثّل الجناح السوري لحزب العمال
“قوات سورية الديمقراطية” أداة واشنطن لإبقاء خيار التقسيم حاضرًا”
الكردستاني التركي الموسوم إرهابياً في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا، ودول عديدة، وقادته في غالبيتهم العظمى من أكراد تركيا، لا يتحدثون الكردية ولا العربية، قرويون جاؤوا من جبال قنديل، معقل حزب العمال شمال العراق، كما قال ويقول دائماً رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، وكما أقر هيثم مناع نفسه (قناة رداو 15 إبريل/ نيسان 2017)، وهو الذي كان يوما رئيس ما تسمى قوات سورية الديمقراطية، والاسم الحركي لبي كا كا السوري. وللمفارقة، هذا الاسم أيضاً من اختراع المبعوث الأميركي لمكافحة “داعش”، بيرتماكغورك الذي استعان عن سبق إصرار بإرهابيين موصوفين في سورية والعراق، في مواجهة إرهاب “داعش” في سياق استسهال مواجهة العرض، من دون المرض.
مع إطلاق النظام وحلفائه في العراق وحش “داعش” من أجل الوصول إلى معادلة الأسد أو التنظيم، قدّم “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي) نفسه أداة أو عنصرا فعالا في المعركة ضد التنظيم. وهنا استخدمته إدارة أوباما أداة رخيصة بدلاً من الجيش الحر الذي رفض القبول بشروط واشنطن، بعدم محاربة الأسد، أصل المرض، والتركيز على عرض “داعش”. وحشدت واشنطن وراءها العالم في معركة عين العرب كوباني (معظم سكانها ما زالوا لاجئين فى تركيا)، ورفضت التفاهم مع تركيا أو الاعتماد على الجيش الحر. وحتى بشأن البشمركة واستعدادهم لإرسال آلاف المقاتلين لتحرير المدينة، عاندت واشنطن، وأصرت على الاعتماد على “بي كاكا”، لمصالح ضيّقة وآنية ضمن استراتيجيتها لقتال “داعش” في سياق سياستها المنكفئة مع عدم ممانعة تسليم المنطقة للشرطي الإيراني، المتوتر، لملء الفراغ الناتج عن ذلك، شرط الإذعان والخضوع لخطوطها الحمر، ومنها عدم تهديد أمن إسرائيل، وعدم تهديد حرية الملاحة في بحار المنطقة ومضائقها.
تصرفت مليشيات الحزب كالغزاة والغرباء في معركتي منبج والرقة، المتشابهتين تماماً مع معركة الموصل، حيث تدمير المدن على يد الغرباء، وتشريد أهلها لتغيير التركيبة الديمغرافية، وممارسة التطهير العرقي، وذلك كله بحجة محاربة “داعش” والقضاء عليه.
وكان تنظيم “قوات سورية الديمقراطية” أيضاً أداة واشنطن لإبقاء خيار التقسيم حاضرا، ولو نظرياً كما السيطرة على ثروات السوريين في المناطق الغنية بالنفط والثروات الطبيعية، أو نهبها، خصوصا في شرق الفرات، مع بقاء نظام الأسد، ولو ضعيفاً نازفاً مهاناً، مع رفض دعم الثورة أو الدفع بانتصار الكتلة الأكثرية الثائرة في وجه النظام العصابة.
وتقدم مدينة تل رفعت المتاخمة لعفرين، هي الأخرى، أيضاً نموذجا أو فكرة عن طبيعة “بي كاكا السوري” أو حقيقته، حيث تم استغلال غارات الاحتلال الروسي في 2016، والأسلحة الأميركية، ودعم النظام اللوجستي الفج والعلني لاحتلال قرية عربية خالصة مع قرى أخرى محيطة بها، بينما كان الجيش الحر منشغلاً بقتال “داعش”، وهو الجهة الوحيدة التي تقاتل هذا التنظيم الإرهابي، كما النظام أصل المرض وسبب اندلاع الثورة.
وعمد التنظيم (بي كاكا السوري) كذلك إلى استنساخ ممارسات النظام المتضمنة التغيير
“استنسخ حزب الاتحاد الديمقراطي ممارسات النظام في التغيير الديمغرافي والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري”
الديمغرافي والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري وابتزاز المواطنين مالياً، كما إقصاء أي صوت معارض لسياستهم الاستبدادية الشمولية، وخنقه وتغييبه. وبالتالي إيجاد كيان أو سلطة تشبه الأنظمة الشيوعية الساقطة، ولكن هذه المرة وللمفارقة بدعم أمبريالي أميركي، وعلى كل المستويات، حتى مع رفع الحزب شعاراته الشيوعية الجوفاء.
وعموما، لا يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأكراد بأي حال، وهو مستبد متسلط عليهم بالقوة الجبرية والدعم الخارجي، والأكراد أخوة للعرب والأتراك، وكانوا تاريخياً جزءا من الأكثرية الكبرى في الحوض العربي الإسلامي الممتد من ماليزيا إلى طنجة، ومنذ صلاح الدين إلى سعيد بيران وبديع الزمان النورسي وشكري القوتلي ومشعل تمو، لم يتعاط الأكراد بنفس أقلوي، وهم أصحاب مطالب محقة ومشروعة، ولكن ضمن القضية العادلة للشعب السوري، وليس مع أعدائه على اختلاف مسمياتهم وأشكالهم.
وقد استشعرت تركيا، من جهتها، الخطر منذ بداية الثورة، سواء من ممارسات النظام وجرائمه، ورفضه أي تساوق أو تجاوب مع مطالب الشعب المحقة والعادلة. كما استشعرت الخطر من “بي كاكا السوري” و”داعش”، وطالبت بإقامة مناطق آمنة محمية للاجئين والثوار، وواجهت لامبالاة من حلفائها، أو من يفترض أنهم حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومبكراً جداً، طلبت القيادة السياسية التركية من القيادة العسكرية وضع خطط للتدخل، وفرض المنطقة الآمنة بالقوة، لكنها قوبلت بالرفض والتلكؤ والتردد من بعض القادة العسكريين، حتى أن قائد القوات الخاصة السابق، سميح ترزي، يكاد يختصر القصة كلها. كان يفترض به أن يضع خططاً لفرض المنطقة الآمنة، وإجهاض مخططات “داعش” و”بي كاكا” والنظام لطعن الثورة وتركيا في بداياته الأولى منذ العام 2014، لكنه كان فى الحقيقة أحد قادة جماعة فتح الله غولن وأحد قادة الانقلاب الفاشل في 2016، وقتله الجندي عمر خالص دمير، ما مثّل أحد العوامل المهمة في إفشال الانقلاب، وبالتالي عودة القيادة العسكرية إلى وصاية السياسية المنتخبة، كما يجب أن يكون عليه الحال في أي دولة ديمقراطية.
كان إفشال محاولة الانقلاب نقطة مفصلية في تاريخ تركيا الحديث كله، داخلياً وخارجياً، وانعكس مباشرة على السياسة التركية في سورية، حيث باتت القيادة أكثر قدرةً على اتخاذ قراراتها وتنفيذها، فعمدت إلى المبادرة والتمرد على القيود والمحدّدات الأميركية، ووضع واشنطن تحت الأمر الواقع، مع تنفيذ عملية درع الفرات، بعد شهر من تجاوز الانقلاب، العملية التي كانت النموذج الناجح الوحيد في محاربة “داعش”، حيث لا تدمير للمدن، ولا تشريد لأهلها، ولا تطهير عرقيا، وقد أجهزت كذلك إلى حد كبير على فكرة إقامة كيان لـ “بي كاكا السوري”، يمتد على حدودها الجنوبية.
في هذا السياق، كانت عفرين الأمل الأخير للانفصاليين من أجل الربط مع الكيان الشوفيني
“كان الأكراد تاريخياً جزءاً من الأكثرية الكبرى في الحوض العربي الإسلامي الممتد من ماليزيا إلى طنجة”
الاستبدادي في شرق الفرات، وإيجاد منفذ له إلى البحر المتوسط غرباً، ما يعطيه أفضلية استراتيجية في الداخل والخارج. وهذا من أسباب معركة “غصن الزيتون” عفرين، إضافة طبعاً إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الأراضي التركية، والذي كان أحد أسباب أن يسلمها النظام لـ “بي كاكا” لتهديد الأمن التركي وحياة المواطنين في ولايات هاتاي وكليس.
المهم، وكما في نموذج درع الفرات المقابل والمنافس لنموذج منبج وعين العرب والرقة والموصل، سيتم تحرير مدينة عفرين وقراها من محتليها ومستبديها. وبات الأمر مسألة وقت فقط منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”، وسيجري تعميم نموذج “درع الفرات” عليها، وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها في أبعادها وتجلياتها المختلفة، كما حصل في مثلث جرابلس الباب الراعي.
بعد ذلك، سيتم التوجه إلى مدينة منبج (غرب الفرات) التي تحتلها قوات سورية الديمقراطية، ويظهر فيها كذلك وجهه الاستبدادي القمعي البشع والبغيض، وهو أمر محسوم أيضاً، خصوصا مع عدم تنفيذ الوعود الأميركية لتركيا بانسحاب التنظيم منها. وأكثر من ذلك، يجري التفكير جدياً في تحرير مناطق أخرى شرق الفرات من قبضة التنظيم، مثل عين العرب كوباني، تل أبيض، على طريق إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية بطول 120 إلى 130 كلم مع عمق 30 كلم تمنع التقسيم فى سورية، أو تكريس الأمر الواقع، وتقضي في السياق على الفكرة الأميركية بإقامة جيش حدودي لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي، يضغط على تركيا ويعزلها عن عمقها ومصالحها فى سورية والمنطقة.
وكما في “درع الفرات”، فإن عملية غصن الزيتون عفرين أثبتت، مرة أخرى، أن الجيش الحر قوة جدية موثوقة مهنية وفاعلة، ولا يمكن الاستغناء عنها، في مواجهة “داعش” أو ما تبقى منه، أو في الحفاظ على وحدة التراب السوري، وإجهاض المشاريع الانفصالية، تمهيداً للمشاركة الفاعلة في ترسيم مستقبل سورية.
وأكدت عملية “غصن الزيتون” – عفرين كذلك تخلي روسيا عن “بي كاكا السوري”، واعتباره أداة أميركية، لا يمكن التضحية بالعلاقات الاستراتيجية مع تركيا من أجله، وليس ذلك فقط، فإن واشنطن أيضاً تخلت عنه في عفرين، وستفعل ذلك مضطرة في منبج، وستمنعه من الوجود غرب الفرات، والتقوقع شرطيا في المناطق الشرقية التي تراها واشنطن حيويةً ومهمةً، لمصالحها الضيّقة في سورية والمنطقة.
عموماً، أكدت عملية غصن الزيتون – عفرين الدور التركي الإقليمي، وصعوبة تجاهل أنقرة في القضية السورية، أو المستجدات الإقليمية بشكل عام، كما أكدت ثقة القيادة التركية بنفسها على أعتاب عام 2019 الحاسم، ليس فقط لجهة اليقين من تحقيق أهداف العملية، وإنما بعدم التأثر سلباً في الحزمة الانتخابية المحلية الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ظل التأييد الشعبي الجارف والحاسم للعملية، والثقة بقدرة القيادة المنتخبة على الدفاع عن المصالح التركية، والاستقرار الداخلي والإقليمى على حد سواء.
العربي الجديد
تركيا والرهانات الصعبة/ محمد السعيد إدريس
على الرغم من أن عملية «غصن الزيتون» التركية في سوريا التي بدأت يوم 20 من يناير/ كانون الثاني الفائت، توشك أن تكمل أسبوعها الثاني، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها على ما يبدو.
قد يتصور البعض أن الأهداف محصورة بين إخراج ما تسميهم أنقرة بـ «الإرهابيين الأكراد»، وتقصد «وحدات حماية الشعب» التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري من مدينة «عفرين» وجوارها، أو قد تمتد إلى مدينة «منبج» حيث الوجود العسكري الأمريكي، وربما تصل إلى الحدود السورية مع العراق وبالتالي تفرض تركيا سيطرتها الكاملة على شمال سوريا، وهذا بدوره يطرح سؤالاً مهماً: هل تركيا تهدف فقط إلى الحيلولة دون تمكين أكراد سوريا من تأسيس فيدرالية كردية في منطقة غرب سوريا؟
السؤال مهم، لأن له علاقة برهانات القوى التي أعطت ضوءاً أخضر لهذه العملية التركية، وخاصة روسيا وإيران والنظام السوري، إضافة إلى فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة التي تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات التركية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين وجوارها.
هذه الرهانات الحالية في شمال سوريا، تستهدف بالأساس النفوذ الأمريكي والقوى المحلية التي يرتكز عليها هذا النفوذ، أي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و«قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب»، وأن تصعيد المجابهة بين تركيا والولايات المتحدة سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تعميق الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة، ومن ثم حلف شمال الأطلسي، وربما خروج تركيا من هذا الحلف، وبالتالي سقوط الجدار أو البوابة الشرقية لهذا الحلف مع روسيا، ومن ثم فرض السيطرة الكاملة لروسيا على البحر الأسود، وكسر الاحتكار الأمريكي للنفوذ في حوض البحر المتوسط، إلى جانب حرق ما تبقى من الأوراق الأمريكية في سوريا، أي الورقة الكردية.
إنهاء الورقة الكردية في سوريا، هو قوة مضافة لإيران أيضاً، لأن إيران تخشى، كما هي حال تركيا، من الخطر الكردي، وتصفية الحلم الكردي في سوريا سيؤثر سلبياً حتماً على طموحات أكراد إيران، لكن الأمر يمتد إلى طموح بدعم نفوذ الحليف السوري بسقوط الطموحات الكردية، لأن تصفية طموح الأكراد في تأسيس «فيدرالية كردية» في شمال سوريا لن يكون أمامهم من سبيل غير العودة إلى حضن الوطن السوري، ومن ثم إفشال مخطط إعادة تقسيم سوريا، والحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري.
هذه الرهانات مبعثها قناعة مفادها، أن الدخول العسكري التركي الحالي إلى سوريا جاء كرد فعل لإعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 14 يناير الجاري، عزمه تأسيس «قوة أمن حدودية» يجري تشكيلها من «قوات سوريا الديمقراطية» (الكردية) المعروفة باسم «قسد»، للانتشار على الحدود الشمالية والجنوبية وشرق نهر الفرات.
هذه الخطوة الأمريكية كان لها أكثر من دلالة، فهي تعني من ناحية أن واشنطن تسعى من خلال هذه القوات إلى ترسيم مناطق النفوذ التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وعزلها عن باقي مناطق نفوذ النظام السوري التي تحظى بالدعم الروسي والإيراني، وتعني من ناحية ثانية العودة الأمريكية مجدداً لفرض واشنطن لاعباً أساسياً من خلال امتلاك مناطق نفوذ عسكري وسياسي على الأرض من خلال القواعد العسكرية الموجودة في هذه المنطقة، ومن خلال النفوذ السياسي الأمريكي على قوات سوريا الديمقراطية، وتعني من ناحية ثالثة أن الولايات المتحدة قررت عملياً حرمان إيران من تنفيذ مشروع الطريق البري الذي تعتزم إقامته ليربط الأراضي الإيرانية بشاطئ البحر المتوسط عبر الأراضي العراقية والسورية، فمنطقة النفوذ الكردية التي ستسيطر عليها هذه القوات تقطع التواصل الإيراني البري المأمول بين الأراضي العراقية والأراضي السورية، كما يعني من ناحية رابعة أن الولايات المتحدة قررت تنفيذ مشروع تقسيم سوريا، وفرض كيان انفصالي كردي في شمال سوريا.
روسيا تابعت هذه التطورات كما تابعتها إيران، لكن تركيا كان إدراكها مختلفاً، لأنها فهمت منذ اللحظة الأولى إنها المستهدفة.
لكن يبقى السؤال الأهم وهو: هل تركيا تهدف فقط إلى إحباط هذا المسعى الأمريكي؟ أم أنها تخطط لما هو أهم، أي فرض وجود عسكري في شمال سوريا يمتد إلى محافظتي حلب وإدلب بعد تحقيق تواصل بين المناطق المسيطر عليها من جانب المنظمات السورية الموالية، والعمل على توظيف هذا الوجود العسكري التركي كورقة تمهد لإحياء دعوة تركية تاريخية تطالب بضرورة إنهاء العمل باتفاقية لوزان التي سوف تنتهي عملياً عام 2022، نظراً لأن عمر هذه الاتفاقية مئة عام.
هل تخطط تركيا للعودة إلى ما قبل اتفاقية لوزان؟
السؤال مهم، لأن الشواهد تؤكد أن تركيا أعلنت منذ سنوات رفضها لهذه الاتفاقية، باعتبارها اتفاقية مجحفة، وتطالب على لسان منظمات سياسية ومراكز بحوث استراتيجية وعسكرية تركية بعودة كل الأراضي والمناطق التي اقتطعت من تركيا بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية، وكما فرضتها بنود معاهدة لوزان.
الشواهد التي تؤكد جدية هذا الطموح كثيرة. فتركيا لم تعد تعتمد كما كان أيام دعوة «العثمانية الجديدة» على أنواع القوة الناعمة، بل هي تعتمد الآن على القوة الصلبة وتبني القواعد العسكرية من الخليج (قطر) إلى القرن الأفريقي في الصومال والسودان، إضافة إلى نفوذ متسع في القارة الأفريقية وآسيا الوسطى، لذلك فإن رهانات دعم التدخل التركي في سوريا ستبقى رهانات محفوفة بالمخاطر، ناهيك عن أنها رهانات صعبة في ظل الطموحات التركية المتصاعدة.
الخليج
عفرين بين مآلين… حصار بحزام أمني أو عودة لسيطرة الأسد/ وائل عصام
على الأغلب، فإن مآل معركة عفرين يتجه نحو احتمالين اثنين، الأول، هو أن يكتفي الأتراك بحزام أمني يمتد من الحدود التركية بعمق بضعة كيلومترات، لتبقى المدينة البعيدة نحو أربعين كيلومترا عن الحدود بيد الأكراد، وقد يحصل هذا السيناريو في حال زادت كلفة المعركة ومدتها، واشتدت مقاومة الأكراد المتحصنين في الجبال الوعرة، لترتفع في المقابل الضغوط الدولية والأمريكية بالذات، بسبب الخسائر بين المدنيين والانتهاكات، ولعل آخرها التمثيل بجثة مقاتلة كردية بطريقة بشعة من قبل مقاتلي الجيش الحر.
السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا، أن تدخل قوات النظام السوري إلى منطقة عفرين بطلب من الأكراد وتستلم المواقع الحدودية المحيطة بعفرين، ليتولى النظام السوري، بالتنسيق مع الأكراد ضم القوى الكردية المسلحة ضمن أجهزة النظام، ولو بطريقة شكلية، ليبقى للأكراد هامش محدود من الإدارة الذاتية في عفرين تحت خيمة السلطة المركزية في دمشق.
في الحالتين، ستبقى عفرين بعيدة عن سيطرة تركيا، وسيبقى للاكراد قدر ولو محدود من الإدارة الذاتية، خصوصا إن اضطروا لاستدعاء النظام، وهو ما سيحصل غالبا في الفترة المقبلة. وان نظرنا للسيناريو الثاني، المتعلق باستدعاء النظام، فالاكراد طالبوا به قبل أيام في بيان رسمي، فلماذا لم يدخل النظام للآن؟ ما يحدث الان، هو لعبة عض الاصابع بين الاكراد ودمشق، أيهما يصرخ أولا!
النظام السوري لا يريد أيضا ان يزداد التوغل التركي والنفوذ الأردوغاني داخل سوريا، وكذلك إيران، ودعونا نتذكر ما حصل بخصوص قوات تركيا في أربيل، التي ارادت حكومة العبادي ومن ورائها طهران إبعادها عن لعب أي دور في منطقة يكثر فيها المتمردون على بغداد، من سنة الموصل العرب، إلى سنة اربيل الكرد البارزانيين، قبل أن تحسم إيران الأمر عسكريا، لتمكن حلفاءها الطالبانيين. لكن في الوقت نفسه، فإن طهران ودمشق، سعيدتان بالدور التركي ما دام يصب في النهاية لصالح إعادة المناطق الكردية لهيمنة دمشق وضرب الكيانات الكردية الخارجة عن بيت الطاعة الإيراني وحلفائه في دمشق وبغداد.
وهكذا فإن لعبة «عض الأصابع» بين دمشق وعفرين ستستمر إلى حين التوصل لتسوية لدخول قوات النظام، فالأكراد يطاولون في المعركة، من أجل الحصول على أفضل اتفاق ممكن مع دمشق، يبقي لهم الحد الأدنى من صلاحيات الإدارة الذاتية داخل كانتون عفرين، والنظام السوري يستفيد من نيران القصف التركي، كضغط عليهم للحصول على أكبر قدر من التنازلات للحد من صلاحيات الإدارة الذاتية للاكراد، مقابل هيمنة أكبر لدمشق، وهذا كله بتنسيق مع روسيا، التي هي من أعطى الضوء الاخضر لتركيا للدخول في هذه العملية، لتبديد مخاوفهم الأزلية من التهديدات الكردية، لتحقق روسيا هدفين استراتيجيين، اولهما، تمكين النظام السوري من السيطرة على ما تبقى من سوريا، من خلال عملية تركية تؤول محصلتها السياسية لتسليم عفرين للأسد، اما الهدف الثاني فهو بعيد المدى ويتعلق بتهميش الدور الامريكي شمال سوريا، بسحب حلفائهم الأكراد لصف موسكو، بعد إضعاف ثقتهم بقدرة واشنطن على حمايتهم، وهذا ايضا ما تريده طهران، التي تسعى لإبعاد نفوذ الامريكيين من مناطق النفوذ الايراني في العراق وسوريا، وستكون سعيدة برؤية «سلوك طالباني» جديد للاكراد في شمال سوريا!
كاتب فلسطيني
القدس العربي»
هل الدعم التركي للجيش الحر احتلال لسوريا؟/ محمد زاهد غول
ينبغي النظر إلى تحذيرات الرئيس الفرنسي ماكرون لتركيا حول عملية «غصن الزيتون» في عفرين على محمل الجد، والبحث عن دلالاتها وآثارها بعد ذلك، فتحذيره ألا يتحول التدخل التركي بمساعدة الجيش السوري الحر لطرد التنظيمات الارهابية من عفرين وغيرها، إلى نوع من الاحتلال التركي لسوريا، فهذا ليس تحذيراً عابراً، لأن التحذير جاء من رئيس دولة كبرى، وبعد عشرة أيام من بدء عملية «غصن الزيتون».
الحكومة التركية أطلعت فرنسا عن فكرة العملية على أعلى المستويات، بما في ذلك اتصال الرئيس أردوغان بماكرون شخصياً، وكذلك تصريحات عديدة من السياسيين والعسكريين الأتراك، بأن أهداف العملية محصورة بتطهير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية اولاً، وإعادة اللاجئين السوريين من أهل هذه المناطق إليها، وبالأخص المتواجدين في المخيمات في تركيا، بحكم أنهم هم سكانها الأصليون، وليس المحتلين لها من ميليشات قوات حماية الشعب (بيد)، ولا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولا تنظيم «داعش» ولا غيرهم، فالعملية هي هدف للشعب السوري أولاً، ثم هي حماية للحدود التركية من تهديدات التنظيمات الارهابية ثانيا، وهذا يعني أن انتهاء التدخل التركي مشروط بتحقيق العملية لأهدافها السابقة، فلن يبقى بعد تحقيق الأهداف عنصر واحد من الجيش التركي إطلاقاً، لأن الجيش السوري الحر وسكان عفرين هما اللذان سيدافعان عن مدينتهما وقراهما، وهما من سيحكمان مدينتهما عبر مجلس منتخب، وهذا الأمر يعلمه ماكرون وتعلمه الحكومة الفرنسية أيضاً، فلماذا جاء التحذير الفرنسي؟ علما بأن مواقف تركيا وفرنسا متطابقة أو متقاربة حول الحل السياسي المقبل في سوريا.
قد يكون أرجح الاحتمالات هو الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الفرنسي من لوبيات اليمين الفرنسي داخل فرنسا، وهي التي تعادي السياسة التركية عموماً، سواء كانت داخل تركيا أو خارجها، وقد تظن تلك اللوبيات أنها وجدت ضالتها بتشويه صورة تركيا، من خلال التنديد بعملية «غصن الزيتون» في سوريا، أي أنها ليست تصريحات صادقة، بل تتعارض مع التفاهمات التركية الفرنسية حول سوريا. والجزء الآخر من تصريح الرئيس الفرنسي مهم جداً أيضاً، وهو مطالبته تركيا بأن تنسق مع حلفائها حول عملية «غصن الزيتون» في عفرين، وكأن ماكرون يشير إلى التنسيق مع أمريكا ومع الدول الأوروبية الغربية، وليس مع روسيا فقط، وبما أن تركيا لا تعلن رفضها التنسيق مع أمريكا، ولكنها ترفض التعاون الأمريكي مع التنظيمات الارهابية الكردية لتقسيم سوريا، وترفض دعم أمريكا لهذه التنظيمات الارهابية الكردية بالأسلحة التي تهدد الأمن القومي التركي، وفي هذه الحالة وإذا صح أن تحذير ماكرون جاء بضغوط أمريكية، فإنه بذلك يسيء للعلاقات التركية الفرنسية، وهو ما اعتبره وزير الخارجية التركي جاويش اغلو بمثابة إهانة، كما اعتبره ازدواجية في المعايير، فمن يمثل دول احتلال في سوريا هي روسيا وأمريكا، فالجيش الروسي تجاوز الأربعين ألف جندي بكامل معداتهم وقواعدهم العسكرية في سوريا، وكذلك الجيش الأمريكي تجاوز الخمسة آلاف، وأكثر من عشر قواعد عسكرية في شمال سوريا، فلماذا لا تنظر فرنسا إلى هذه الجيوش والقواعد العسكرية الثابتة على أنها احتلال؟
إن أعداء تركيا يوهمون البعض بأن الأهداف التركية ليست في عفرين، ولا في منبج فقط، ولا بسبب التهديدات الأمنية لها، وإنما بسبب أحلام تركية قديمة في سوريا بحسب زعمهم، وبادعائهم أن هذه الأهداف ليست خاصة بأردوغان، بل كانت من أيام اتاتورك ومن بعده، ويستدلون على ذلك بموافقة الأحزاب القومية التركية الحالية على دعمهم خطة الجيش التركي بالتدخل في سوريا، متجاهلين أن أحزاب المعارضة التركية تجمع على دعم الجيش التركي والحكومة التركية في هذه العملية، لأنها مقتنعة فعلاً بالتهديدات التي تلحق بالأمن القومي التركي من جراء تمدد الأحزاب الارهابية الكردية على حدود تركيا الجنوبية أولاً، وبسبب بقاء ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ سوري عبئا على الاقتصاد التركي، مع ما يمثله من تهديد اجتماعي للاستقرار في تركيا أيضاً، والأهم من ذلك أن المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا لم يتعاون مع تركيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم ومدنهم شمال سوريا، بل ساهم في طردهم من شمال سوريا إلى تركيا، لجعلها دولة خاصة بالأكراد، رغما عن إرادة الشعب السوري، وبهدف واضح ولو بعد سنين وهو تقسيم سوريا، ولذلك أغمض الأوروبيون والأمريكيون أعينهم عن عمليات التطهير العرقي، التي تعرض لها العرب السنة من الشعب السوري من هذه الأحزاب الارهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني، فالأحزاب التركية المعارضة تؤيد عملية «غصن الزيتون» لاقتناعها بأن الجيش التركي يقوم بواجبه، وأن الحكومة التركية تقوم بواجبها لتصحيح أخطاء من استهانوا بالإرادة التركية الشعبية والسياسية والعسكرية في السنوات القليلة الماضية، وهم يدعون أنهم حلفاء لتركيا.
هذه هي الحقيقة التي ينبغي للرئيس الفرنسي ماكرون التنبه لها، وكذلك ينبغي لأولئك الصحافيين الذين يشوهون عملية «غصن الزيتون» التنبه لها، ونخص منهم بالنصيحة أولئك الصحافيين الذين يظنون أنهم يدافعون عن الشعب الكردي، أو إنهم من أبناء الشعب الكردي العزيز، فهؤلاء نذكرهم بأن عليهم ان يحسنوا قراءة المشهد الحقيقي للأحداث، فامريكا تحمل على عاتقها اليوم مشروعا مشابها للمشروع البريطاني في فلسطين قبل مئة عام، يوم منحت اليهود وطنا قوميا في فلسطين، لم تكن بريطانيا تملكه، وطردت منه سكانه الأصليين ظلما وحقداً على أهلها، ولتبقى منطقة مشتعلة بالصراعات عقودا مقبلة، وهكذا جاءت مخططات البنتاغون لتمنح الأحزاب الكردية الارهابية وطناً ليس لهم، وعلى حساب طرد أهله منه بمن فيهم الأكراد أنفسهم، ظلما وحقدا على أهله أيضاً، وخدمة لمصالح أمريكا وليس مصالح الشعب الكردي، ولا الشعب السوري، فهو مشروع انتهازي يستغل الأزمة السورية لتقسيم سوريا وزراعة كيان هجين تستخدمه أمريكا قاعدة عسكرية لها، لتنافس به روسيا في سوريا والشرق الأوسط، فلماذا يقبل الأخوة الكرد أن يكونوا أدوات عسكرية أو سياسية بأيدي المستعمرين الجدد، ولماذا تكون دماء الشعب الكردي الزكية ثمنا لتقسيم سوريا؟ ولذلك فإن القوات التركية والجيش السوري الحر لا يستهدفون المواطنين المدنيين في عفرين، ولا يستهدفون الشعب الكردي بسبب قوميته إطلاقاً، وإنما يعملون لإحباط مشاريع استعمارية جديدة تسعى إلى تقسيم سوريا إلى عدة كيانات أو دول.
الشعب السوري تحرك في بداية ثورته 2011 من أجل الإصلاح وليس تدمير بلاده ولا قتل أبنائه، ولكن القوى الاستعمارية الطامعة في سوريا استغلت ضعفه وسعت لإحلال جيوشها فيه، سواء كانت إيران أو روسيا او أمريكا، وأمريكا أعطت الضوء الأخضر لإيران لتخريب سوريا لخلط الأوراق فيها ولمنع سقوط الأسد، وأمريكا دعت روسيا للتدخل العسكري في سوريا، لأنها تريد تبرير إرسال جيشها إليه أيضاً، ومن ثم تبرير بناء قواعد عسكرية فيه، وبقيت تركيا تعترض على كل ذلك لسنوات، ولكنها لم تتحرك حتى أصبح الخطر داخل حدودها، ويقتل شعبها بالعمليات الارهابية التي يتبناها حزب العمال الكردستاني، وتأخرها أكثر من ذلك يعني زيادة الخطر عليها، ورغم تحالف تركيا الاستراتيجي مع أمريكا، ولكن أمريكا لم تسمع التحذيرات التركية، بل خالفتها، فالتحرك التركي ليس لاحتلال سوريا ولا لأخذ جزء من أراضيها، وإنما لمساعدة الشعب السوري والجيش السوري الحر للسيطرة على أراضيه ومدنه وقراه أولاً، ومنع بناء أوكار إرهاب على حدوده ولو بعد سنين، وهذا الأمر، سواء أرضى أمريكا أو فرنسا أو لم يرضهما فلن تتراجع تركيا عن حماية نفسها، فهذا قرار الدفاع عن النفس من الدرجة الأولى، بغض النظر عن مواقف أمريكا أو عواصم الدول الأوروبية، التي من مصلحتها أن تبقى الأراضي التركية آمنة ومستقرة ومزدهرة، وإلا فإن التهديد ليس بعيدا عن الأراضي الأوروبية أيضا.
أما مساعي أمريكا لحصر العملية في عفرين، فسببه أن أمريكا لا تريد أن تفقد الأمل بإمكانية نجاح مشروعها بتقسيم سوريا، ولا بتحقيق أطماعها بإقامة قواعد عسكرية دائمة لها في شمال سوريا، ولذلك ستضع في طريق تركيا والجيش السوري الحر الكثير من العراقيل، وستكون هذه العراقيل في منبج أكبر منها في عفرين، ولذلك يأتي تصريح ماكرون للدلالة على خطورة المراحل المقبلة، وتحمل نوعاً من التحذير الذي يصل حد التهديد من العواقب، ففرنسا كدولة مستعمرة لسوريا سابقاً تعتبر نفسها وصية عليها، وما يهمها أن تبقى سوريا تحت الوصاية الغربية، وليس تحت الوصاية الايرانية ولا الروسية، وتريد من تركيا ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهي تدعم احد أطراف الصراع في سوريا.
كاتب تركي
القدس العربي»
حرب عفرين.. حرب الآثار/ محمود الزيباوي
تحت عنوان “الضحية المنسية للحرب”، أُطلقت منذ أربع سنوات في روما حملة دولية لتوعية الرأي العام في العالم على الأضرار المخيفة التي لحقت بميراث سوريا الحضاري منذ اندلاع الأزمة التي أشعلت الحرب المدمّرة في هذا البقاع في شباط 2011. مع استمرار هذه الحرب، يتعرض هذا الميراث إلى مزيد من الخراب، وآخر ضحاياه موقع تل عين دارة الأثري في منطقة عفرين الذي دُمّر بشكل كامل مؤخرا.
يقع موقع تل عين دارة على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمالي غرب حلب، وسبعة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة عفرين، على الضفة الشرقية لنهر عفرين، أحد روافد نهر العاصي. وهذا النهر معروف بهذا الاسم منذ الحقبة العباسية، ذكره ياقوت الحموي في “معجم البلدان”، وكتب معّرفا به: “نهر في نواحي المصيّصة يخرج إلى أعمال نواحي حلب، له ذكر في الأخبار”. يُعرف هذا الموقع باسم “تل عين دارة”، نسبة إلى قرية صغيرة تُعرف بـ”عين دارة”، ويقع على بعد كيلومترين من هذه القرية، عل ارتفاع نحو 240 مترا عن سطح البحر، ويتألف من قسمين، أحدهما مرتفع، ويسمى المدينة العليا، والآخر منخفض، ويسمى المدينة السفلى، ويحيط به سور تتخلّله عدة بوابات.
بدأ الكشف عن هذا الموقع العام 1954، يوم عثر أحد الرعاة فيه على تمثال لأسد بازلتي. أوفدت “مديرية آثار حلب”، فيصل الصيرفي، لزيارة الموقع، فقصده مع الخبير الفرنسي موريس دونان، وجرت حملة التنقيب الأولى في العام 1956، وتبعتها حملة أخرى في 1962، وثالثة في 1964. في 1976، تولى علي أبو عساف، ومحمد وحيد خياطة، مهمة مواصلة التنقيب في الموقع، وقاما بهذا العمل على مدى عشرين عاما، بعدها رممت بعثة يابانية من “متحف الشرق القديم” في طوكيو آثار الموقع بين العامين 1994 و1995. نُشرت نتائج هذه التنقيبات بشكل علمي، وأثارت الباحثين الذين اختلفوا في تحديد هويّتها وتاريخها، وهذا السجال ما زال مفتوحا اليوم، وذلك في غياب أي شواهد كتابية تسمح بطوي النقاش المستمر.
أهمّ معالم هذا الموقع الأثري، معبد يشغل الربع الشمالي من مساحة التل المرتفع، يتقدّمه الأسد البازلتي الضخم الواقف كحارس بوابة في الناحية الجنوبية. شُيّد هذا المعبد فوق مصطبة كانت في الأصل جزءًا من باحة واسعة كُسيت أرضها بشكل متناوب بألواح من حجر البازلت وأخرى من الحجر الكلسي. يتم الدخول إلى المصطبة عبر مدرج حجري مؤلف من بضع درجات يسلكها المتعبّد بعد أن يتطهر بالاغتسال في حوض الماء القائم في الأصل أمام المدخل. تزين عتبة المدرج الأولى طبعة قدمين بشريتين تتميز بحجمها الضخم، ونجد عند العتبة الثانية طبعة للقدم اليسرى، ثم طبعة لليمنى عند عتبة المصلى، ويشير هذا الترتيب إلى طقوس معينة كان يتبعها كل داخل إلى المعبد، غير اننا لا نملك تعريفاً دقيقاً بهذه الطقوس. يرى علي أبو عساف ان هذه النقوش “تثير العديد من التساؤلات التي تخص الغاية أو الهدف من وجودها، ولا تتوافر لدينا قرائن نعرف في ضوئها السبب في نقشها على عتبتي مدخل المعبد، كما لا تتوافر لدينا نصوص أدبية تخصّ الموضوع، وفي هذه الحال نسمح لخيالنا في طرح بعض الأفكار حول الغاية منها. إنّ أول ما يتبادر إلى ذهننا هو أنّ هذه الأقدام الكبيرة بمقاييسها غير البشرية قد ترمز إلى دخول الرب إلى المعبد ووجوده فيه أو تحدد كيفية الدخول إلى المعبد، فعلى الداخل أن يقف على العتبة الأولى ليردد بعض الأدعية والتراتيل الدينية ثم يخطو بالقدم اليسرى، فيدخل المصلّى بالقدم اليمنى”.
يُجمع أهل الاختصاص على القول بأن المعبد يعود إلى مراحل عديدة. في البدء، شيّد البناء فوق مصطبة أقدم، وفي مرحلة ثانية شُيّدت مصطبة أخرى وهيكلاً جديداً، وأُضيف رواق خاص بهذه المصطبة في مرحلة ثالثة، كما جرى تسوير المعبد بسور خارجي. يتبع هذا المخطط الهندسي طرازاً معروفاً بـ”المعبد البيت”، وهو طراز المعبد ذي الغرفة الأمامية التي تسبق المصلّى، وهذا الطراز معروف في العالم الآرامي، ولا نجد ما يماثله في المعابد الآشورية والبابلية، كما اننا لا نجده في معابد الإمبراطورية الحيثية التي شملت الأناضول وجزءًا كبيراً من شمالي غرب الهلال الخصيب. من هنا، يمكن القول إن هندسة بناء معبد عين دارة تنتمي إلى تقليد سوري محلي، وهو تقليد قديم استمرّ على عدة عصور، وتبنيّه لا يسمح بتحديد تاريخ البناء. على العكس، تزين هذا المعبد مجموعة كبيرة من التماثيل والنقوش المجسّدة تنتمي إلى الفن الحيثي بشكل لا لبس فيه. أشهر هذه التماثيل هي تلك التي تحتل الواجهة الخارجية للمصطبة، وتمثل اسودا مجنحة لها رؤوس آدمية تعلوها ضفيرة مزينة بوردة في وسطها. من حيث الأسلوب الفني، تتبع هذه الأسود طرازاً ظهر في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وتعود على الأرجح إلى المرحلة النهائية من تشييد البناء. تشكل هذه الواجهة سدا للمعبد الذي حوى أنصابا ونقوشاً أخرى تمثل آلهة يُصعب تحديد هويّتها بدقّة، وهذه الصور حيثية بالدرجة الأولى، وليس لها أصول سورية، بمعزل عن هويّة أصحابها.
على الصعيد الزخرفي، اعتمدت حلّة المعبد طريقة محلية خاصة في استخدام الحجر الكلسي والألواح البازلتية لا نجد ما يماثلها في معابد الأناضول. اعتُمد الحجر الكلسي لتبليط الأرضيات والعتبات، واعتمد الحجر البازلتي لنقش الزخارف التصويرية، وقد ظهر هذا الأسلوب في موقع آخر اكتُشف في نهاية القرن الماضي داخل قلعة حلب، ويُعرف باسم “معبد إله العاصفة”. مثل معبد عين دارة، يعود هذا المعبد إلى حقب عمرانية متعددة، وتتميّز حلّته النحتية بطابعها الحيثي، وأهم شواهدها سلسلة من الألواح الجدارية البازلتية المنقوشة تصطفّ على جداره الشمالي.
في الخلاصة، يتضّح أن بناء المعبد ينتمي إلى تقليد محلي إقليمي عاش طويلا، وهو التقليد الذي اتّبع في بناء هيكل سليمان، بحسب ما جاء في الإصحاح السادس من”سفر الملوك الأول”. على الطرف النقيض، حوى هذا المعبد نصُباً وصوراً منقوشة بدت حيثية بامتياز، وغاب عنه الأثر السوري المحلي. وهذا “التناقض” يدعو إلى القول بوجود المعبد في حقبة سبقت نحت أولى التصاوير الناتئة بزمن طويل، والأرجح أنه يعود إلى عصر البرونز الوسيط. في زمن امتداد الإمبراطورية الحثية إلى شمال سوريا، أو في الحقبة التي تلت انهيارها، جُدّد هذا المعبد بشكل كبير، وزُوّد بتماثيل وصور جديدة تماثل تلك التي نجدها في المعابد والهياكل الأناضولية، ولا ندري إن كان روّاده من الأناضوليين الذين استوطنوا هذه البقاع، أم من السكان المحليين الذين تبنّوا الثقافة الحيثية بعد انتشارها.
كما في”معبد إله العاصفة” في قلعة حلب، يجمع هذا التزاوج بين الميراث المحلّي والتقاليد الأناضولية، ويشكّل انطلاقة لما يُعرف بـ”الفن الحيثي الحديث” الذي طبع العمارة الدينية المشرقية اللاحقة في جنوبي شرق الأناضول وشمالي المشرق، وقد اتبع النبي سليمان كما يبدو هذا النهج حين شرع في بناء الهيكل في السنة الرابعة من حكمه.
دُمّر موقع عين دارة بشكل كامل خلال الحرب الدائرة في منطقة عفرين، ولم تسلم تماثيله ونقوشه من هذا الدمار. ونخشى أن يلحق هذا الخراب المتواصل بمواقع أخرى مجاورة مدرجة على لائحة “التراث العالمي”، منها ثلاثة في “جبل سمعان” حيث تحتدم المعارك حاليا، وخمسة في محافظة حلب.
المدن