الحشّاشون.. من آلموت إلى الضاحية الجنوبية وغزة وجبل قنديل/ محمد ديبو
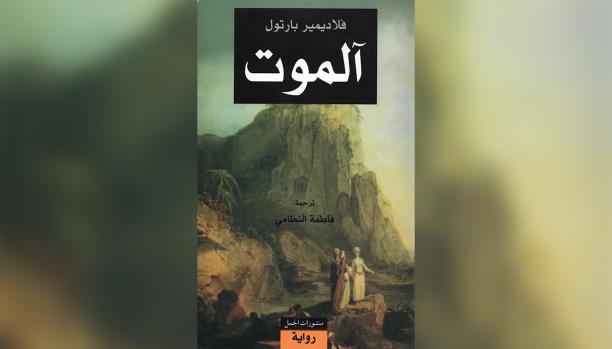
تفتح قراءة رواية “آلموت” للكاتب فلاديمير بارتول، اليوم، على ضوء أحداث الراهن العربي والعالمي، الوعي على أسئلة جديدة تمتحن أفكارنا، تبدأ من الاجتماعي الاقتصادي، ولا تنتهي عند السياسي الفكري، وأيضا أسئلة مهمومة بآلية وكيفية تشكل الجماعات والإيديولوجيات المحتفية بالقتل والموت، إذ لطالما كان التاريخ مسرحا لهذا النوع من الجماعات، ولا يزال الحاضر يقدم لنا ما يفوق خيالنا من الإجرام والكذب والتزوير. وما برز على سطح الأحداث منذ بدء الربيع العربي يقدم أمثلة كثيرة، ليس عن هذه الجماعات فحسب، بل عن وعينا المشوّه بها أيضا، إذ كانت الثورات في أحد جوانبها ثورة على أفكارنا ومفاهيمنا التي كنّا نظنها ثوريةً، فتكشّف كثير منها عن خواءٍ لم يصمد أمام امتحان الواقع وتحولاته، الأمر الذي يفرض علينا حتمية النقد الذي يصل إلى حد تعرية الذات وقلب أحشائها بمباضع الجراحة النقدية، لنسائل أنفسنا عن سر احتفائنا بالموت وتقديسه في ما سبق، تحت أسماء كثيرة، تبدأ من المقاومة، ولا تنتهي عند القضية والحرية وغيرها من “القضايا” التي خلقنا على تقديسها، وكأننا نقدّس السكين التي تعدّ لأعناقنا.
تفتح رواية “آلموت” باب المقارنة بين تنظيم الحشاشين الذي أسسه الحسن الصباح آنذاك وسيلة لتحقيق طموحاته السياسية، وتنظيمات اليوم الكثيرة والمتناسلة، بدءا من حزب الله وحركة حماس وحزب العمال الكردستاني، وليس انتهاءً بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما. تلك التنظيمات التي تحتفي بالقتل وتمجّده باعتباره المعنى الأهم، فهو (القتل أو الموت) أداة ومعنى هنا، أداة لتحقيق أهداف هذه الجماعات بالانتصار على العدو، وهو معنى بحد ذاته، لأنه يعطي القتيل الراحة الأبدية، إذ يصل إلى الفردوس عند الجماعات الدينية، فمن يحصل على لقب الشهيد أو الرمز أو الأيقونة عند الجماعات اليسارية والعلمانية يغدو حيا بطريقة أخرى، أي عبر الخلود!
تعتمد تلك الجماعات على عملية صناعة الوعي من الصفر، أو العمل على استبدال منظومة فكرية بأخرى، لدى أتباعها الذين ينضمون إليها في سن الشباب، فيما تتكفل آلتها الإعلامية وقوتها الجبرية في احتواء الأطفال، لتكوين عقولهم وفق ما تريد، عبر عملية بناء متسلسلة. إنها عملية أشبه بهندسة اجتماعية متكاملة، صناعة من نوع خاص، لا يقطف ثمارها إلا
“تفتح رواية “آلموت” باب المقارنة بين تنظيم الحشاشين الذي أسسه الحسن الصباح وسيلة لتحقيق طموحاته السياسية، وتنظيمات اليوم الكثيرة والمتناسلة” الصبورون، ولكن الممتلكون أفكارا شيطانية مجبولة بأفكار عن الخير والعدالة والكرامة، إلى درجة تضيع معها الحقيقة في جبال التأويلات التي تبدو متعمّدة هنا لتحصين الذات وإشاعة البلبلة، أوَليس هذا ما يحصل في حواراتنا اليوم عن حزب الله وحماس وحزب العمال و.. بين من يقول إننا إزاء مقاومة في ما يقول آخرون إننا إزاء أحزاب شيطانية أو استبدادية أو… من يملك الحقيقة هنا؟ وحتى الحقيقة إن امتلكناها اليوم فعلا، فإنها لا تعفينا من عدم معرفتها في اللحظة التي كان يتوجب علينا معرفتها بها، أي قبل أن يقع الفأس في الرأس. ونعني بذلك أنّ كثيرين منّا كانوا يتعاطفون سابقا مع حزب الله وحركة حماس باعتبارهما مقاومة، وحتى حزب العمال الكردستاني الذي كان ينظر له حزبا يساريا يحمل قيم المقاومة والحرية والنضال، إذ جرى التحوّل، في وعي الغالبية منا، بعد الربيع العربي الذي كشف جوهر هذه التنظيمات وآليات حكمها، ليغدو السؤال: ما نفع معرفة الحقيقة بعد أن يكون فات وقت الاستفادة من معرفتها، أي بعد أن تمكّنت هذه التنظيمات من تحقيق مرادها وتحطيم آمالنا وأحلامنا؟ والسؤال الأهم: كم من حقائق نظنها اليوم “الحقيقة” فيما هي ليست أكثر من وهم مخاتل؟ وكيف يمكن ألا نلدغ من جحر مرتين؟
نحاول مقاربة الإجابة عمّا سبق، من خلال المقارنة والبحث عمّا يجمع تلك المجموعات عبر التاريخ، إذ ما الذي يربط بين تنظيم الحشاشين وحزب الله وحماس وحزب العمال الكردستاني أو حتى الحزب القومي الاجتماعي وحزب البعث وغيرها من الأحزاب الشمولية الطابع، بما فيها المقاومات التي لا شك بصوابية رؤيتها تجاه قضيتها؟
اعتمد الحسن الصباح، في المقام الأول، على المظلومية التي يتعرّض لها أبناء جلدته الإسماعيلون، فبنى أفكاره الخاصة عن الظلم والخلاص (النظرية)، ثم نشر تلك الأفكار وبدأ العمل على تنفيذها في آلموت (التطبيق)، ليجمع بين الدهاء والذكاء والخبث، بين التعليم الذي يتلقاه المريدون، حيث يتم غسل أدمغتهم بامتلاك الحقيقة دون سواهم، إلى أن يصلوا إلى قناعة بأنّ كل معرفة غير التي يمتلكونها هي ضلال، وأنها (معرفة الآخرين) مصممة لتضليلهم، أي مؤامرة بلغة العصر، لنصبح أمام سد معرفي أمام أية معرفة دخيلة، فتتحصّن الذات داخل كهوفها، ثم تأتي مرحلة التدريب العسكري، ثم تأتي مرحلة الوعد بالخلود والفردوس، وهي التي أعد لها الحسن الصباح خطة جهنمية، إذ كان يأخذ مريديه في رحلة إلى الفردوس، وهي حدائق واسعة وجميلة، في الفناء الخلفي للقلعة، تشبه الفردوس أو تقاربه، ليقضي المريد يوما بين العذارى، ويعود أكثر رغبة بالموت، سعيا إلى العودة إلى الفردوس، إذ يصبح الموت معنى الحياة هنا، يطلبه المريد أكثر من قادته الذين علموه ذلك.
تأمُّل ما سبق، ومقارنته مع ما تقوم به حركات، مثل حزب الله وحماس و.. يُبيّنان أنها في الجوهر تعتمد الأسلوب نفسه مع اختلاف الأدوات والتنفيذ، إذ لكل منها قضية مظلومية، يتم الاستثمار فيها وبناء نظرية حولها (ولاية الفقيه في حالة حزب الله، الحاكمية لله والحوريات والجنة في حالة التنظيمات الجهادية، مضافا لهما المقاومة في حالة حماس، قيمة الشهيد ومعناه وخلوده في حالة الحركات اليسارية…)، لتتم بعدها صناعة وعي الجماعات بتلك الأساطير التي تهيّئ وتجهز المريد أو المناصر للموت، فيغدو موته أسطوريا، أو محققا لمعنىً أراده: الجهادي في حالة حزب الله، الاستشهادي في حالة حماس، الانتحاري والذئب المنفرد في حالة التنظيمات الجهادية، الشهيد في حالة المقاومات كلها… هنا يغدو طلب الموت والسعي إليه غاية بحد ذاتها. وهنا ثمّة فارق كبير بين أن تموت وأنت تقاوم وأن تعتبر الموت بحد ذاته مقاومة، أي أن تذهب إلى الموت طائعا مختارا، بحثا عن رسالةٍ ما لتترك الحياة بكل ما فيها. وهذا
“عملية أشبه بهندسة اجتماعية متكاملة، صناعة من نوع خاص، لا يقطف ثمارها إلا الصبورون” الأخير لا يصل إليه المرء، إلا بعد أن يكون “صُنِعَ عقله” في مخابر الموت هذه، إذ تغدو أفكار الحشاشين وولاية الفقيه والحاكمية لله واللينينية الثورية والأوجلانية وأفكار أنطون سعادة بمثابة الإيديولوجيا الغاسلة لدماء مناصريها، أي تتحول إلى دين لا يأتيه الباطل، فيغدو المؤمن بها قابلا بقدره. وهي حتما لكي تحقق ذلك، لا تقبل الاعتراض، فالنص لا يُناقَش، ثمّة مقدسات وبديهيات، تستمد قداستها من أنها كلام الله في التنظيمات الدينية، وكلام المؤسس (الأب القائد) في التنظيمات الدنيوية. وهنا يغدو المناصر رافضا تلقائيا لما هو خارج نصوصه، فالحقيقة لديه وحده، وطريق الله أو القضية لديه وحده، والقائد وحده من يفهم الدروب، وهذا ما يفسر إيمان هؤلاء بأن طريق القدس يمر من جونيه لدى المقاومة الفلسطينية سابقا، فيما يمر اليوم من القصير وحمص وحلب في حالة حزب الله، بينما تتحقق الأمة السورية بالقتال في سورية إلى جانب الدكتاتورية لدى أنصار الحزب السوري القومي، وأيضا تتحقّق أفكار أوجلان بالوقوف إلى جانب نظام الاستبداد السوري، على الرغم من أنه هو ذاته من سلم قائدهم أوجلان إلى تركيا سابقا! هذه المتناقضات التي لا تستقيم مع عقل يملك الحد الأدنى من التفكير، لا يمكن تفسيرها إلا باعتبار أن معتنقيها يملكون وعيا دينيا، وليس هناك أكثر من كون “الدين أفيون الشعوب”، كما يقول كانط.
ينطبق هذا على اليساريين والعلمانيين، فكما لدينا أصولية دينية لدينا أصولية يسارية، وهذا ما يفسر لنا أن كل هذه التنظيمات شمولية لا تقبل أي اختلاف معها في الرأي، ولا تسمح بأي اعتراض في المساحة الاجتماعية التي تحكمها. التدقيق في تجربتي حزب الله في الضاحية الجنوبية والجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني في سورية، ونعني حزب الاتحاد الديمقراطي، ستقودنا إلى تشابهٍ كامل، فنحن أولا إزاء بيئاتٍ شبه “متجانسة” فكل من هو خارج الملة أو العرق غريب، وإن وجد فهو ليس أكثر من ديكور لإظهار “تسامح” الجماعة أو “ديمقراطيتها”، أي مجرّد أداة، ناهيك عن أن هذه الجماعات هي الأكثر بطشا بمناصريها، فالعلاقة مع المحكومين تقوم على الخوف والطاعة، ولعل ما جرى في حي السلم أخيرا أبرز دليل على ذلك، وما يجري في مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث يساق من هم دون السن القانوني، وبالإجبار لخدمة “القضية”… التشابه بين تجارب هذه الجماعات وتجارب الدكتاتوريات مذهل، بدءا من آلياتها وليس انتهاءً باحتفائها بالموت وتعميمه نموذجا للحياة. إنها دكتاتوريات حاكمة في مناطقها الصغيرة، فهي باسم القضية تحتل مناطقها تلك، وتفرض قوانينها وسلطتها، من دون أن تسأل نفسها: من أعطاها هذا الحق؟ ولأنها تدرك أنها تمتلك حقا ليس لها، يكون القمع أحد أدواتها للإمساك بمناطق نفوذها.
ليست المظلومية وحدها ما يتم استغلالها وتطويعها لخدمة ما تريده تلك الجماعات، بل الفقر
“فارق كبير بين أن تموت وأنت تقاوم وأن تعتبر الموت بحد ذاته مقاومة” والوضع الاجتماعي والطبقي المتدني، إذ يلاحظ أن تلك الجماعات تنجح حصرا في البيئات الفقيرة والمتدنية التعليم، حيث يتم تقديم “الكرامة والمكانة” عبر إيهام الأنصار بالانتماء إلى مكانٍ أرقى اجتماعيا وإنسانيا، والخبز الذي يحتاجه هؤلاء وأيضا التعليم وغيرها من الخدمات التي تعجز الدولة عن توفيرها في تلك المناطق. وهنا تسعى تلك الجماعات إلى التحول إلى “رب عمل” لمؤيديها، لتتمكّن من إدارة تلك المجتمعات عبر العصا والجزرة، فمن يخرج عن الطاعة لن يجد قوت يومه. وعلى من يخطئ الاعتذار العلني أو مواجهة النبذ والنفي، والموت إن كان يشكل خطرا حقيقيا على الجماعة.
مهما اختلفت أوصاف الموت فهو موت، وصنّاع الموت يغيّبون الحياة ويدعون إلى اعتبارها مجرد زيف، وأنّ القضية، كل القضية، تكمن في الموت، فيما القضية الحقيقية هي الحياة، وهذا ما يسعى لقتله فينا صناع الموت هؤلاء.
ما يجري هنا صناعة متقنة، يتم العمل لها بتخطيط ودهاء، وعن سابق تصميم وإصرار، لتحقيق أهداف سياسية وجهنمية لأصحاب تلك القضايا الخائبة أو المجنونة، من دون أن ننسى أن الكثير من تلك القضايا بدأ نبيلا حقا، لكنها إذ تحتفي بالموت بتلك الطريقة تتحول، مع الزمن، إلى مجرد قتل لمجرد القتل، أو قتل لتحقيق أهداف غير عادلة، إذ يغدو الخير أو العدل أو المقاومة أو الظلم الواقع على فئة معينة من الناس مجرد مطية للشر ليتسيّد، إذ لا أحد يجادل بأن الشيعة في لبنان كانوا مظلومين ومضطهدين وجياعا، وأن العلويين في سورية كانوا منفيين في الجبال والفقر، وأن الفلسطينيين مظلومون والمقاومة حق لهم، وأن اليهود في أوروبا تعرّضوا لأبشع أنواع الظلم، وأن تاريخ الكرد ليس إلا عنوانا بارزا للظلم والاضطهاد… ولكن كل هذه القضايا المحقة، حوّلها أولئك إلى مجرد مطية لأطماعهم وأغراضهم، وبأبشع الأشكال والصور، إذ يحتاج هؤلاء للضحايا ليتم شحنهم وتعبئتهم بإيديولوجيا الموت هذه، ليتم تحويلهم إلى آلة قتل متنقلة، بعد أن يتم تعطيل عقولهم بالوعود الكاذبة. إلا أن السؤال الأبرز هنا: لمَ يبدو هؤلاء قابلين لهذا الدور الذي يؤدونه في آلة القتل، على الرغم من أنهم فقراء و”معترون وغلابة”، كما رأينا في احتجاجات الضاحية الجنوبية أخيرا، والتي وأدها بطريقة “إجا ليكحلها قام عماها”؟
يجعلنا تأمل التاريخ من هذه الزاوية أمام سؤال تراجيدي: هل يكرّر التاريخ نفسه حقا بألوان متعدّدة؟ وهل يقع البشر دوما ضحايا لهذه العقول المجرمة؟ ولمَ لم نتمكّن، نحن البشر، على امتداد هذا الكوكب من إيقاف هذا القتل باسم الدين أو الإيديولوجيا أو الوطن أو الكرامة أو السيادة أو؟ والأهم: من يضمن لنا اليوم أنه ليس بين أفكارنا عن الثورة والحرية والعدالة، وكل ما ندافع عنه شيئا شبيها بذلك؟
العربي الجديد


