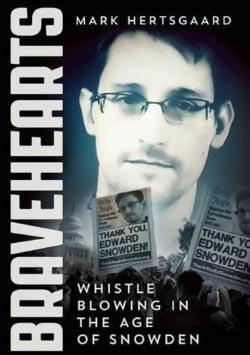آلام النساء في الثورة السورية/ جولان حاجي

“الى أن قامت الحرب – نساء في الثورة السورية”، كتاب يصدر قريباً لدى “دار رياض الريس للكتب والنشر” في بيروت، ويروي شهادات ميدانية لنساء شاركن في الثورة السورية السلميّة، التي تمتد من بداية الثورة السورية في منتصف آذار 2011 حتى انقلابها حرباً ليس لبدئها تاريخٌ متفق عليه. فمنظمة “استيقظت” أجرت ستين مقابلة بين ربيع 2011 وربيع 2013، مع ستين سيدة، فاختيرت من بينها سبع عشرة مقابلة، ثم أعيدت كتابة أجوبتهن وشهاداتهن، كل شخصية على حدة في مقاطع طويلة.
الراويات أو الشهادات هي لناشطات نسمعهن يتحدثن عن مناطقهن، والمجازر التي وقعت فيها، وعن القصف والتدمير والذين ماتوا. يجد القارئ كيف تروي المرأة تصورها عن الثورة التي شاركت فيها تدريجاً. النساء مختلفات، وقد توصف بعضهن بأنهن محافظات أو متزمتات أكثر من سواهن، غير أنهن جميعاً يشتركن في مزيّة واضحة هي الشجاعة، وقد أحسسن عند انطلاقة الثورة بوجوب المشاركة فيها. لكنهن لم يكنّ واثقات مما يمكنهنّ القيامُ به، فنراهن يبدأن بالتفرج على التظاهرات من شرفة البيت أو الطرف البعيد للشارع. وهنّ يشعرن غالباً بأن إنسانيتهن منقوصة، ولا يقمن بما يجب عليهن القيام به. ثم بدأن الخروج ببطء. فقوبلن بالممانعة خارج البيت أيضاً. أراد الرجال حمايتهن تحت مسمّى الشرف، وغالباً ما أيّدت النساء الأكبر عمراً وجهة النظر هذه المتعلقة بالشرف. أما الشابات فأبدين الضيق وعصين أحياناً فكرة الطاعة المطروحة والمفروضة عليهن. توسل الرجال إليهن، وكادوا يقبّلون أيديهن لكي يعدن إلى البيوت ويلازمنها، لأنهم يعرفون أن “هذا النظام لا يخاف الله”. كانت الهواجس المهيمنة على الرجال تجاه النساء هي تعرضهن للقتل والاعتقال والاغتصاب.
الثورة ضد القبح
بينهن محافظات وعلمانيات (كما يصفن أنفسهن)، وبينهن ناشطات سياسيات، لكنهن جميعاً يشتركن مرة أخرى في نقطة واحدة: لقد أحسسن جميعاً بأن هناك لحظة قد حانت وعليهن الدخول والانخراط فيها، فيفصحن عنها قائلات إنهن كنَّ في حاجة إلى اللحاق بالثورة والانغماس فيها، ويستخدمن عبارات جميلة في وصف هذه الضرورة أو هذا النداء، فتقول إحداهن: “كنتُ أخرج في التظاهرات بكامل أناقتي مرتديةً أجمل ثيابي، فالثورة قامت أيضاً ضد القبح، ثم سرعان ما تنقضي ساعة التظاهرة، كمثل كل حالات الجمال، بلمح البصر”.
بعض النساء اللواتي نقرأهن، اعتُقلن مرة واحدة على الأقل خلال الثورة، ويشهدن على الآلة الساحقة التي شُنَّت بها الحرب على المدن والأحياء، وقد رأين هذه الآلة واختبرنها من داخلها. بالدخول إلى صميم هذه الآلة الجهنمية نصادف منظوراً آخر. فالنساء اللواتي واجهن النظام وتحدّينه، اعتُقلن وأمضين أوقاتاً متفاوتة في مساحات السجون الشديدة الضيق. نسمع آراءهن، وكيف يرين الأمور بعين مغايرة، حتى لو كنّ غائبات عن ساحات القتال.
يقظة الالم
لطالما تداولت الأحاديث طيبة السوريين أو سذاجتهم. لم يكونوا سذّجاً، كانوا بالأحرى أبرياء، ومدركين فداحة الأكلاف إذا ثاروا، ويعلمون أن النظام سيستميت في الذود عن نفسه. كانت التبعات معلومة لأغلبية السوريين، ومع ذلك لم يفتقروا إلى البراءة. كانت الثورة في البداية احتفالاً بانبعاث المجتمع السوري الذي وصفته إحدى الشهادات بإنسان “مشلول شللاً رباعياً طوال خمسين عاماً، يعيش ويتنفس فقط، ثم أيقظه الألم”.
الكتاب من مستهله إلى ختامه يروي كيف كان الألم نائماً في سوريا التي استيقظت على الآمال والكوابيس. يرى القارئ في هذا الكتاب الفقر والإهمال والفساد والسجناء السياسيين وكلَّ ما أدّى إلى هذه اللحظة التاريخية التي أدهشت كثيرين وترقّبها كثيرون، لكنها ظلت معلقة كنوعٍ من الرجاء أو الأمل الذي لا يتحقق. انها رحلة لاكتشاف الذات تنتهي بمأساة. تنتهي المقابلات في ربيع 2013، مع ذلك تتحدث كل امرأة عن المأساة قائلةً إنها كانت أمراً لا مفر منه. المأساة شخصية وجمعية في آن واحد. لقد نُكبن وفُجعن بأهلهن وخسرن بيوتهن وبلدهن وتشرّدن في المنافي. المرارة والحزن طاغيان لدى بعضهن، بينما أخريات مرتابات، لكنهن جميعاً مختلفات بعد كل ما جرى. هناك الألم الشخصي، والألم الجمعي، وهناك الخيبة والإحباط.
القسوة ووفرة الموت
لقد أحسسن بتخلي الجميع عنهن. أولاً، معظمهن لم يؤمنّ بالمعارضة السياسية ولا يتوانين عن انتقادها بدرجات متفاوتة. ثانياً، انتابهن الاشمئزاز حيال الطبيعة الانتهازية لبعض الأشخاص في أوقات الحروب والأزمات وكيف يطمعون في الاغتناء عبر عذابات الآخرين وبؤسهم. ثالثاً، هنّ أنفسهن يخشين أن القسوة قد تمكّنت منهنّ ككائنات إنسانية، لأنهن قد رأين الموت، ولأن الجميع قد صاروا قساة إثر وفرة الموت الذي شهدوه والفظاعات الكثيرة التي مروا بها، فتصف إحداهن ميتاً ملقى على قارعة الطريق “مغطى بقطعة من الكرتون، والعابرون يرونه من دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه”. إنهن يشعرن، ولا سيما النساء المقيمات في المناطق التي تدور فيها المعارك، بأن الوحش قد تكاثر واستشرى.
السؤال الكبير الذي يطرحه الكتاب هو: ما هي المرأة؟ القسم الأول يقدم مجتمعات من الممكن وصفها بالمحافظة في ريف دمشق، عبر مدن وبلدات هي: داريا، الزبداني، دوما، حرستا، جسرين، التل، القابون.
البندقية والدراجة
صاحبة إحدى الشهادات من دوما، نشأت في بيئة متزمتة، لكن والدها كان يسمح لها بركوب الدراجة الهوائية في طفولتها بينما هو يتبعها بسيارته (ثمة سمة مشتركة بين الراويات هي حب آبائهن لهنّ والحرية التي منحوهنّ إياها. للعديد من هؤلاء الآباء مواقف سياسية معارضة، وكانوا المصادر التي استقت منها النساء معرفتهن الأولى بالنظام). السيدة التي في دوما تزوجت في عمر مبكّر، وانزوت في منزل زوجها. بقيام الثورة انتابها دافع يلحّ عليها بالخروج والمشاركة في ما يجري في الشارع، وهذا ما فعلته. عند ذهابها مع نساء أخريات إلى مجلس عزاء لشهداء دوما فوجئن بأن الرجال أحضروا لهنّ الكراسي وقدموا القهوة المرّة، بينما كنّ يخشين أن يمتعض الرجال من حضورهن.
تستشهد إحداهن بمثل شعبي: “إن المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات: من بطن أمها إلى بيت أبيها، ومن بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى القبر”. إنهن يَعيْنَ السيطرة والقيود المفروضة عليهن وقسوة المجتمع ووقوف القوانين أيضاً ضدّهن. فاللواتي طلبن الطلاق يعرفن جيداً كيف يعترض القانون طريقهن، ويلمسن الظلم وعدم المساواة. العديد منهن يعتنقن الإسلام كديانة يرَيْن فيها الحق والجمال، ويعلمن أن المساواة مع الرجل غير ممكنة، فتقول إحداهن بالتكامل مع الرجل. إثر الثورة تتساءل بعضهن: هل نحن مكملات للرجال؟ ما هي الحدود؟ هل ممارسة الجنس ممكنة؟ لقد أفضت الثورة وأحلام الحرية إلى ألم جديد، حيث النساء تراودهن الأسئلة المرتبطة بالعادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات، وقد يبدأن بالتفكير وحدهنّ كنساء مستقلات.
اللافت أن هذه الاستقلالية ملحوظة أكثر لدى نساء الأرياف، وسط اللواتي خرجن يتظاهرن بعدما تخطين الحدود المرسومة للجندر، وخرجن بذلك على سلّم القيم المهيمنة وسكون الأعراف الاجتماعية وسطوتها. إنهن يسائلن الوضع الراهن القائم ورسوخ البديهيات، سواء في أنفسهن ومجتمعاتهن أو في المجتمع السوري كله. ثمة ألم يساورهن: ألمُ أن يكنَّ نساء، وما تنطوي عليه هذه العبارة من آلام أخرى.
لدى قسم آخر من النساء المشاركات في الكتاب إيمان أعمى بأن النساء يكملن الرجال، تالياً لا يمكنهنّ أن يتوقّعن منهنّ ما يتوقعنه من الرجال في شتى المجالات. إحداهنّ، مقتنعة بأن النساء غير قادرات على حمل السلاح، بينما ترى امرأة كردية في نهاية الكتاب أن حمل السلاح واجب على النساء، وإلاّ بقين في الصفوف الخلفية.
ما المرأة وما الرجل؟
بعضهن يتساءلن: لماذا يستطيع الرجل ممارسة الجنس خارج الزواج، بينما أنا لا أستطيع؟ ما هي المرأة وما هو الرجل؟ ما هي حدودي وإلى أي مدى يمكنني الخروج عنها وتجاوزها؟ أين هي هذه الحدود؟
من السذاجة توقع الخروج المفاجئ للمرأة، فالنساء يختلفن وتتباين ظروفهنّ، لأنهن لا يشغلن المكان نفسه في الحياة، وليست لهن العقلية نفسها. لكل امرأة كفاح مختلف وتجارب مختلفة لا تشترك فيها بالضرورة مع الأخريات. ثمة امرأة تستهجن ما يسمّى الـ”بوي فراند”، بينما يُعثَر في حقيبة امرأة أخرى على واقٍ ذكري عند اعتقالها، فيخبرها العميد بعد انصراف والديها، أن أمها تريد مكالمتها بالهاتف، وتسألها: “ماذا فعلتِ؟”، فتجيب الابنة: “رأيت بعينك قبل أن تنصرفي”، فتردُّ الأمّ: “لا أقصد تلك القصة [الاعتقال]، أعني الشيء الذي وجدوه في حقيبتك”. هكذا تحوّل الواقي الذكري إلى القضية الأساسية وأنسى الأهل مسألة التوقيف برمتها.
تصلح هذه الحادثة الصغيرة كمثل عن القوانين المعطَّلة، أو التي عفا عليها الزمن. لكن يمكن استخدامها من جديد، لأسباب أخرى على الأرجح. فالفتاة الموقوفة، عند اعتقالها في مخفر الشرطة إثر توزيعها منشورات تنادي بإسقاط النظام، علمت أن قانون العقوبات السوري لا يبيح حيازة “الكوندوم” أو الترويج له، على الرغم من توافره في الصيدليات.
كاتبة إحدى الشهادات، عملت صحافية في الإعلام الثوري، وصارت ناطقة إعلامية كما تمنت، ونقلت الأخبار عبر إذاعة محلية، لولا أن زوجها الصحافي مثلها صارحها بالغيرة، إذ كان يزعجه سماع صوتها عبر الاذاعة. امرأة أخرى، منفتحة ومتدينة ومحجبة، جادلت أحد أعضاء الائتلاف السوري المعارض حين قال لها إن المرأة تغيب لأنها تغيّب نفسها أيضاً، ثم سكتت “لأنها لا تعرف ما هي الحقيقة”.
تذكر صاحبة شهادة، “لاءات” المجتمع الثلاث بطريقة جميلة: “المجتمع قانونه العيب والسياسة قانونها الممنوع والقرآن قانونه الحرام”. النساء محكومات بهذه القوانين الثلاثة مجتمعة لأنهن مستبعدات إلى محيط النظام البطريركي وهوامشه، فهناك “العيب” في المجتمع لأن الرجال قد يحاولون، بمشقة، التصالح مع جنسانية النساء.
كان مسعى النظام، باعتقاله للنساء وتعريضهن للانتهاكات في سجونه، دفع الذكور في المناطق المنتفضة ليمنعوا بأنفسهم نصف السكان (فالنساء أقلية حتى لو تجاوزت نسبتهن في المجتمع خمسين في المئة) من الخروج للتظاهر في الشوارع، لكي يحموا شرفهم وتجنباً لأي انتهاك، وربما كذلك لمنع أي علاقة جنسية محتملة قبل الزواج أو خارجه. المعارضة السياسية، بسبب تقليديتها وبطريركيتها، استبعدت النساء والشبان أيضاً، ووقفت ضد مشاركتهم الفعالة في السياسة.
الشخصي سياسي
الشخصي سياسي أيضاً: هذا هو الاكتشاف العادي المهمل والمهم الذي توصلت إليه نساء كثيرات، وإن تباينت تعابيرهن وكلماتهن. كما اكتشفن أن الأمور الصغيرة قد تكون سياسية أيضاً، حتى الطبخ والعمل في المنزل ورمي المنشورات في الشوارع وسواها من الأفعال التي يقلَّل شأنها عادة. فالخطوة السياسية الأولى يمكن أن تبدأ ببساطة من الوعي، ثم تشتبك الأفعال والمواقف والآراء بالمصائر الشخصية.
كثرة من صاحبات الشهادات، يقمن الآن خارج سوريا أو عشن حياتهن مع الرجال، وقد عبّرت إحداهن التي حافظت على علاقة متميزة مع أبيها، فأشارت إلى مأزق هذه الاستراتيجيا بشكل جميل: “لم يفرض أبي أية تربية دينية ولم يمارس عليَّ أي ضغوط. كنت أخبره بعلاقاتي العاطفية. ثم تبيّن أن من الأحسن الاحتفاظ بتلك التفاصيل لنفسي وصرت لا أطلع أحداً عليها، فحياتنا الخاصة كأفكارنا لا تخرج كلها إلى الضوء، وهناك جزء يجب أن يبقى داخلنا”.
معظم النساء العلمانيات، المؤمنات بأن للنساء حقوقاً جنسية، لم يبدين ارتياحاً عند التطرق إلى حياتهن الخاصة أو مناقشة مسائلها. فربما إذا تجرأن وتقدمن إلى صدارة المناقشات، افتضحت هشاشتهن، لأن عدم مطالبتهن بحقوقهن الجنسية على الملأ تنطوي على إقرارهن بالإدانة التي ستطالهنّ حتى – أو ربما على الخصوص- من طرف عوائلهن. المفارقة أن النساء المحافظات، وهن يمثلن النسبة الكبرى بين نساء سوريا، كن يشعرن بأنهن أكثر حرية وحديثهن لا تشوبه نبرة الاعتذار عند تطرقهن إلى حياتهن الخاصة باضطراباتها وآمالها.
نصادف كيف أن النساء في المناطق المنتفضة يرعين الرجال. تقول إحدى الشهادات إن ممرضة طبّبت الجرحى في المستشفى الميداني، ولم يقل لها أحد لا تخالطي الرجال ولا تلمسيهم فينتقض وضوؤك، كأن ذلك إشارة إلى سماح الظروف بالتغيير. النساء التقليديات أو المحافظات يبعدن عن أنفسهن ما قد يبدو شبهة الظهور بمظهر التخلف، ومحاولاتهن تدل على وجود طريق ما مفتوح. تقول صاحبة شهادة إنها كانت تتنكّر بارتداء النقاب عند توزيع المناشير، فلم يتعرف إليها أبوها وأبدى احترامه وإعجابه بها قائلاً: “أنتو أخوات رجال”. الرجال يبدون الإعجاب، لكن الشجاعة تظلّ مقرونة بهم. هذه نقطة تسترعي الاهتمام، فسؤال الرجل يُطرح مع سؤال المرأة: خير للنساء أن يكنّ رجالاً وكأنهن يسعين إلى الرجولة ويتطلعن إليها، فلو كانت المرأة رجلاً لاستطاعت القيام بما هو أكثر من المتاح لها، لأن الجندر يقيّدها ويضع حدوداً وشروطاً لأفعالها.
المتأسلمون ومحو المرأة
عندما خرجت ثائرات الزبداني وقمن بتمثيل تظاهرة في مسرحية ألّفن لها الأغاني ورحن يغنّينها، رأى بعض الرجال في تلك الجرأة وقاحة وعيباً وحراماً، فقطعوا التيار الكهربائي عن مكبّرات الصوت. تقول امرأة أخرى: “لا أخشى عسف المتأسلمين الذين يمحون بأفكارهم وسلوكهم المرأة والحياة نفسها. إنها فترة موقتة، فلو اعتُقلت مثلهم وعُذّبت لتطرفت يقيناً”. المسألة إذاً مرتبطة بالجندر مرة أخرى، لأن النساء مغيَّبات عن التجارب الكبرى: إنهن “محرومات” من حَمل السلاح، “محرومات” من “شَرف” الاعتقال، و”محرومات” أيضاً من التعذيب الذي يتعرض له الرجال، فأين العجب إذا كنّ محرومات من القوانين والقواعد. تقول امرأة: “كأن عليّ ملازمة المنزل وانتظار الرجل المخلّص، لأنني عاجزة عن رفع السلاح دفاعاً عن أهلي”، فاعتدادها بنفسها لا يسمح لها بانتظار أي مخلص. وقد أشارت امرأة إلى النقطة نفسها على الأرجح. فحين ترى صديقها الذي اعتقلت معه، حليقاً معذَّباً، تصمم على حلاقة شعرها كله مثله، في فعلٍ قد يُرى بمثابة تضامن، كأنها بهذا التمثل ستخفف عنه وطأة وحدته ضد الانشاء البطريركي.
عملنا على عدم صياغة القصص والوقائع داخل خطاب جديد، يتركز على ما ينبغي أن تكون عليه النساء. فمثل هذا الشكل من الخطاب هو داء البطريركية المستفحل وقد ألمّ حتى بالكثير من الحركات النسوية، وإنما كان اختيارنا هو وقوف الأصوات فرادى، كلٌّ على حدة، حافلاً بالتناقضات والمفارقات والعداوات والغضب والكراهية والجمال، لعلنا نلقي ضوءاً على ما نحسبه سوريا داخل تصورات أرحب، فيضيء سؤال: “مَن هنّ النساء السوريات؟”، وكم تباينت السوريات اللواتي لا يتشابهن، وكم اختلفن وافترقن، ولو كنّ جميعهن سوريات.
كانت مشاركة النساء أساسية وتنامت على الأرجح حتى اندلاع الحرب حين أرغم تفاقم العنف النساء على مغادرة الفضاء العام لينزوين في الفضاء الخاص، هذا إن كان لا يزال لهنّ منزل أو مأوى. لكن وعلى الرغم من كل شيء، فإن توثيق مشاركة المرأة السورية أضاء مرة أخرى الحاجة الماسة إلى التفكير ملياً في طبيعة الصمت واللامبالاة والريبة التي يضجُّ بها زماننا، حيث النساء مُستبعَدات ولا تُسْمع أصواتهنّ.
النهار