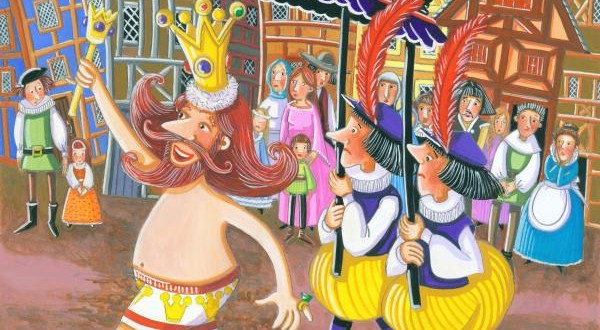الأتاسي: بالسينما ظهّرنا ياسين الحاج صالح الإنسان والجيل/ ديمة ونوس

“بلدنا الرهيب” فيلم وثائقي طويل عن الثورة السورية نال قبل أيام قليلة، الجائزة الكبرى في “مهرجان مارسيليا الدولي للأفلام”. الفيلم الذي يستغرق ٨٥ دقيقة، لا يشعر المتفرّج بعده بالشبع. كثافته تجعل من تلك الدقائق، زمناً فعلياً لسنوات ثلاث مرّت خارج وعينا. وكأننا إذ بدأت الثورة، ثبّتنا أقدامنا على رقعة محددة، رافضين التخلي عن تلك اللحظة. وما زالت الذاكرة مرتبكة في تفاصيل تفوق قدرتها على الاستيعاب. ثلاث سنوات ونيف، كأنها رمشة عين. خلف تلك الرمشة، أكثر من مئة ألف سوري قتلوا، ومثلهم عذّب وخطف واعتقل وهاجر وهرب. ذلك الفائض في الذاكرة، يجعل من فيلم “بلدنا الرهيب”، فيلم اللحظة السورية التي ضاعت خلف رمشة العين تلك. ثمة توق لدى المتفرّج السوري تحديداً، إلى ملء الفراغات، بحثاً عن لحظة أمان. وقد يبدو غريباً، أن يعثر أحدنا على لحظة الأمان تلك، في الصوت العنيف والقاسي المنبعث من بارودة أحد أفراد الجيش الحرّ أثناء تحرير ما يسمّى “برج الموت” في مدينة دوما في ريف دمشق.
الفيلم الذي أنجزه محمد علي الأتاسي وزياد حمصي، هو فيلم الصدفة السورية، إن صحّ التعبير. إذ لم تكن ثمة فكرة فيلم في البداية، كما يقول الأتاسي في لقاء مع “المدن”. الحدث السوري خلال السنوات الماضية لا يمهل. “لم تكن ثمة فكرة فيلم في البداية. عندما كان ياسين الحاج صالح لا يزال في دمشق، حاولت أكثر من مرة أن أبدأ معه هذا المشروع، لكن الأمر لم يكن متاحاً نظراً للظروف الأمنية الصعبة. عندما ترك ياسين دمشق إلى دوما، طلبت من زياد أن يصوّر معه مشاهد عن وجوده هناك وتحرّكاته وعمله. ربما بسبب الخوف على ياسين، أردت توثيق حضوره في الغوطة بمادة بصرية”، يقول علي الأتاسي.
يبدأ الفيلم في دوما وينتهي في اسطنبول. بينهما، ثمة محطات أساسية في رحلة ياسين من سوريا إلى الخارج. ثمة طريق طويل وشاقّ استغرق 19 يوماً بين دوما والرقة. وثمة ياسين الحاج صالح، الإنسان وليس المفكّر. وأعتقد أن أنسنة ياسين، وهو رمز من رموز الثورة السورية، لم تكن مهمة صعبة. ليس فقط بسبب تواضعه وزهده واختياره البقاء في الداخل قدر المستطاع، جنباً إلى جنب مع الثوار وضحايا الإجرام، بل لأن الثورة أعادت للسوريين إنسانيتهم وإحساسهم بذواتهم بمعزل عن أي تابو أو قدسية. كل من اختار البقاء والمشاركة في التغيير، بطل. وليست البطولة هنا بالمعنى الأسطوري أو الدرامي، بل بمعنى المواطنة والرغبة في المشاركة. “وراء فكرة الرمز أو المثقف والمفكّر، ثمة إنسان بكل ضعفه وهشاشته. هذا ما يمكن للسينما أن تضيفه. هذا النوع يعطي لفكرة الرمز والمثقف عمقها الإنساني الذي تعجز الكتابة عن تجسيده”، يقول الأتاسي في حديث عن ياسين، الرجل السوري العادي الذي سكن في دوما بصحبة زوجته سميرة الخليل وأصدقاء مثل الناشطة رزان زيتونة، وشاركوا أهلها حراكهم السلمي والمدني.
في شوارع دوما المحرّرة، كانت تجري محاولة لخلق حياة مدنية بديلة. ياسين وسميرة ورزان كانوا يحملون مكانس وينظفون الشارع، رغم عدم اكتراث الأهالي لتلك المبادرة. أحد الأهالي تحدّث إلى كاميرا زياد مطالباً سميرة ورزان بارتداء الحجاب. “إنها إشكالية علاقة المثقف مع الناس العاديين. وإشكالية الحوار والتواصل أو عدمه. عدم القدرة على التواصل كان حاضراً في مشهد تنظيف الشارع في دوما. هناك حالة قطيعة بين بعض الأهالي وبين ناشطي الحراك السلمي مع أنهم عاشوا بينهم وشاركوهم القصف والأوضاع الأمنية الكارثية”.
تلك الإشكالية في العلاقة، راسخة وقديمة ومتجذرة. وربما نحتاج إلى سنوات طويلة لكسر ذلك الحاجز بين المثقف والناس. مسؤولية ذلك الحاجز يتحمّله المثقف إلى جانب النظام السوري الذي ساهم في عزل المثقفين عن باقي فئات المجتمع. عزَلهم في بيوتهم وفي السجون. منعَهم من المشاركة ومن الظهور الإعلامي. منع الصحف التي يكتبون فيها وشفّر الأقنية التي يظهرون عليها وحجب مواقع الأنترنت التي ينشطون على صفحاتها.
لم يستعن مخرجا “بلدنا الرهيب” بأي مقطع فيديو من “يوتيوب”. ربما لأن الفيلم صوّر في قلب الحدث. وليس ثمة أبلغ من المشاهد التي صوّرت في دوما، مُظهرة حجم الدمار الذي طاول الأبنية وحوّل المكان إلى مدينة أشباح اختار ياسين أن يسكن فيها، إلى جانب المكان الذي يستقبلون فيه جثث الشهداء ليغسلوها ويكفّنوها. إنه خيار العيش مع الموت، لأن ياسين، كما يقول في إحدى المشاهد، يريد أن يبقى قريباً، ليرى سوريا وهي تتغيّر. ذلك التغيير الذي يتحدث عنه ياسين، يعجز عن التقاطه مَن يعيش في مدينة دمشق أو في طرطوس أو خارج سوريا. هذا ما يفسّر حالة الإحباط التي تتعاظم في روح ياسين وزياد مع مراحل خروجهما من سوريا. أولاً عندما تركا دوما إلى الرقة، ثم عندما تركا الرقة إلى تركيا. في تلك اللحظة، يشعر المشاهد بأنانية مفرطة، بالعجز، ليس لخروجه هو، بل لخروج ياسين وزياد وأمثالهما من المشاركين الفعليين في الثورة والحراك المدني والسلمي. مع العلم أن الفيلم لا يجمّل الواقع، ولا يكذب عندما يقول إن النظام السوري احتلّ سوريا وإن تنظيم “داعش” سرقها.
حكاية جيلين من السوريين، ياسين السياسي والمفكّر المعارض الذي قضى 16 عاماً في سجون الأسد، وزياد حمصي الشاب الطموح الذي عمل في دوما مصوّراً وناطقاً إعلامياً ومقاتلاً إلى جانب الجيش الحرّ من دون أن يقتل أحداً. “نشأت علاقة صداقة بين ياسين وزياد خلال مراحل تصوير الفيلم. جيلان يلتقيان في الثورة وليس الفيلم وحده ما يجمعهما. الصورة تقول ما لا يقوله الكلام. إنها تستنطق ما يختبئ خلف العينين وخلف الخطاب السياسي والفكري لكل منا. ياسين رمز بالنسبة إلى العديد من شباب الثورة. العلاقة الإنسانية التي جمعتهما، هي حال الثورة ومحرّكها”، يقول علي الأتاسي الذي انضمّ إلى ياسين وزياد في الرقة قبل عام تقريباً، مكملاً ما بدأه زياد. في طريقهما من دوما إلى الرقة، يعيشان التجربة ذاتها تقريباً. في صحراء الضمير، يتمددان مع آخرين لساعات طويلة على الأرض الترابية، يعزلهم عن الفضاء، غطاء بلون التراب، يرفعونه بأصابعهم قليلاً كي لا يغطي وجوههم. في الطريق، يعرف ياسين أن “داعش” اعتقلت أخويه في الرقة، ويعرف زياد أن النظام اعتقل والده في دوما. إنها المأساة ذاتها التي يعيشها معظم السوريين، وحدة حالهم.
تبقى سميرة الخليل حاضرة في الفيلم دائماً. يذكرها ياسين، يستعجل قدومها، يخاف عليها، يتجنّب الغرق في العواطف في لحظات كثيرة، وتهرب الدموع من عينيه رغماً عنه في لحظات أخرى. سميرة التي تقول له في آخر “سكايب” نشاهده في الفيلم، إنها ربما تتغيب عنه لأيام نظراً للظروف الصعبة التي يعيشونها. حصار خانق، لا كهرباء ولا ماء ولا خبز. لكنها تعده قبل أن ينقطع الاتصال بينهما، بمحاولة الحصول قريباً على هوية أخرى، للالتحاق به. وياسين الذي يبدو في دوما واثقاً، قوياً، مطمئناً رغم كل الدمار والقصف، ينكسر كأنه في اسطنبول وتصيبه حالة من الضياع لابتعاده القسري عن ذلك الضجيج المبشّر بتغيير ما.
بعد الانتهاء من تصوير الفيلم بأيام، اعتُقلت سميرة الخليل مع رزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي، في مدينة دوما. وزياد وصل، مع نهاية الفيلم، إلى اسطنبول بعد شهرين من الاعتقال عند “داعش”، لكنه لم يُخفِ رغبته بالعودة في وقت قريب. ينتهي الفيلم خارج سوريا، ربما لأن داخلها بات مسجوناً.
المدن