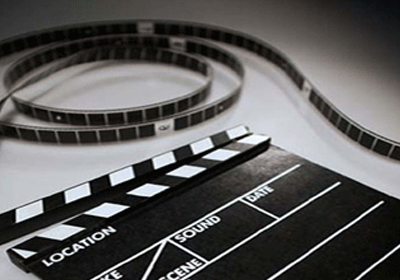بين “السياسيّ” و”الثقافيّ”
حازم صاغية
مع اندلاع ثورات “الربيع العربيّ”، ظهر في المنطقة العربيّة صوتان سجاليّان يقرآن الحدث انطلاقاً من تموضعهما على خريطة الأفكار والتحليل: صوت ثقافيّ يستعيد بعض أطروحاته القديمة التي تركّز على الدين والتقاليد والقيم، ليستنتج أصحابه بالتالي موقفاً فاتراً حيال الثورات، إن لم يكن معادياً لها أحياناً. وصوت سياسيّ يركّز رموزه كلّيّاً على السلطات السياسيّة وعلى استبدادها وتكوينها الأمنيّ والقهريّ، ليخلصوا إلى إبداء الحماسة للثورات أو إلى الالتحام الكامل بها.
الصوت الأوّل نخبويّ الطابع، مادّته ثقافيّة ومجتمعيّة على نحو يؤدّي به إلى تحييد السلطة السياسيّة، أو أقلّه اعتبارها تفصيلاً عارضاً لا يستحقّ الوقوف عنده أو التأمّل فيه. لهذا ظلّ بعض وجوهه، ولسنوات طويلة، يضعون الاستبداد بين هلالين، ولا يتورّعون عن المشاركة في مناسبات ثقافيّة وفكريّة تنعقد في هذه أو تلك من عواصم الاستبداد وتحت رعاية أنظمته ووزاراته، بما فيها وزارات الإعلام السيّئة الصيت.
الصوت الثاني جماهيريّ أو طامح أن يكون كذلك، وهو لا يرى أمامه إلاّ السلطات السياسيّة وأجهزتها هدفاً، من دون أن يعير أيّ اهتمام نقديّ يُذكر لمسائل الاجتماع والثقافة، كنظام القيم السائدة أو الممارسة الدينيّة أو اللغة وأنظمة القرابة وشبكات العصبيّة. إنّه يرى إلى عمليّة تغيير السلطة بوصفها قضيّة كاملةً مستقلّة عن سواها.
لنقل، بادىء ذي بدء، أنّ المشترك بين هذين الصوتين كان عجزهما الكامل (وبالتالي عجز الفكر السياسيّ العربيّ كلّه) عن توقّع الحدث الكبير الذي مثّلته ثورات “الربيع العربيّ”. فالثقافويّون انصبّ كلّ اهتمامهم، ولعقود متّصلة، على عناوين “الحداثة والأصالة” و”التراث والمعاصرة” و”الإسلام والتغريب” ممّا ثبت أنّه لا يسمن ولا يغني من جوع في حركة الواقع، علماً بأنّ هذه الاهتمامات كانت تعطي أصحابها مواقع التصدّر في تراتبيّة الثقافة والفكر السياسيّ العربيّين عاماً بعد عام. أمّا السياسويّون فاستغرقهم، في المقابل، رصد الظروف السياسيّة وتحوّلاتها وإمكاناتها المتاحة. ولأنّه لم يكن في وسعهم أن يتوقّعوا التحوّلات التي طرأت، اصطبغ رصدهم هذا بمواقف شعوريّة لا تخلو أحياناً من الحدّة أو من إعلان اليأس والإحباط.
ولربّما كمن العيب الأكبر في التحليل الثقافيّ (أو الثقافويّ) في تقليله من أهميّة السلطات السياسيّة ومن قدرتها على الإسهام في صناعة موادّ الثقافة والاجتماع وفي تكييفها. وهذا مع العلم بأنّ تلك السلطات، التي تجتمع فيها عناصر ديكتاتوريّة وعناصر توتاليتاريّة، ليست قليلة التدخّل في الشؤون المذكورة ولا هي بالحياديّة على الإطلاق. على أنّ هذه الاستهانة بالسياسيّ رتّبت عيباً أكبر هو افتراض امتلاك القدرة على تغيير الاجتماع والثقافة من دون تغيير السلطة. فبحجّة التركيز على ما هو “أهمّ” (الثقافة)، لم يعد “المهمّ” (السياسة) يحظى بأيّ اهتمام، علماً بأنّ تذليله يبقى الشرط الشارط للانتقال إلى مهمّات أخرى يُفترض أنّها أعقد وأشدّ تأثيراً.
من ناحية أخرى، ترتفع في التحليل السياسيّ (أو السياسويّ) جرعة الشعبويّة إذ ينقاد أصحابه، بفعل تماهيهم مع العمل الثوريّ وإنكارهم للبُعد الثقافيّ النقديّ، إلى تقديس “الشعب” وأفعاله العفويّة بالسلبيّ منها والإيجابيّ. وبالمعنى ذاته، فإنّ الموقف الذي يتبنّاه السياسويوّن يقول، أحياناً على نحو مباشر وغالباً على نحو مداور، إنّ إسقاط السلطة القائمة إنّما هو الهدف الأوحد المستقلّ والمكتفي بذاته.
وربّما كان هذا التأويل مفهوماً ومعذوراً من وجهة نظر الصعوبة الهائلة التي يتكشّف عنها إسقاط السلطة في بلد كسوريّا، سلطتُه وحشيّة وانسدادها عن السياسة تامّ مكتمل. فالمهمّة هذه، وكما تكشف أيّامنا هذه، تستنزف من الجهود ما لا يُبقي شيئاً لأهداف أخرى. والحال أنّ السلطة السوريّة نجحت، منذ أيّامها الأولى، في أن تجعل مهمّة انفتاح السياسيّ على الثقافيّ أصعب، إذ صفّت أو اعتقلت الناشطين المدنيّين الأشدّ تأهيلاً لعقد ذاك القران الموعود. أمّا الذين نجوا من الموت والاعتقال بينهم فقادتْهم خطاهم إلى المنافي والمهاجر. هكذا، وبدل اعتبار الافتقار إلى التنظيم والوعي بمعناهما القديم مقدّمة للبحث عن أشكال جديدة في التنظيم والوعي، صار من الشائع هجاء كلّ تنظيم وكلّ وعي.
وعلى العموم يُعدّ الطرح السياسيّ البحت إنقاصاً لمعنى الثورة ولما يمكن أن يُعتَبَر إنجازاتها، تماماً بقدر ما يُعدّ الطرح الثقافيّ البحت، وفي أحسن أحواله، طريقاً إلى استبعاد العمل الثوريّ، أو إلى تأجيله إلى أن يقضي الله أمراً.
موقع 24