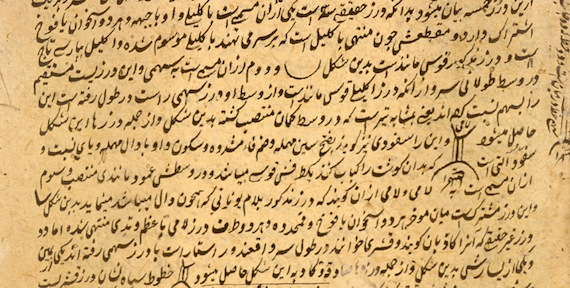دقيقة الإعتام الأولى/ أحمد باشا

إعتام لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، شبه مسافة فاصلة بين الحياة والأسطورة، بين الحياة وضدها. بدأ المشاهدون بمهمة ضبط أنفاسهم. إنهم يتوحّدون في هذه اللحظة، يخرجون من أزمنتهم ليدخلوا في عماءٍ مُشتهى. قبل انتهاء الثواني الخمس الأولى، في الصف ما قبل الأخير، ثمة أمٌّ تحاول أن تُسكت ولدها ذا الأشهر الستة. لكن لا فائدة.
لا أحد يكترث بمحمد، حارس المسرح منذ خمسة عشر عاماً، لا وهو يسير في الممر محاولاً لفت الانتباه إليه، ولا حتى حين يغلق باب الصالة خلفه بقوة. كأن لعبه لمئات الأدوار الثانوية لم يجلب له أهميةً تُذكَر؛ بقي حارساً. في العروض التي لا يشارك فيها، كان دائماً يجلس على كرسيه الخشبي، خارج الصالة، ويدخّن بشراهة. مرةً، أسرّ لي بأن ممثلة مبتدئة قبّلته على الخشبة بقرفٍ. رد الاعتبار إلى نفسه حين صفعها في مسرحية لاحقة بعد سنوات، واعتزل التمثيل.
لحظة تلو الأخرى، تخفتُ التنهيدات، ويصير المكان أشبه بوادٍ ارتكبت فيه جريمة قتل منذ زمن بعيد، لا سيما تلك التي سمعتها على لسان أبناء مدينتنا بأكثر من عشر نسخ مختلفة تماماً، ولكن الثابت فيها أن أبناء القتلى ما زالوا على قيد الحياة. يتسلل إليّ شعور بالخوف. يسعل رجل عجوز بجانبي. أشعر أن زمن الاِعتام قد شارف على الانتهاء. ألتفت إلى الوراء، فلا ألمح سوى صلعة رجل الأمن الذي يفرد دستةً من الأوراق على ركبتيه.
أقارب الممثلين وأصدقاؤهم يجلسون خلفي تماماً، ما الذي ينتظره هؤلاء؟ بالتأكيد، لن يروي علاء، الفلسطيني الأسمر، ما فعله في زيارتنا إلى وادي رم، في الصيف الماضي. وقتها اختفى لساعات، ونحن نبحث عنه. عندما عاد، أخبرنا بأن الطبيعة فتنته في الوادي الأردني إلى درجة أنه تعرّى وتمدّد على الرمال، وأصيب بنشوة لا مثيل لها. ونورا، صديقتنا الجريئة جداً، لا أعتقد أنها ستعيد جملتها الشهيرة في عرض اليوم: “سيبدأ المسرح عندما تتوقف الدرّاجات الهوائية والأراجيح عن انتهاك عذرية الفتيات في بلادنا”.
ثوان لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وسأشاهد أول عرض مسرحي في حياتي. العجوز بجانبي يحرّك عصاه، يحرّك أصابعه بالطريقة نفسها حينما كان يفتح عينا زوجته قبل تغسيلها. يوم دفنها أيضاً، طلب منّا، نحن الأطفال، أن نمسك بالغطاء. نزل إلى القبر وهمس في أذنها كلاماً غير واضح، لكن في ما بعد فسّرناه على طريقتنا؛ لقد أعاد كلام حفار القبور الشكسبيري، لا أكثر.
حدقات مَن في الصالة تبدأ بالتوسّع. صوت سيارة مسرعة في الخارج، يختلط صوتها عليّ مع صراخ جارنا أبو حازم المعتاد وما يفعله أسبوعياً بعد مشاجرته مع زوجته بسبب فشل أطفاله في الدراسة: يقف وسط الزقاق، يمسك بجرّة الغاز باليد اليمنى، وفي اليد الأخرى ولاعة مهدداً بصراخه كل سكان الحي بأنه سيشعلها، ثم يعود صاغراً إلى بيته. موسيقى. إضاءة. يظهر الممثلون. تبدأ المسرحية. تنتهي. يصفّق الجميع، ثم يخرجون لينتعلوا حيواتهم التي خلعوها على باب المسرح.
منذ أيام كنت في الساحة العامة، هنا في المدينة الفرنسية التي أعيش فيها، وإذا بخمسة شبان يحاولون أن يلفتوا النظر إليهم لتقديم عرض في الهواء الطلق. صرخ أحدهم في المذياع: “تعالوا، لا يوجد ما يدعو للخوف، لا تخشوا شيئاً، ثلاثة سود واثنان عرب”، وغرق في الضحك بعدها. بعد عرض الشبان، وأنا في طريق العودة إلى المنزل، خطر على بالي محمد، تذكّرت دقيقة الإعتام الأولى قبل خمسة عشر عاماً: هل كانت مهمة محمد تقتصر على فرز وترتيب حيوات الجميع في الخارج، كي لا تلتبس على أحدهم حياة الآخر؟
العربي الجديد