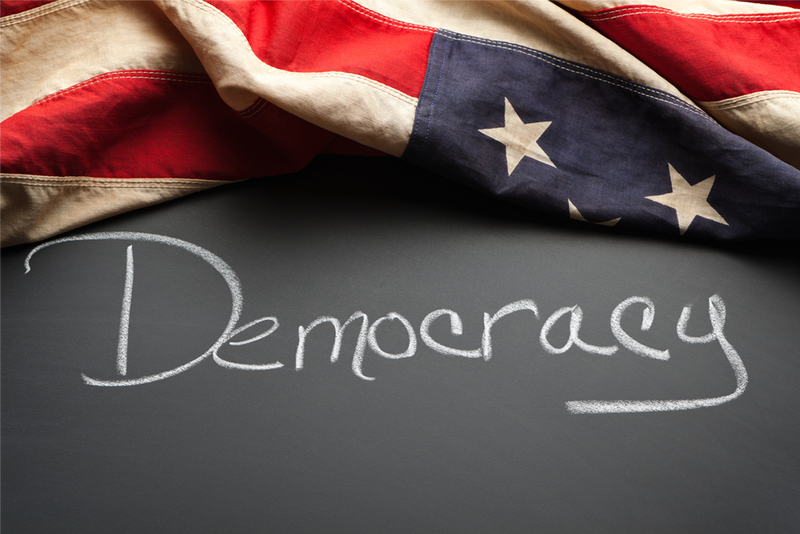عالم «ما بعد الوقائع» يتمدد/ بريس كوتورييه

ولجت الديموقراطية عالم ما بعد الوقائع، ولم تعد بينات بائنة على ما وقع تقنع الناخبين. وعلى رغم أن عبارة «بوست – تروث» ظهرت في الولايات المتحدة في 2004، فإن الطعن في مفهوم الحقيقة أبصر النور في الستينات مع مفكرين فرنسيين من أمثال ديريدا وفوكو. وفي نهاية السبعينات، بدا أن كل ما تحمله الفلسفة الجديدة، جديد ويقطع مع سالفه (أعمال أندريه غلوكسمان وبرنار – هنري ليفي) وأعمال اليمينيين الجدد من أمثال ألان دي بينوا. ولكن أصحاب حس السخرية لم يفتهم أن ما يقوله «الجدد» لا يحمل جديداً: فهم يرددون ما انفك يفسره منذ عقود أمثال ريمون آرون وكلود لوفور، وآخرين يعيدون ما حمله كارل شميدت، وبعضهم الثالث اقترح العودة الى ليبيرالية عمرها قرن. واليوم، تنتشر عبارة «ما بعد». وكأننا ندرك في عالم بالغ القدم أننا متأخرون أو لاحقون عليه. ولم يعد في وسعنا زعم الجِدة، فنحن نأتي (في مرحلة ما) بَعد، ونكمل ما سبقنا. ولكن ما يلي ننزع عنه طابعه ولونه، ونطعن فيه. فـ «ما بعد» يخالف ما يقال أكثر مما يبني بناء عليه. فما بعد العلمانية يرى ان العالم لا يتجه الى الخروج من الدين، كما حسِب الأوروبيون. وما بعد الحداثة تعلن إخفاق مشروع الحداثة، والأنوار. وما بعد الديموقراطية هو نظام تتفلت فيه القرارات من أيدي الجسم الانتخابي وتؤول الى مؤسسات غير منتخبة خارج المحاسبة. وأكثر عبارة نقع عليها أينما بدّل المرء نظره، هي عبارة ما بعد الوقائع والحقيقة التي وجدت طريقها الى قاموس أكسفورد. وبعضهم يرى انها تفسر الضيق او القلق السياسي اليوم وحوادث مثل الاقتراع الإيجابي على بريكزيت (انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وانتخاب دونالد ترامب.
وعبارة «ما بعد الحقيقة» أو ما بعد الوقائع صاغها المفكر الأميركـــي رالف كييـــس، في كتاب نشره في 2004، عنوانه «عصر ما بعد الحقيقة. نـــقص الأمانـــة والخداع في الحياة المعاصرة». ويقدم الكاتـب عمله بالقــول:» فـــي الماضي، كانت الحقيقة والأكاذيب. واليوم، لدينا الحقيقة والأكاذيب ثم بيانات لا يعتد بها، وعلى قدر ما هي ثانوية لا تفند ولا يقال انها خاطئة وضالة…» وفي عالم ما بعد الحقيقة والوقائع «تلتبس الحدود بين الحقيقي والخيالي، وبين النزاهة وغيابها، وبين الخيال والواقع الفعلي». ومسرح المعارك السياسية اليوم هو هذا الحيز الغامض والملتبس.
ونظام ما بعد الوقائع والحقيقة سمته الأبرز افتقار حوادثه الى التماسك واعتبار شطر راجح من الرأي العام أنها مثبتة ويعول عليها. ووسائل الإعلام تفند أشباه «الوقائع»، وتلجأ الى التحقق منها كلما أعلن سياسي ما يبدو انه «حقيقة معدلة الى الأحسن»، وتسعى الى تبيان الحقيقة من الكذب. ولكن المُثبت والبائن لا يُبدِّل ما في نفوس الناخبين. ويبدو ان تشذيب الخبر والوقائع مما يشوبها من تضليل وكذب، يثبت الناس على آرائها. وراق لمؤيدي البريكزيت ودونالد ترامب أن «النخب اليبرالية» لا توافقهم الرأي. فهم يعرّفون أنفسهم على انهم خلافها. ولذا، لم تلق الحملات الكبيرة ضد الشعبوية التي شنتها الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة الموثوقة، آذاناً صاغية، وأدت الى خلاف ما رجت. وفي وجه الخطابة التقليدية – وأعلامها من التكنوقراط – وعِظات «الصواب في السياسة»، برز الخطاب الاستفزازي والصاخب الذي انتهجته شخصيات مثل دونالد ترامب وبوريس جونسون، في صورة الأصيل والموثوق. فهو يتماشى مع الثقافة الشعبية، اي ثقافة تلفزيون الواقع، ويبدو انه «صائب»، على رغم انه على خلاف الوقائع.
والسياسي في عالم ما بعد الوقائع «يوضب» الوقائع على ما يشاء. فهو في مثابة «حرفي الهراء» الذي وصفه الفيلسوف الأميركي هاري ج. فرانكفُورت في كتابة «فن قول الهراء او الحماقات» (2006). وميّز فرانكفُورت بين الكاذب، وهو على يقين من ان الحقيقة موجودة وأنه ينتهكها، وبين «الحرفي» هذا الذي ضاع في بحر اكاذيبه، فلم يعد يعرف اين تنتهي الحقيقة وأين تبدأ الأكاذيب. ومثل هذا الحرفي يندد بـ «فساد النظام» وتلفه، وهو لا يسعى سوى الى النفاد بمصالحه. فهو يقول ان كذب النخب المعمم يحمل الضحية على الكذب. وفي كتابه السابق، «عن الحقيقة» الصادر في 2008، تناول فرانكفُورت أخطار التذرر والتفكك في مجتمعاتنا نتيجة اختلاط الحدود بين الواقع والكذب. فـ «حين يذيع المرء بنات خياله على انها وقائع، يخسر المجتمع أسسه». ولا تقوم قائمة لمجتمع ديموقراطي في غياب اجماع على معنى الكلمات وحقيقة الوقائع، ومن غير تشخيص المشكلات التي تقتضي العلاج. وثقة الناس تهتز حين تشعر أن كثراً من الممسكين بمقاليد الحياة الاجتماعية والسياسية يغشون وينشرون معلومات كاذبة لتحسين مراتبهم ومواقعهم.
ولم يخف أعداء الديموقراطيات الليبرالية فوائد التلاعب بميلنا الى عدم التصديق. فبوتين يمطرنا بمعلومات كاذبة. فهو نسب صاروخ «بوك» الذي دمر رحلة بوينغ 777 بين امستردام وكوالا لامبور (فوق اوكرانيا) الى الجيش الأوكراني، على رغم ان التحقيق الدولي أثبت ان الانفصاليين الموالين للروس هم من اطلقوه، وقال إن الجثامين والأشلاء في موقع انفجار الطائرة جلبت من بعيد. «ويساهم انفجار الأخبار الكاذبة وتعاظم أعداد مروجيها في تبدد ثقة الناس في ما يسمعون ويقرأون»، كتبت لوري بيني في «نيو ستايتمن». والإنترنت هو أداة ما بعد الوقائع والحقيقة. فشبكات التواصل الاجتماعي ونظم الحسابات الشبكية يطوّقان رواد الإنترنت بـ «فقاعة معرفية».
واليسار كان اول ضحايا هذه الأضاليل والمعلومات الكاذبة، فانحسرت شعبيته الانتخابية، وكان اول المنددين بنظام ما بعد الحقيقة، وأعلن ان الشعبويين يروون ما تيسر لهم من قصص وأكاذيب للتلاعب بالانفعالات الجماعية. فهم ينفون كل الآفات التي يناضل ضدها اليسار: التلوث والرأسمالية والاحتباس الحراري والتفاوت الاجتماعي… ووعود الشعبويين ديماغوجية ترفع لواء الديموقراطية المباشرة لترجيح كفتهم على كفة المؤسسات التمثيلية. واليمين شأن اليسار تنزل به اضرار نظام ما بعد «الواقع». فالحزب الجمهوري الأميركي ينظر بعين الاستياء إلى ترامب.
* كاتب افتتاحيات في «فرانس كولتور»، عن «لوبوان» الفرنسية، 19/1/2017، إعداد منال نحاس.
الحياة