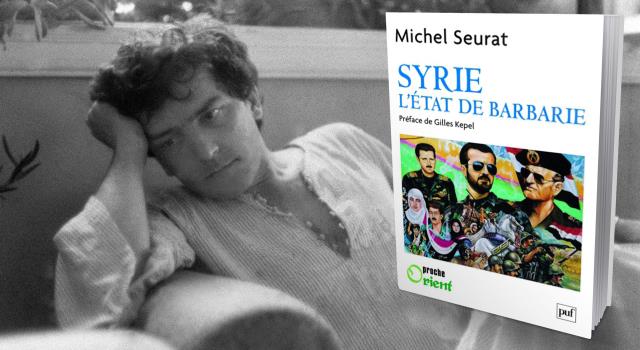عن العناوين والأفكار…/ سلام الكواكبي

استخدم الإعلام، بأشكاله كلها، العناوين وسيلة إيصال وتوصيل فعّالة. واختلفت معايير عرض العناوين، باختلاف نوعيات الجهاز الإعلامي العارض وخلفياته. وفي هذا السياق، أصبحت المعاهد الإعلامية تدرّس تركيب العناوين ومحتواها وموسيقاها. واشتهرت صحف باختياراتها المانشيت الجاذب، المعتمد على عناوين مثيرة، أو استندت إلى عملية اللعب بالكلمات لتحريض فضول المتابع.
وفي الفترات الأخيرة، حيث اشتد التنافس التجاري، ووقعت وسائل الإعلام في مأزق البحث عن الزبون، تدهور أسلوب صياغة العناوين. وتراجع التركيز على مضمون الخبر وأهميته، ليصبح الخبر ذاته مُختصراً ومشوهاً، في عنوانٍ يمكن له أن لا يمت بصلةٍ إلى محتوى المقال أو النشرة. وبات العنوان يُحاكي الأحاسيس والعواطف، بسلبها وإيجابها، بعيداً عن محاكاة العقل والتفكير. الحاجة التجارية كانت أُمّ هذه المدرسة الجديدة من الاختصار المشوّه والإثارة المسيئة.
ظاهرة العناوين انتقلت من رأس الصفحة الأولى، أو من مقدمة النشرات، أو البرامج، إلى صلبها، وإلى مضمونها. فإن كان الاختصار والإثارة محمودين نظرياً في العنوان، فإن تطبيقهما على ما يلي في النص تشويهٌ متعمّد للفكر وللوعي. حتى أن جزءاً من النخب صار يفضّل القصير والصادم والمثير.
ولم يعد فن العناوين المثيرة مقتصراً على الأصفر من الإعلام، وعلى المقدمات والافتتاحيات، بل انتشر، بشكل واسع، حيث ساعد في انتشاره ثقافة السرعة المتفسبكة والمغرّدة. و”فيسبوك”، كما مرتاده، لا يحب الإطالة لتوضيح الفكرة، فتفقد المتابعة رونقها، ويصير الرأي يصرخ في الربع الخالي. أما التغريد على “تويتر” فهو محدودٌ في عدد الكلمات، ما يدعوك إلى كتابة ما قلّ ودلّ، أو لم يدلّ، لا فارق بينهما. المهم هو السرعة والاجتزاء.
صارت محاولة التخلص من ضرورة التحليل والتفسير والقراءة المعمّقة للمعنى حتمية العصر. وصارت الشعبوية الثقافية الإثارية تسمو على الطروحات المدعّمة والموثّقة والتحاليل المعمّقة. فأن يخرج “باحثٌ” متمكن لغوياً وخطابياً، ولديه أمثلة جذّابة ليس من الضروري التأكّد من صدقيتها، ليطرحها في “سلّة” واحدة من دون محاولة، ولو متواضعة، لربط الحدث المُعالج بسياقه التاريخي، فنٌ لا يتقنه إلا المحظيون الإعلاميون.
فعلى سبيل المثال، اتحفنا برنامج فضائي، يحوز على أعلى المشاهدات عربياً منذ سنوات، بعرض “حوار” بين الفيلسوف صادق جلال العظم، صاحب الفكر والتحليل الهادئ والعميق، مع داعيةٍ، نسيت اسمه لقوة ذاكرتي الانتقائية التي تتحاشى المُسيء والإساءة. في البرنامج الذي يغلب على حلقاته عنصرا الصراع والصراخ، والذي من المؤكد أن العظم كان قد أخطأ بقبول المشاركة فيه، أُفرغ في يده منذ المقدمة، ولم يستطع أن يوضّح أياً من أفكاره، أو يتابع أياً من جمله أمام كلام “مهاجمه”. ولم يكن ذلك بسبب “تآمر” أو شراكة مُدير الحوار فحسب، بل، وأيضاً، لدرجة الوقاحة العالية التي تميّز بها الداعية، وشراسة لغة الجسد ونبرة الصوت الجهوري المحارب، واعتماد العنوان المثير في كل جملة، من دون تطوير أية فكرة، أو مقابلة الطرح الهادئ بنقاش معمق. جرعات من التعنيف والتكفير والرذيلة الذهنية أوقعت العظم بالضربة القاضية في حلبةٍ، كان الحكم فيها متحيّزاً، أو في أحسن الأحوال، ضعيف المهنية. وبالطبع، خرج المشاهد العادي الذي يتعاطى هذا الصنف من “الثقافة” الإعلامية، من أمام هذا المشهد “الدموي” أخلاقياً، بخلاصة أن العظم كان ضعيف الحجة، ولم يكن قادراً على مجاراة الداعية المُدّعي علماً بالدين ومجادلته.
إنْ كان منطقياً أن يروق هذا النوع من الحوار للبعض الباحث عن الإثارة والتشويق، والذي انتقل إليه من مشاهدة مقاطع المصارعة الأميركية الكاذبة التي تحفل بها قنواتٌ عدّة، حيث ينهال فيها المتصارعون، ضرباً وهمياً على بعضهم، مثيرين المتابعين “السذّج” المحتشدين في الصالة وأمام الشاشة. فمن الغريب، أو المستغرب، أن يجتذب هذا الشكل من “الحوار” جزءاً من “النخبة”، والتي أضحت تفلسف قبولها وإعجابها لتبرّره. فهي ترى فيه مجاراة لضرورات عصر السرعة و”الفاست” فكر، إضافة إلى اعتباره عرضاً “لحقائق”، لا ينبغي أن “نخجل” منها. ومن ينقده، فهو منتم حكماً إلى الماضي.
لقد دفع نجاح مثل هذه البرامج أقنية عدّة للتمثّل، إضافة إلى إلغائها ما تبقى من برامج رصينة، كالتي تناقش كتاباً أو كاتباً، أو التي تستعرض فكرة بأبعادها المختلفة، مانحة الوقت لاستعراض مقوماتها ومؤيديها والمعترضين عليها، والخروج بخلاصةٍ تساعد المتلقي على بناء فكرته المستقلة، مستنداً إلى تغذية مناسبة فكرياً، منحته إياها وسيلة إعلامية، لا تحتقر ذكاءه، أو لا تبحث عن تجييشه، أو إثارته الرخيصة.
لقد صار هذا النوع الإعلام هو الأساس، وصارت مقاطعه الأكثر انتشاراً على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأضحت التعليقات الأكثر تسرّعاً والأقل تفكيراً والأشد إثارة جزءاً من صراع الديكة، وأبناء آوى. وصار التنافس بتعليقات شاتمة، أو محبّذة، أو مهينة لمن يطّلع على مقطع مجتزأ من سياقه، ليبدي الإعجاب، أو الاستياء من هذا المحاور، أو من ذاك. وانتقل التشويه من العنوان إلى المحتوى. إن في الإثارة على حساب الفهم والمفهوم، احتقاراً مبيناً للمنطق وللعقل.
العربي الجديد