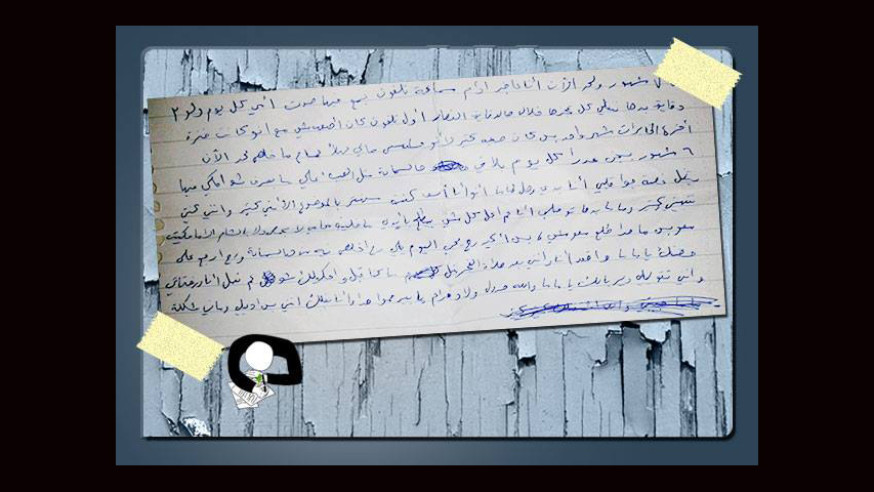يوميات البؤس السوري في لبنان
إبرهيم الزيدي
أعلم أن الكلمات تنقل صورة عن المعاناة، وقد تقصّر عن نقل الإحساس بها. فملامسة الحد الفاصل بين الدمعة والعين، تحتاج إلى مجازات لغوية لا تعرفها الصحافة. لكن هذا لا يعني أن تتحول مأساة اللاجئين السوريين إلى قضية لغوية؛ وتصل المتاجرة بهم إلى درجة الكتابة عنهم من أجل الكتابة!
كل الكائنات الحيّة تولد، وتولد معها خصائصها، إلا الإنسان، فإنه مطالَب بأن يثبت إنسانيته كل يوم، وقد أثبت العالم أنه ليس في هذا الصدد. منذ زمن طويل والعالم لا يهتم، ليس بمشكلات العرب أو المسلمين أو الأفارقة، بل لا يهتم بكل الشعوب المتأخرة عن ركب حضارته. كأننا لسنا أكثر من سوق لمنتجات تلك الحضارة. السوق ليست مقتصرة على ما نأكله أو نلبسه أو نستعمله للحاجة أو للمتعة؛ ثمة بضاعة أخرى، هي الأغلى، والأهم أيضاً. بيد أن تلك البضاعة لها مواسم خاصة، تسمّى الحروب، التي يجب أن تشتعل قبل أن تصدأ الأسلحة في مخازن السلاح. لذا ليس الوضع الإنساني في سوريا هو الأهم، بل الصواريخ الروسية، وتسليح المعارضة، وما إلى ذلك مما ينشغل به الرأي العام. أما أولئك الذين تحوّلوا من “مواطنين” إلى لاجئين، وتكدسوا في المخيمات وغير المخيمات، فاهتمام العالم بهم يقتصر على إحصاء أعدادهم، وتوثيقها، مما يحوّلهم أرقاماً، ولا عجب، فهذا شأن القتلى قبلهم.
¶¶¶
أحدّق في الكثير من العيون أمامي، لكنني أتجنّب تلك التي تعرض ضفافها بوضوح. سألت أبا عمر الذي انتحى مكانا قصياً عن الجموع المزدحمة في الشارع المفضي إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: كيف تتدبر أمورك هنا؟ لم يقل شيئاً. وضع لفافة تبغ بين شفتيه اللتين عجزتا عن الكلام، كأنه يداري ارتجافهما، وبالكاد سمعته يقول: على الله.
أبو عمر القادم من ريف دمشق، لم يعد لديه ابن يحمل اسم عمر، ولا زوجة كان اسمها فاطمة، ولا عمل، ولا بيت، ولا سيارة. لديه ابنة لا يتجاوز عمرها عشر سنين. كانت تجلس بعيدا منا، على الرصيف، تحتضن طفلا لا تزال في عينيه ظلال من المهد. لم تكن أم محمد القادمة من الوعر في ريف حمص، أفضل حالاً. فزوجها الذي لا تعرف عنه شيئاً، غيابه أثقلُ عليها مما تركه لها: أعباء أطفال ثلاثة لم تجد بدّاً من حملهم والفرار بهم من الجحيم.
بدأت مأساة أم محمد حين حوّلت الـ25 ألف ليرة سورية، التي بحوزتها، وهي كل ما تملك، إلى 180 دولاراً أميركياً. “والله يا أخي، الساتر الله، سترت علينا هالبطانيتين، واحدة نمدّها فوقنا وواحدة تحتنا، والله اللي اسمو الله، صرنا…”. ثم اختنقت في صدرها الكلمات. لم تخجل أم محمد من انتمائها إلى اللاجئين، لكنها غصّت بالبكاء. لقد خجلت من انتمائها إلى الجنس البشري، الذي يدّعي الإنسانية.
مشكلة اللاجئين السوريين ليست سياسية، أو عرقية، أو طائفية. إنها مأساة إنسانية، مسؤوليتها تقع على النظام والمعارضة في آن واحد، بعدما تجاوز العالم ضميره وإنسانيته في تعامله مع مأساتهم.
¶¶¶
استوقفتُ أبا جاسم الذي نزح من قرية الموحسن في ريف دير الزور إلى الرقة. وحين سقطت الرقة من يد النظام وأصبحت هدفاً للطائرات وراجمات الموت، غادرها إلى دمشق، وحطّ رحاله في حديقة الطلائع، القريبة من منطقة الفحامة. هو كما يقول: رجل وحيد، لا مال ولا عيال، ما بتفرق. حديقة. خيمة. وين ما كان. لكن نذير الموت لحقه إلى هناك، فلجأ إلى لبنان واتخذ من حي السلّم، في الضاحية الجنوبية، مأوى له. في كل يوم يستوقفني أبو جاسم، فأقدّم له سيجارة. يسألني: شنون (كيف) الوضع؟ من دون أن ينتظر جواباً مني. إلا أنني هذه المرة، خالفتُ القاعدة في لقائي معه، فقدّمت له السيجارة، وسألته مازحاً: ما قلتلّي انت مين يمثّلك؟ قال: ما فهمت عليك شو قصدك؟ فقلت: في ناس بيمثّلهم النظام، يعني أنهم مع النظام، وفي ناس بتمثّلهم المعارضة، يعني أنهم مع المعارضة. انت مين يمثّلك؟ أجابني بدماثته المعهودة: أنا – ووضع راحة يده على صدره – يمثّلني أبو حسين، كل يوم يحسب حسابي بسندويشة فلافل. أربكني هذا الانتماء للقمة العيش، فهو بقدر واقعيته الساخرة المريرة خطير أيضاً.
¶¶¶
في الطريق إلى صبرا صادفتُ ستة أطفال، استرعت انتباهي لهجتهم السورية. تقدمتُ منهم مبتسما، فاستأنسوا بي. سألتهم: من أين أنتم؟ أجابني كبيرهم الذي لا يتجاوز عمره الـ 14 عاماً: هاد (هذا) أخي – وأشار إلى أحد أطفال المجموعة – وهدول ولاد عمي، نحنا من حلب. طلبتُ من صديقي الذي تطوّع لمرافقتي في رحلة البحث هذه، أن يلتقط لي صورة معهم، فانفضّوا عني، وتفرّقوا ما إن رأوا الكاميرا، كأنما قد شُهر بوجوههم سلاح. لم أستغرب موقفهم. فكل من التقيتُ بهم لم يوافق أيٌّ منهم على أن تصبح مأساته صورةً يتفرج عليها العالم.
إحدى العائلات السورية التي تقاسمت مقعداً على رصيف الروشة، اختصرت موقفها سيدةٌ متقدمة في السن، كانوا يلتفّون حولها، حين قالت: الله يخلّيك، اتركنا بحالنا. كأن حالهم غير حالي.
لم يصل اللاجئون السوريون إلى مرحلة الثقة في ما بينهم، والى الشعور بمصيرهم المشترك. ثمة الكثير من العقبات تحول دون ذلك. فالنظام الأمني الذي عايشوه عقوداً خمسة، جعل الشك والريبة والحذر من سمات الشخصية السورية، وخصوصاً في ما يتعلق بالدولة، والأمور السياسية، علماً أن وضعهم نتاج السياسة في سوريا، وليس سببها. فرجل الأمن يفترض أن يحضر معه الأمان، أما في سوريا فإن حضوره تجسيد للقهر والخوف.
¶¶¶
لم تعد مجدية الحيل اللغوية للخروج من المواقف المأسوية. في الغربة تأخذ المكاشفات شكل السخرية المرة التي لا يرافقها الضحك.
التقيتُه إلى فنجان قهوة عند أحد الأصدقاء في حي السلّم. استغربتُ وجوده في لبنان، فسألتُه ما الذي أتى بك الى هنا؟ قال: مطلوب. فسألته: لمن؟ قال: لـ”الجيش الحر”. هذا اضطرني لملاحقته بالاستفسارات: لماذا؟ فقال: لأنني شبّيح. اضطربت الكلمات بين شفتي، وساد الصمت الذي قطعه بقوله: المشكلة أنني لا أتقن أيّ نوع من أنواع العمل، سوى الصحافة، ليس أي صحافة، بل فقط تلك الصحافة التي تعرفها وليس لها سوق هنا. حاولتُ أن أشتغل عاملاً في إحدى ورشات البناء، فلم أعمل اكثر من يوم واحد، مرضتُ على أثره مدة أسبوع. لم يبق أمامي سوى الانتظار. تركتُ التدخين، واختصرتُ المصاريف التي يمكن اختصارها، وأقمتُ مع مجموعة من أقاربي هنا في حي السلّم، وعلى الله.
¶¶¶
في موسم الخوف هذا، لم تكن الطريق مفتوحة للسوريين وحدهم. فالفلسطينيون المقيمون في سوريا سلكوا الطريق نفسها. الغربة التي أصابتهم في نزوحهم القديم استيقظت من جديد. في المرة الأولى أخذت شكل الاقتلاع. أما غربتهم هذه، فجاءت لتثبت أن كل من يُقتلع من أرضه لا يمكن أن ينبت في أرض أخرى، مهما مكث فيها. إن في ذلك، برغم قسوته، إعادة تأهيل لفكرة الوطن، باعتباره مركز الكون. مشكلتهم لا تقتصر على ما حصل ويحصل في مخيم اليرموك الدمشقي، وإن كان قد استحوذ على الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء. مأساتهم هي مأساة الشعب السوري نفسها. يحدث الاختلاف في تشخيص نتائجها وأبعادها. أبو محمد الفلسطيني خير مثال على ذلك. لا أحد يعرف اسمه الوارد في بطاقته الشخصية. إنه الفلسطيني وحسب. وحين تقدّم به العمر أصبح أبا محمد الفلسطيني. هو أفضل نجار موبيليا في الرقة التي لا يوجد فيها مخيمات للفلسطينيين، على غرار دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودرعا.
منذ سبعينات القرن المنصرم، يقيم أبو محمد الفلسطيني في الرقة. في السنة الثانية من الثورة، رحل إلى دمشق. لم يمكث هناك سوى بضعة أشهر، ثمّ غادرها إلى بيروت. التقيتُه بمحض المصادفة قبل مغادرته إلى طرابلس. أخبرني أن ما حمله معه من نقود، لم يتجاوز 1200 دولار وهي لا تساوي شيئاً لأسرة غير متعودة على غلاء المعيشة وارتفاع إيجار البيوت في لبنان.
والله أنا عندي استعداد أنام بالمقبرة – قال أبو محمد – ما عندي مشكلة. المشكلة مشكلة العيلة والأولاد، عم بيقولو في مخيمات للاجئين بطرابلس، بدّي أروح أشوف.
– ومدارس الأولاد؟
– يا أخي، أي مدارس، أي بطيخ، شو يعني، مشـان ياخدو البكالوريا نبعتهم عالموت؟!
بهذه البساطة يلخص أبو محمد مأساة اللاجئين. فالخيار هو بين الموت والحياة فقط. الانحياز إلى الحياة هو الذي دفع السوريين والفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأعمالهم وأحلامهم، ليصيروا مشردين.
¶¶¶
في الضفة الأحرى لنهر البؤس السوري هذا، ثمة من هو متماسك، أو لا يزال متماسكا. فليس كل اللاجئين السوريين في لبنان تحت رحمة المحسنين. فالعائلات التي حملت معها في رحلة التشرد ما يكفي لإقامة مشاريع صغيرة، استقرت في المدن اللبنانية، وباشرت تلك المشاريع (محلات، مطاعم) وغير ذلك. ثمة أسر بين أفرادها أيد عاملة، هي الأخرى انطلقت في رحلة البحث عن عمل. لكن انهيار العملة السورية، وعدم قدرة السوق اللبنانية على استيعاب العمالة السورية، تركا الكثير من العائلات في حال خوف مما سيؤول إليه مصيرها بعد نفاد مدّخراتها.
أما أولئك المترفون الذين ارتفع بفضلهم بدل إيجار الشقق المفروشة في لبنان، فإن أوضاعهم تستدعي من الذاكرة قولاً قديماً: “سادتنا في الجاهلية، سادتنا في الإسلام”.
النهار