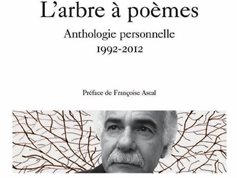رضوان السيد والصراع على الدين داخل الإسلام السني/ محمد تركي الربيعو

في سياق قراءته لتجربة الحركات الإحيائية والإسلام الحزبي في العالم العربي، خلال المئة سنة الماضية، يقدم المفكر العربي رضوان السيد في كتابه «أزمنة التغيير: الدين والدولة والإسلام السياسي» قراءة غنية ومحفزة على إعادة النظر من جديد في مشروعه؛ سواء على صعيد دراسته لعلاقة الإسلام بالدولة في الأزمنة الحديثة، أو على مستوى إعادة قراءته العميقة لتاريخ النظرية السياسية في التراث الإسلامي.
ورغم أن مشروع السيد لم يطو وما زال فاعلاً في عدد من الدوائر البحثية والمؤسساتية، إضافة إلى أنه من أهم المتابعين للدراسات الغربية الحديثة حول الإسلام وعالم المسلمين اليوم، كما يحظى السيد بمكانة مهمة داخل هذه الأوساط، إلا أن المثير للاهتمام هو أن الجيل الجديد من القراء والباحثين في تاريخ الإسلام والسياسة (خاصة جيل ما بعد الربيع العربي إن صح التعبير) بات أكثر اهتماماً بكتابات بعض الأكاديميين الغربيين المشغولين بمسألة نقد المنظومة الحداثية الغربية، كالاهتمام اللافت للنظر في الثلاث سنوات الأخيرة (بعيد عودة الجيش إلى السلطة في مصر، وبقاء الأسد في السلطة) في أطروحات وائل حلاق أو بعض كتابات الأنثروبولوجي الباكستاني طلال أسد، خاصة داخل بعض الأوساط السلفية والإسلامية، أو العلمانية الشابة، رغم أن أي مراجعة دقيقة لمشروع السيد خلال العقود الأربعة الأخيرة تبين لنا أن السيد سبق حلاق مثلاً في رؤيته لعلاقة الدين بالدولة في التجربة الإسلامية الكلاسيكية، أو حتى على مستوى التغييرات المفاهيمية التي أحدثها أو تخيلها الإسلاميون حيال طبيعة هذه العلاقة، وهذا ما ظهر منذ كتبه الأولى «الأمة والجماعة والسلطة» أو «الجماعة والمجتمع والدولة»، أو من خلال تحقيقاته لبعض كتب التراث الإسلامي، مثل كتاب «قوانين الوزارة وسياسة الملك» للماوردي، كما استمر ذلك لاحقاً من خلال أبحاثه وكتبه، أو من خلال مشاركته وإشرافه على ترجمة بعض الكتب المهمة، مثل كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي» للباحث في جامعة برينستون مايكل كوك، الذي بين فيه كوك من خلال دراسته لعبارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي ترد في القرآن في أكثر من سياق، كيف أن هذه العبارة قد وفرت مدخلاً مناسباً للمسلمين في التجربة الإسلامية الكلاسيكية، للمساهمة في الخير العام والتدخل من أجل التصحيح، وبالتالي فإن المدينة العربية لم تأنس الطاعة، والنمط النبوي ما كان سائداً في التجربة الإسلامية الكلاسيكية، على عكس المقاربات التي سعى بعض المفكرين العرب إلى تمثلها حيال المدينة العربية الكلاسيكية في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات، نتيجة تأثرهم بتضخّم الدولة العربية (وفق تعبير نزيه أيوبي) وعدم قدرة الشارع على إزالة ظلمها (رغم أن الشارع لم يأنس للدولة الاستبدادية ولطالما واجهها بأشكال عديدة، مثلما بيّن تشارلز تريب في كتابه الأخير «السلطة والشعب: مسارات المقاومة في الشرق الأوسط»). كما شارك السيد أيضاً في ترجمة أطروحة نيمرود هورفيتز (أحد تلامذة مايكل كوك) تحت عنوان «ابن حنبل وتشكل المذهب الحنبلي». التي قدّم فيها هورفيتز من خلال دراسته للمصادر الحنبلية قراءة جديدة لمحنة خلق القرآن، إذ يرى الأخير أنه من بين الخمسمئة تلميذ لابن حنبل الذين ذكرتهم المصادر الحنبلية ليس هناك سوى واحد وهو أحمد بن نصر بن مالك الخزعلي (ت231) قيل إنه شارك في النشاطات السياسية. كما أن سياسات الخلافة كانت خارج تطلعات الحنابلة. ووفقاً لرضوان السيد في قراءته لهذا الكتاب، فإن موقف ابن حنبل من مسألة خلق القرآن لم يكن قائماً على موقف ديني متشنج، أو أنه «أموي الهوى» كما أشار إلى ذلك فهمي جدعان في كتابه «المحنة» (خاصة أن ابن حنبل قبل مسألة خلق القرآن وبعدها لطالما جادل المعتزلة والمرجئة والقدرية)، بيد أن تدخل السلطة ومحاولتها فرض عقيدة دينية، دفعت ابن حنبل إلى أخذ موقفه العقدي المشحون برمزية رافضة لتدخل السلطة في عقائد الناس أو أحكام القضاة، الأمر الذي يعني ـ برأينا- الدفاع عن دور الأفراد العاديين في تكوين عملية التراث، بعيداً عن رقابة السلطة. ولعل هذه الرؤية الجديدة لعلاقة العامة بالسلطة، أو حتى على مستوى قراءات السيد للتراث السياسي الإسلامي، تتقاطع إلى حد كبير مع ما وصل إليه مثلاً وائل حلاق (رغم الملاحظات العديدة للسيد على رؤية حلاق الأخيرة) في سياق قراءته للتجربة الإسلامية الكلاسيكية ومقارنتها لاحقاً بتجربة الدولة الحديثة، وربما ما ميز حلاق في كتابه الأخير هو اعتماده على الرؤية الفوكودية (كما فعل إدوارد سعيد) لقراءة نشأة السياسة الحديثة، وهو ما ظهر بشكل عميق في الفصل الرابع من كتابه «الدولة المستحيلة» الذي تطرق من خلاله إلى التحولات التي جرت على مستوى «تقنيات الذات» في فترة الحداثة وما قبلها، بداية بتصور الغزالي عن «تدريب النفس» إلى «تقنيات الجسد» التي أخذت تميز الفترة الحديثة. مع ذلك ورغم هذه التقاطعات، لا بل وأسبقية السيد في الوصول إلى هذه النتائج، فإن ما نلحظه هنا هو أن العديد من الأوساط الإسلامية والسلفية بدت في سنوات ما بعد الثورة أكثر اهتماماً بطروحات حلاق، أو طلال أسد وبعض الأنثربولوجيين مقارنة بطروحات السيد، وقد يكون هذا الأمر مفهوماً، كون خطاب الأخير لطالما بقي أقل جذرية تجاه المنظومة القيمية الغربية، مقارنة بكتابات التيار السابق، وربما لحداثة هذا الجيل أيضاً، وإن كنا نظن أن السبب الأساسي يعود إلى أن السيد لا يرى أن الصراع اليوم في المنطقة هو صراع على الإسلام بين الغرب والأصوليين والدول العربية المستبدة، بل هو في قلب الإسلام ذاته، بين الذين يريدون أن يبقى دينهم على سويته كمعطى ثقافي واجتماعي داخل الحياة اليومية، وبين من يسعى إلى إدخال الدين في بطن الدولة باسم الهوية. دون أن يعني ذلك أن الرجل يتغاضى من خلال كلامه هذا عما يحدث اليوم من مذابح بحق الناس في سوريا ومصر مثلاً، لا بل على العكس من ذلك، إذ من الملاحظ انشغال السيد في السنوات الأخيرة بالدفاع عن الثورات العربية وتحليل أحداثها اليومية على حساب مشروعه الفكري. بيد أن ذلك لم يمنع السيد وفي مناسبات عديدة من القول إن السعي للحكم الصالح في البلدان العربية يجب أن يترافق أو يتوازى مع القيام بإصلاح ديني جذري عبر «نقد التحويلات الشاسعة التي أحدثها الإسلاميون في مفهوم الدين والتدين، وفي علاقة الدين بالدولة، وفي تجديد وفتح التقليد الديني، بحيث تتصدر المؤسسات الدينية لمهماتها الباقية والضرورية في التعليم والفتوى، وفقه العبادات وفقه العيش، وإعادة المشهد الديني إلى سويته» (أزمنة التغيير).
ولفهم أدق لرؤية السيد الأخيرة، يمكن هنا أن نعود إلى كتابه الذي ذكرناه في البداية (أزمنة التغيير والذي صدر سنة 2014). إذ يرى السيد أن الإصلاحية الإسلامية سعت منذ الربع الأخير في القرن التاسع عشر لتجاوز التقليد وفتح باب الاجتهاد، ولذلك لم تنظر إلى الدين بوصفه مهدداً من الخارج، بل هو مهدد نتيجة الجمود في حركة التفكير، أما التهديد الأكبر –بالنسبة لها– فقد كان يتمثل في واقع الدول والمجتمعات الإسلامية التي ينبغي أن تمضي في سبل التقدم التي مضى فيها الغربيون لكي تنجو من العواصف الغربية الهائجة. بيد أن هذه الاستجابة ما كانت سريعة، لتتفاقم الأمور لاحقاً في ظل قدوم الاستعمار وسقوط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة لاحقاً في سنة 1924، التي مثلت برأي السيد مرحلة جديدة في سياق الوعي المتأزم الناجم عن السيطرة الاستعمارية على العوالم غير الأوروبية ومنها العالم الإسلامي، والتي عنت انتقالاً من إشكالية الإصلاح في السياق الأوروبي بغرض التقدم بالمعنى الغربي، إلى إشكالية الهوية والخصوصية. وفي هذا السياق يشير السيد إلى ملاحظات تشارلز آدمز في كتابه «الإسلام والتجديد في مصر» 1933، الذي بين كيف أن مئات الجمعيات التربوية والاجتماعية ظهرت عشية الحرب العالمية الأولى وفي أثناء العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومن ضمنها جمعيات: «الشبان المسلمين، والإخوان المسلمين، وإحياء السنة، والجمعية الشرعية والشبيبة الإسلامية في بلاد الشام). وقد اختلط في هذه الجمعيات والجماعات الديني بالقومي والوطني والمحلي والخيري والاجتماعي، وبالتدريج وخلال فترة قصيرة انفصل الديني الإحيائي عن الوطني والقومي، فالحركات الوطنية والقومية انصرفت لاستعادة الشرعية من طريق الكفاح من أجل الاستقلال وإقامة السلطات الوطنية، أما النزعة الإحيائية الإسلامية فقد انقسمت إلى قسمين: الإحيائية السلفية التي استكانت إلى قيام الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود، والإحيائية الأصولية خارج المملكة العربية السعودية التي انصرفت إلى بناء شرعية بديلة عبر الجمعيات التي تعتمد أسلوب بيعة المرشد، فصار التنظيم هو المحور أو هو الدائرة التي تعتصم بها الشرعية التي يراد بناؤها.
وقد عرفت الحقبة الممتدة من الثلاثينيات إلى الستينيات اكتمال مقولات الحاكمية وتطبيق الشريعة، وهو ما أخذ يعني «تحولاً مرعباً»- وفقاً لتعبير السيد- في المنظومة المفاهيمية ضمن إسلام أهل السنة والجماعة، بإحلال الشريعة محل الأمة، وإحلال التنظيم محل العقيدة، واعتبار التنظيم مكلفاً بتزعم النظام لإعادة الشريعة والشرعية إلى الدولة والمجتمع. وبذلك صار الموضوع الوهمي الثابت في أخلاد فئات واسعة من العامة والمتعلمين المتدينين، إنما هو استعادة الدين أو استكمال ما نقص منه نتيجة التغريب (بعكس مرحلة الإصلاحية التي لم تكن تخاف على الدين سوى من الجمود)، ووفقاً لهذه الرؤية فإن مهمة الدولة الأساسية تصبح في تطبيق الدين أو شريعته، ويصبح الدين بيد المسيطرين في النظام السياسي. بينما كانت أكبر شكاوى تاريخنا الديني والسياسي هذا الأمر بالذات، أي وضع الدين بيد السلطة السياسية بحيث تستخدمه كيف شاءت (وهو أمر أشرنا إليه سابقاً في رؤية السيد لموقف ابن حنبل من مسألة خلق القرآن)، وسواء أكانت ذات أيديولوجية دينية أم مدنية أم بين بين، فإن أي جهة تحصل على شرعية باسم الدين تصبح قوتها مطلقة، فتفسد الدين من جهة، وتفسد إدارة الشأن العام من جهة أخرى.
وفي هذا السياق يتساءل السيد: من أين أتى اعتبار النظام السياسي ضرورة للدين أو ركناً من أركانه؟ فهذا الأمر كان موجوداً لدى الشيعة الإسماعيلية والاثني عشرية، لكنه ليس موجوداً لدى أهل السنة والجماعة، وهم سواد المسلمين الأعظم. فعلماء الكلام المسلمون من السنة والمعتزلة، وفقهاء المذاهب الكبار جميعا لطالما اعتبروا الإمامة أو رئاسة الدولة شأناً مصلحياً وتدبيرياً واجتهادياً، لا علاقة له بالتعبديات ولا بالعقائديات، أما في أطروحة الحاكمية والنظام الكامل فإن الشأن السياسي صار شأنا اعتقادياً، ويمكن أن يحكم على من لا يقول به بالكفر. ورغم أن السيد يؤكد على أننا قد عانينا وما نزال من ديكتاتوريات الجمهوريات الوراثية، إلا أن الإسلام السياسي خلق مشكلة مستعصية داخل الإسلام ذاته، من خلال تغييره لمفهوم الدين داخل الإسلام السني، ولذلك يرى أننا بأمس الحاجة اليوم إلى حركة نقدية لمسألة «تحويل المفاهيم» التي مارسها الإسلاميون لأكثر من نصف قرن، فأوشكت أن تغير من طبيعة الدين، وأن تتسبب في انشقاقات اجتماعية ودينية عميقة، ذلك أن الالتباسات لم تعد تقتصر على وضع الدين في خدمة الدولة، أو الدولة في خدمة الأحزاب الدينية، بل أنها باتت تشمل تغيير علائق الأفراد بدينهم صغاراً وكباراً.
٭ كاتب سوري
القدس العربي